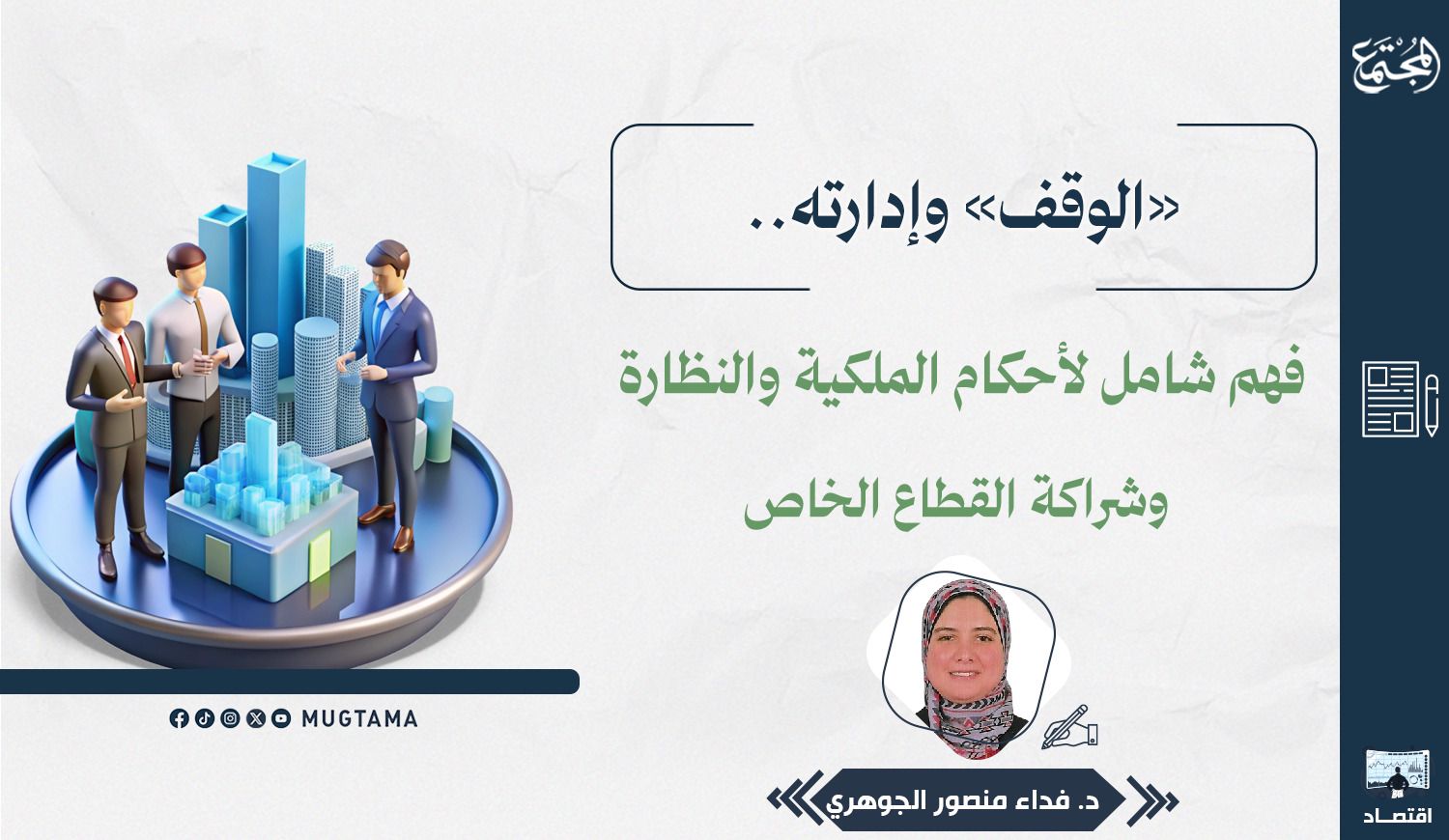4 مسائل في الوقف الإسلامي

يعتمد
النظام الاجتماعي في الإسلام في المقام الأول على فكرة التكافل والإنفاق في سبيل
الله عبر القنوات الشرعية المعروفة، بدءًا من الفريضة وانتهاءً بالفضل والصدقات،
مرورًا بالوقف. فالغني يحمل الفقير؛ لما له في ماله من حقوق فرضها الله عز وجل
عليه في الزكاة الواجبة، فالعطاء ليس منة ولا تفضلًا من الغني على الفقير، وإنما
هو فريضة عليه وحق يؤديه في مال استخلفه الله عز وجل فيه.
يقول
تعالى في الجمع بين فريضتي الصلاة والزكاة مؤكدًا أهمية كل منهما: (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ
مَعَ الرَّاكِعِينَ) (البقرة:43).
ويقول
سبحانه: (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ
الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ)
(البقرة:110)
ويقول
عز وجل: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ رَاكِعُونَ) (المائدة:55)
وقد
جعل الله الإنفاق على السائل والمحروم من أسمى صفات عباد الله المحسنين، فقال عنهم:
(إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ *
كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)
(الذاريات:16-19)
ووعد
سبحانه بالإخلاف على من أنفق في سبيله، فقال: (وَمَا
أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (سبأ:39)
ووعد
بمضاعفة العطية للمنفقين بأعظم مما أنفقوا أضعافًا كثيرة، فقال سبحانه: (مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً) (البقرة:245)
وقد
حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإنفاق ودفع المسلمين إليه دفعًا، وهو من أعظم
أسباب بركة المال، وزيادة الرزق، وإخلاف الله على صاحبه بما هو أحسن. قال الله جل
وعلا في الحديث القدسي: «يا ابن آدم، أَنفقْ أُنفقْ عليك» (رواه مسلم)، وجعلها
الله عز وجل وقاية وحجابًا بين العبد وبين النار، فقال نبي الله صلى الله عليه
وسلم: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» (رواه البخاري).
ومن أوجه الإنفاق الهامة في الإسلام هو الوقف الإسلامي، وقد قام به العديد من الصحابة رضوان الله عليهم، واستمر على مدى التاريخ الإسلامي كله، وساهم بشكل كبير في استمرار الإنفاق في أوجه الخير على الفقراء والطلاب وأعمال خيرية تنفع المسلمين في كل بقاع بلادهم. فما هو الوقف الإسلامي، وما أهميته؟
أولا: تعريف الوقف الإسلامي[1]
(1) الوقف لغةً: الوقف
لغة معناه الحبس والمنع، فيقال: وقفت، بمعنى حبست، واستبداله بكلمة
"أوقفت" يعتبر لغة رديئة وغير مقبولة.
الوقف اصطلاحًا: حبس العين عن تمليكها لأحد من
العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح، والعين إما أن تكون دارًا أو بستانًا أو
نقدًا.
الفرق بين التبرع والوقف: أن الوقف تبرع
دائم؛ لأن المال الموقوف ثابت لا يجوز بيعه ولا التصدق به ولا هبته، وإنما يتم
التبرع فقط بغلته وريعه ويصرف في الجهات التي حددها الواقف.
أما
التبرع فهو بذل المال أو المنفعة للغير بلا عوض بقصد البر والمعروف، وللتبرع صور
كثيرة منها: الصدقة، والهبة، والوصية، والقرض، والوقف، والكفالة.
والوقف
عمل ناجز في الحياة تقر عين صاحبه به؛ وذلك أنه يباشره بنفسه ويرى آثاره الطيبة.
وقد سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقات أفضل؟ فقال: «أن تتصدق وأنت صحيح
شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت: لفلان
كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان». ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية،...» (رواه مسلم).
ثانيًا: الوقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
اختلف
العلماء حول تحديد أول وقف في الإسلام وذلك في عهد النبوة الكريمة، فقال أبو بكر
الخصاف: «وقد اختلف علينا في أول صدقة كانت في الإسلام فقال بعضهم: أول صدقة كانت
في الإسلام صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم السبعة الحوائط، ثم من بعد ذلك
صدقة عمر بثمغ عند مرجع الرسول صلى الله عليه وسلم السنة السابعة من الهجرة» (2).
وعن
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها
ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: «من يشتري بئر رومة فيجعل منها دلوه مع دلاء
المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي» (رواه البخاري).
ثالثًا: الوقف عبر العصور الإسلامية
ومن
أهم العصور التي ازدهر فيها الوقف الإسلامي بعد العصر النبوي الذهبي، هو عصر
الصحابة، حيث ازدهرت كافة مقومات الحضارة الإسلامية، ومثلت التطبيق الأمثل لمقاصد
الشريعة، حيث قيم العدل والرحمة والتكافل والأخوة والمحبة بين المسلمين، ومثل
الصحابة النموذج النوراني المتكامل في تطبيق تعاليم القرآن وتعاليم السنة المطهرة،
فقد أوقف عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وتصدق علي بن أبي طالب والزبير بن العوام
ومعاذ بن جبل وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عامر، وكذلك أمهات المؤمنين رضي الله عنهم
أجمعين.
يقول
الدكتور راغب السرجاني: «وعلى هذا المنوال سار الخلفاء والأمراء في بقية العصور
التالية للخلافة الراشدة، ففي الخلافة الأموية شهدت الأوقاف الإسلامية تطورات
ملموسة، فقد كان الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك أول من اتخذ المستشفيات
للمرضى، وبنى الجامع الأموي وأمر بتسهيل الثنايا وحفر الآبار الموقوفة، واهتم
خلفاء بني أمية ببناء الجسور والقناطر وجعلوا لها أوقافًا، فقد أمر عمر بن عبد
العزيز ببناء قنطرة في قرطبة، كما اهتم الأمويون ببناء المقاييس على الأنهار
الجارية، ومن أشهرها مقياس حلوان في مصر الذي بناه عبد العزيز بن مروان في خلافة
أخيه عبد الملك بن مروان» (3).
ويشير
السرجاني لاستمرار الوقف في التاريخ الإسلامي وإقبال أثرياء المسلمين عليه، بل لقد
قام به بعض فقرائهم في حدود ما يمتلكونه، ومنهم من أوقف بعض أملاكه لصالح ذريته
وليس لنفسه فقط، وتميز بالوقف الصحي في الدولة العباسية على سبيل المثال، فيقول في
نفس الكتاب: «أما في الدولة العباسية فقد اهتمت مؤسسة الخلافة بالوقف الصحي
اهتمامًا بالغًا، فانتشرت المستشفيات واستقدم الخلفاء كبار الأطباء وقاموا بشراء
كتب كبار علماء الطب ووقفها في المستشفيات العامة، كما اهتموا بإنشاء الأوقاف
الدينية والخيرية والاجتماعية والاقتصادية، وكان للعلماء ورجال الأعمال دور كبير
في المساهمة في الأوقاف العامة والخاصة، ومن الأمثلة على ذلك الإمام الواعظ عبد
الملك بن محمد الخركوشي النيسابوري الذي بنى مدرسة ودارًا للمرضى، ووقف الأوقاف،
وكانت له خزانة كتب موقوفة» (4).
ويعتبر
السلطان صلاح الدين الأيوبي من أشهر السلاطين الذين أحيوا سنة الوقف العلمي، فبنى
مدرسة بالقاهرة وأنشأ المدرسة الصلاحية الوقفية العظيمة في القدس، وبعد صلاح الدين
الأيوبي حرص أمراء الأيوبيين على إنشاء المدارس الموقوفة، فبنى الملك العادل
مدرسته المشهورة (المدرسة العادلية في دمشق)، واهتم الأمير نور الدين محمود بإنشاء
مستشفيات خيرية في كل المدن التابعة لدولته، ومن غريب الأوقاف وأجملها قصر الفقراء
الذي عمره في ربوع دمشق نور الدين محمود زنكي.
رابعًا: وظيفة الوقف عبر التاريخ الإسلامي
(5) لم يكن الوقف الإسلامي فكرة مجردة سطعت في فكر أحد من المسلمين، وإنما كان جزءًا من الشريعة اهتم بها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت النصوص مؤكدة أهمية الوقف لاستقامة الحياة المجتمعية داخل الدولة المسلمة، ومؤكدة كذلك على العائد الكبير على فاعله، والأجر العظيم والمكانة الراقية التي يتبوأها عند رب العالمين. قال تعالى: (وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ) (البقرة:272)، وقال سبحانه: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً) (البقرة:245)، (لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) (آل عمران:92).
ومن
تلك النصوص انطلق المسلمون لتفعيل الوقف وتوجيهه لخدمة مجتمعاتهم بشكل يحقق مصلحة
المسلمين، خاصة الفقراء منهم، ومن هذه الوظائف:
1. في مجال العلم
والتعليم: فتم تأسيس الجامعات والمدارس من خلال الأوقاف، مثل
الجامع الأزهر في مصر والمدرسة النظامية في بغداد، بل وحتى جامعة القرويين في فاس،
وهي أقدم جامعة في العالم، كانت موقوفة.
2. في مجال الرعاية
الصحية:
حيث أنشئت المستشفيات "البيمارستانات" من خلال أوقاف خصصت لعلاج المرضى،
مثل بيمارستان نور الدين في دمشق، والمستشفيات في القاهرة وإسطنبول.
3. في مجال رعاية
الفقراء: وتعددت أشكال تلك الرعاية ما بين أوقاف إطعام
المحتاجين، وأوقاف لتزويج من لا يستطيع تكاليف الزواج، وأوقاف لرعاية الحيوانات،
وأوقاف لتحرير الأسرى الذين لا يستطيعون دفع تكاليف تحريرهم.
4. في المجال الاقتصادي: حيث
أوقفت الأراضي الزراعية والمحال التجارية لينفق ريعها على المجالات السابق ذكرها
بالإضافة إلى بناء الجسور والطرق والمساجد.
ويضاف
إلى تلك المصارف العشرات من الصور الأخرى التي ميزت دولة الإسلام عن غيرها من
الحضارات، ليظل الوقف الإسلامي هو الصورة المشرقة الأكبر في تاريخ الأمة، والذي
يمكن أن يعيدها سيرتها الأولى إذا أحسن توظيفه وتوجيهه والاهتمام بشأنه، فلا يجوع
مسلم أو غير مسلم في بلاد المسلمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف التجارية تحت عنوان: تعريف الوقف.
(2)
أحكام الوقف، ص 2.
(3)
من كتاب روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية للدكتور راغب السرجاني.
(4)
المصدر السابق.
(5)
بحوث مجلة الوقف والتنمية – وزارة الأوقاف الكويتية.