يتأسس النظر الشرعي في هذه النازلة على عدد من النقاط: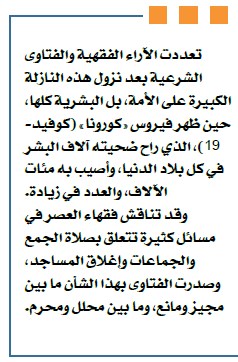
أولاً: تقرير فرضية صلاة الجمعة على كل مسلم بالغ عاقل مقيم حر ذكر، وهي فرض عين لا يسع مسلماً تركُها، وحكى الخطابي عن بعض الفقهاء: أن صلاة الجمعة فرض على الكفاية، وقال القرافي: هو وجه لبعض أصحاب الشافعية، وذهب مالك، والشافعي في الجديد، وأحمد، أنها فرض مستقل وليس الظهر بدلاً عنها، ولا هي بدل عن الظهر، وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إن فرض وقت الجمعة في الأصل إنما هو الظهر، إلا أن من تكاملت فيه شرائط الجمعة الآتي ذكرها فإنه مأمور بإسقاطه وإقامة الجمعة في مكانه على سبيل الحتم، أما من لم تتكامل فيه شرائطها، فيبقى على أصل الظهر.
ثانياً: زمن فرضها مختلف فيه بين قائل بمكة وقائل بالمدينة، ومن قال بمكة قرر ثبوت صلاة أسعد بن زرارة بالمدينة قبل هجرة النبي، وكان يترحم عليه كلما أقام الجمعة، وصلى أسعد بنفر قليل، وعللوا عدم إقامة النبي لها بمكة بعدم توافر كثير من شرائطها، ومنها أن شعارها الإظهار، وكان صلى الله عليه وسلم مستخفياً فيها.
ثالثاً: الحكمة من مشروعيتها، قال الدهلوي في حجة الله البالغة: «إنه لما كانت إشاعة الصلاة في البلد بحيث يجتمع لها أهلها متعذرة كل يوم، وجب أن يعين لها ميقات لا يتكرر دورانه بسرعة حتى لا تعسر عليهم المواظبة على الاجتماع لها، ولا يبطؤ دورانه بأن يطول الزمن الفاصل بين المرة والأخرى، كي لا يفوت المقصود وهو تلاقي المسلمين واجتماعهم بين الحين والآخر، ولما كان الأسبوع قدراً زمنياً مستعملاً لدى العرب والعجم وأكثر الملل، وهو قدر متوسط الدوران والتكرار بين السرعة والبطء؛ وجب جعل الأسبوع ميقاتاً لهذا الواجب»(1).
رابعاً: هناك شروط للصحة والوجوب معاً، وشروط للصحة فقط، وشروط للوجوب فقط(2):
فأما شروط الصحة والوجوب معاً:
1- أن تقام في المصر وتوابعه، ومن لم يكن فيهما فلا يطالبون بإقامتها ولا تصح منهم الجمعة وهذا شرط الحنفية، ولم يشترط غيرهم ذلك؛ فالمالكية اشترطوا أن تقام في مكان مستوطن صالح للعيش، والشافعية اشترطوا أن تقام في خطة أبنية سواء أكانت بلدة أو قرية، والحنابلة أجازوا إقامتها في الصحاري فضلاً عن البلدان والقرى.
2- أن تكون بإذن السلطان أو حضوره أو حضور من ينيبه، وهو شرط الحنفية، ولم يشترط غيرهم هذا الشرط لا إذناً ولا حضوراً ولا إنابة.
3- دخول الوقت، ووقتها عند الجمهور غير الحنابلة وقت صلاة الظهر، ولا تصح الصلاة إن بدأ الإمام الخطبة قبل دخول وقت الظهر، ونهاية الوقت دخول وقت العصر، ولا تُقضى صلاة الجمعة، بل تُصلى ظهراً عندئذ، والحنابلة يرون أن وقتها هو أول وقت صلاة العيد.
وأما شروط الوجوب، فلم يختلف فيها الفقهاء، وهي: الإقامة، الذكورة، الصحة البدنية، الحرية، السلامة من العاهات المقعدة عن الذهاب، على تفصيل فيه. 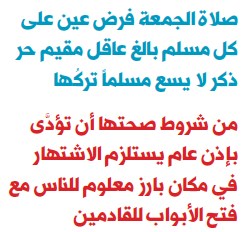
وأما شروط الصحة:
1- الخطبة.
2- الجماعة، وفيها الخلاف المعروف في العدد، فالحنفية قالوا: واحد سوى الإمام أو ثلاثة غيره يحضرون الخطبتين، والمالكية اشترطوا حضور اثني عشر من أهلها، والشافعية والحنابلة اشترطوا ألا يقل عن أربعين من أهلها، واشترطوا حضور الخطبتين.
3- أن تؤدَّى بإذن عام يستلزم الاشتهار في مكان بارز معلوم للناس مع فتح الأبواب للقادمين عليه، والحكمة من هذا الشرط ما قاله صاحب البدائع: «وإنما كان هذا شرطاً؛ لأن الله تعالى شرع النداء لصلاة الجمعة بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) (الجمعة: 9)، والنداء للاشتهار؛ ولذا يسمى جمعة، لاجتماع الجماعات فيها، فاقتضى أن تكون الجماعات كلها مأذونين بالحضور إذناً عاماً تحقيقاً لمعنى الاسم»(3).
4- ألا تتعدد في المِصر الواحد، قالوا: لأن الحكمة من مشروعيتها هي الاجتماع والتلاقي، وينافيه التفرق بدون حاجة في عدة مساجد، ولأنه لم يحفظ عن صحابي ولا تابعي تجويز تعددها، وعند محمد، وأبي يوسف يجوز إذا دعت الحاجة.
نازلة «كورونا»
ذِكْر الشروط المتنوعة لصلاة الجمعة أعلاه كان لأهميتها في تنزيل الحكم على هذه النازلة، ومن ثم فإن الأمر لا يتعلق بعدد فقط كما يُتداول بين بعض فقهاء العصر، وإنما ينبغي تحصيل الشرائط الأخرى سواء أكانت وجوباً وصحة، أم وجوباً فقط، أم صحة فقط.
والذي قرره الخبراء من الأطباء في فيروس «كورونا» أنه مهلك، ومتعدٍّ ومعدٍ بمجرد الاجتماع أو الملامسة، كما أن الإنسان قد يحمل الفيروس ويكون كامناً دون أن تظهر عليه أعراض المرض، ويكون نقالاً له أثناء حمله له في هذه الحالة.
وقد اتخذت الجهات المختصة تدابير صحية مهمة للوقاية منه والحد من انتشاره بالأمر بالتزام البيوت، والحجر الصحي، وإلغاء رحلات الطيران، وبلغ الأمر إلى فرض حالة الطوارئ في كثير من البلاد، مع تقديم النصائح الطبية بوسائل النظافة والمعقمات الوقائية وما يتصل بذلك.
اتجاهات الفتاوى المعاصرة في نازلة «كورونا»:
هناك فريق من الذين «أفتوا» في هذه النازلة حرموا إغلاق المساجد، وحرموا تعليق الجمع والجماعات، وقرروا أنه عند النوازل يجب الهروع إلى المساجد والدعاء فيها! فكان النبي إذا حزبه أمر هُرع إلى الصلاة! وأن الذين يمنعونها في المساجد يدخلون تحت طائلة قوله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (البقرة: 114).
وفريق ثانٍ رأى جواز صلاة الجمعة في البيوت، مرجحاً رأي الحنفية في العدد الذي تنعقد به الجمعة، مستدلاً بأن شرائط صحة صلاة الجماعة هي نفسها شرائط صلاة الجمعة دون تخصيص يخصص هذه الشروط، وأن إقامتها في البيوت أولى من صلاتها ظهراً. 
وفريق ثالث ذهب إلى جواز تعليق العمل بصلاة الجماعات والجمع، مع استبقاء المسجد لرفع الأذان، وصلاة الإمام الراتب فيه، فهو جماعة وحده، كما ذهب المالكية.
الرأي في الاتجاهات الثلاثة:
الفريق الأول أهمل بالكلية رأي الخبراء في المسألة وغض الطرف تماماً عن الهلاك والإهلاك المترتب على الاجتماع كما قرره الخبراء والأطباء والمختصون في الفيروسات، ومن ثم فهو أنزل رأيه الشرعي دون رعاية لفقه الواقعة والنازلة مع إهمال كامل لرأي الخبراء المتعلق بالواقعة، وهو ما لا يمكن قبوله، فالفقيه الحق –كما قرر ابن القيم- «هو الذي يطبق بين الواجب والواقع».
والفريق الثاني: قدَّر رأي الخبراء من الأطباء والجهات المختصة، لكنه أخذ ببعض الشروط، وهي العدد الذي تنعقد به الصلاة عند الحنفية، وأهمل الشروط الأخرى التي ذكرها الحنفية أنفسهم من اشتراط أن تقام الصلاة في مكان مشتهر ومعروف أنه تقام فيه الصلاة، ومفتوح للساعين إليها، وهي شروط صحة، أي لا تصح الصلاة بغيرها.
ولا يحتج هنا بأن العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة تنعقد به صلاة الجمعة، ولا يخصصه شيء في صلاة الجمعة كما ذهب عبدالحق الإشبيلي، فهذا صحيح من حيث العدد لكنه غير صحيح من حيث الجملة؛ فإن صلاة الجمعة لها شرائط تختلف كثيراً عن صلوات الجماعة، والذي يخصصها هي طبيعة صلاة الجمعة، وكذلك اسمها المقتضي للاجتماع والاشتهار والانفتاح، كما أن اسمها يستوجب السعي إليها طبقاً للآية الكريمة: (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ)، قال صديق حسن خان في «فتح البيان»: «قال عطاء: يعني الذهاب والمشي إلى الصلاة، وقال الفراء: المضي والسعي والذهاب في معنى واحد، ويدل على ذلك قراءة عمر بن الخطاب، وابن مسعود رضي الله عنهما: فامضوا إلى ذكر الله، كما سيأتي، وقيل: المراد القصد، قال الحسن: والله ما هو سعي على الأقدام، ولكنه قصد بالقلوب والنيات، وقيل: المراد به السعي على الأقدام، وذلك فضيلة وليس بشرط، والأول أولى، وقيل: هو العمل، قال ابن عباس: يعني ليس المراد به السرعة في المشي، كقوله: (وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) (الإسراء: 19)، وقوله: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) (الليل: 4)، وقوله: (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) (النجم: 39)، وقول الداعي: وإليك نسعى ونحفد، قال القرطبي: وهذا قول الجمهور، أي فاعملوا على المضي إلى ذكر الله، واشتغلوا بأسبابه من الغسل والوضوء والتوجه إليه، وعن خرشة بن الحر قال: رأى معي عمر بن الخطاب لوحاً مكتوباً فيه: «فامضوا إلى ذكر الله»، فقال: من أملى عليك هذا؟ قلت: أبيّ بن كعب قال: إن أبياً أقرأنا المنسوخ أقرأها فامضوا إلى ذكر الله؟ رواه ابن المنذر وابن الأنباري وابن أبي شيبة وأبو عبيدة في فضائله وسعيد بن منصور»(4).
أما الرأي الثالث، فقد ذهب إلى جواز تعليق صلاة الجمع والجماعات مع بقاء المسجد يرفع فيه الأذان، ويصلي فيه الإمام الراتب، مع تقدير واعتبار المسألة الفنية الطبية؛ رعاية لحفظ النفوس، ونزولاً على رأي الخبراء، ومنعاً للضرر.
الرأي المختار:
والذي أؤمن به أن المسألة الطبية ورأي الخبراء والفنيين يجب أن تكون محور الاجتهاد، ويكون في بؤرة الشعور، وفي عمق الاهتمام، جنباً إلى جنب مع النصوص الشرعية المتعلقة بالمسألة محل الاجتهاد؛ ففي مثل هذه النوازل لا تتأسس فتاوى الفقهاء إلا على تقارير الخبراء، ومن المعلوم أن رأي الخبراء هنا يتضمن حقيقة «فقه» الواقعة الذي يمثل ما لا يقل عن 50% من عملية الاجتهاد فيها.
وقد اعتبر القرآن الكريم المسألة الفنية، بل أمر بها بشكل صريح حين قال: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) (الأنبياء: 7).
وإذا كان الاتجاه الثالث ذهب إلى جواز منع صلاة الجمع والجماعات في المسجد، فإن الأقرب إلى روح الشريعة هو «وجوب» منعها من المساجد مع استمرار إقامة الأذان وصلاة الإمام الراتب بما هو جماعة وحده طبقاً لمذهب المالكية؛ استناداً لما هو مقرر عند الخبراء من الأطباء والجهات المختصة التي رأت ونشرت أنه فيروس مهلك ومعدٍ؛ وذلك حفظاً للأرواح واستبقاء للمهج، وإبعاداً للضرر والمرض، وصلاة الظهر تكون بدلاً منها، كما هو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف، في بدلية صلاة الظهر عن الجمعة.
كما أن صلاة الجمعة في البيوت لا تستكمل فيها شرائط الصحة لصلاة الجمعة، فالذي يأخذ برأي مذهب –كالأحناف مثلاً- يجب أن يستكمل رأيه في المسألة بما يتضمنه من شرائط وغير ذلك، لا أن يأخذ شرطاً ويهمل الشروط الأخرى المتضمنة للاشتهار والمعلومية والانفتاح، و»السعي» إليها، كما ورد في سورة «الجمعة».
يضاف لهذا أن صورة إقامة صلاة الجمعة في البيوت لا تتحقق بها مقاصدها، من الاجتماع الحاشد، والاحتفاء والاحتفال؛ فالجمعة عيد في الأرض وعيد في السماء، كما أن صلاتها في البيوت مخالف لطبيعة اسمها «الجمعة» ومقتضاه، ومن أجل هذه المعاني ذهب فريق من الفقهاء إلى منع تعددها في المِصر الواحد.
ومن المحمود أن يتألم المسلم للحرمان من صلاتها في المساجد، فهذه عاطفة محمودة وعلامة صحة إيمان وعبادة، ولكن العزاء فيما أخرجه البخاري بسنده عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مرِض العبدُ أو سافَر كُتِبَ له مِثلُ ما كان يَعمَلُ مُقيماً صَحيحاً»(5).
والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم.
_________________________________________________________________
(1) حجة الله البالغة: 2/44. دار الجيل، بيروت – لبنان. الطبعة الأولى. 1426هـ – 2005م
(2) هذه الشروط والفرضية وزمنها والحكمة مستفادة باختصار شديد من الموسوعة الفقهية الكويتية: 27: 192-204.
(3) بدائع الصنائع: 1/ 269. دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية. 1406هـ – 1986م.
(4) فتحُ البيان في مقاصد القرآن/ 14: 138. محمد صديق خان القِنَّوجي. قدّم له وراجعه عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري. المَكتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْر، صَيدَا – بَيروت. 1412هـ – 1992م.
(5) صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. رقم (2996).







