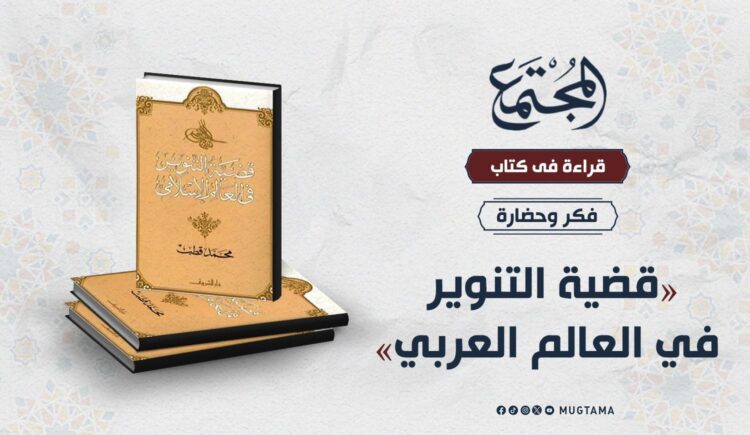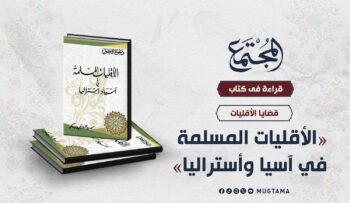يعتبر كتاب «قراءة في قضية التنوير» من أهم الكتب التي ألفها المفكر الإسلامي محمد قطب، حيث قدم فيه قراءة نقدية لما قدمته ما يسمى بحركة التنوير في الوطن العربي، وهو الاسم المفضل لها (على حد قوله)، وهي الحركة الليبرالية العربية التي تشكلت مع وجود الاستعمار وتأخرت في الوجود عن الحركة الإسلامية، وارتبط وجودها بالمستعربين، والعرب الذين تلقوا التعليم الأجنبي في السوربون وغيرها من الجامعات الأوروبية فعادوا بفكرها حاملين الفكر التحرري، أو التنويري كما يطلقون على أنفسهم.
ويقدم قطب في تلك الرسالة حصيلة ما يقرب من قرنين من الزمان مما قدمته تلك الحركة الأمة، ويأتي الكتاب في 105 من الصفحات ذات الحجم الصغير في 6 فصول مفصلة داخل الكتاب طبعة دار الشروق عام 2002م.
الفصل الأول: أحوال الأمة في القرنين الماضيين:
يستعرض قطب في هذا الفصل أحوال الأمة في آخر قرنين والأمراض التي أصابتا في تلك الفترة، وما نتج عن تراكم أمراض من القرون التي سبقتها، وهي:
– أمراض العقيدة: وتتفرع أمراض العقيدة كالتالي: الفكر الإرجائي الذي يستبعد العمل ويكتفي بالإيمان والإقرار القلبي، الفكر الصوفي الذي يستبعد فريضة الجهاد وسائر العبادات في مقابل الذكر وطاعة الشيخ، الانحسار التدريجي في مفهوم العبادة، تحويل مفهوم عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر لعقيدة صارفة عن العمل باعتبار أن المقدر سوف يكون، تحويل التوكل إلى تواكل.
– أمراض السلوك: كخلف الوعد، واستباحة الكذب، والغيبة والنميمة، الالتواء في التعامل مع الآخرين، وعدم الأمانة في العمل، وعدم احترام الوقت، والغش والاستهانة بالمسؤولية وإهدار المصلحة العامة للأمة.. وغيرها من أمراض السلوك المنتشرة بالشارع العربي والإسلامي.
وقد نتج عن تلك الأمراض التخلف العقدي، والتخلف الحضاري، والتخلف العلمي، والتخلف العسكري، والتخلف الاقتصادي، والتخلف السياسي، والتخلف الفكري.
الفصل الثاني: منهج التغيير في حركة التنوير:
وأبسط ما يوضح فكرة الحل عند التنويريين هو ما قاله طه حسين في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر»؛ حيث يقول: «إن سبيل النهضة واضحة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء، وهي أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أنداداً، ولنكون لهم شركاء في الحضارة، خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره، وما يحمد منها وما يعاب».
ومن التنويريين رفاعة الطهطاوي الذي وصفه قطب بالمخلص، لكن الإخلاص وحده غير كاف لعملية الإصلاح، لقد رأوا واقع أمتهم السيئ، وكانوا راغبين حقاً في إنقاذ أمتهم؛ الأمة الإسلامية على وجه التحديد، بصفتها تلك، لا بأي صفة سواها، وظنوا أن السبيل الأوحد للإنقاذ هو تقليد أوروبا.
فكان خطؤهم في طريقة التفكير، وليس من فساد في الضمير، وكان الخطأ ناشئاً من الهزيمة الروحية التي استولت على أرواحهم تجاه الغرب والحضارة الغربية، ولم يكونوا من أولى العزم؛ لذلك لفتهم الدوامة وذهبت بهم كل مذهب فلم يقووا على مقاومتها وتحديد مسارهم الذاتي في داخلها، هذا بالنسبة للقدامى أمثال الطهطاوي، أما المحدثون فكان غرضهم الأول نزع الرداء الإسلامي عن الأمة قاطبة.
الفصل الثالث: الإنجازات الكبرى لحركة التنوير:
لا يترتب بالضرورة على خطأ المنهج عند التنويرين أن تكون كل أعمالهم خطأ لا صواب فيه، ففي كل جاهلية من جاهليات التاريخ كانت هناك بعض الأعمال المفيدة، وبعض التصرفات المحمودة، وبعض الخير في بعض النفوس، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجاهلية العربية: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا» (أخرجه البخاري)، وقد كان من أهم إنجازات التنويريين تحرير المرأة، وحرية الفكر، والحرية السياسية.
فبالنسبة لقضية المرأة؛ كانت المرأة في الشرق الإسلامي قد عادت كماً مهملاً قريباً مما كانت عليه في الجاهلية، لا تتعلم، ولا يؤخذ رأيها في أخص شؤونها وهو الزواج، ويعتدى على حقها في الميراث إما بعدم التوريث أصلاً أو بسلب ميراثها عنوة واقتداراً دون أن تجد من تشكو إليه، لا تتعدى اهتماماتها شؤون المنزل القريبة، والرعاية التقليدية للأطفال.
وكان هذا الوضع مخالفاً مخالفة صريحة لما جاء به الإسلام، فقد ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في الإنسانية، وفي العبودية لله وحده بلا شريك، وفي الجزاء الأخروي، وكانت الصحابيات مثلاً في أخلاقهن، ووعيهن، واهتماماتهن، ونشاطهن، مع طهر الإسلام، ونظافة الإسلام، والانضباط الكامل بآداب الإسلام؛ لا اختلاط، لا خلوة مع الأجانب، لا تخلع ولا تكسر ولا تميع، ولا إبداء زينة لغير المحارم، كما أمر الله تعالى.
ولكن المجتمع الإسلامي كان قد انحدر عن المعايير الإسلامية الأصيلة في كثير من الأمور، وربما كان انحداره في شأن المرأة أشد لأنها مستضعفة، والظلم دائماً يكون على المستضعفين أشد.
ولو كان في أوروبا تشريع سماوي –كالإسلام- يوجب على الرجل كفالة المرأة في جميع أحوالها؛ بنتاً وزوجة وأماً، ويعفيها من العمل بنفسها، لتتفرغ لما هو أعلى وأهم وأخطر، وهو تنشئة الأجيال وبناء المجتمع على أسس صالحة، لما وجدت المرأة التي تتعرض للموت جوعاً في الريف، وتضطر إلى الهجرة إلى المدينة للعمل من أجل القوت.
وصب التنويريين جام غضبهم على الحجاب كمظهر من مظاهر الدين يجب انتزاعه وكأنه سبب كل هذا التخلف، وليس انسلاخ الأمة من دينها هو ما أدى إلى حالة التردي التي تعيشه.
وأما قضية حرية الفكر؛ ففي الفترة الأخيرة من حياة الأمة الإسلامية كان فكر الأمة قد تجمد في قوالب معينة، يدور في داخلها ولا يتعداها، وكرر نفسه في تقليد لا أصالة فيه، وأصبح العلم استظهاراً لما سبق به الأولون، مع فارق واضح بين المبدع الذي أبدع الفكر أول مرة، والمردد الذي يردده مختصراً أو محشياً أو شارحاً أو ناقلاً؛ فالأول عنده الموهبة التي مكنته من الإبداع، والثاني عاجز عن إحداث أي جديد، ومضت فترة من الركود لم تحس الأمة فيها بالحاجة إلى فكر جديد! فما عندها يكفيها، سواء ما كان قد فكر فيه العلماء لمواجهة حاجات المجتمع في وقتهم، أو ما تخيلوا حدوثه في يوم من الأيام.
وأما عن الحرية السياسية؛ فقد أعلن التنويريون عن أنفسهم أنهم قائمون بمهمة ضخمة، هي تحرير الشعوب من الاستبداد السياسي الذي عاشت في نيره عدة قرون، وهي مهمة ضخمة بالفعل، يستحق من يقوم بها أن يقدم له الشكر، وأن يكتب جهاده بحروف من نور.
الفصل الرابع: حصيلة التنويريين في قرنين من الزمان:
لا شك أن وضع المرأة بصفة عامة قد تغير كثيراً عما كان عليه في السابق، وجدت في الوضع إيجابيات لم تكن لتنال لو لم تقم حركة هادفة، تهدف إلى إخراج المرأة من الظلم والظلام الذي كانت تعيش فيه، فمن الإيجابيات تعليم المرأة، وتغيير نظرة الرجل والمجتمع إليها، وتوسيع أفقها.
لكن السلبيات كانت أكبر لاستخدام وسائل تخرج عن نطاق الأرض والتاريخ وطبيعة البشر، فظهر الفساد الأخلاقي نتيجة الاختلاط الدخيل، وظهر ما يسمى بترجيل المرأة وإخراجها من مهمتها الأساسية للسكن والمودة والتربية والرحمة بالبيت.
أما حرية الفكرة فقد توقفت للنيل من الإسلام وقيمه الثابتة، وأما الحرية السياسية فاتخذت لها أساساً لتسير عليه، وهو أن الدين لا علاقة له بالحكم، والعبادة في المسجد والسياسة لأهلها.
الفصل الخامس: المستقبل للإسلام:
لا يستطيع التنويريون أن يقدموا للأمة أكثر مما قدموه خلال قرن أو قرنين من الزمان، إلا مزيداً من الهجوم على الإسلام، ومزيداً من الفوضى الخلقية، ومزيداً من التبعية للغرب، وبالتالي المزيد من الضياع.
ولا أمل لهذه الأمة إلا بالرجوع إلى الإسلام، هو وحده الذي يمكن أن يبعث الأمة بعثاً جديداً تسترد فيه عافيتها، وتنطلق من جديد، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
ولقد ظهرت الحركة الإسلامية لتنقض ما زعمه التنويريون، وقد كانت هي ذاتها قدراً ربانياً، جاء في موعده المقدور عند الله، وكانت هي الرد على كيد الأعداء الذي أرادوا به القضاء الأخير على الإسلام، بإزالة الخلافة.
إن اليقظة الإسلامية هي العودة إلى النبض الطبيعي لهذه الأمة، التي صاحبت هذا الدين وعاشت به وعاشت له 14 قرناً متواصلة، وإن كانت قد غفلت عنه فترة من الوقت، فهي لا تحتاج إلى أسباب خارجية لتحدثها، إنما أسبابها كامنة في ذاتها، سواء في كون هذا الدين هو دين الفطرة، الذي تستجيب له الفطرة السليمة استجابة تلقائية، أو في الصحبة الطويلة لهذا الدين، أو لكون أزهى فترات التاريخ الإسلامي هي الفترات التي كان الناس فيها ألصق بهذا الدين وأكثر استجابة لمقتضياته، وكلها أسباب تجعل احتمال اليقظة موجوداً دائماً في كيان الأمة.