بين علم النحو وعلوم الشريعة (5 - 6)
العلاقة بين علم النحو وعلم الفقه
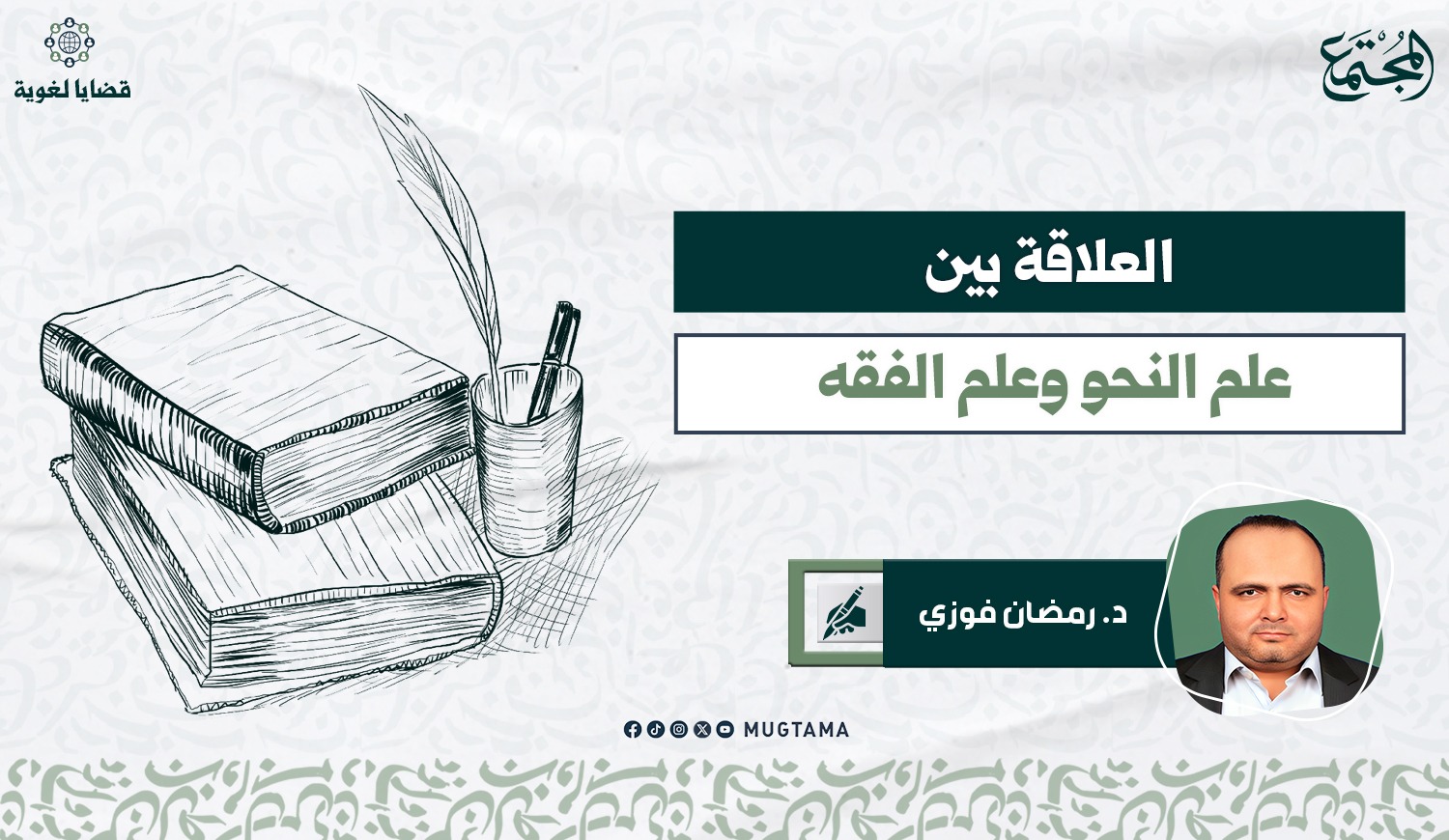
بعد ما اتضح، في المقالات السابقة، من
أثر لعلم النحو في تفسير النصوص بصورة عامة، وفي النصوص الدينية ومنها القرآن والسُّنة
بصورة خاصة، وبعد الحديث عن العلاقة بين أصول علمي النحو والفقه، يأتي الحديث عن
علاقة النحو القوية بعلم الفقه، وهو ما يُعد انعكاساً عملياً لكل ما سبق؛ ذلك أن
جزءاً كبيراً من الفقه وتخريجاته مبني على هذه نصوص الكتاب والسُّنة، وكلما تعددت
توجيهاتها تعددت في المقابل التخريجات الفقهية المستنبطة منها.
وهو ما عبر عنه الزمخشري بقوله: «ويرون
الكلامَ في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنياً على علم الإعراب، والتفاسيرَ
مشحونةً بالروايات عن سيبويه، والأخفش، والكسائي، والفراء.. وغيرهم من النحويين
البصريين والكوفيين، والاستظهار في مآخذ النصوص بأقاويلهم، والتشبث بأهداب تأويلهم»
(المفصل في صنعة الإعراب، ص18).
ويقول أحد المعاصرين: «تأثير النحو في
المجال الفقهي كان أوسع نطاقاً من تأثيره في العلوم الأخرى؛ فإذا كان تعدد الوجه
النحوي يترتب عليه اختلاف المعاني؛ فإن تعدده في مجال الفقه يتوقف عليه تعدد
الأحكام الفقهية واستنباطات الفقهاء.
ومن هنا كان لزاماً على الفقيه أن يبدأ
من باب النحاة ويتخرج عليهم، ويقف على آرائهم ومذاهبهم، ثم يدخل ميدان الفقه
الواسع.
وعلى العكس من ذلك، فإن الفقيه إذا ولج
عالم الفقه قبل تحصيل النحو فإنه لا شك يفقد أداة الفقه الأولى، وتصبح فتاواه
رهينة النقد، مهتزة البرهان.
ونبه على ذلك الفقهاء أنفسهم إذ بينوا
حاجة الفقه والفقيه إلى النحو والنحاة؛ إذ النحو أساس الفقه وعدة الفقيه، وبدونه
فلا أهلية كاملة له، أو لا يُعتد بحكمه إذا كان فقيراً في عدة الإعراب والنحو»
(دور النحو في العلوم الشرعية للدكتور جمال عبدالعزيز، ص415).
وقد أدرك الإمام ابن حزم الظاهري هذه
العلاقة جيداً؛ فحرَّم على الجاهل باللغة أن يفتي الناس في أمور دينهم، كما حرم
على الناس أن يستفتوا جاهلاً باللغة في أمور دينهم (رسائل ابن حزم: 3/ 162، 163).
وهناك بعض المصنفات التي خصصت لدراسة
العلاقة بين النحو والفقه، يأتي على رأسها كتاب «الصعقة الغضبية في الرد على منكري
العربية» للطوفي الصرصري (ت716هـ)، وهو عُني بالجانب التطبيقي في هذه العلاقة من
خلال توضيحات وأمثلة عملية لتأثير النحو في استنباط الأحكام الفقهية، وكتاب «الكوكب
الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية» لعبدالرحيم بن الحسن
الإسنوي (ت 772هـ).
ومنها ما صنف حديثاً ككتاب «أثر اللغة في
اختلاف المجتهدين» لعبدالوهاب طويلة، ومنها كذلك «أثر العربية في استنباط الأحكام
الفقهية من السُّنة النبوية» لخلف العيساوي، والكتاب في الأصل رسالة دكتوراة
بجامعة بغداد.
ويدخل في هذا السياق أيضاً «دور النحو في
العلوم الشرعية» لجمال عبدالعزيز، وهو رسالة ماجستير بكلية دار العلوم بالقاهرة،
وأيضاً «أثر التوجيهات النحوية والصرفية في الاختلافات الفقهية عند ابن حزم»، وهو
رسالة دكتوراة بكلية دار العلوم لكاتب هذه السطور.
أمثلة من تأثير التوجيه النحوي في الاستنباط الفقهي
1- حجب الأم في الميراث من الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة أم بثلاثة؟:
هناك خلاف بين النحاة في أقل الجمع؛
فبعضهم قال: أقله اثنان وبعضهم قال أقله ثلاثة.
وبناء على هذ الخلاف اختلف الفقهاء في
حجب الأم من الثلث إلى السدس في الميراث، توجيهاً لقول الله تعالى: (فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) (النساء: 11)؛ فعلى القول بأن أقل الجمع اثنان تحجب
إلى السدس بأخوين، وعلى القول بأن أقله ثلاثة لا تحجب بأقل من ثلاثة.
2- غسل المرفقين وتركهما في الوضوء:
من معاني الحرف «إلى»، عند النحاة، أنها
تفيد انتهاء الغاية، لكنهم اختلفوا هل ما بعدها يدخل فيما قبلها أما لا يدخل؛
فبعضهم قال: يدخل، والبعض الآخر قال: لا يدخل.
وبناء على ذلك اختلفوا في غسل المرفقين
وتركهما في الوضوء بناء على قول تعالى: (فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) (المائدة: 6)؛
فمن قال بدخول ما بعد «إلى» فيما قبلها أوجب غسل المرفقين في الوضوء، ومن قال بعدم
دخولها لم يوجب غسل المرفقين.
3- حكم الرجلين في الوضوء بين المسح والغسل:
ورد في قول الله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ
فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) (المائدة: 6) قراءتان؛
الأولى: بنصب اللام في «وأرجلكم»، والثانية بجرها؛ فعلى القراءة الأولى تكون «أرجلَكم»
معطوفة على «وجوهكم»، وقيل: «أيديكم»، ويكون حكم الرجلين هنا الغسل، وعلى قراءة
الجر تكون معطوفة على «رؤوسكم»، ويكون حكم الرجلين هنا المسح، وللفقهاء توجيهات
وتفريعات أخرى في هذه المسألة يضيق المقام عن تتبعها هنا.
اقرأ في هذه السلسلة:
















