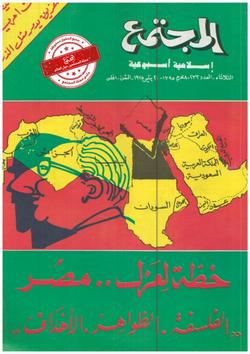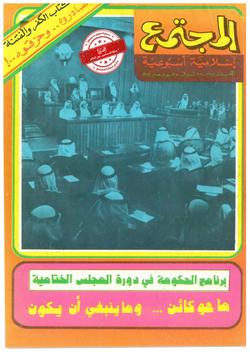العنوان دراسات في السّيرَة (حلقة 12): أسلوب المستشرقين في كتابة السيرة
الكاتب محمد النايف
تاريخ النشر الثلاثاء 14-يناير-1975
مشاهدات 15
نشر في العدد 232
نشر في الصفحة 30
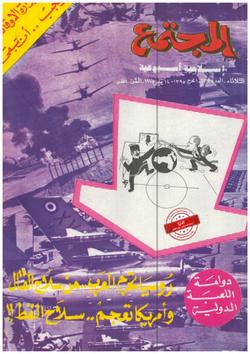
الثلاثاء 14-يناير-1975
دراسات في السّيرَة
(حلقة 12)
أسلوب المستشرقين
في كتابة السيرة
◘كتاب «تاريخ الشعُوب الإسلامَية» نموذَج للغش التاريخي.
◘طَريقة المؤلف في البَحث.. «أظن» «وَلَعَلَّ» «وَربَّما»!!
وبدراسة «تاريخ الشعوب الإسلامية» لمؤلفه كال بروكلمان نكون قد انتهينا من الحديث عن أسلوب المستشرقين في دراسة السيرة
ومؤلف الكتاب كارل بروکلمان هو شيخ المستشرقين الألمان المحدثين، ولد عام ١٨٦٨ وتوفي عام ١٩٥٦. ودرس اللغة في عدد من الجامعات الألمانية، وهو من محرري «دائرة المعارف الإسلامية» وكان عضواً بالمجمع العلمي العربي في دمشق.
من أهم كتبه «تاريخ الأدب العربي» ويقع في خمسة مجلدات، ثم «تاريخ الشعوب الإسلامية» الكتاب الذي نحن بصدد دراسته.
وبروكلمان صليبي حاقد على الإسلام والمسلمين، حاول فيما كتب الإساءة إلى لغة القرآن الكريم، وتقديم صورة كاذبة عن رسول الله-- صلى الله عليه وسلم- ، والدين الذي شرفه الله بحمله وتبليغه للناس ونسخ به الأديان السابقة ويصدق على بروكلمان- فيما ذهب إليه- قول الشاعر:
كضرائر الحسناء قلن لوجهها
حسداً وبغضاً: إنه لدميم
ولو كان بروكلمان أميناً فيما كتب، ثبتاٍ فيما سرد من روايات.. لكان كتابه «تاريخ الشعوب الإسلامية»، قيمة كبرى في الإنتاج العلمي الحديث، ولكن الاستشراق والأمانة قطبان متنافران لا ينجذب أحدهما إلى الأخر.
«وتاريخ الشعوب الإسلامية» مع ما فيه من جحود برسالة محمد-- صلى الله عليه وسلم- ، وكفر بالإسلام واسع الانتشار في البلاد الإسلامية، ويزكيه حتى بعض المتتبعين لمخططات الصليبيين، ولا يرون بأساً من انتشاره مع التنبيه إلى ما فيه من أخطاء، وحجتهم في ذلك أنه كتاب أرخ صاحبه جميع العهود حتى عام ۱۹۳۹، وأن كثيرًا من المؤلفين يقفزون عن تاريخ الدولة العثمانية، لوعوره البحث في تلك الحقبة التاريخية، وهو رأي بالغ الضعف، إذ ليست القضية في التأليف وعدمه بل بسلامة المنهج أو زيفه.
ولم أقف على أبحاث في نقد الكتاب والتحذير منه سوى ما نقله الدكتور محمد البهي في كتابه الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي «ص: ٥٣٧» قال «انظر إلى بعض أخطائه التاريخية والعلمية في مجلة الإسلام التي تصدر بالإنجليزية في كراتشي باكستان ص ١٤١ من عدد أول مايو سنة ١٩٥٨»
وإشارة عابرة عنه للأستــــــاذ السباعي في كتيبه «الاستشراق والمستشرقون».
و «بروکلمان» يستهل كتابه بوصف العربي بأقبح النعوت:
«والبدوي كائن فردي النزعة مفرط الأنانية، قبل كل شيء، ولا تزال بعض الأحاديث تسمح للعربي الداخل في الإسلام أن يقول في دعائه: «اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدًا». «ص:۱۸»
ولا غرابة في ذلك فالمؤلف ألماني، والألمان يستخفون بجميع الأجناس البشرية، ولقد اجتمع في شخصه تعصب صليبي واستعلاء عنصري.
وهو حتى في نقده للحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام. يحاول أن يجعل الإسلام صورة من صور الحياة الجاهلية وها هو ذا يقول:
«والواقع أن الساميين اعتبروا الأشجار، والكهوف، والينابيع والحجارة العراض، على الخصوص مأهولة بالأرواح. ومن هنا قدس العرب القدماء ضروباً من الحجارة في سلع وغيرها من بلاد العرب، كما يقدس المسلمون الحجر الأسود، القائم في زاوية من الكعبة في مكة» «ص: ٢٤ – ٢٥»
ولا شك أنه يعلم ما قاله عمر بن الخطاب «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أنني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك».
وهذه حقيقة اعتقاد المسلمين بالحجر الأسود بأنه لا يضر ولا ينفع فكيف يزعم أن المسلمين جعلوا منه وثناً يعبد. «ص: ٦١».
وبعد أن انتهى المؤلف من الحديث عن حياة العرب قبل الإسلام، عمد إلى التشكيك بأصول ديننا فابتدأ بشخص رسول الله-- صلى الله عليه وسلم-- وانتهى بالإسلام.
نبوة محمد «ص» كما يراها بروكلمان:
يتحدث عن حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم-- قبل النبوة فيقول: «وكان مولعاً في حديثه المجازي بالصور والاستعارات التجارية».
ثم ينقل المؤلف أكاذيب بني قومه الذين يزعمون أن الرسول أخذ الإسلام عن اليهود والنصارى لا عن وحي أنزله الله إليه:
«وتذهب الروايات إلى أنه اتصل في رحلاته ببعض اليهود والنصارى، أما في مكة نفسها فلعله اتصل بجماعات من النصارى كانت معرفتهم بالتوراة والإنجيل هزيلة إلى حد بعيد». «ص: ٣٤»
أما عن الوحي فيقول:
«لقد تحقق عنده أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة فارغة، فكان يضج في أعماق نفسه هذا السؤال: إلى متى يمدهم الله في ضلالهم، ما دام هو- عز وجل- قد تجلى، آخر الأمر، للشعوب الأخرى بواسطة أنبيائه؟ وهكذا نضجت في نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أداء هذه الرسالة، رسالة النبوة، ولكن حياءه حال بينه وبين إعلان نبوته فترة غير قصيرة، ولم تتبدد شكوكه إلى بعد أن خضع لإحدى الخبرات الخارقة في غار حراء. وذلك بأن طائفاً تجلى له هناك يوماً هو الملك جبرائيل على ما تمثله محمد فيما بعد ...ولم تكد هذه الحالات تنقضي حتى أعلن ما ظن أنه قد سمعه كوحي من عند الله».
«ص:36»
إني أشفق على العلم أن تلوثه أقلام المستشرقين، الذين يتحدثون عن النبوة بمثل هذا الأسلوب الفج. فالرسول تحقق من فساد العقيدة الوثنية وضج في أعماق نفسه... وهكذا نضجت في نفسه فكرة النبوة حتى تجلى له طائف فأعلن ما ظن أنه قد سمعه كوحي.. ثم يمضي بعد ذلك فيشبه النبوة بدعوة أي كاهن وآيات القرآن كنفثات الكهان الوثنيين «ص: ۳۷»
ونعيد للأذهان الرد نفسه الذي عقبنا فيه على كلام أرنولد:
إن برو کلمان نصراني يثبت نبوة بل ألوهية عيسى وينكر نبوة محمد، وهكذا يردي التعصب الظالم صاحبه في الهلاك.
وعما بين الأوس والخزرج من خلافات وعن المخرج يقول لا بد أن يكون الحل من خارج المدينة على عاتق كاهن وثني ما، ولكن شيئاً مثل ذلك لم يحدث، فإذا الخلاف بين أبناء العمومة يمهد السبيل أمام النبي. «ص:٤٣»
ويرى- بروکمان- أن الإسراء أسطورة من الأساطير ثم يتلاعب بتاريخ وقوعه:
«ومن الجائز أن تكون هذه الرحلة السماوية التي كثيراً ما أشير إليها بعد في الأساطير الشعرية التي خلفتها لنا الكتب الإسلامية جميعها أقدم من ذلك عهداً ولعلها ترجع إلى الأيام الأولى للبعثة النبوية وأمثال هذه الرؤى في أثناء تهجد العراف معروفة ثابتة لدى بعض الشعوب البدائية».
«ص:٤٤»
وإذا كان بروكلمان توقف عند هذا الحد فالمستشرق موير يعلق على حادث شق الصدر- الذي رواه البخاري- فيقول: إن هذه نوبة صرعية وكذلك نيكولسون في كتابه «تاريخ أدب العرب:147-148».
وأجهد مرجليوث نفسه في كتابه «محمد» في البحث عن الأساتذة الذين كانوا يعلمون رسول الله «ص» الكتب المقدسة فذكر جابر بن عبد الله مولى بني عبد الدار وياسر وأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- كان يمر بهما وهما يقرآن التوراة.. وقال ويظن أن الجزء الخاص بالمسيحية في القرآن قد تعلمه النبي من صهيب.
«وكانون سل» يزعم في كتابه «حياة محمد» «ص» أخذ أفكاره عن زيد بن عمر بن نفيل وأصحابه.
رأي بروكلمان بالقرآن والإسلام:
إنكار «بروکلمان للوحي والإسراء وسائر معجزات النبوة تمهيد لأفكاره أن يكون القرآن كلام الله- جل وعلا.. إنما هو كما يرى بروكلمان- من محمد نفسه أخذه عن اليهود والنصارى وحكايات العرب القديمة. ومما قال: «في غمرة هذا النضال الناصب المخفق ضد جحود مواطنيه الارستقراطيين وإنكارهم، كان محمد يعزي نفسه بالأنبياء السابقين الذين لم تكن مهمتهم مع أقوامهم أسهل من مهمته. وهكذا نجده، في عهده الأول، يكثر من الإشارة إلى قصص هؤلاء الأنبياء، وإلى قصة موسى بخاصة. وليس من شك في أن معرفته بمادة الكتاب المقدس كانت سطحية إلى أبعد الحدود، وحافلة بالأخطاء، وقد يكون مديناً ببعض الأخطاء للأساطير اليهودية التي يحفل بها القصص التلمودي، ولكنه مدين بذلك، ديناً أكبر للمعلمين المسيحيين الذين عرفوه بإنجيل الطفولة، وبحديث أهل الكهف السبعة وحديث الإسكندر، وغيرها من الموضوعات التي تتواتر في كتب العصر الوسيط، وكان إلى جانب ذلك قصص عربية كتلك التي تتحدث عن هلاك قبيلة ثمود، التي قد يكون وضع لها قصة النبي صالح الثانوية كملحق ضروري. وههنا. في هذه القصص، نجد أن أسلوبه ينزع إلى أن يكون أكثر إسهاباً وأقل توقداً، كما نجد أنه كان يوشح هذه القصص بمناقشات خطابية تدور على محور إثبات وجود الله بمختلف الدلائل التي تقدمها الطبيعة».
هكذا يقول: «إن أسلوبه ينزع إلى أن يكون أكثر إسهاباً وأقل توقداً» والقرآن أسلوب الله وكلامه وليس من كلام رسوله.. وفي كل مناسبة من مناسبات السيرة يؤكد أن القرآن من الرسول، فإذا تحدث عن «أبي لهب» قال: «وعلى الرغم من أن النبي- لعنه في إحدى السور» «ص: 4» وإذا تحدث عن اليوم
الآخر قال:
«ويساق الذين اتقوا ربهم إلى جنة عدن التي تمثلها محمد».
«ص:۷۲»
وإذا كان رأيه بالقرآن أنه ليس كلام الله، ومحمد أخذه ممن التقى معهم من الذين يدينون بالنصرانية واليهودية والوثنيين من العرب، وبالتالي هذا رأيه بكل ما جاء به محمد- صلى الله عليه وسلم- فتراه يقول:
«لم يكن عالمه الفكري من إبداعه الخاص إلا إلى حد صغير، فقد انبثق في الدرجة الأولى عن اليهودية والنصرانية، فكيفه محمد تكييفاً بارعاً وفقاً لحاجات شعبه الدينية. وبذلك ارتفع بهم إلى مستوى أعلى من الإيمان الفطري والحساسية الخلقية» «ص:69»
فالصلاة أول الأمر اقتبسها عن اليهود، وبعد صدامه مع اليهود تأثر بطقوس الفرس في الصلاة والمآذن أخذها المسلمون عن أبراج الكنائس.. وصلاة الجمعة اقتبسها عـن اليهود. «ص:٧٤»
والصوم: يتساءل بروكلمان من أین اقتبسها؟ ويلح في التساؤل، فأمر الاقتباس في عقل بروكلمان قبل البحث والتحقيق «هل اقتبس محمد هذه الفريضة عن إحدى الفرق الفنوستية أم عن الماينين الذين نفذ مبشروهم إلى بلاد العرب أيضاً فقد كان لا يعرف شيئاً، أو يكاد، عن الحراينين في العراق، الذين كانوا يصومون كذلك في شهر آذار، تمجيداً للقمر».
«ص:48»
والحج أخذه عن العرب الجاهليين وزعم بروكلمان أن بملامسة الرسول- صلى الله عليه وسلم- للحجر الأسود ضم هذا الطقس الوثني إلى دينه. «ص:٦١»
والزكاة- يراها- ضريبة للدولة (ص:78) ويقول عن تحريم الإسلام للتماثيل: إنه اعتقاد خرافي مشترك بين عدد من شعوب الأرض. وعن الرق يقول أن محمداً لم يتعرض له أكثر مما تعرضت الكنيسة المسيحية، ولكنه لطف من حدة هذا النظام.
«أما القانون الجزائي في الإسلام فقد ظل على مستوى يقرب من السذاجة وهو لا يمثل إلا تقدماً ضئيلاً بالنسبة إلى مفاهيم القوانين الوثنية القديمة» «ص:82»
الرابط المختصر :
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل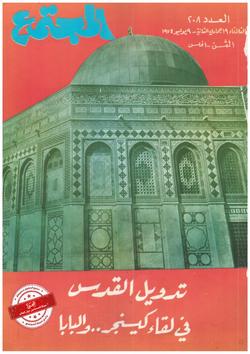
دراسات في السّيرَة.. أسلوب المستشرقين في كتابة السيرة «تَاريخ الشعوب الإسلامَية».. أيضًا - الحلقة ۱۳
نشر في العدد 233
11
الثلاثاء 21-يناير-1975