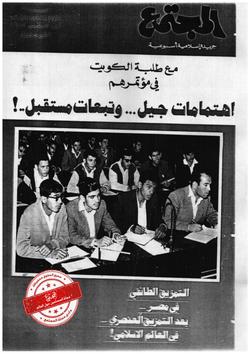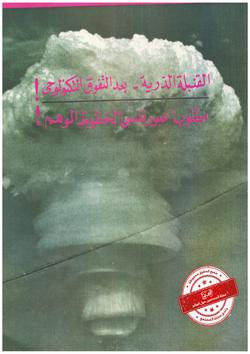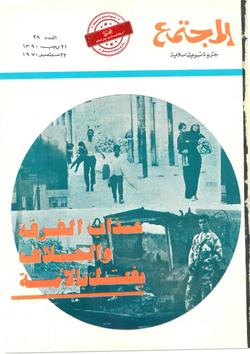العنوان المتفيهقون «2»
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 30-ديسمبر-1980
مشاهدات 27
نشر في العدد 509
نشر في الصفحة 46
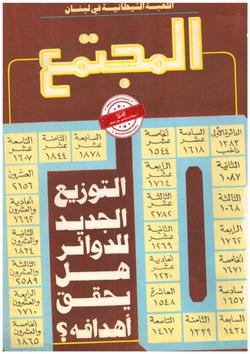
الثلاثاء 30-ديسمبر-1980
•من آفات الجهل أنه يوحي إلى صاحبه أنه عالم، وأنه ينطق بكلام العلماء
•من كان شيخه كتابه كثر خطؤه وقل صوابه .
•يقول أحدهم لمن تبعه منهم أنه يستطيع أن يجعلهم مجتهدين بجلسة واحدة وبنصف ساعة.
•قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أبغضكم إليّ الثرثارون المتفيهقون»
•ما ضحك من خطأ امرئ قط إلا و ثبت صوابه في قلبه.
إن من أعظم آفات الجهل أنه يوحي إلى صاحبه أنه عالم.. وأنه ينطق بكلام العلماء، بل الحكماء، ويلحن لحنهم.. فيتكلم.. ويسكت العلماء عنه لجهله.. وهنا يعمل الغرور عمله، فيجتمع مع الجهل عليه، ويوحي له أنهم ما سكتوا عنه إلا لإفحامه إياهم، وأنه الآن سلطانهم، ولا سلطان عليه.. إذ شب عقله عن الطوق، فيهذي بما يظنه علمًا، ولا يزال يهذي، حتى تفوح رائحة جهله، ويسقط في يديه... بما يكشفه الله من عواره، ويفضحه من أباطيله، وإذا به أمام مرآة الحقيقة عاريًا، يستغفر الله- إن عاد إليه عقله- مما كان يظنه تسبيحًا له.
وإني لأذكر غرور من ذكرت، ممن وصفت، فأذكر قول الشاعر:
ألقاب مملكة في غير موضعها
كالهر يحكي انتفاضًا صولة الأسد
وأذكر إعراض العلماء عنه، فأذكر قول الشاعر:
وإن عناء أن تعلم جاهلًا
ويحسب جهلًا أنه منك أعلم
وأذكر ما يكشف الله به العوار ويفضح به الأباطيل فأذكر قصة «كفر الذبابة» في «وحي القلم» لمعجزة الأدب العربي، مصطفى صادق الرافعي.
وأتساءل ما الذي يضير العلماء من سفه الجهلاء. فيجيبني المتنبي بقوله:
وأني رأيت الضر أسهل منظرًا
وأهون من مرأی صغیر به کبر
أخبرني شيخي أنه قرأ يومًا أثناء طلبه للعلم في كتاب المعاملات من الفقه ما نصه: «ويحرم بيع برمبلول ببرمبلول» قال: فنظرت في الشروح فلم أجد لهذه الكلمة معنى، ونظرت في الحواشي أيضًا فلم أجد معناها، فرجعت إلى شيخي أسأله عنها، فقال لي: «يا بني ما أخذ إنسان العلم من الكتاب إلا ضل، إذ لا بد من المعلم ليشرح ويبين، ولو كان الكتاب وحده ينفع، لما أرسل الله مع كل كتاب رسولًا يشرحه ويبينه ويبلغه، ولما أخذ الله العهد من الذين أوتوا الكتاب أن يبينوه للناس، ولما ألجم الله كاتم العلم بلجام من نار وكتب العلم متوفرة للقاصي والداني.. يا بني.. إن صواب العبارة: «ويحرم بيع برمبلول ببرمبلول» والأمر لا يحتاج المعاجم وقواميس، وشروح وحواشي، وإنما يحتاج لتواضع كتواضعك إذ سألتني»
قال لي شيخي: فما نسيت منذ ذلك اليوم حكمة الشيخ، وذكرت قول الشافعي: «ما ضحك من خطأ امرىء قط إلا وثبت صوابه في قلبه».
ولقد ابتلي المسلمون اليوم- زيادة عما هم فيه من البلاء- وفي هذا العصر الذي قبض فيه العلم بقبض العلماء بصنف من الناس، أخذوا العلم من الكتاب، دون الرجوع إلى المعلم والمرشد، ففهموا النصوص خطأ، وأولوها على هواهم جهلًا، وليتهم سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، ولكنهم أوغلوا في أوهامهم، وجعلوا بلبلة العقول أكبر همهم، بما أتوا به من عظائم الأمور التي أوصى بها جهلهم، زاعمين أنها هي الشرع الذي لا يجوز العدول عنه، ولا الابتعاد منه، مع أنها مخالفة لسيرة هذه الأمة منذ أن بعث الله نبيها إلى يومها هذا، وستبقى كذلك إن شاء الله، لا تغير مسيرتها الأهوال، ولا تصدها الأوهام، إذا ضمن الله بقاءها، وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام باستمرارها، لا يضرها من خذلها، حتى يأتي أمر الله.
وإني ذاكر هنا بعض ما افترى به أولئك النفر، ليطلع المسلمون على الجاهلية العلمية التي وصل إليها كثير من الشباب في هذا العصر، بعد أن فقدوا الضوابط العلمية للخوص في دين الله، مستهينين بتراث هذه الأمة الذي فخرت به على كل الأمم في الأرض، بعد أن وقر في أذهانهم أن الاجتهاد مباح لكل واحد منهم، عالمًا كان أم جاهلًا، وأنه إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد..
1- قال أحدهم لمن تبعه منهم وفي درس عام في المسجد، إنه يستطيع أن يجعلهم مجتهدين بجلسة واحدة، وبنصف ساعة.. فقلت: هذا تفاعل كيميائي وليس ببرنامج علمي، لأنه لا العقل القديم، ولا العقل الحديث يؤمن بهذا، إلا إن كان القائل قد أوتي المعجزة، وكان كفه ككف عيسى عليه السلام.. تبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموتى بإذن الله، ولعل إحياء الموتى أقرب في مجوزات العقل من أن يصير الإنسان عالمًا بدقائق؛ لأن العقل البشري يفكر في إحياء الموتى ويهجم عليه؛ ولكنه ما فكر بعد في أن يجعل الإنسان عالماً بدقائق
2- وقال آخر: إن الإنسان يكفيه ليكون مجتهدًا أن يحفظ سنن أبي داود في الحديث ومختار الصحاح في اللغة.
وأنا أريد أن أرشده إلى كتاب أقرب إلى الغاية من مختار الصحاح ألا وهو المصباح المنير للفيومي والزاهر للأزهري فإنهما معجمان فقهيان ولعلهما أمس بالمقصود من المختار.
وإلى أريد أن أرشده إلى القاموس، أو تهذيب اللغة، أو لسان العرب، أو تاج العروس؛ لأن الإحاطة بهذه الكتب يحتاج إلى أكثر من نصف ساعة؟!
ومما فرعوه على هذه القاعدة الأصولية أن قال بعضهم:
1- إن أكل السكر حرام؛ ولذلك فهو يشرب الشاي بدون سكر أو بسكر النبات.
2- وقال بعضهم: إن حلق شعر الرأس وإن كان عاما لجميع الرأس حرام؛ لأنه تغيير لخلق الله، ما لم يكن في حج أو عمرة.
3- وقال بعضهم: إن الدراسة في الجامعات والمدارس حرام، لا لشيء، وإنما لأنه يوجد فيهما جرس، ومدرس حليق.
4- وقال بعضهم: إن رفع اليدين في الدعاء حرام.
5- وقال بعضهم إن صلاة التراويح عشرين ركعة بدعة، وحرام، علما بأنها مما أجمعت عليه الأمة قولا وعملا، منذ عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا ، وصرح به كل من كتب في الفقه ولا داعي للإطناب فيه.
6- ثم تمادى الأمر ببعضهم قال: إن صلاة التراويح في المسجد وراء الإمام بدعة، ولا تجوز، ولذلك امتنع بعضهم عن صلاتها في المساجد.
7- وقال بعضهم: إذا قال القارئ وراء قراءته صدق الله العظيم، فإن هذا القول بدعة وحرام، وليته ذكر قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ﴿قل صدق الله﴾ وقول رسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أمره أن يسقي ابن أخيه عسلا «صدق الله وكذب بطن ابن أخيك».
8- وقال بعضهم: إن الأذان الأول في الفجر بدعة وحرام.
9- وقال بعضهم: إن قول المؤذن لصلاة الفجر «الصلاة خير من النوم» بدعة وحرام.
10- وقال بعضهم إن التكبير الجماعي يوم العيد حرام، حتى أنه أصبح مما يلغز به بين الشباب، ما هو الشيء الذي إن فعله الإنسان منفردًا دخل الجنة، وإن فعله مع الجماعة دخل النار؟
11- وقال بعضهم: إن القول بدوران الأرض يتنافى مع العقيدة؟!!.
12- وقال بعضهم: إن صلاة المغرب تقصر في السفر، ولعل القارئ يظن أني أغالي في أقوالي هذه، إلا أنها الحقيقة ومع الأسف، فقد قصر جماعة من الناس صلاة المغرب في خيران، وكان خلفهم اثنان من أصحابي، فسبّحا خلف الإمام، ظنًّا منهم أنه سهى، إلا أنه أخبرهم بعد الصلاة، بأنه في سفر، وأنه قصر المغرب فصلاها ركعتين بأصحابه المسافرين معه.
وجهل هذا الإنسان أنه مما يكاد يكون معلومًا من الدين بالضرورة أن المغرب لا تقصر، وأنه انعقد إجماع الأمة بدون مخالف على هذا، وأنه لا يعرف في دين الله أبدًا، وأن القول به من عظائم الأمور.. والله المستعان.
13- وقال بعضهم: وهو ما لا يكاد يصدق إن لعن الشيطان لا يجوز، ولما لعن أحد الإخوة الشيطان أمامه قال له: لا تلعنه، فإن لعنه غير جائز، وعلل ذلك بأن الشيطان إذا لعن افتخر وسر؛ ولذلك فإنه لا يجوز لعنه، لأن لعنه يؤدي إلى سروره.
أمور تضحك السفهاء منها
ويبكي من عواقبها الحليم
وإني لعلى يقين بأن كثيرًا ممن سيقرأون هذا الكلام سوف يظنون أني إنما أرمي الناس بوهم وخيال، لأن كثيرًا مما ذكرته مما لا يصدق أن عاقلًا ينطق به أو يعمله، إلا أنها الحقيقة المُرة.. ويا للأسف، وما ذكرت إلا بعضًا مما علمته وعلمه كل من تتبع أولئك المتفيهقين.
14- وإني سأختم موضوعي هذا بما قاله لي بعض المتفيهقين: سألني عن قضاء الصلاة التي تترك عمدًا، فقلت له: يجب قضاؤها بإتفاق الأئمة الأربعة مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأتباعهم في كل العصور، فقال لي: إن هذا يخالف الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا يوجب القضاء إلا على الناسي والنائم.
فقلت له: وما هو هذا الحديث؟
والحديث معروف.
فقال: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».
فنص الحديث على وجوب القضاء على الناسي والنائم فقط بمنطوقه، وعلى نفيه عما عداهما بمفهومه.
فقلت له: يا هذا.. لا تقل إن الأمة خالفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في الأمة من هو أحرص مني ومنك على دين الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فيهم لمن عرف به تاريخ هذه الأمة على وجه الأرض وإن الفقه الإسلامي ما قام إلا على كتاب الله وسنة رسوله.
ولكن قل لي، وبأدب المتعلم: كيف فهم أولئك السلف من عظماء هذه الأمة حديث رسول الله؟ لتفوز بشرف الفهم، وشرف الأدب، وعندها يمكن لي أن أجيب.
وأنا لا أريد أن أخوض في هذه المسألة وأدلتها فقد فرغت منه أمتنا منذ أربعة عشر قرنًا، واتفق الأئمة الأربعة وأتباعهم على وجوب القضاء للصلاة التي تترك عمدًا.
ونحن عندما نقول اتفق الأئمة الأربعة وأتباعهم لا نعني بذلك عدة رجال، إنما نعني به كل عظماء أمتنا الذين تملأ تراجمهم مئات المجلدات.
وإنما أريد أن أبين لك خطأ استدلالك بهذا الحديث فقط، لتعلم أن الخطأ ليس في فهم الفقهاء، وإنما هو في فهمك الخاطئ لهذا الحديث.
يا هذا.. لقد استدللت بمنطوق الحديث على وجوب القضاء على النائم والناسي وهذا لا غبار عليه.
واستدللت بمفهومه على عدم وجوب القضاء على من سواهما. وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه.
وذلك لما يأتي:
إن الاستدلال بمفهوم المخالفة استدلال مهزوز ضعيف، وقع فيه نزاع كبير بين الأصوليين، فقد أنكره الحنفية، والقاضي أبو بكر الباقلاني، والقفال الشاشي، والقاضي أبو حامد المروزي، والغزالي في «المستصفى» دون «المنخول». والقاضي عبد الجبار، وأبو الحسين البصري، والأمدي، والرازي في «المنتخب» و«المحصول» من الجمهور.
والقائلون بالمفهوم لم يقولوا به في كل مفهوم، إذ اتفقوا تقريبًا على إنكار مفهوم اللقب.
وبقية أنواع المفهوم وقع فيها خلاف بين القائلين بها، في تفصيل يرجع فيه إلى كتب الأصول، وليس هذا مكانه.
واتفق القائلون بالمفهوم أن المفهوم يعمل به بستة شروط، إذا انتفى واحد منها تعطل العمل به، وهي:
أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، أو مساويًا له. وذلك كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ (الإسراء: 23) فإنه لا يفهم منه جواز الضرب؛ لأن الضرب المسكوت عنه أولى بالحرمة من التأفيف.
أن يكون المسكوت عنه ترك لخوف، فإن كان كذلك، لا يعمل بالمفهوم، وذلك كقول رجل حديث عهد بالإسلام لخادمه، بحضور المسلمين: تصدق بهذا المال على المسلمين، وهو يريد المسلمين وغيرهم من المحتاجين، إلا أنه سكت عنهم خوفًا من أن يتهم بالنفاق، فإذا قامت القرينة على أنه إنما سكت عن المعنى المفهوم خوفًا، تعطل العمل به.
ج- أن لا يكون المسكوت عنه ترك للجهل به، كمن قال: النفقة واجبة للأصول والفروع، وهو يجهل حكم النفقة على الأطراف، فإنه لا يعمل بالمفهوم هنا، فلا يحكم بأن النفقة للأطراف غير واجبة، لأنه يجهل حكمها فسكوته عنه، لا لأن النفقة غير واجبة، وإنما لعدم علمه بها، ولذلك تعطل العمل بالمفهوم.
د- أن لا يكون المنطوق خرج مخرج الغالب، فإن كان كذلك تعطل العمل به، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾ (النساء: 23) فإن مفهوم هذا النص أن الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج الأم، جاز نكاحها، إلا أن هذا المفهوم غير مراد، والعمل به معطل؛ لأن الحكم خرج مخرج الغالب، إذ غالبًا ما تكون الربيبة في حجر الزوج مع أمها، ولذلك قيد بها، وليس المراد نفي الحكم عن الربيبة التي لا تكون في الحجر.
كذلك لم يعملوا بمفهوم قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ (آل عمران: 130) لأن ذكر الأضعاف خرج مخرج الغالب، أو العادة الجارية التي كان متعارفًا عليها، لا من أجل نفي الحرمة عن الربا اليسير، وإن كان مفهومًا من الكلام لكل عاقل.
ولم يعملوا بمفهوم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (البقرة: 229) وإن كان المفهوم من الكلام نفي جواز الخلع في حالة الصلح؛ لأن الغالب أن الخلع لا يقع إلا في حالة الخوف، ولا يدل ذلك على المنع عند انتقاء حالة الخوف، فالتقييد بحالة الخوف خرج مخرج الغالب. ولا مفهوم له.
هـ- أن لا يكون المذكور بالحكم خرج جوابًا لحادثة أو واقعة معينة. كما لو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فقال: نعم، فإن هذا لا يعني أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها، لأن الحكم لم يخرج لنفي الحكم عن المعلوفة، وإنما هو جواب خاص، لبيان حكم السائمة التي سئل عنها فقط.
و- أن لا يكون المذكور خرج مخرج الواقع، فإن خرج مخرج الواقع لم يعمل به، وذلك كقوله تعالى: ﴿لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: 28) فإن مفهوم هذه الآية أنه يجوز موالاة الكافرين مع المؤمنين، وإنما النهي عن موالاتهم دون المؤمنين، إلا أن هذا المفهوم غير مراد، والآية لم تنزل لبيان هذا المفهوم، وإنما نزلت في واقعة معينة، وفي قوم والوا الكافرين دون المؤمنين، فنهوا عن ذلك، فالحكم أريد به بيان الواقع، لا نفي الحكم عن غيره.
وأنا لا أريد أن أستطرد في ذكر الأمثلة، فكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام مليئان بها، وإنما ذكرت ما ذكرت تمهيدًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا نكرها».
فقد قال العلماء فيه ما قالوه في الأمثلة التي ذكرتها.
فقالوا: هذا الحديث لا مفهوم له لأن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. فإذا كان القضاء قد وجب على تارك الصلاة بعذر النوم أو النسيان، وقد رفع عنه القلم وسقط التكليف، فوجوبها على التارك بغير عذر أولى .
وثانيًا: لأن هذا الحكم خرج مخرج الغالب؛ إذ الغالب من حال المؤمن أنه لا يترك الصلاة بسبب النوم أو النسيان، وليس معناه أنه إذا تركها في غير هاتين الحالتين لا قضاء عليه.
ولا ضرورة للتنصيص على كل حالة؛ إذ الشارع يكتفي بالتنصيص على بعض الصور، ويقاس عليها كل ما في معناها من الصور الأخرى التي لم ينص عليها.
وإلا، فما هو القياس..؟! الذي يعتبر أوسع مصادر التشريع على الإطلاق..؟؟
وثالثًا: قد ورد هذا الحديث في واقعة حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، إذ ناموا عن صلاة الصبح حتى ضربتهم الشمس، وبعد أن استيقظوا وخرجوا من الوادي الذي كانوا فيه أمر رسول الله بلالًا أن يؤذن ويقيم، وصلى بالناس الصلاة قضاء، وقال لهم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» ومراده بيان حكم الواقعة التي وقعت، وليس مراده نفي الحكم عما سواها من الوقائع.
ورابعًا: لقد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب قضاء الحج عن الميت بقوله: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال: فدين الله أحق بالقضاء».
وهذا عام فيما كان بعذر أو بغير عذر، وعام في الحج وغيره، والعمل بمنطوق هذا الحديث أولى من العمل بمفهوم ذاك إذا تعارضا، فما بالنا إذا لم يتعارضا، إذ تعطل مفهوم ذاك، ووجب العمل بمنطوق هذا..؟!
يا هذا.. من أجل ما ذكرته لك هنا في تعطيل العمل بمفهوم هذا الحديث أعرض فقهاء المسلمين من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، عن العمل بمفهومه؛ لأنه لا يجوز العمل به بين القائلين بالمفهوم لما ذكرت، لا إعراضًا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإلا فهم أحرص على دين الله، وحديث رسول الله من كثير من المتفيهقين في عصرنا هذا، إن جاز لنا أن نفاضل بينهم، متجاهلين قول الشاعر :
ألم تر أن السيف ينقص قدره
إذا قيل: هذا السيف خير من العصى
ومرة ثانية أنا لا أريد الأن الاستدلال على هذه المسألة فقد فرغت منها أمتنا منذ أمد بعيد وإنما أريد أن أبين وجه خطأ من أخطأ بجهله وتفيهقه.
يا هذا.. أنا لا أريد أن أحجر على الناس الفتوى والاجتهاد.. فما كان لي أن أغلق بابًا فتحه الشرع، ولكني أريد أن أقول لهم: تعلموا قبل أن تفتوا وتجتهدوا...
يا هذا.. من تطبب بغير طب فقد برئت منه ذمة الإسلام.
ومن أفتى بغير علم فقد ضل وأضل.
ومن اجتهد بجهل فقد اقتحم لجج النار.
وقد روي في الحديث: «إن أبغضكم إليّ الثرثارون المتفيهقون».
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل