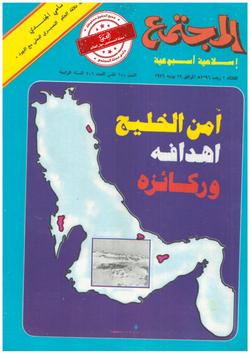العنوان من إعجاز النظم القرآني في شهادة شاهدي الميت المغترب
الكاتب الدكتور عبد الكريم الخطيب
تاريخ النشر الثلاثاء 26-مارس-1974
مشاهدات 15
نشر في العدد 193
نشر في الصفحة 20
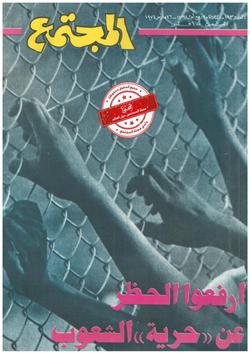
الثلاثاء 26-مارس-1974
من إعجاز النظم القرآني
في شهادة شاهدي الميت المغترب
بقلم عبد الكريم الخطيب
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (المائدة: ١٠٦- ١٠٨).
الإعراب:
قوله تعالى: «اثنان» هو خبر المبتدأ «شهادة بينكم» وقد فصل بين الخبر والمبتدأ بقوله تعالى: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ﴾، وقوله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ هو صفة ثانية لقوله تعالى: «اثنان».
التفسير:
هذه الآيات الثلاث تعرض لأمر كان ولا يزال يقع كثيرًا في حياة المسلمين وهم على سفر، لغزو أو تجارة، وبمنقطع عن أهليهم وذوي قرابتهم.. فيمرض أحدهم، ويجد ريح الموت دانية منه، وبين يديه مال أو متاع، يريد أن يصل إلى ولده وأهله، أو وصية يريد أن يوصي بها، أو إقرار بما في ذمته من دين، أو نحو هذا مما يحضر الميت حال موته في غير أهله.
تلك هي المشكلة التي عرضت لها هذه الآيات، وجاءت لتضع العلاج السليم لها، حتى تصل الحقوق إلى أهلها، وحتـى يموت الميت وهو مطمئن إلى أنه لن يعتدى على ماله، وهو لا يملك أن يدفع هذا الاعتداء، وقد أصبح في عالم الموتى!
والملاحظ في هذه الآيات أنها جاءت على نظم خاص، وأسلوب يكاد يكون فريدًا في القرآن الكريم.
فقد كثر فيها الخروج على مألوف النظم القرآني، خروجًا متعمدًا..
فهناك تقديم وتأخير.. بحيث تبدو الجمل وكأنما يدفع بعضها بعضًا، ليزيله عن موضعه قسرًا..
هناك جمل اعتراضية، تكاد تعزل المبتدأ عن خبره، والفعل عن فاعله.. بحيث لا يهتدي إلى الجمع بينهما إلا بعد نظر دقيق، وبحث شامل..
وهناك ضمائر يتجاذبها أكثر من عائد يريدها أن تعود إليه، وتلتقي به..
ثم هناك هذا العسر الشديد في النطق بالكلمات، شدها إلى اللسان، وجمعها عليه..
هذا وذاك كله، مما يجعلنا نقف بين يدي هذه الآيات، ونملأ العين والقلب من بعض ما يفيض من أضوائها، لعلنا نمسك بشيء من الحكمة في قيام بنائها على هذه الصورة الفريدة في النظم القرآني!
ونقرأ الآيات مرة، فاذا هي كعهدنا بها، تتأبى على اللسان، وتكاد تمسك به..
ثم نعود فنقرؤها قرآنًا مرتلًا، ونجيئها مستصحبين قوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (المزمل: ٤).
فإذا هي كلمات متناغمة، يأنس بعضها إلى بعض، ويتجاوب بعضها مع بعض، وإذا هي على اللسان لينة المس، عذبة المذاق، وإذا هي على الأذن لحن موسيقى علوي النغم، يهز القلب، ويمسك بمجامعه!
وننظر في وجه الآيات مرة أخرى، فإذا هي مسفرة مشرقة، تتلألأ بأضواء الحكمة والموعظة الحسنة، وإذا بنا منها بين يدي دعوة قاهرة، وسلطان غالب، يلزمنا أن نقف عند حدوده، ويمسكنا أن نفلت من بين يديه، إذا نحن حاولنا ذلك، واستجبنا لداعي أنفسنا للإفلات منه..
ونسأل: ما حكمة هذا التدبير في النظم الذي جاءت عليه تلك الآيات؟
ولم هذا الخروج الذي جاء عن عمد، على غير المألوف من النظم القرآني؟
والجواب:
أولًا: إن هذه الآيات تضبط حالًا من أحوال الناس، تقع على صورة غير مألوفة لما تجري عليه حياتهم، في الغالب الأعم منها..
فالناس أكثر ما يموتون، يموتون وهم بين أهليهم، وذوي قرابتهم..
حيث يجد من يحضره الموت منهم، الوجوه التي ألفها، وعاش معها وأودعها سره وما ملكت يمينه.. فلا يجد -والحال هذه- من الوحشة للموت أو الفزع منه، والخوف الكارب من الضياع له، ولماله ومتاعه الذي بين يديه، ما يجده ذلك الذي يموت غريبًا، في طريق سفر، أو دار غربة..
ومن هناك جاءت كلمات الآيات متزاحمة، متراكبة، أشبه بتلك الحال القلقة المضطربة، المستولية على هذا الغريب الذي يحضره الموت، وفي صدره كثير من الأسرار، يريد أن يفضي بها إلى أهله، ويكشف مستورها لهم.
هذه واحدة!
وثانيًا: الذين حضروا هذا الميت الغريب، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة من الحياة قد شهدوا منه هذا الاضطراب المستولى عليه، وتلك الوحشة التي تمسك لسانه، وتــرد الأسرار التي تضطرب في صدره... ثم إذا هم يطلون عليه بنظرات حزينة، مواسية، يرى أنهم أهل لأن يفضي إليهم ببعض ما عنده.. إذا كان ما لا بد أن يكون..
وهنا شد وجذب، وأخذ وعطاء، وخواطر متناثرة، وكلمات حذرة قلقة، ملفقة في دخان من الريبة والشك، وأسرار تمشي على استحياء يعرف بعضها ويعرض عن بعض..
ومن هنا أمسك النظم القرآني بهذه المشاعر المختلطة المضطربة، وعرضها في هذه الصورة، التي تكاد تكون وعاء حاملًا لتلك المشاعر، بحيث ترى وتحس..
وتلك أخرى..
وثالثًا: هذا المال والمتاع الذي بين يدي هذا الإنسان المحتضر.. إنه متعلق بأكثر من جهة.. فهناك صاحب هذا المتاع الذي يريده أن يبلغ أهله.. وهو في شك من أن يصل إليهم سالمًا.. وهناك الشاهدان اللذان أشهدهما المحتضر على وصيته، ووضع في أيديهما كل ما في يده.. أنهما يحملان أمانة ليس وراءها من يطالبهما بها، إلا ما معهما من إيمان وتقوى.. وما أكثر وساوس النفس في تلك الحال، وما أكثر نداءها الصارخ لاغتيال هذا المال الذي غاب عنه صاحبه... إن لم يكن كله، فالخيار الكريم منه.
وهناك ورثة صاحب هذا المال، ومن أوصى لهم بشيء منه.. إنهم مهما حرص الشاهدان على أداء الأمانة كاملة فيما اؤتمنا عليه، ومهما تحريا الصدق في قولهما، وفيما أدى إليهما هذا الميت من اعترافات وأسرار وأموال -فلن يقع هذا كله من أهل الميت من اعترافات وأسرار وأموال- فلن يقع هذا كله من أهل الميت موقع اليقين والطمأنينة في أغلب الأحيان.
من أجل هذا أيضًا كان تنازع الكلمات القرآنية فيما بينها، حتى لكأنها هي هذه الجهات المتنازعة المتخاصمة، في مسارب نفوسها، وفي مجرى خواطرها، حتى وإن لم يتخذ هذا النزاع وذلك التخاصم صورة عملية في واقع الحياة..
وقد آن لنا -بعد هذا- أن ننظر في معنى هذه الآيات، على هذا الوجه الذي فهمناها عليه، ونظرنا إليها منه..
فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ (المائدة: ١٠٦).
هو تشريع للمؤمنين، فيما يواجهون به موقفًا كهذا الموقف، وهو موت أحدهم، وهو يضرب في الأرض، بعيدًا عن أهله، وذوي قرابته.
ففي تلك الحال ينبغي أن يتخير المحتضر شاهدين يتوسم فيهما الأمانة والاستقامة، ثم يدعوهما إليه ويفضي إليهما بما يريد أن يوصي به أهله فيما خلفه وراءه من شئون تتصل بماله، وأهله، وما له، وما عليه.. ثم يسلم إليهما ما يريد أن يحملاه إلى أهله، من ماله ومتاعه.
فقوله تعالى: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ مبتدأ، خبره «اثنان». والجملة الخبرية هنا مراد بها الأمر والإلزام.. والتقدير: إذا حضر أحدكم الموت فشهادة قائمة بينكم لهذا المحتضر، يشهدها اثنان ذوا عدل منكم... أي من المؤمنين.. فانظر كيف تلتقي بالخبر عن المبتدأ الذي يطالعك بعد هذا النداء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فبعد هذا النداء يلقاك المبتدأ ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾، ثم تلقاك هذه الجملة المعترضة: إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، وبعدها يلقاك الخبر: «اثنان»، ولا تكاد تتبينه إلا بعد معاودة الفكر، وترداد النظر.
وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ ﴾ إشارة إلى أن هذا الموت الذي يقع في الغربة هو شيء أكثر من الموت، لما يبعث من حسرة مضاعفة في المحتضر الذي لم يشهده أهله، وفي أهله الذين لم يحضروا موته، ولم يؤدوا ما يجب للميت على الحي.. ومن هنا جاء التعبير عن الموت بالمصيبة، الذي هو في واقعه شيء طبيعي، في غير تلك الحال التي وقع فيها.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ﴾ (المائدة: ١٠٦).
فإذا أدى الشاهدان ما حملهما الميت إلى أهله، من قول، ومن مال ومتاع، ورضى أهله بما أدى إليهما الشاهدان، فقد انتهى الأمر عند هذا الحد، ولا متعلق لأحد عند هذين الشاهدين بعد أن أديا شهادتهما ووقعت موقع الرضا والقبول من أهل الميت.
أما إذا وقع في نفس الورثة وأولياء الميت شيء من الريبة والشك، فيما جاءهما به الشاهدان من عند صاحبهم، ثم ارتقى هذا الشك والارتياب إلى التهمة، ثم النزاع والخصام، فإن للقضية وجهًا آخر.. بل وجهين آخرين:
والوجه الأول: هو أن يدعى الشاهدان إلى الحلف على ما أشهدهما عليه الميت، وما حملهما من مال ومتاع..
وحلف الشاهدين مشروط بشرط، وهو أن يدعيا بعد الصلاة مباشرة، وهما خارجان من بين يدي الله، قبل أن يتلبسا بشيء من أمور الدنيا، وذلك ليكون لهذا الموقف أثره في إقامة شهادتهما على الحق والعدل، أو على ما هو أقرب إلى الحق والعدل..
وهذا ما يشير إليه وله قوله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ﴾ (المائدة: ١٠٦).
فحبسهما من بعد الصلاة، هو إمساكهما قبل أن يتصلا بالحياة العامة، ويباشرا شئونًا مختلفة فيها.. حتى يكونا أقرب إلى الخير، وأبعد من الضلال.
وقد اختلف في الصلاة التي يحبسان بعدها: أهي صلاة العصر، أو صلاة الظهر؟
والرأي، أنها أي صلاة، حيث أطلق القرآن ذلك، ولم يقيده، وصلاة أي وقت على إطلاقها من شأنها أن تبعث من الخشية في قلب المؤمن ما تبعثه الصلاة في أي وقت للصلوات الخمس..
وقوله تعالى: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ هو جملة اعتراضية، أريد بها بيان الحال الداعية إلى حلف الشاهدين، وهي الشك والريبة في شهادتهما.
وقوله تعالى: ﴿لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ﴾ هو بيان النص الحلفة التي يحلف بها الشاهدان..
وفيها من التوكيد والتحذير والتخويف، ما يجعل لهذه الحلفة أثرًا بالغًا واقعًا في نفس الشاهدين..
والضمير في قوله تعالى: ﴿بِهِ﴾ يعود إلى هذا القسم الذي يقسمان به، وأنهما لا يحنثان في هذا القسم، ولا يبيعانه بأي ثمن وإن كثر؛ لأنه حطام من حطام الدنيا، لا يساوي شيئًا إزاء جلال الله وعظمته، وقد أقسما به، وأشهداه على ما يقولان، فأي نفع مادي يعود عليهما بالحنث في اليمين، هو -وإن بلغ من الكثرة- لا يساوي شيئًا مما يعترضان له أنفسهما من غضب الله وسخطه.
هذا، وقد أثار بعض الفقهاء والمفسرين اعتراضًا على حلف الشاهدين... وأنهما حين رد ورثة الميت شهادتهما، أصبحا متهمين بالنسبة لهم، على حين أصبح أهل الميت أصحاب دعوى عليهما.. وإذ لم يكن لأهل الميت بينة على دعواهم، كان على المدعى عليهما من أهل الميت، الحلف، عملًا بالمبدأ الشرعي: «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر». فهما على هذا الرأي متهمان، وليســــــــــــا شاهدين، فلا يحلفان إلا إذا ادعى عليهما أهل الميت دعوى، ثم أقاموا البينة على هذه الدعوى.. فكيف -والحال كذلك- توجه إليهما اليمين؟
وإثارة مثل هذه التساؤلات أمام النص القرآني بتوجيه اليمين إليهما ضرب من المماحكة، التي لا محصل لها في هذا الموقف الذي لا يحتمل إلا قولًا واحدًا. وإذن فلتكن هذه التساؤلات من قبيل الرياضة الذهنية التي لا حرج على العقل فيها ما دام ينتهي إلى التسليم بما أمر الله، مقرًّا بالعجز والقصور..
على أن الموقف هنا لا يدعو إلى مثل هذه التساؤلات التي أثارها الفقهاء والمفسرون حول موقف الشاهدين، وأنهــــــما بارتياب أهل المتوفى فيهما أصبحا متهمين، وأن أهل الميت أصبحوا أصحاب دعوی، وهذا التخريج للآية الكريمة على هذا الوجه غير صحيح.. فالمفروض في الشاهدين أنهما ذوا عدل، وأن في دعوتهما إلى القسم بما شهدا عليه ليس اتهامًا لهما، ولكنه توثيق وتأكيد للشهادة التي يشهدان بها، ولهذا فإنا لا نذهب في فهم الآية الكريمة إلى ما ذهب إليه المفسرون من أن حبس الشاهدين بعد الصلاة وتوجيه اليمين إليهما، إنما يكون ذلك عند الارتياب في شهادتهما.. وكلا، فإن حبسهما بعد الصلاة وقبل أداء الشهادة هو الإجراء المطلوب على كل حال، سواء وقع في نفس أهل المتوفى ارتياب أو لم يقع.. فذلك التدبير من أداء الشهادة بعد الصلاة مما يدخل الطمأنينة في النفوس، ومما يقيم في نفس الشاهدين وازعًا يزعهما عــن الانحراف في أداء الشهادة على وجهها، كما يقول سبحانه: ﴿ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا...﴾ (المائدة: ١٠٨)، ولهذا جاء قوله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ قبل قوله تعالى: ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ فالحبس والإمساك بالشاهدين بعد الصلاة مطلوب قبل أداء الشاهدين الشهادة على كل حال، كما قلنا، أما حلف اليمين مع أداء الشهادة فقد جعل مرده إلى أهل الميت، إن أرادوا توثيقًا للشهادة، ونزعا لكل ريبة أو شك فيها، طلبوا إلى الشاهدين أن يقسما بالله على ما يشهدان عليه، وإلا شهد الشاهدان دون قسم، وهما في كلا الحالين ليسا موضع اتهام ولا رد لشهادتهما.
فإذا وجد أهل الميت مقنعًا بعد حلف الشاهدين، انتهى الأمر، وإلا سارت القضية إلى الوجه الآخر من وجهيها..
وفي هذا الوجه يندب أهل الميت اثنين منهما، فيشهدان بما يعلمان من أمر الميت، وبما لم يشهد به الشاهدان من قبل، أو بما شهدا بخلافه، وأن يقسما على ذلك الذي يشهدان به، وأن يقسما كذلك على أن شهادتهما أحق من شهادة هذين الشاهدين..
على أنه لا يصار إلى هذا الموقف إلا بعد أن يثبت بالبينة القاطعة، والبرهان الواضح، أن هذين الشاهدين لم يقولا الحق، ولم يؤديا الأمانة.. وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (المائدة: ١٠٧).
والمعنى: فإن ظهر، أو تبين أن الشاهدين قد اقترفا إثمًا بسبب تلك الشهادة التي أدياها على غير وجهها، فليقم آخران مقامهما بتلك الشهادة، من أهل الميت الذين فرض عليهم الشاهدان السابقان، اللذان كانا أولى من أهل المتوفى بالحكم في شئون قريبهم الميت؛ لأنهما كانا شاهدين وفاة المتوفى، قد حضرا، ورأيا، وسمعا، على حين أن أهله غائبون عنه، لم يروا ولم يسمعوا..
فالذين استحق عليهم الأوليان، هم أهل المتوفى، ومعنى استحق عليهم الأوليان؛ أي: وجب حق الشاهدين عليهم، بأن يستمعوا لشهادتهما، وأن يقبلوا هذه الشهادة إلا إذا عثروا على دليل مادي ينكر عليهما ما شهدا به.. والأوليان هما الشاهدان اللذان أشهدهما المتوفى، والأوليان مثنى الأولى بمعنى الأحق؛ أي أن هذين الشاهدين، أحق من غيرهما بالاستماع إلى شهادتهما.
وفي قوله تعالى: ﴿فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ﴾ تحريض للشاهدين على أن يؤديا الشهادة على وجهها، وأنهما بما احتملا من أمانة الشهادة، أصبحا بهذه المنزلة من الميت، وأنهما أقرب من قرابته وأولى منهم بكلمة الفصل في شئونه، ولكنهما إذا خانا الأمانة، ولم يؤديا الشهادة على وجهها، زحزحا عن هذا الموقف، وانتقلا من منصة الحكم، إلى موقف الاتهام.. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ (المائدة: ١٠٨).. أي في هذا التدبير الحكيم بإقامة شاهدين من أولياء الميت مقام هذين الشاهدين، عند العثور على خيانتهما في هذا ما يدعوهما إلى الحرص على أداء الشهادة، أقرب ما تكون إلى الحق، إن لم يكن ذلك عن ديانة وإيمان، كان عن خوف من الفضيحة والاتهام والخزي أمام الناس، بعد أن يرد أهل الميت شهادتهما، ويقسم شاهدان منهم أن شهادتهما أحق من شهادة هذين الشاهدين، وأقرب إلى الصدق، وأولى بالقبول..
وقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾، هو دعوة للشاهدين، ولأولياء الميت، ثم لكل مؤمن، بتقوى الله، والامتثال لأمره ونهيه، فمن خرج عن شريعة الله، فهو في ضلال دائم، لا يهتدي إلى خير أبدًا.. ﴿وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (الرعد: ٣٣).
وفي الأمر بتقوى الله في هذا المقام تذكير بجلاله وعظمته، وبما ينبغي أن تمتلئ به القلوب من خشيته وسطوة عقابه بمن لا يتقون الله، ولا يقولون قولة الحق، وفي قوله تعالى: ﴿وَاسْمَعُوا﴾ توكيد للأمر بالتقوى، أي: واسمعوا هذا الأمر جيدًا، وعوه، واعملوا به، فمن لم يعمل بما أمر الله به من التقوى فقد خرج عن أمر ربه، وعد من الفاسقين.
وهكذا نرى في هذا النظم القرآني، الخارج -في ظاهره- على ما جاء عليه نظم القرآن كله من تساوق الألفاظ، وتجاوب النغم، وتواصل الجمل وترابطها- نرى في هذا النظم تصويرًا معجزًا المسارب النفوس، وخلجات الصدور، واهتياج المشاعر واهتزازها في تلك الحال العارضة من الموت في مطارح الغربة، وما يبعثه في نفوس الذين حضروه من غير أهل الميت، والذين لم يحضروه من أهله، من مشاعر مختلطة غائمة، ومن تصورات قلقة مضطربة، لا تثبت على حال، فجاءت موسيقى النظم القرآني ناقلة تلك المشاعر، وهذه التصورات على ما هي عليه، مجسدة لها في كلمات محدثة عن أخبارها، ناطقة بما استكن في الضمائر، وما أخفته الصدور.. فسبحان الله رب العالمين، ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾ (الإسراء: ١١١).
عبد الكريم الخطيب
الأستاذ بكلية الشريعة
-الرياض-
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
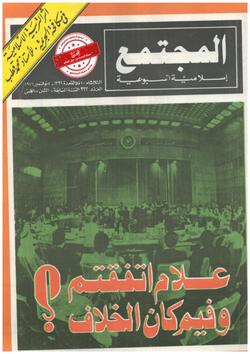
مراكز تحفيظ القرآن الكريم لجمعية الإصلاح الاجتماعي تعلن عن افتتاح مراكز تحفيظ جديدة
نشر في العدد 306
9
الثلاثاء 22-يونيو-1976