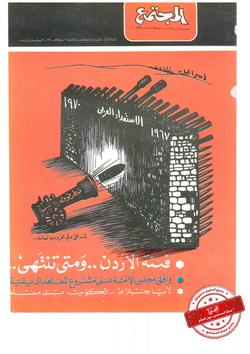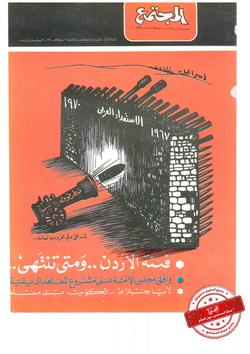العنوان في فقه الدعوة «١١».. غطة من جهبذ
الكاتب محمد أحمد الراشد
تاريخ النشر الثلاثاء 08-أغسطس-1972
مشاهدات 54
نشر في العدد 112
نشر في الصفحة 26
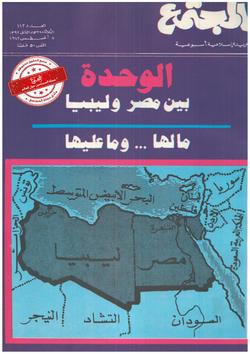
الثلاثاء 08-أغسطس-1972
يتمنى المؤمن أن يغفر الله له ويدخله الجنة، وإنه لفوز عظيم نفوزه بمجرد أن نتجاوز باب الجنة بخطوات، ولكن الطمع بما عند الله طمع حلو لذيذ، وإذا بنا نعيش بين مدة وأخرى لحظات من اللحظات اللذيذة، لا نقنع فيها بأن ندلف من باب الجنة فحسب، ولا أن نبقى في منازلها الواطئة، بل نطمع أن نكون في عليين، وفي الفردوس، من منازلها الرفيعة.
وهنا يكون الكلام المنطقي أن من يريد المنزلة العليا القصوى من الجنة، فعليه أن يكون في المنزلة القصوى في هذه الحياة الدنيا.
واحدة بواحدة
ولكل سلعة ثمن
وما هذه المنزلة القصوى في الدنيا إلا منزلة الدعوة إلى الله، كما يقول الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمه الله في كتابه الآخر الذي سماه «فتوح الغيب».
كان هو داعية مصلحًا، ولذلك تجد كل كتبه تركز على معنى الدعوة، ووجوبها.
إن الفائز عند الكيلاني من اختاره الله «وجعله جهبذًا وداعيًا للعباد ونذيرًا لهم، وحجة فيهم، هاديًا مهديًّا».
ثم قال: «فهذه هي الغاية القصوى في بني آدم، لا منزلة فوق منزلته إلا النبوة» (2).
المؤمن الأخرس متأخر
وكان الشيخ قد عد دونه في المنزلة آخر له «قلب بلا لسان، وهو مؤمن ستره الله عز وجل عن خلقه، وأسبل عليه كنفه، وبصَّره بعيوب نفسه، ونور قلبه». فلأن هذا المؤمن لم يملك اللسان، نزلت مرتبته، وتأخرت، وفقد ما في القاب الأول من الهيبة والفخامة، فالأول: «جهبذ» و«داعية» و«حجة»، وله ما في هذه الكلمات من إشعاع البهاء، والثاني: «مستور» فحسب، وبين جرس هذه الكلمة ولفظها، وتلك الكلمات وألفاظها، وتلك الكلمات وألفاظها من البعد مثل ما بين الأرض والسماء.
إن بونًا شاسعًا، وطفرة واسعة بين المنزلتين، منزلة الدعوة، ومنزلة الإيمان المستور المنعزل، وسبب البون هو اللسان الناطق بالحق لا غير.
من ملك هذا اللسان فقد بذَّ وسبق قافلة السائرين إلى الله.
كلهم يسير إلى الله، ولكن أين من في المقدمة، ممن في المؤخرة؟
وكلهم يدخل إن شاء الله الجنة، ولكن أين من يدخلها في الزمر الأولى، ممن يدخلها بعد أعوام من الانتظار في ساحة العرض؟ ولذلك جعل الكيلاني رحمه الله فقه الداعية لواجبه في تغيير الباطل وإظهار الحق منحة ربانية لمن يعلم الله صلاح قلوبهم، وصاغ هذا المعنى بأحرف يسيرة، لكنها ثمينة، فقال: «إذا صلح قلب العبد للحق عز وجل، وتمكن من قربه، أعطي المملكة والسلطنة في أقطار الأرض، وسلم إليه نشر الدعوة في الخلق، والصبر على أذاهم، يسلم إليه تغيير الباطل، وإظهار الحق» (2).
وكذلك البلاغة تكون حين تقتبس من مشكاة النبوة، نسبًا وعلمًا، فإنه كـــــــان رحمه الله في الذروة من الشرف، علويًّا صحيح النسب، كما كان في الذروة من علم الحديث وفقه أقوال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
إنه يقول: إن نشر الدعوة توفيق من الله، يوفق له من يعلم صلاح قلبه، فهو تشريف، وليس بتكليف.
ودقق النظر في قوله: «يسلم إليه تغيير الباطل وإظهار الحق».
الباطل يجب أن «يغير»، يغيره «الداعية» أي يحاربه، ويزيله، ويهيل عليه التراب يقبره.
إما أن ترجو من الباطل أن يترك مكانه ويعطيه إياك.
وإمَّا أن تتكلم معه باللغة الدبلوماسية، فذلك لن يكون ولن يفيد؛ إنما هو التغيير فقط ينص عليه قانون الدعوة.
نصل الماضي بالآتي
وإذن، فإن الإسلام اليوم أحوج ما يكون إلى جماعة من الدعاة الذين يملكون هذه النظرة التغييرية المفاصلة؛ دعاة يدركون جيدًا واجبهم في هداية الناس، ويبصرون موقعهم في موكب الدعوة السائر، وإنهم حلقة تصل الماضي بالآتي، وينشدون:
نحن في ذي الحياة ركب سفار يصل اللاحقين بالماضينا
قد هدانا السبيل من سبقونا وعلينا هداية الآتينا (3)
نعم، تعبوا رحمهم الله، حتى أوصلوا عقيدة التوحيد لنا، وربونا، وهذبونا، وانتشلونا من مخاطر متلفة، وعلينا أن نكون أوفياء لهم، ننفذ عهدنا، حين أخذوا علينا أن نعمل مثل الذي عملوا.
غرسوا فأكلنا، ونغرس فيأكلون.
والغرس يقتضي مخالطة الناس، ومشافهتهم، والصدع بالحق.
أما أن يختار الخلوة، ويترك محاربة الأفكار الأرضية، والمفاسد الخلقية، فهو كما وصفه مصطفى صادق الرافعي: «يحسب أنه قد فرَّ من الرذائل إلى فضائله، ولكن فراره من مجاهدة الرذيلة هو في نفسه رذيلة لكل فضائله، وماذا تكون العفة والأمانة والصدق والوفاء والبر والإحسان وغيرها، إذا كانت فيمن انقطع في صحراء أو على رأس جبل؟ أيزعم أحد أن الصدق فضيلة في إنسان ليس حوله إلا عشرة أحجار؟ وايم الله، إن الخالي من مجاهدة الرذائل جميعًا لهو الخالي من الفضائل جميعًا» (4).
وأي فرق بين المعتزل في رأس جبل، وبين من يعيش مع الناس أخرسًا صامتًا؟ إن مشكلة المسلمين اليوم لا يسببها نقص عددهم، ومشكلة الدعوة الإسلامية اليوم لا تتمثل في قلة عدد مَن بقي ثابتًا صامدًا على إسلامه حين كثر في الأمة ترك الصلاة والابتداع وحمل أفكار الكفر، فإن كل قطر من أقطار الإسلام لا يزال فيه شباب خير كثير عددهم، ولكن المشكلة في أنهم لا يصدعون بإسلامهم، ولا يدعون، أو يدعون من غير تنسيق بينهم، وإلى هذا المعنى أرشد الداعية البطل المقدام الفقيه عبد القادر عودة رحمه الله فقال: إن «في البلاد الإسلامية اليوم جيل مثقف ثقافة إسلامية عالية، حريص على أن يعيد للإسلام ما فقده، لا تأخذه في الحق لومة لائم، ولا عيب فيهم إلا أنهم متأثرون بأسلافهم إلى حدٍّ كبير في بعض الاتجاهات؛ حيث يصرفون أكثر جهدهم في العبادات والمواعظ، ولو أنهم صرفوا أكثر جهدهم في تذكير المسلمين بشريعتهم المعطلة وقوانينهم المخالفة للشريعة وحكم الإسلام فيها، لكان خيرًا لهم وللإسلام»(5).
الإمام أحمد يباشر التجميع
وشأن الداعية أن يترصد أخيار الرجال في المجتمع، فيحتك بهم، ويتعرف عليهم، ويزورهم، ويعلمهم طريق ضم الجهود الإسلامية وتنسيقها، فيجدد بذلك سيرة الإمام الداعية المبجل أحمد بن حنبل.
قالوا: كان الإمام أحمد «إذا بلغه عن شخص صلاح، أو زهد، أو قيام بحق، واتباع للأمر: سأل عنه، وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة، وأحب أن يعرف أحواله» (6).
لم يكن بالمنعزل المتواري الهارب من الناس.
ولا يكون داعية اليوم إلا مَن يفتش عن الناس، ويبحث عنهم، ويسأل عن أخبارهم ويرحل للقائهم، ويزورهم في مجالسهم ومنتدياتهم، ومن انتظر مجيء الناس إليه في مسجده أو بيته، فإن الأيام تبقيه وحيدًا، ويتعلم فنَّ التثاؤب.
وانظر من تطبيق الإمام أحمد لحرصه هذا مثالًا يذكرونه في معرض التعريف بشيخ البخاري والترمذي موسى بن حزام؛ قالوا: إنه كان ثقة صالحًا؛ لكنه «كان في أول أمره ينتحل الإرجاء، ثم أعانه الله تعالى بأحمد بن حنبل، فانتحل السُّنة وذبَّ عنها، وقمع مَن خالفها، مع لزوم الدين، حتى مات» (7).
وإنها لكلمات تحوي من معاني الدعوة شيئًا كثيرًا.
إن هذا التغيير لم يتم بالأماني المجردة؛ ألا ترى أن الإمام أحمد لزمه أن يجلس معه المجالس الطوال، مناقشًا له برفق وسكينة وحكمة وموعظة حسنة حتى استطاع صرفه عن بدعة الإرجاء التي توهمه أن العمل ليس شرطًا في الإيمان، وإنما هو تصديق القلب فقط، ثم مجالس أخرى علمه فيها السنن، ثم مجالس أخرى بعث فيه همَّة عالية استمر معها حتى موته بالدفاع عن السُّنة وقمع مخالفيها من أهل البدع والشهوات؟
إنه كذلك طريق الدعوة وسبيل خدمة الإسلام، وكذلك كان سلفنا من دعاة الإسلام.
لا بد من اتصال بالناس.
لا بد لك من مجالس معهم تعلمهم فيها.
لا بد لك من ترك زوجك وأولادك ومجالس الدنيا وهموم التجارة بضع ساعات في كل يوم، تتوجه فيها إلى الله، داعيًا أن يعين بك ضالًّا من ضحايا الطواغيت الحالية، فتهديه، أو يعين بك يائسًا جامدًا، يستهلكه الحزن على واقع المسلمين، وتقيده همومه الدنيوية، فتحركه وتهزه وتغطه غطًّا.
إنها غطة العزم.
غط جبريل عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثًا في غار حراء في أول لحظات نبوته، فضمَّه إلى صدره ضمًّا شديدًا، ثم قال له: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (العلق: ١).
وغطَّ النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس، فضمه إلى صدره، وقال: «اللهم علِّمه القرآن».
وغطك الدعاة.
وعليك أن تغطَّ غيرك هذه الغطة الواجبة التي تضع حدًّا فاصلًا بين عهد الرخاوة وعهد حمل الأمانة بحزمٍ وعزم ووفاء.
لقد أعان الله تعالى بأحمد آلافًا من مثل موسى بن حزام هذا، وبهم استطاع أن يرد فتنة وكيد الجهمية والمعتزلة وينصر السُّنة، فكم يا ترى سيعين الله بك اليوم من ترد بهم كيد الشرق والغرب؟
لقد كان السلف رضي الله عنهم أفرح ما يكونون عند العمل للدعوة وهداية أحد على أيديهم.
كان عبد القادر الكيلاني يقول: «سبحان مَن ألقى في قلبي نصح الخلق وجعله أكبر همي»، ثم يقول: «إذا رأيت وجه مرید صادق قد أفلح على يدي: شبعتُ وارتويتُ، واكتسبت، وفرحت، كيف خرج مثله من تحت يدي؟» (8).
هذا شبعهم وريهم؛ لا في تأليف الكتب فحسب، والتي تكرر المعاني الواحدة.
العالم من كان داعية؛ أمَّا مؤلف الكتب فحسب فنقول له:
لست والله عالمًا أو حكيمًا إنما أنت تاجر في العلوم (9)
الإسلام اليوم لا يحتاج مزيد بحوث في جزئيات الفقه، بقدر ما يحتاج إلى دعاة يتكاتفون.
فقه الوزير الداعية
واسمع إلى طريف ما فهمه الفقيه المحدث العابد الوزير العباسي الصالح ابن هبيرة الدوري رحمه الله من قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ﴾ (يس:20)، وقوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ﴾ (القصص:20) إذ يقول: «تأملت ذكر أقصى المدينة، فإذا الرجلان جاءا من بعد في الأمر بالمعروف، ولم يتقاعدا لبُعد الطريق» (10).
ويا له من استخراج بديع مع بساطته يجعل الداعية يتأمل ويقول: هل يتأتى للداعية اليوم أن يستكثر ما توجبه الدعوة عليه من حركة يومية بعيدة بعد أن يعرف هذا الذي كان عليه سلفه من دعاة القرون الأولى، وصفتهم هذه التي خلَّدها القرآن في الجوب والتجول والذهاب إلى الأقاصي بغية بثِّ الدعوة والأمر بالمعروف؟
﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ (يس: ٢٠).
«فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب لها بعدما رأى فيها من دلائل الحق والمنطق ما يتحدث عنه في مقالته لقومه، وحينما استشعر قلبه حقيقة الإيمان تحركت هذه الحقيقة في ضميره فلم يطق عليها سكوتًا، ولم يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله والجحود والفجور، ولكنه سعى بالحق الذي استقر في ضميره وتحرك في شعوره، سعى به إلى قومه وهم يكذبون ويجحدون ويتوعدون ويهددون، وجاء من أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق، وفي كفهم عن البغي، وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم الذي يوشكون أن يصبوه على المرسلين.
وظاهر أن الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان، ولم يكن في عزوة من قومه أو مَنعة من عشيرته؛ ولكنها العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء به من أقصى المدينة إلى أقصاها» (11).
(1) فتوح الغيب للشيخ عبد القادر/ ٤٩.
(2) الفتح الرباني للشيخ عبد القادر/ ١٤٤.
(3) لعزام في ديوان المثاني/ ١٤٩.
(4) وحي القلم: 2/ 97.
(5) الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه/ ٦٥.
(6) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي/ ۲۱۸
(7) تهذيب التهذيب لابن حجر: 10/ 341.
(8) الفتح الرباني/ ۲۷
(9) لعزام في ديوان المثاني/ ۹۸.
(10) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب: 1/ ٢٦٩.
(11) في ظلال القرآن: 23/ ۱٦.
تصويب: ورد في المقال السابق أن الفتح الرباني للشيخ عبد القادر هو مجموع خطب ألقاها سنة ٥٤١هـ، والصواب أنه ألقاها سنة ٥٤٥هـ
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل