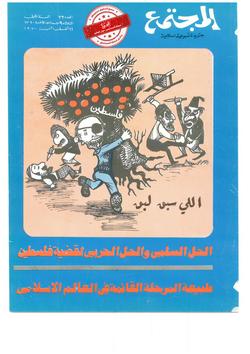العنوان أبهذا الأسلوب تُناقش مسائل الخلاف الفقهي؟
الكاتب المستشار عبدالله العقيل
تاريخ النشر الثلاثاء 12-يناير-1971
مشاهدات 17
نشر في العدد 43
نشر في الصفحة 10
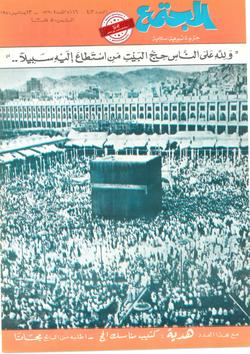
الثلاثاء 12-يناير-1971
- لم يكن الدكتور زيدان من أنصار الحكم الفردي
- مناط الخلاف هو ما بعد أن يستشير ولي الأمر من يراهم من أهل الحل والعقد من المسلمين، هل يأخذ برأيهم ولو ظهر له أن الحق والمصلحة العامة خلافه، أم يُخالفهم ويُنفّذ ما يراه الأرجح لمصلحة الإسلام والمسلمين؟
في مجلس من مجالس الإيمان جمع كثيرًا من الإخوة الكرام سألني أحدهم هل اطَّلعت على مقال
«الشورى أم الاستبداد» للأستاذ عبد الله أبو عزة الذي نشره في مجلة المجتمع الكويتية بعددها المرقم (٣٨) بتاريخ (١٠) شوال (1390هـ)، فأجبت بالنفي، فقال: أرجو إفادتي برأيك بعد قراءته، وشاءت إرادة الله أن تشغلني عن قراءة المقال المذكور مشاغل الحياة ومتاعب العمل حتى تناولته قبل أيام وقرأته قراءة فاحصة، فوجدت أن الأخ الكاتب -سامحه الله- قد استعمل من التعابير والألفاظ في مناقشة مخالفيه في الرأي -وهم من نعلم استقامة في السلوك وعمقًا في الفهم وأصالة في الرأي- ألفاظا ما كان يحسن صدورها من مثله، وهو الذي نعرف عنه كل خير، ولكن جلَّ من لا يسهو، ولكل جواد كبوة، ولكل كاتب هفوة.
وأحبُّ أن أقول بادئ ذي بدء بأن من حق كل إنسان أن يتبنى من الآراء ما يراه صالحًا من وجهة نظره، وإنني هنا قد أتفق مع كاتب المقال في وجهة نظره، وقد أخالفه، ولكن هذا لا يمنع من أن أستدرك عليه ما أظن أنه قد جاوز فيه جانب الصواب وركب الأسلوب الصعب في تجريحه لمخالفيه في الرأي، وقسى عليهم بشكل خرج فيه من حدود آداب المناظرة ومقارعة الحجة بالحجة، واتخذ من ألفاظ التشهير والطعن وسيلة لنشر منقولاته «ولا أقول أفكاره» علی صفحات جريدة المجتمع الغراء بعد أن نشرها قبل ثلاث سنوات في جريدة الشهاب اللبنانية مع بعض الزيادة في الأخيرة.
لا يخفى على من له أدنى اطلاع على كتب التفسير والحديث والفقه والأصول والسِير والتراجم أن قضية الشورى وهل هي مُلزمة لولي الأمر أم مُعلِمة قضيةٌ تضرب في أغوار القِدم، وقد صال فيها العلماء وجالوا حتى لا تكاد تجد كتابًا من الكتب المذكورة إلا وأورد مواطن الخلاف بين العلماء حولها، وآراء كل فريق ووجهة نظره، وآراء الفريق الآخر ووجهة نظره، وساق من الأدلة ما تعزز الرأي الذي يميل إليه ويستريح إليه عقله وقلبه، وهذا شأن علماء السلف الأجلاء، وقليل من الخلف الفضلاء الذين يتحرون الحق فيما يقصدون ويكتبون، ويبحثون في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها أو تختلف مفاهيمهم في دلالة النص بشأنها، وقد يتمسك كل فريق منهم بوجهة النظر التي يتبناها ويراها الأولى بالاتباع والعمل على أنها الحق المطلق، وكثيرًا ما يصدرون كلامهم بقولهم «والذي يميل إليه القلب أو الذي يظهر لي أنه الحق، والذي أرى أنه الحق والذي يترجح لدي أنه الحق إلى غير ذلك من الألفاظ، كما يختمونها بقولهم «والله أعلم»، ولم أقف فيما قرأت لعالِم يحترم نفسه ويخشى ربه سواء أكان من القدامى أو المحدثين يقول بصفة الجزم إن رأيه هو الحق وما عداه هو الباطل، بل كان كل من هؤلاء يطالب تلامذته ومتبعيه أن يجعلوا النص هو الأصل وما عداه مردود، ويناشدهم أن يتركوا رأيه أو فتواه إذا خالفت النص من الكتاب والسنة وما أجدرنا أن نسوق هنا طائفة من أقوال الأئمة الأعلام كي نُذكِّر بها أنفسنا وإخواننا القراء حتى لا تطيش أحلامنا، ونلتزم حدودنا، ونطامن من غرور نفوسنا، فما نحن من أولئك الجهابذة إلا تلامذة صغار لا نزال عاجزين عن حصر ما كتبوا وألّفوا، فضلًا عن استيعاب قراءته وهضم محتواه.
يقول الإمام الشافعي رحمه الله: «ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصَّلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فأقول ما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو قولي (1) ». وقال أيضًا: «كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي» (2).
وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول: «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسُّنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه» (3).
وهذا الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله يُحذّر تلميذه أبا يوسف بقوله: «ويحك يا يعقوب؛ لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأْي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأْي غدا وأتركه بعد غد».
وأما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقد بلغ من تمسكه بالسُّنة أنه كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي وكان يقول: «لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذوا من حيث أخذوا» (5).
ويقول: «رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحُجَّة في الآثار» (6).
ولا أريد الاسترسال في ذكر ما قاله بقية العلماء والفقهاء، فهذا مجاله غير هذا المقال، ومن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه في مظانه من المراجع المعتمدة، بل أردت أن تكون كلمات هؤلاء الأئمة الأجلاء دروسًا لمَن يُقلّدهم ويحاول التعصب لرأيهم بدون دليل أو برهان؛ معرضًا بذلك عن صريح الكتاب وصحيح السُّنة، مع أنهم رضوان الله عليهم جميعًا حذَّروا من ذلك وشددوا.
إن الأخ الفاضل كاتب المقال جعل عنوان مقالته «الشورى أم الاستبداد» والعنوان بحدّ ذاته تنقصه الدقة في التعبير، وكان الأولى أن يُسمّيه «هل نتيجة الشورى ملزمة أم معلمة» لأن العنوان الذي اختاره يوحي بأن من لم يأخذ بإلزامية الشورى قد أقر الاستبداد والتزمه.
والواقع غير هذا، فالشوری حق للرعية واجبة على ولي الأمر، وهذا لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان.
وإنما مناط الخلاف هو ما بعدها أي بعد أن يستشير ولي الأمر من يراهم من أهل الحل والعقد من المسلمين، هل يأخذ برأيهم ولو ظهرله الحق والمصحلة العامة خلافه، أم يخالفهم وينفذ ما يراه الأرجح لمصلحة الإسلام والمسلمين؟ لأن الاستبداد هو عدم المشاورة قبل اتخاذ الرأي، وليس هو اتخاذ الرأي بعد المشاورة حسب ما يترجح لولي الأمر من المصلحة كما ذكرت آنفا.
وإنني أستغرب إیراد لفظ الاستبداد في مقابلة الشورى؛ حيث لم يرد في أي كتاب من الكتب التي تعرَّضت للموضوع سواء أكان مؤلف الكتاب من مؤيدي هذا الرأي أو ذاك، بل إن إيراد لفظ «الاستبداد» في مقابلة الشورى تعبير تواضع عليه المحدثون من خصوم الإسلام وبعض المتأثرين بثقافة الغرب ومصطلحاته من أبناء المسلمين الذين حُجبوا عن الاطلاع على كنوز الإسلام وذخائره وجهلوا دلالة الألفاظ ومعاني النصوص لبُعدهم عن إدراك قواعد اللغة العربية التي هي مفتاح الكتاب والسُّنة وطريق فهم الشريعة الغراء.
ولا أظن الأخ الفاضل كاتب المقال يرضى لنفسه مجاراة هؤلاء في مصطلحاتهم وتسمياتهم، ثم إذا أمعنا النظر في مقال الكاتب نراه يسوق بعض ما جاء في بعض المراجع من كتب التفسير والحديث والتاريخ والفقه عن الشورى، ويناقش بعض المفاهيم مكررًا هذه المصطلحات الغربية ويسوق افتراضات لم ترد على لسان من حمل عليهم حملته الشعواء واتهمهم بأقسى الاتهامات، حيث يقول عن الدكتورين زيدان وبابلى: «والأخوان عندنا غير متهمين ولكنها العاطفة «كذا» والهوى «كذا» يجوران على المنطق أحيانًا أو هو التساهل بالاعتماد على الروايات السهلة المأخذ «كذا»، وعلى آراء بعض الدارسين دون المعاناة الذاتية العميقة وإعمال الفكر ليالي طوالًا «كذا».
ويقول الكاتب كذلك: «ونقطة الضعف الخطيرة في بحوث الذين تصوروا الإسلام مناصرًا لفردية واستبدادية الحكم أنهم يتصورون الروايات ولا يرجعون للأصول، وهنا أحبُّ أن أسأل الكاتب: من هم الذين يتصورون أن الإسلام يناصر فردية الحاكم واستبداديته؟ ومن أين جاء بهذا الكلام الذي نسبه إليهم؟ وهل هم من علماء الإسلام القدامى أم المُحدثين؟ وفي أي كتاب نشروا هذا الرأي الشاذ؟ اللهم إلا إذا كان كاتب المقال يقصد بهم العلماء الذين أخذوا بأن الشورى معلمة وليست بملزمة، فإن كان هؤلاء هم المقصودون فيا ويح كل مجتهد من المجتهدين من عصر الصحابة والتابعين إلى يوم الناس هذا لأن كل من لم يقل بإلزامية الشورى فهو من دعاة الاستبداد ومناصري الفردية والتسلط «حسب مفهوم الكاتب»، وأظنهم قياسًا على ذلك في حاجة لاستغفار الكاتب لهم عن زلّتهم كما استغفر للأخوين زيدان وبابلي، وكأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبشر المجتهد المصيب بأجرين والمجتهد المخطئ بأجر واحد لا ينسحب على هؤلاء ولا يشملهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يجعل للمجتهد المخطئ «أجرًا»، وأخونا الكاتب يعتبره مقصرًا في حاجة للاستغفار.
ويستمر الكاتب -سامحه الله- بالادّعاء لنفسه على ضوء فهمه للنقول التي أخذ تفاريقها من هنا وهناك فيقول: «لقد بينا الآن بما لا يدع مجالًا للشك أن الذين يزعمون أن هناك أدلة شرعية تُثبِت أن الشورى في الإسلام غير مُلزمة بنتيجتها إنما يبنون مزاعمهم «كذا» على أوهام «كذا» لا تعدو أن تكون ناتجة عن فهم خاطئ بسبب التسرع في تبني أحكام دارسين آخرين «كذا»، وعدم استيعاب المصادر كذا أو بسبب الميل مع الهوى «كذا».
إن الأخ الكاتب قد اشتط غاية الشطط فيما كتب، وظن أنه قد جاء بعلمٍ جديدٍ لم يسبقه إليه أحد، وزعم لنفسه أنه الذي اطَّلع على المراجع وغيره أخذ عن الدارسين، كأن من علامة الفقه والفهم ألا تنقل إلا من نفس المرجع، ولا يصح أن تنقل ممن نقل عن المراجع وفاته أن معظم المراجع إن لم يكن كلها تورد الروايات بالنقل والإسناد، بل إنني أُجزم بأن معظم المراجع التي ذكر أسماءها في ذيل مقالته ليس مؤلفوها من أصحاب الفقه، ودورهم فيها إنما هو دور المؤرخ الناقل على اختلاف درجاتهم في الدقة؛ كابن عساكر وابن الأثير والبلاذري والخطيب البغدادي، وليس هذا تعريضًا بهؤلاء الأعلام من المؤرخين الأفذاذ، بل المقصود أن الفقيه غير المؤرخ والأصولي غير الأديب، وإن كان البعض يجمع أكثر من علم؛ كابن كثير والطبري والذهبي وغيرهم.
إنني أستطيع أن أقول بدون تحفظ بأن الدكتور عبد الكريم زيدان من أكثر الدارسين المعاصرين للمراجع الفقهية والأصولية قديمها وحديثها، بل إنه من القلائل الذين استوعبوا وهضموا جميع ما كتبه الإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أفذاذ الرجال، وأن كل من سمع دروسه أو محاضراته، وقرأ كتبه أو مقالاته شهد بجلالة قدر الرجل، وعُمق فهمه، وجمال عرضه، ودقة تعبيره.
حتى إن الذين استمعوا إلى محاضراته في الموسم الثقافي بالكويت، وجلّهم من أساتذة الجامعة وقضاة المحاكم ومستشاريها أكبروا فيه هذا العمق والأصالة والدقة، وإن فيما كتب من مؤلفات وسطّر من مقالات الدليل الناصع على أن مثله لا ينقصهم «استيعاب المصادر»، ولا هو ممن «يتساهل بالاعتماد على الروايات السهلة المأخذ»، ولا ممن يُصدرون الرأي «دون المعاناة الذاتية العميقة وإعمال الفكر ليالٍ طوالًا».
ولم يكن في كل ما كتب وخطب وحاضر من «أنصار الحكم الفردي»، وليس ممن تستبد بهم «العاطفة»، أو يتصفون «بالفهم الخاطئ»، وحبذا لو نشرت المجتمع بحث الدكتور زيدان عن الشورى بكامله من كتابه «في أصول الدعوة» ليعرف القراء رأيه، كما أنني أستطيع القول بأن كاتب المقال من الناحية الفقهية والأصولية لا تؤهله الخوض في مثل هذا الميدان فضلًا عن أن يكون ندًّا للدكتور زيدان، والتعريض بأفاضل العلماء الذين أفنوا حياتهم وقضوا زهرة شبابهم في فقه الشريعة وأصولها وقدموا من نتائج أفكارهم المؤلفات الدسمة والبحوث الرصينة التي استفادت منها جماهير المسلمين وخدموا بها الدين.
ورحم الله الإمام الشهيد الذي قال: «والخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سببًا للتفرق ولا يؤدي إلى خصومة ولا بغضاء، ولكل مجتهد أجره، ولا مانع من التحقيق العلمي النزيه في مسائل الخلاف في ظل الحب في الله والتعاون على الوصول إلى الحقيقة من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب، وكل أحد يؤخذ من كلامه ويُترك إلا المعصوم -صلى الله عليه وسلم-، وكل ما جاء عن السلف -رضوان الله عليهم- موافقًا للكتاب والسُّنة قابلناه، وإلا فكتاب الله وسنة رسوله أولى بالاتباع، ولكنا لا نعرض للأشخاص فيما اختُلف فيه بطعن أو تجريح، ونكلهم إلى نياتهم وقد أفضوا إلى ما قدَّموا، والقرآن الكريم والسُّنة المُطهَّرة مرجع كل مسلم في تعريف أحكام الإسلام ويُفهم القرآن طبقًا لقواعد اللغة العربية، من غير تكلُّف ولا تعسُّف، ويرجع في فهم السُّنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقاة»7.
وختامًا أودُّ أن أسأل لي وللأخ كاتب المقال الهدى والتقى والسداد والرشد والعِصمة من الزلل في القول والعمل.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
عبد الله العقيل
المراجع
1) رواه الحاكم بسنده المتصل إلى الشافعي كما في ابن عساكر «15/1/3» وإعلام الموقعين «2/363، 364» والإيقاظ «ص100».
2) الهروي «47/1» وابن القيم في إعلام الموقعين «2/363» والفلاني «ص 104».
3) ابن عبد البر في الجامع «2/32» وعن ابن حزم في أصول الأحكام «6/149» وكذا الفلاني «72ص».
4) ابن معين في التاريخ «6/77/1» والإيقاظ «52ص» وابن القيم في إعلام الموقعين «2/344».
5) الفلاني «113 ص» وابن القيم في «الإعلام» «2/302».
6) ابن عبد البر في «الجامع» «2/149».
7) رسالة التعاليم.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل