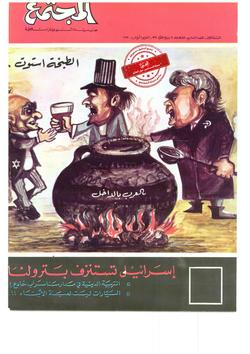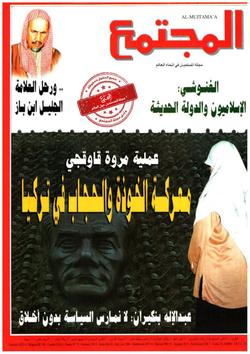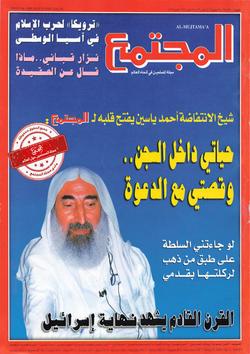العنوان أصول الجرح والتعديل
الكاتب محمد سلامة جبر
تاريخ النشر الثلاثاء 26-ديسمبر-1972
مشاهدات 79
نشر في العدد 131
نشر في الصفحة 22
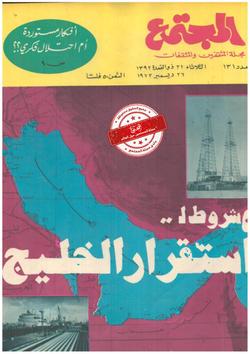
الثلاثاء 26-ديسمبر-1972
إلام ندعو.. وكيف: ۱۳
المقاييس أولًا؟
أصول الجرح والتعديل
بقلم الأستاذ: محمد سلامة جبر
«الجرح والتعديل»، علم قائم بذاته، وهو من العلوم الشرعية الجليلة التي تفردت بها أمتنا والحمد لله.
نشأ -كعلم مستقل -بنشوء الحاجة إلى معرفة الرواة في زمن اتساع الدولة الإسلامية وترامي أطرافها وشيوع النقل والرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم.
والصحابة كلهم عدول عند علماء أهل السنة، فيكفي ثبوت الصحبة للراوي حتى تثبت عدالته وتقبل روايته.
وللجرح والتعديل قواعد وأصول، مستندها الكتاب والسنة، وللاجتهاد فيها نصيب.
وإن من مفاخر شريعتنا والحمد لله، إنها وصلت إلينا بالسند الصحيح المتصل، الذي تطمئن القلوب إلى صحته، وتسكن النفوس إلى سلامته، وتقنع العقول برجاحته.
ولعل الوعد الإلهي الحق بحفظ الكتاب الكريم، يتضمن كذلك الوعد بحفظ السنة النبوية، حيث إنها شارحة للكتاب، مبينة لمجمله، مفسرة لمشكله.
وسقوط الثقة بالسنة يبطل ركنا أساسيًا من أركان الشريعة الإسلامية حيث إن كثيرًا من الأحكام الهامة ليس له مستند إلا السنة الصحيحة فانظر كيف يؤول الأمر لو انهد هذا الركن العظيم؟!
وإن الدعوات الآثمة التي نسمعها في هذه الأيام، وينادي أصحابها بالاقتصار على الكتاب في استنباط الأحكام بدعوى أن الأحاديث المتواترة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة وما بقي فأحاديث آحاد لا تقوم بها الحجة في زعمهم.
هذه دعوى باطلة، وحجة داحضة، وقول مردود على أصحابه، يحتملون وزره ووزر من تبعهم إلى يوم الدين، وكفانا الله شرهم وعصمنا برحمته عن الزيغ مع الأهواء.
ومما يروى في هذا المقام أن رجلا من هؤلاء قدم على أحد العلماء وسأله مسألة طلب عليها دليلًا من كتاب الله لا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الشيخ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر: 7)
فبهت الذي سأل. ولله الحجة البالغة.
قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: 9) وقال سبحانه ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (النجم: 3-4) فما دام نطقه صلى الله عليه وسلم وحيا غير متلو، وما دام كمال فهم القرآن متوقفاً على هذا النطق الكريم، والسنة العملية الهادية، فمن سوء الظن بالله سبحانه أن نحسب أنه يدع أقوال نبيه وأفعاله وتقريراته تضيع في الضياع وتزول مع الزوال دون أن يقيض لحفظها والذب عنها من يوصلها بإذن الله إلينا سليمة من كل شائبة، مبرأة من كل زيف خالصة من كل افتراء ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (الأنعام: 149).
ولأولئك أقول ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (النمل: 64) وما أظنهم بفاعلين
«أنتم شهداء الله في الأرض» والأصل في باب الجرح: والتعديل ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنهم أنهم مروا بجنان فاثنوا عليها خيرًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «وجبت» ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجيت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض»
وفي رواية للبخاري عن عمر رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «أيما مسلم شهد له أربع بخير أدخله الله الجنة»، فقلنا وثلاثة؟ قال: «وثلاثة فقلنا: واثنان؟ قال «واثنان» ثم لم نسأله عن الواحد.
فإن قلت: وكيف يتفق هذا مع ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَسُبُّوا الأموات فَإنَّهُمْ قدْ أفْضَوا إِلى ما قَدَّموا»
وكيف يتفق أيضًا مع ما رواه الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء».
وكيف يتفق كذلك مع الآيات والأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم الغيبة تحريمًا قاطعًا؟
وحد الغيبة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟
قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته» قلت: لا تعارض بحمد الله بين نصوص الشريعة، وللتوفيق بين ما سبق مما يبدو متعارضًا في الظاهر أقول: أولًا: الأصل في الغيبة أنها محرمة تحريمًا قاطعًا لا خلاف فيه بين أحد من العلماء، ويدخل في ذلك «الجرح» الذي أنشأت له هذه المقالة.
وقد وضح الإمام الغزالي حد الغيبة بقوله في الإحياء ج ۳ ص ١٤٠ «حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه حتى في ثوبه وداره ودابته».
وقال رحمه الله في ص ١٤٢ أعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريضه بما يكرهه، فالتعريض به كالتصريح، والفعل فيه كالقول، والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام، فمن ذلك قول عائشة رضي الله عنها: «دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي أنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: «اغتبتيها» (رواه ابن أبي الدنيا بسند صحيح).
ثانيًا: مع الاتفاق على تحريم الغيبة بكافة صورها أجازها العلماء في حالات ست، جمعها بعضهم بقوله:
الذم ليس بغيبة في ستة لمعرف، ومحذر، متظلم ولمظهر فسقًا، ومستفت ومن طلب الإعانة في هداية مسلم.
ويقول الإمام النووي رحمه الله في بيان ذلك: «أعلم أن الغيبة تُباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب:
الأول: التظلم، فيجوز للمتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه أن يقول: «ظلمني فلان بكذا»
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصودة التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا.
الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة.
الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه:
منها: المشاورة في مصاهرة إنسان، أو مشاركته، أو إيداعه، أو معاملته، أو غير ذلك، أو مجاورته، ويجب على المشاور أن لا يخفى حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.
ومنها: إذا رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك.
ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحًا لها، وإما بأن يكون فاسقًا أو مغفلًا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولى من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يفتر به وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به.
الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة الناس، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلمًا، وتولى الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.
السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.
ثم قال رحمه الله: فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء، وأكثرها مجمع عليه، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة فمن ذلك:
ا - عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ائذنوا له، بئس أخو العشيرة هو» متفق عليه، احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب.
۲ - وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئًا » رواه البخاري قال: قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين.
٣ - وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه» متفق عليه وفي رواية المسلم «وأما أبو الجهم فضراب للنساء»
٤ ـ وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زید رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تصديقي ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ (المنافقون :١).
ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رءوسهم» متفق عليه
٥ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه انتهى بنصه عن رياض الصالحين الباب ٢٥٦.
«سوء الظن من الغيبة»
سوء الظن بالمسلم غيبة بالقلب، كما أن الحديث عنه بسوء غيبة باللسان، وكلاهما محرم، وقد نص على ذلك الإمام الغزالي في كتاب الغيبة من الأحياء.
وسوء الظن الجائز هو ما قام عليه دليل من مشاهدة أو شهادة عدول تقوم الحجة بقولهم، فعند ذلك لا يسعنا إلا التصديق.
أما سوء الظن المبنى على الفراسة، أو تأويل للسلوك أو القول، فذلك من تخييل الشيطان وتزيينه، ونعوذ بالله منه.
قال الإمام الغزالي «ومن ثمرات سوء الظن التجسس فان القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق، فيشتغل بالتجسس وهو أيضًا منهى عنه، قال الله تعالى ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ (الحجرات: ١٢).
فالغيبة وسوء الظن والتجسس منهي عنه في آية واحدة، ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله فيتوصل إلى الاطّلاع وهتك الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستورًا عنه كان أسلم لقلبه ودينه» انتهى بنصه عن الأحياء.
وبعد، فمن منا من سلم قلبه، وتنزه لسانه؟ ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الأعراف: ٢٣) ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل