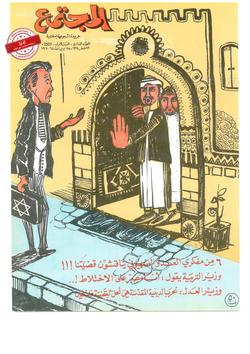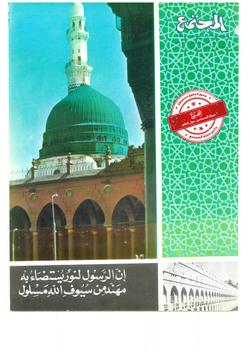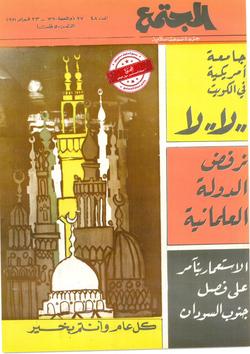العنوان المجتمع التربوي (1643)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 19-مارس-2005
مشاهدات 19
نشر في العدد 1643
نشر في الصفحة 52
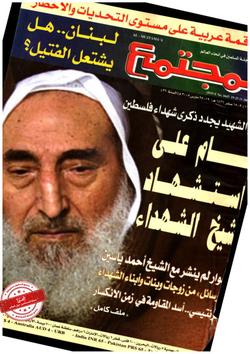
السبت 19-مارس-2005
آفات على الطريق
د. السيد محمد نوح
أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الكويت
ما أكثر الأمراض الأخلاقية والآفات الاجتماعية التي يعاني منها بعض الأفراد والمجتمعات.. حري بنا أن نتوقف عندها ونحذر منها ونقدم علاجا لها...
وقد اهتم فضيلة الدكتور السيد نوح بهذه القضية وأصدر فيها أكثر من مؤلف. وهذه المقالات التي بين أيديكم جديدة في موضوعها وطرحها ولم يسبق نشرها.
- الاحتقار«2من2» علاجه.. والوقاية منه
تناولنا في العدد الماضي تعريف الاحتقار، وتحدثنا عن سماته وأسبابه وآثاره... وفي هذا العدد نتحدث عن طرق العلاج والوقاية منه.
ويمكن إجمال ذلك في هذه الخطوات:
- أن يقوي المرء في نفسه ملكة المراقبة لله تعالى:
ذلك أنه إذا قويت مراقبة العبد لربه من أنه سبحانه يسمع ويرى ويعلم كل شيء، وكان مبتلى بآفة احتقار عباد الله، والنيل منهم فإنه يقلع من ذلك استحياء من ذي الجلال والإكرام. أما إذا كان سالما من هذه الآفة، فإنه يتفقد نفسه ويحرص كل الحرص ألا تتسرب إليه، أو تسيطر عليه، وسبق بیان طريق تقوية هذه المملكة.
2-أن يستحضر الوقوف بين يدي الله للحساب: ذلك أن المرء حين يستحضر ساعة الوقوف بين يدي الله -سبحانه- وأنه سيسأله عن كل شيء، ومن ذلك احتقاره عباد الله والنيل منهم، والعدوان عليهم، ثم بعد ذلك يكون القصاص، أو ربما التعذيب بالنار، وبئس المصير، حين يستحضر ذلك فإنه يبادر بتطهير نفسه من آفة الاحتقار هذه بل يعمل على ألا يبتلي بها مرة أخرى، وقاية لنفسه من هذا الموقف الأليم، وما سيكون بعده من شدائد وأهوال.
3-أن تعيد الأسرة النظر في سلوكياتها: ذلك أن الأسرة إذا أعادت النظر في سلوكياتها، أقوالًا وأفعالًا وأقلعت عن احتقار الآخرين، والنيل منهم، واعتذرت لأبنائها عما كان منها في الماضي، وبصرتهم بضرورة تقدير الناس واحترامهم، وكف الأذى عنهم. إذا فعلت ذلك، فإن له أعظم الأثر في التخلي عن الاحتقار، وتحصين النفس ضده.
4-أن ينزع المرء نفسه من الصداقات الضارة: ذلك أن المرء إذا انتزع نفسه من الصداقات الضارة، وحرص على الارتماء في محضن الصداقات النافعة، فإن ذلك يفتح له نافذة: أن يقلع عن احتقار الآخرين، بل والوقاية من العودة إلى ذلك مرة أخرى، حيث وجد على الخير أعوانًا. بعد أن كان يجد على الشر أعوانا.
5-أن يجاهد المرء نفسه: ذلك أن المرء إذا أراد التخلص من احتقار الآخرين، والنيل منهم فإن عليه أن ينسى إيذاء الآخرين له بالاحتقار المتمثل في العدوان عليه، إذ هذا ذنب الذين آذوه لا ذنب من يفكر هو في إيذائهم.
وليتذكر أجر الصفح، والعفو، بل الإحسان، انطلاقا من قوله سبحانه: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران: 134).
﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (الأعراف: 199).
﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾.
(الشورى: 40) وليتذكر موقف يوسف من إخوانه وقد آذوه في صور شتي، وكذلك آذوا أخاه بنيامين، وقابل ذلك بالعفو قائلًا: ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (يوسف: 92) كما يتذكر موقف النبي r من أعدائه، وقد عاملهم بالعفو والصفح، فانقلبوا محبين له بعد أن كانوا مبغضين.
6-أن يكثر المرء من ذكر المنعم عند ذكر النعمة: ذلك أن النعمة التي يتمرغ العيد فيها ليل نهار لم تأته في تلقاء نفسها، وإنما كانت فضلًا من الله تعالى، والواجب حينئذ عبادته لا عبادة النعمة، ويوم يصل المرء إلى هذا المستوى، فإنه سيقلع عن احتقار الآخرين بالنيل منهم، والعدوان عليهم، من باب التوبة عما وقع منه في الماضي، والعزم الأكيد ألا يعود إلى هذا الاحتقار مرة أخرى، وإن قطع وحرق بالنار، على أن هذا المحتقر للآخرين بسبب تفرده بنعمة ما ينبغي ألا ينسى: أن لدى الآخرين نعمًا مفردة ليست لديه وما كان عطاء ربك محظورًا
7-أن يدرك المرء حقيقة ميزان التفاضل في هذا الدين: ذلك أن ميزان الدين في هذا الدين إنما هو بالإيمان، «التقوى» لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13)
وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾ (سبأ: 37). وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورًا عملية لهذا الميزان: عن سهل قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما تقولون في هذا؟.. قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال: إن يستمع، قال: ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين، فقال: «ما تقولون في هذا؟»
قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع، فقال رسول الله r: «هذا خيرملء الأرض مثل هذا» (1)
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة...وبيننا صحبي يرضع أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة، وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: «اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع»، قال: مكأني أنظر إلى رسول الله r وهي يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فمه، فجعل بمصها، قال: «ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني ملها، فترك الرضاع ونظر إليها، فقال: اللهم اجعلي مثلها. فهناك تراجعا الحديث قالت: حلقی، مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم أجعل ابني مثله فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون، زنيت سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها، قال: إن ذاك الرجل كان جبارًا، فقلت: اللهم لا تجعلي مثله، وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها» (۲)
وجاءت تطبيقات الصحابة لتؤكد هذا الميزان:
فبلال العبد كان يوصف بالسيد بين الصحابة، وهذا ممر يذكر فضل أبي بكر، ومناقبه، ومنها قوله: «هذا سيدنا بلال حسنة من حسنانه»(۳)
وأقبل بلال، وأخوه في الإسلام أبو رويحة إلى قوم من خولان، فقالوا: «إنا قد أتيناكم خاطبين، وقد كنا كافرين، فهدانا الله، ومملوكين فأعتقنا الله، وفقيرين فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وأن تردونا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فزوجوهما»(4).
وهذا أسامة بن زيد المولى ابن المولى يغرض له عمر ثلاثة آلاف وخمسمئة ويفرض لابنه عبد الله ثلاثة آلاف، فقال عبد الله: لم فضلته علي! فوالله ما سيقني إلى مشهد؟ قال: لأن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وهو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي» (5) وكان عمر رضي الله عنه: لا يلقى أسامة قط إلا قال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت على أمير» (6)
أن إدراك المرء الحقيقة هذا الميزان سيحمله - إن كان جادًا - على الانسلاخ من احتقار الآخرين، وإهانتهم، بل ويجعله يحرص على شهادة نفسه طهارة كاملة.
8-أن يهتم المرء بحسن مظهره: ذلك أن المرء حين يهتم، ويعتني بمظهره، فإنه يغلق الباب أمام احتقار الآخرين له، إذ هذا يعني أنه يعتز بنفسه میرزًا نعمة الله
- تعالى - عليه، وأنه لا يقبل الضيم والإهانة حينئذ يهابه الآخرون، ويعرفون له قدره ومكانته.
9-أن يقوم المجتمع بواجبه نحو من يحتقرون الآخرين: ذلك أن المجتمع إذا قام بواجبه نحو من يحتقرون الآخرين، بكل الأساليب والوسائل التي لا تتعارض مع مبادئ الشرع الحنيف، وأقل ذلك الإنكار القلبي المتمثل في قطيعة هؤلاء ومحاصرتهم بحيث يشعرون أنهم غرباء، وأن مصالحهم أصبحت معطلة، إن ذلك لو وقع من المجتمع سيكون من أنجح الطرق التي تحمل على التحرر من احتقار الآخرين، بل والعمل على تحصين النفس من دخول الاحتقار إليها مرة أخرى. ١٠- أن يقوم ولي الأمر بواجبه: أو أن ولي الأمر قام بواجبه نحو من يحتقرون الآخرين مرة باللين، ومرة بالشدة، مرة
بالترغيب، ومرة بالترهيب، ولولي الأمر من
الهيبة، والاحترام ما ليس لغيره، إنه لم قام بذلك لعمل بسرعة على معالجة الاحتقار، والحصانة ضده، وما أجمل لو كان ذلك مصحوبًا بالإخلاص لله، واتباع السنة، إن الله حينئذ سيبارك العمل، ويمنح النصر والتأييد.
11- أن يتذكر المرء على الدوام عواقب الاحتقار: ذلك أن هذا التذكر سيحمل العاقل على ترك الاحتقار، وحماية النفس من أن يقتحمها مرة أخرى، لا سيما أن هذه العواقب تشمل الدنيا والآخرة، وتتناول الفرد والجماعة جميعًا.
الهوامش
(1) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، وابن
ماجه في السنن
(۲) الحديث أخرجه مسلم في الصحيح.
(3) انظر: نزهة الفضلاء، تهذيب سير أعلام النبلاء لمحمد بن حسن بن عقيل موسى 1/64،
الترجمة بلال.
(4) المصدر السابق
(5)المصدر السابق 1/184 ترجمة أسامة بن زيد.
(6) المصدر السابق 1/185 ترجمة أسامة بن زيد.
_______________________________
بين داعية وداعية
صنف ادعى العلم واهتم بالمظهر دون الجوه، وآخر تلمس فيه صدق الإيمان وإخلاص النية. ولا يعجبني صنف من الناس نصب نفسه داعية، وجمع حوله أتباعًا ومريدين.
واتخذ سمت الشيوخ فلم ينس أن يختار أثوابًا ومسوحًا تليق بمقامه السامي الرفيع يمضي في طريقه ويجمع مع كل متعرج مزيدًا من الدهماء، ويعظم الأمر في عينيه فيظن المسكين نفسه داعي الدعاة الأوحد، يملأ الموارد ادعاءات والموائد ثرثرة، ينتقد السابقين على كل حركة بدرت منهم أو سكنة شاعت عنهم، يحط من شأنهم ويتهم عقولهم.. فإذا اقتربت من هذه الشخصية، وأردت أن تستكشف مجهول كنوزها، وتنهل من معين علمها. هالتك المفاجأك، وصعقك سوداوية المزاج، لا تتطلق إلا من الأنا ولا تصل إلى سواها.
دعاة من هذا النوع، يحرثون في البحر ويزرعون «ويسبحون» في الهواء، ويلعبون على شفا جرف هار، وهاوية سحيقة بلا قرار، تتكرس في وجودهم عوامل الانهزام، إنهم يؤخرون ساعة النصر بقدر أعمار دعوتهم المغشوشة.
ويعجبني صنف آخر من الدعاة، تلمس فيه صدق الإيمان وإخلاص النية وعقلًا وقادًا. يجتمع الناس حوله، يصقل الأرواح والألباب، يفرغ ويملأ، فيفرع الأفئدة والأرواح من تصورات وتخرصات وأدران الجاهلية، ويملؤها بعذب حكم وأحكام الإسلام الحنيف، وهو لا يبتغي من وراء ذلك جزاءً ولا شكورًا من الخلق، إنما مدده الذي يغنيه وطاقته التي تحركه تتبع مقالة الأنبياء لأقوامهم: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورة الشعراء: 109) وعلى هذي هذا الطريق الواضح المستقيم فإنه لا ينتقص مجهود سابقين ولا يحط من فضلهم، بل يقبل عثرتهم، ويلتمس لهم العذر، وينسب لهم الفضيلة، ويحمد لهم دورهم، ويترحم على أرواحهم، وبذلك تجتمع لديه طهارة النية وسمو الغاية.
دعوة بمثل هذه الخصائص العالية استجمعت عناصر النجاح، فقوي عودها، واشتد ساعدها، واستوى سوقها وتجذرت عروقها... أما الدعوة التي تلوث غايتها السامية بقايات دنيئة فلن يجني القائمون عليها إلا خسران الدنيا والدين. إن الغابة إذا كانت مشوية بمصالح هابطة: كطلب المال أو المنصب أو الشهرة أو غيرها من سفاسف الحياة، تتلوث فتخسر مدد السماء وتقدير أهل الأرض.
سنة الله في التغيير
د. حمدي شعيب
«لما فتحت قبرص، فرق بين أهلها. فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسًا وحده يبكي!. فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟!!!.
فقال: ويحك يا جبير؛ ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ماترى»
حادثة غريبة رواها عبد الرحمن بن جبير بن مفير عن والده رضي الله عنه وهو يستغرب موقف أبي الدرداء رضي الله عنه: الباكي الوحيد، ويستغرب تفاعل مشاعره المناقضة لمعظم مشاعر من حضروا فتح قبرص. وهو الوقف الذي يذكرنا بموقف مؤمن آل فرعون، عندما وقف وحده، لينصح قومه المعرضين عن رسالة موسى عليه السلام إليهم، لعلهم يفيقوا ولا يغتروا وينخدعوا بحاضر ينذر بمستقبل مغاير، وهو نفس شعور وتخوف خبير الفتن حذيفة رضي الله عنه عندما خالف غيره؛ ووقف وحده، ولم يسأل عن الخير بل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أسباب الشر والفتن مخافة تداول الأيام فتدركه وتهدد أمته.
عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: «كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني». وهي كذلك؛ رؤية الرجل المؤمن في حواره مع صاحبة الكافر وتدير أهم وأبرز مفردات خطابه الديني الهادئ الراقي ﴿وَلَوۡلَآ إِذۡ دَخَلۡتَ جَنَّتَكَ قُلۡتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالٗا وَوَلَدٗا (39) فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤۡتِيَنِ خَيۡرٗا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرۡسِلَ عَلَيۡهَا حُسۡبَانٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصۡبِحَ صَعِيدٗا زَلَقًا (40) أَوۡ يُصۡبِحَ مَآؤُهَا غَوۡرٗا فَلَن تَسۡتَطِيعَ لَهُۥ طَلَبٗا (41) وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصۡبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيۡهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي لَمۡ أُشۡرِكۡ بِرَبِّيٓ أَحَدٗا (42)﴾(الكهف:39-42)
ولقد ارتكزت أهم نقطتين في هذا الخطاب الديني الرائد على قاعدة فقه الرجل المؤمن للسنن الإلهية.
فالنقطة الأولى: تبين فقهه لسنة الله في بطر النعمة وتغييرها: أو الرؤية الإسلامية للتعامل مع النعم.
النقطة الثانية: تبين فقهه للسنن الإلهية في الذنوب؛ والظلم، والعفاف، والابتلاء؛ وهي القوانين الربانية التي من ثمار فقهها ومعرفتها: الرؤية العميقة لقراءة مصير الأمم والجماعات والمؤسسات والأفراد بقراءة تاريخية ماضية، واستقراء لحاضر تشهد مسبباته بالمصير المستقبلي المتوقع.
فراسة.. يصنعها فقه حضاري!!
ولو تدبرنا المواقف الراقية لهؤلاء الرواد العظام؛ لوجدنا الكثير من الملامح التربوية الطيبة:
1-قليل هم أولئك الذين يفكرون عكس التيار؛ فيقرؤون المستقبل المغاير للحاضر، فيكون تفاعلهم مع الأحداث مختلفًا عن غيرهم.
2- قليل هم كذلك الذين يفقهون سننه تعالى الإلهية، بمعرفة القوانين الربانية والقواعد الإلهية الثابتة، وهي التي تؤدي إلى نتائج معينة لوجود أسباب بشرية وزمانية ومكانية معينة، انطبقت عليها هذه القوانين الإلهية فكان الجزاء أو النتيجة من جنس السبب أو العمل.
وهذه السنن الإلهية تتميز بسمات ثلاث: في العموم والثبات والاطراد أي التكرار إن وجدت الظروف البشرية والمكانية والزمانية.
ونذكر أن السنن الإلهية؛ هي:
أولًا: سننن إلهية كونية؛ تنظم عالم المادة في الآفاق.
ثانيا: سنن إلهية اجتماعية؛ تنظم عالم الأحياء أو الأنفس خاصة البشر. والقسم الثاني هو الذي يهمنا وهو ما يعرف بالفقه الحضاري. وهو الفقه الذي يستمد مادته من قراءة التاريخ ومن التدبر في القصص القرآني. فكل حدث تاريخي أو بشري فردي أو جماعي إنما له أسباب أوجدته. وهذه الأسباب أوجدت خللًا.
وهذا الخلل أوجب العقاب الإلهي؛ أو الجزاء.
وهذا العقاب أو الجزاء تحكمه قوانين تعرف بالسنن الإلهية الاجتماعية. والمعادلة أو القانون أو سلسلة تتابع هذه السنة الإلهية هي كالتالي:
«أسباب تعود إلى العبد - خلل تربوي. عقاب إلهي على هيئة جزاء من جنس العمل».
3- ومن هذه السنن الإلهية الاجتماعية التي فقهها هؤلاء الرواد؛ سنة الله في الأسباب والمسببات: أو قانون السببية. ومنها سنة الله في الفتنة أو قانون الابتلاء.
ومنها سنة الله في الظلم والظالمين؛ أو قانون المحق.
ومنها سنة الله في الطغيان والطغاة؛ أو قانون الطغاة.
ومنها سنة الله في بطر النعمة وتغييرها؛ أو قانون النعم وتغييرها.
ومنها سنة الله في الذنوب والسيئات؛ أو قانون الذنوب والسيئات.
ومنها سنة الله في الاستدراج؛ أو قانون الاستدراج.
ومنها أيضًا، سنة المدافعة أو قانون التدافع الحضاري. ﴿لوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (البقرة: 251).
وهو القانون الإلهي أو السنة الإلهية التي تفرز الأصوب والأبقى والأصلح في كل شيء سواء أفكار أو آراء أم أفراد أو أمم فإذا توقفت تلك العملية التدافعية الحضارية المختلفة الصور المكان الفساد، وهذا من فضلة سبحانه من أجل ديمومة واستمرارية عملية الاستخلاف والإعمار في الأرض.
ومنها سنة المداولة أو قانون التداول الحضاري: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (آل عمران: 140).
وكذلك سنة أو قانون الاستبدال: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم﴾ (محمد: 38).
- رسالة علمية عن: جهود الشيخ الغزالي في الحديث والفقه
كثيرًا ما يثار جدل حول بعض القضايا، غير أن ما أثير حول الشيخ الغزالي -رحمه الله- وموقفه من السنة النبوية أخذ شكلًا مختلفًا كانت حتى هناك شبه حملة إعلامية، ما أحسب أنها خمدت حتى الآن، ففهم الشيخ للسنة النبوية وموقفه من عدد من الأحاديث النبوية الواردة في الصحيحين، وإحياؤه لمبدأ الحكم على الحديث من خلال المتن بجوار السند وأن الحديث قد يصح سندًا، ويضعف متنًا. أجرت الأقلام كتبًا والألسن شرائط، من مدافعة عنه وقادحة فيه ومدحه بأنه العالم الفقيه، وقدحه بأنه لا علم له بالسنة ولا الفقه، وأنه عصراني عقلاني يريد أن يرضي الغرب على حساب دينه، والزعم بأنه يرفض أحاديث الآحاد.
مع أن جل السنة النبوية من هذا النوع. وقنبلته التي قذفها في أخريات عصره، أقصد كتاب "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث". كل ذلك وغيره كان دافعًا لي أن أجعل جهود الشيخ في الحديث والفقه معًا، محل بحثي في أطروحتي لرسالة الماجستير بقسم الشريعة في كلية دار العلوم وعمدت في الدراسة إلى الجمع بين الحديث والفقه، لارتباطهما الوثيق ولأنهما المجالان اللذان فجر فيهما الشيخ آراء أثارت عليه كثيرًا من الخلق فأحببت أن أدرس كل آرائه فيهما بشكل علمي دقيق بعيدًا عن التعصب له أو عليه. أما عن منهج البحث الذي اتبعته، فقد قمت بمسح ما في كتب الشيخ واستخراج آرائه وجهوده في الحديث والفقه، ثم بوبتها حسب خطة البحث.
فجاء الباب الأول ليبين منهج الشيخ في السنة النبوية، وهو يمثل مبحث السنة من خلال الدراسات الأصولية، فكان الحديث عن موقف الشيخ الغزالي من السنة، وعلاقة السنة بالقرآن وموقفه من أحاديث الأحاد، وموقفه من النسخ في القرآن وموقفه من أفعال الرسول.
أما الباب الثاني فجاء يمثل التطبيق العملي لمنهج الشيخ من خلال حكمه وفهمه على مجموعة من الأحاديث جلها من الصحيح.
أما الباب الثالث فهو يمثل تاريخ التشريع الإسلامي، أو ما يمكن أن يطلق عليه تاريخ الفقه تناولت فيه معنى الفقه عند الغزالي، ورأيه في الاختلاف الفقهي والأئمة الأربعة، وموقفه من المدارس الفقهية قديمًا وحديثًا، والمدرسة التي ينتمي إليها، ورأيه في التأليف الفقهي بشكل عام ومصادر التشريع عنده وهو يمثل الجانب التنظيري.
أما الباب الرابع، فهو يمثل تطبيق الشيخ لمنهجه الفقهي من خلال طائفة من مسائل الفقه الجزئية قسمتها إلى سمات منهجية، من الاستناد إلى الكتاب، والسنة والمصلحة، وقبول التنوع الفقهي، وخدمة الفقه للدعوة واختيار ما يناسب الزمان والمكان والاستئناس بالنظريات العلمية في المسائل التي لا نص فيها، واعتماد قاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة».
وجاءت الخاتمة لتمثل نتائج البحث وأهمها:
-أن الشيخ لم يكن معاديًا للسنة، بل كان من المدافعين عنها وأنه كان يقبل أحاديث الآحاد في الأحكام بشكل عام، وفي العقائد إذا كانت مندرجة تحت أصل قرآني، ولا يقبل أن تنفرد
بعقائد أساسية وحدها، وأنه لا نسخ في القرآن وأنه يجب التفريق بين أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم من كونه نبيًا، أو أفعال يأتيها ككونه إنسانا، أو قاضيًا وغير ذلك، وأن الحكم على الحديث يجب أن يشترك فيه مع المحدثين علماء آخرون وخاصة الفقهاء وأن للشيخ جهدًا مشكورًا في فهم الحديث النبوي، وأنه كان يرفض العمل بالحديث الضعيف، إلا في الوعظ والإرشاد، أو ما كان موافقًا للقواعد العامة في القرآن والسنة الصحيحة. أما فيما يخص مجال الفقه، فقد أثبت أن الشيخ كان فقيهًا متميزًا من الطراز الأول، وأنه كان يجعل الفقه في خدمة الدعوة، وأنه كان يقبل الاختلاف الفقهي دون تعصب لرأي دون آخر. وأن من الحكمة الانتفاع بتراث الأئمة كلهم، وأنه على الباحثين تعميق البحث العلمي في المجالات المعاصرة كالاقتصاد والسياسة والإدارة، وأن الاجتهاد فيها يجب أن يفتح على مصراعيه، مع وقفه في العبادات والعقائد، كما أثبت أن الشيخ لم يكن صاحب مدرسة مستقلة، بل هو مجدد في مدرسة الإصلاح والتجديد بشقها الفكري المتمثل في مدرسة المنار، وشقها الاجتماعي المتمثل في شيخه حسن البنا، ومدرسته الإخوان المسلمون، وأن الشيخ في آرائه لم يخرق إجماعًا قط. كل ما هنالك أنه قد يخالف رأي الجمهور.
من الأوائل
وهب بن محصن «أبو سنان»
محمد مصطفى ناصيف
إنه الصحابي الجليل المناضل المقدام المسارع إلى الفداء والشهادة «وهب بن محصن الأسدي»، امتاز أبو سنان بأولية خالدة تكفيه شرفًا وتكريمًا، فقد كان أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان حيث أقبل على الرسول الكريم وقال له في صدق وإخلاص: يا رسول الله ابسط يدك أبايعك. فقال له النبي: على ماذا؟ فأجابه أبو سنان على ما في نفسك يا رسول الله، فقال النبي: وما في نفسي؟ فأجابه أبو سنان الفتح أو الشهادة فسر النبي الكريم من ذلك وبسط يده فبايعه أبو سنان وأقبل الصحابة من ورائه يبايعون الرسول المعلم قائلين: نبايعك يا رسول على ما بايعك عليه أبو سنان، ويا له من شرف مجيد ووسام عظيم أن يكون أبو سنان في طليعة المبايعين في تلك البيعة التي يقول عنها الحق تبارك وتعالى في سورة الفتح: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الفتح: 10)، وعاش أبو سنان مجاهدًا مناضلًا، فشهد مع رسول الله غزوات بدر وأحد والخندق حتى لحق بربه عند حصار المسلمين لبني قريظة رضي الله عنه وأرضاه.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل