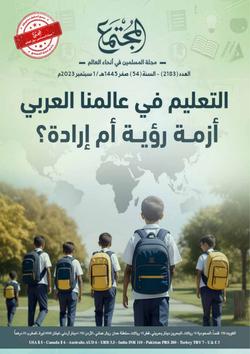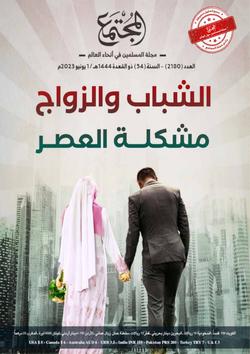العنوان البجعة السوداء تداعيات الأحداث غير المتوقعة
الكاتب د. محمود المنير
تاريخ النشر الجمعة 01-ديسمبر-2017
مشاهدات 21
نشر في العدد 2114
نشر في الصفحة 53

الجمعة 01-ديسمبر-2017
قراءة في كتاب
البجعة السوداء
تداعيات الأحداث غير المتوقعة
الكتاب يدعو لإعادة النظر في مفاهيمنا عن الحياة خاصة ما نتعامل معه باعتباره «بديهياً»
وضْع نظرية واحدة يحتاج إلى أدلة كثيرة جداً للتصديق بها في حين أن هدمها يحتاج لدليل واحد فقط
3 عناصر ترتبط بالبجعة السوداء تبدأ بحدث غير متوقع ثم ظهور تأثيره ثم الدهشة بعد وقوعه
الاكتشافات العلمية الكبرى والأحداث التاريخية والإنجازات الفنية هي «البجعات السوداء» غير الموجهة
الهدف الذي دخل مرماك لن يكون الأخير لكنك كذلك ستحرز مثله الكثير
إننا عبيد لتفكيرنا في الأشياء المألوفة والعادية وهو ما يجعلنا نتأخر ولا نستفيد مما يقع لنا من أحداث
عدم المقدرة على التنبؤ بما هو خارج المألوف يكمن في صعوبة التكهن بمسار التاريخ
عرض: محمود سمير المنير
(*) الأفكار الواردة في الكتاب تعبر عن رأي الكاتب.
بيانات الكتاب
- المؤلف: نسيم طالب.
- الناشر: الدار العربية للعلوم (ناشرون).
- الطبعة الأولى: 2009.
- عدد صفحات الكتاب: 533 صفحة من القطع الكبير.
عن الكتاب:
- تصدر قائمة نيويورك تايمز لـ13 أسبوعاً على التوالي فور صدوره.
- ترجم إلى 31 لغة.
- صنفه موقع «أمازون» كواحد من أفضل الكتب في العام ذاته.
نبذة عن المؤلف:
- نسيم طالب من مواليد لبنان عام 1960 معروف بصفة فيلسوف الصدفة.
- درس الفلسفة والرياضيات من أجل تعميق معارفه بما يسميه «علم الصدفة».
- يحمل شهادة عليا من مدرسة وارتون التابعة لجامعة بنسلفانيا وشهادة الدكتوراه من جامعة باريس - دوفين، الأكثر شهرة بفرنسا في مجال الاقتصاد.
- يقوم حالياً بتدريس مادة «التسويق» في مدرسة لندن للأعمال التجارية وعلوم «الاحتمالات» في جامعة ماساشوستس والرياضيات في جامعة نيويورك.
- له العديد من المؤلفات من بينها: «الصدفة المتوحشة: أسواق البورصات هي حياتنا، الدور المخبوء للحظ»، وهذا الكتاب نال شهرة عالمية وجرت ترجمته إلى عدة لغات عالمية.
هذا الكتاب:
يدعو كتاب «البجعة السوداء» قرّاءه لإعادة النظر في مفاهيمهم عن الحياة وخاصة ما يتعاملون معه باعتباره «بديهياً»، لافتاً إلى عدم وجود «يقين» حقيقي يمكنه الصمود أمام الحياة، مشيراً إلى أن مرور أي من «البجعات السوداء» في حياة أي منا بإمكانه قلبها رأساً على عقب، ليفسحوا مجالاً أكبر لـ«الصدف» التي بإمكانها تغيير الكثير.
أما سبب تسمية كتابه بـ«البجعة السوداء» فيقول المؤلف: إنه قبل اكتشاف قارة أستراليا كان يعتقد الجميع في عدم وجود البجع الأسود الذي ظهر لأول مرة في القارة، وأنه لا يوجد في العالم سوى البجع الأبيض، لافتاً إلى أنه إذا تتطلع الإنسان إلى الواقع من حوله من زاوية مستقبلية فسيجد فيه أموراً «غير متوقعة» ولكنها ستصبح «متوقعة» إذا نظر لها من زاوية الماضي.
ويستشهد المؤلف بمثالين للتدليل على نظريته عن البجعة السوداء، موضحاً أن الحرب اللبنانية وأحداث الحادي عشر من سبتمبر كان من الممكن التنبؤ بهما إذا رأينا ماضي هذه الأحداث بصورة أفضل، ويحدد المؤلف في كتابة ثلاثة عناصر ترتبط بمفهوم «البجعة السوداء» تبدأ بحدث غير متوقع، ثم ظهور تأثير لذلك الحدث، ثم الدهشة التي تصيب الناس بعد وقوع الحدث فيبدؤوا في البحث عن الأسباب التي أدت لوقوعه.
ويلقي المؤلف في «البجعة السوداء» الضوء على ما يصفه بـ«عيوب التفكير البشري» التي من بينها التدقيق في التفاصيل وتجاهل الصورة الأكبر، لافتاً إلى أن الجنس البشري أصبح «عبداً» للتفكير المألوف النمطي الذي لا يساعده على التنبؤ بالمستقبل، ويرى المؤلف أن بعض البشر مصابون بـ«وهم المعرفة»، وهو أكبر أكذوبة يقنع بها الإنسان نفسه بأنه يستطيع الإلمام بعالم تعد «العشوائية» و«التعقيد» من صفاته الأصيلة التي يستحيل معها أن يدركه الإنسان كاملاً، ويلفت المؤلف في كتابه إلى وجود عدة أمثلة للبجعة السوداء، حدثت بالفعل، من بينها الانهيارات الاقتصادية في عدة دول في العالم.
اكتشاف البجعة السوداء
يحدد الكاتب ماهية مفهوم حدث «البجعة السوداء»، بعناصره الثلاثة؛ وهي:
- حدث غير متوقع تماماً.
- حدث له تأثير هائل.
- بعد وقوع الحقيقة، يُرشد الحدث قبل فوات الأوان، كما لو كان متوقعاً، وأن دماغنا سوف يجتهد بعد حصوله للبحث عن الأسباب المنطقية التي أدت إليه.
يقدم المؤلف من خلال هذا الكتاب دعوة مفتوحة للجميع، لإعادة النظر والتساؤل من جديد حول كل ما يعتبر أمراً بديهياً، فما من يقين فعلي ودائم لأي فكر أو قناعة أو توجه في مسيرة الحياة بشكل عام، ولا لمسيرة الفرد الشخصية، نتيجة وجود هذه «البجعات السوداء» التي لا يضعها الإنسان في الحسبان، ونتيجة إهماله لمقاربتها، في حين أن حدوثها سيؤدي إلى قلب حياته رأساً على عقب.
فليتواضع الذين يعتبرون أنفسهم «خبراء» في مختلف ميادين الحياة، وليضعوا حسبان «اللايقين» في أقوالهم واستنتاجاتهم وخططهم المستقبلية، وليتذكروا على الدوام الدور الكبير والهائل الذي يمكن للصدفة أن تمارسه في تغيير مجرى الأمور وحتى نسف وإبادة المعطيات التي تبنى عليها أسس تنظيم الحياة حاضراً، كما أسس رؤيتها مستقبلاً.
وليتوقع الإنسان ما هو غير متوقع؛ لأن «التطرف، والمجهول وغير المتوقع هي ما يتحكم بعالمنا»، كما يقول الكاتب، وكي لا نكون كالدجاج الذي لا يشك لحظة أن الإنسان اللطيف الذي يتعامل معه والذي يقدم له الغذاء والماء يومياً، إنما هو يفعل ذلك ليقطع عنقه فيما بعد.
من فكرة إلى نظرية
مصطلح «بجعة سوداء» -كما أشرنا- كان رمزاً لشيء ما كان مستحيلاً أو لا يمكن أن يوجد وهو البجع الأسود، وفي القرن الـ18 تم اكتشاف البجع الأسود في أستراليا الغربية، وهو ما جعل الاستحالة المتصورة في الواقع قد حان أن تُمرر.
يرى المؤلف أن الاكتشافات العلمية الكبرى تقريباً، والأحداث التاريخية، والإنجازات الفنية هي «البجعات السوداء» غير الموجهة وغير المتوقعة، ويدلل على ذلك بأمثلة كثيرة مثل: شبكة الإنترنت، واختراع الكمبيوتر الشخصي واندلاع الحرب العالمية الأولى، وهجمات 11 سبتمبر 2001م.
فلسفة المؤلف تقوم على عدم إضاعة الوقت في إثبات شيء يمكن نقضه بسهولة، ويكتفي بالاستعداد لحدوث هذا الاحتمال الضئيل الذي يهدم النظرية؛ لذا يركز المؤلف في كتابه على الظواهر النادرة الحدوث، وأيضاً يركز على عيوب التفكير البشري، وكيف أن الإنسان يركز في تفكيره على أدق التفاصيل وتغيب عنه الصورة الأكبر!
يدرس المؤلف في الواقع طبيعة العلاقة بين المقولات الفلسفية - المنطقية وبين الواقع التجريبي، فمثلاً إذا تم التأمل في التفجيرات التي عرفتها نيويورك وواشنطن في صباح 11 سبتمبر 2001م، فإن «الخطر كان قابلاً للتصور منطقياً يوم 10 سبتمبر».
لكن الفرق كبير بين ما يتفق مع «المنطق» وما يجري في الواقع، ومن هنا يعتبر المؤلف أن تلك التفجيرات كانت بمثابة «بجعة سوداء»، ومثلها في ذلك مثل «الحرب الأهلية اللبنانية» التي اندلعت في ربيع عام 1975م، وهو يصف تفجيرات 11 سبتمبر والحرب الأهلية اللبنانية على أنهما بجعتان سوداوان كاملتا الأوصاف، وذلك بمقدار ما كانت «مفاجأتهما» كبيرة.
«البجعات السوداء» -كما يتم تقديمها- تمثل أيضاً منعطفات حقيقية في التاريخ الإنساني أحياناً، وهذا ما يعبّر عنه المؤلف بالقول: «عندما أسأل الناس عن التكنولوجيات الثلاث التي كان لها أثر كبير في مسيرة العالم الذي نعيش فيه اليوم، فإنهم يجيبون عادة بالقول: إنها تتمثل في الحاسوب وشبكة الإنترنت وأشعة الليزر»، هذه التكنولوجيات الثلاث يعتبرها بالتحديد «أوزات سوداء»، وذلك على أساس أنها لم تكن «مرئية» قبل اختراعها، ولو كان لدينا اليوم «وهم» أنها كانت «مرسومة» وفق خطط تربط السبب بالنتيجة.
القدرة على التنبؤ
يورد المؤلف أسباباً ثلاثة تحول بيننا وبين قدرتنا على التنبؤ بـ«البجعة السوداء/ الأحداث غير المتوقعة»، يرجع السبب الأول منها في كون البجع الأسود غير قابل للتنبؤ، وثانيها هو أن القادة ينزعون إلى التركيز على ما يعرفونه وعلى تفاصيل ما يعرفونه فقط، أما السبب الثالث فهو تأثير البيئة المحيطة.
وهذا كله في رأي المؤلف يعود إلى أن احتمال تغيير طريقة تفكيرنا محدودة، ويفسر هذه الحالة بتأثير ديناميكيتين على كيفية تفكيرنا، هما: التحيز والانحراف في التفكير، والنزوع إلى عدم التخلي عن رأي ما طوره الشخص.
فنحن نتعامل مع أفكارنا كممتلكات، وإن كانت هاتان الديناميكيتان مسؤولتين عن حالة من القصور في الطريقة التي نتلقى بها الأحداث ونفسرها، وعلى أساسه يقسم المؤلف العالم إلى مكانين «وهدائستان» و«غلوائستان»، في وهدائستان يعيش من هم على سوية واحدة من التفكير متمسكين بالأنماط التقليدية رافضين الجديد وغير المألوف وهنا تكثر البجعات السوداء وأثرها المفاجئ، أما غلوائستان على العكس تماماً يعيش من هم على سوية عالية من التفكير والمبدعون، ويكون احتمال البجعات السوداء أقل تأثيراً ممّا عليه في المكان الأول.
ويخلص المؤلف إلى أن هناك نوعين للبجع الأسود، «البجعة السوداء السلبية» أي الموقف الذي يترتب فيه على الأمر غير المتوقع الإصابة بضرر بالغ، و«البجعة السوداء الإيجابية» أي الموقف الذي يترتب فيه على الأمر غير المتوقع فائدة ما.
يسرد المؤلف المثال تلو المثال، ويسرد مشاهير الأسماء، ليؤكد حقيقة، أن من نجح يظن أنه نجح بسبب كذا وكذا، لكن الناظر من بعيد سيجد أدلة تؤكد عدم صحة هذا الزعم، النجاح في البورصة ليس دليلاً على أي شيء، وسيارة الدفع الرباعي ذات الثمن الباهظ ليست دليلاً على أن سائقها عبقري فذ، والرصيد المليوني ليس دليلاً على الذكاء أو النبوغ، لماذا نجح هذا أو ذاك؟ اجتهاد منه؟ جائز، توفيق؟ جائز، لكن الأكيد أن النجاح ليس حكراً على أحد!
هل هي الدعوة للتخاذل وعدم فعل شيء؟ بالطبع لا، ما أريد قوله هو: إن المباراة لم تنته، وربما لن تنتهي، وأن الهدف الذي دخل مرماك لن يكون الأخير، لكنك كذلك ستحرز مثله الكثير، كل محاولة تبذلها قد تكون هي الناجحة، فلا شيء يمنعها من أن تكون كذلك، على العكس، الاحتمالات تلعب لصالحك، لا يهم أن تكون غنياً أو قريباً لمسؤول، ولا يهم أن تكون في بلد غني أو فقير، طبعاً كل هذه الأمور قد تجعل الوقت اللازم للنجاح أقل، لكن مرة أخرى ليس بالضرورة، لقد عثروا على البجعة السوداء في أستراليا، فهل عثرت أنت عليها؟
يدعونا المؤلف إلى أن نستمر في البحث عن بجعتنا السوداء وعن نجاحنا وعن فرصتنا؛ فهي حتماً هناك!
خلاصات الأفكار
- وضْع نظرية واحدة يحتاج إلى أدلة كثيرة جداً للتصديق بها، في حين أن هدمها يحتاج لدليل واحد فقط.
- كلما ظن الإنسان معرفته بما يحدث الآن، وما سيحدث في المستقبل؛ كانت صدمته عنيفة بأحداث تثبت له عدم صحة زعمه هذا.
- يرى المؤلف أننا عبيد لتفكيرنا في الأشياء المألوفة والعادية مما يجعلنا نتأخر ولا نستفيد مما يقع لنا من أحداث.
- يعتقد الغرب أن الديمقراطية المقبلة سوف تكون مرتبطة به ارتباطاً عضوياً، الأمر الذي يجعلها تدور في فلكه سياسياً واقتصادياً، على غرار ما جرى في دول أوروبا الشرقية.
- لن يكون غريباً أبداً أن يظل الغرب يرتكب الحماقات واحدة تلو أخرى، وأن يدير ظهره للبجعة السوداء، الذي يعرف أنها موجودة كاحتمال كبير في أي لحظة وفي أي مكان.
- الغرب فقد القدرة على التحكم في مسار الشعوب وإراداتها، وكل ما نراه من مواقف داعمة أو رافضة ليس سوى محاولات لاستباق النتائج، التي يعلم الغرب جيداً أنها قد تحمل الكثير من البجعات السود، وهو ما لا يريده.
- حين تتكرر أشياء وأمور من حولنا، نميل إلى تنظير النظريات ووضع القواعد، لكن حقيقة الأمر تثبت أنه إذا أمعنا البحث أكثر، واجتنبنا انتقاء المعلومات التي تؤيد نظريتنا واستبعدنا كل ما يشكك فيها، لو فعلنا كل هذا، فستقل النظريات التي نضعها كثيراً، ولأبقينا عيوننا مفتوحة، بحثاً عن المزيد من المعلومات، ولأبقينا أذهاننا متفتحة، تتقبل الجديد والغريب.
- إن عجز العقل البشري عن توقع أي حدث، وبالتالي عجزه التحضير للتعامل مع نتائجه ومع التغييرات الحاسمة التي يولدها، يعود إلى ندرة إمكانية وقوعه، تلك التي تؤدي إلى إهماله وتجاهله.
- يعتقد المؤلف أننا مجرد ماكينات «عظيمة» للنظر إلى الوراء، وبأن ليس هنالك من هو أشد من البشر مخادعة للذات، وكلما مر عام زاد اقتناعه بهذه العلة البشرية!
- مشكلات المعرفة لدينا هي «المعرفة الاستقرائية» ويتساءل: كيف للإنسان أن يذهب من مثال محدد وضئيل ليصل إلى استنتاجات عامة!
- لا أحد يجد متعة في الإصغاء إلى الأفكار التافهة والسفاسف فجدوى مشروع بشري بشكل عام إنما يعكس طرداً نسبة توقعات نجاحه.
- إن ما تعرفه لا يمكن له أن يؤذيك.
- إن عدم المقدرة على التنبؤ والتكهن بما هو خارج عن المألوف إنما يكمن في صعوبة التكهن بمسار التاريخ مع الأخذ بعين الاعتبار مساهمة هذه الوقائع في ديناميات الأحداث.
- نحن لا نتعلم القواعد، بل يبقى تعلمنا قاصراً على الحقائق ولا شيء غيرها.
- نحن في أشد حاجة إلى الوقاية مما نحن بحاجة إلى العلاج، ولكن ما أقل من يكافئ جهود الوقاية.
- نحن نمجد من تركوا أسماءهم في كتب التاريخ على حساب أولئك المساهمين في أدوار بيت كتب التاريخ صامتة عنها.
- نحن البشر لسنا مجرد مخلوقات سطحية التفكير فقط، بل نحن أيضاً أبعد ما نكون عن الإنصاف والعدل.
- إذا شئت الحصول على فكرة عن طباع صديق، أو أخلاقه، أو عن ألق شخصيته، فعليك تفحصه تحت ظروف قاسية، وليس تحت وهج اليسر الاعتيادي للحياة العادية.
- هل نستطيع أن نفهم الصحة دون أن ندرس الأمراض الفتاكة والأوبئة المعدية؟ فبالفعل، إن «العادي» كثيراً ما يكون عديم الصلة والأهمية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل