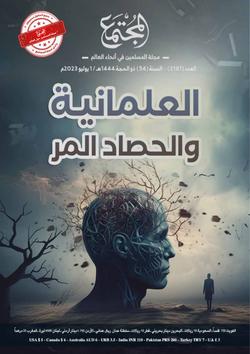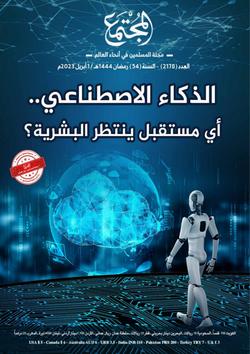العنوان التغريب وخطره على الأمة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 01-سبتمبر-2020
مشاهدات 13
نشر في العدد 2147
نشر في الصفحة 15
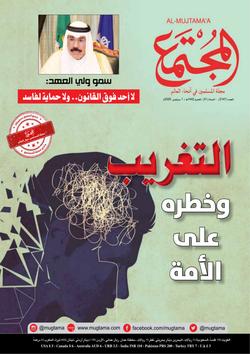
الثلاثاء 01-سبتمبر-2020
يعد التغريب من المصطلحات التي تعددت
تعريفاتها، ودراساتها، وتنوعت زوايا تناولها نظرًا لما يمثله من خطورة على هوية
الأمة من حيث التصور والاعتقاد، خاصة بعد أن خرج الاحتلال الغربي لبلادنا بجنوده
وأجساده، وترك فينا مفاهيمه وأفكاره.
ولعل من أخطر التصورات التي طغت على عقول
الكثير من أبناء الأمة ومثقفيها -للأسف- هو هذا الخلط بين مفهوم التغريب «بما
يعنيه من استلاب كامل للغرب حلوه ومره خيره وشره»، ومفهوم التطور أو الحداثة: حيث
ساد الاعتقاد بأن الأول شرط للثاني، وأن الثاني نتيجة للأول؛ وهو ما ترتب عليه فقد
الثقة في الذات وتسليم زمامنا للغرب يجرنا خلفه حسبما يسير.
وإزاء هذا الأمر، كان لا بد من إفاقة للعقول،
وتصحيح للمفاهيم، ودق لنواقيس الخطر، من خلال هذا الملف الذي تساهم به «المجتمع»
قيامًا بواجبها الإعلامي الذي تقدم فيه الموضوعات التالية:
التغريب.. ومخاطره على الأمة.
جذور التغريب في التعليم الحديث بالعالم
الإسلامي.
التغريب.. والاقتصاد الإسلامي.
التشريع.. من ضيق التغريب إلى رحابة الإسلام.
السينما العربية والتغريب.. واقع الصناعة
وأبعاد التأثير.
كلمة في «تغريب» الفكر السياسي.
الأسرة والتغريب.. بين الأمس واليوم.
التغريب.. ومخاطره على الأمة
أ. د. حلمي محمد القاعود
أستاذ الأدب والنقد
الناس يحفظون للغرب فيضًا من العنصرية والوحشية
والحروب الدموية الاستئصالية وقليلًا من التراث الوثني.
مع انتهاء الحروب الصليبية نشطت عملية التغريب
بمصر والشام وأفريقيا والخليج بحركة متفاوتة.
الحكمة في الحضارة الإسلامية تتسع لتضم كل ما
يعود بالفائدة على المسلمين، وليس ما يخرجهم من دينهم.
التغريب في أمتنا المنكوبة وصل ببعض النخب إلى
حد جعل الإسلام قرينًا للإرهاب والتطرف.
دولنا لا تضع اعتبارًا للثوابت الإسلامية في
العلاقات بينما يرفع اليهود التوراة بوجه المفاوض.
التعليم صار تقليدًا كاريكاتوريًا للغرب تتداخل
فيه البيروقراطية وتزييف التاريخ والجغرافيا والاستهانة باللغة وتهميش الإسلام.
التغريب نسخة شبه سلمية من الاستعمار الغربي،
حيث تصمت قعقعة السلاح وتتوقف الوحشية الغربية مؤقتًا، لتقوم الطلائع الأوروبية
الناعمة والوكلاء المحليون الخشنون بالدور الاحتلالي المطلوب في إخضاع السكان
العرب والمسلمين لثقافة الغرب الهمجية والاستسلام لفكره وإرادته، والدفاع عن
جرائمه ومخططاته، فالتغريب ليس مجرد ارتداء القميص والسروال والسترة الأوروبية، أو
استخدام الشوكة والسكين عند تناول الطعام، وتناول المشروبات المحرمة، ومراقصة
النساء للرجال في الحفلات، ولكنه أعمق من ذلك؛ إنه تشرب الروح الغربية الوثنية
المعادية للإسلام والأخلاق والإنسانية، وإن تزيّت بأزياء رقيقة مهذبة.
غاية التغريب بالنسبة للمسلمين أن يتحولوا من
دينهم إلى الوثنية الغربية التي تنسى الله الواحد وتعبد المادة والشهوة، وتستنيم
إلى الكسل، فليس في منهج التغريب أن يعمل المسلمون وينتجوا ويكتفوا ذاتيًا من
الغذاء والدواء والسلاح، إن غاية غاياته أن يعيش المسلم متسولًا على باب الغرب،
ليمنحه عطاء رديئًا أو لا يمنحه شيئًا على الإطلاق.
التغريب هو التبعية المطلقة للغرب في المجالات
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، وهي تبعية العبد لسيده الذي
يأتمر بأمره، دون أن يستطيع أن يقرر لنفسه شيئًا، والتغريب لا يعلن عن نفسه مباشرة
ولكنه يتسلل تحت شعارات ومصطلحات مراوغة يتقبلها الناس بسهولة، مثل الحرية وتحرير
المرأة والتطور والحداثة والعلمانية والتنوير والسلام والعولمة والشركات عابرة
القارات.
ينبهر البسطاء بهذه المصطلحات وأمثالها،
فيستسلمون لمدلولها السطحي، ويتجاهلون عمقها الخفي الذي يقصده التغريب وصناعه، هل
هناك أحد يرفض الحرية وتحرير المرأة مثلًا؟ بالطبع لا.. ولكن صناع التغريب يلحون
على الحرية الفردية المنفلتة، وتحرير المرأة من قيود الأسرة، والالتزام الديني
والخلقي، ليتجاهل الناس حرية الأوطان واستقلالها وقدرتها على بناء نفسها وقوتها
وصناعة مستقبلها بيدها وعقلها وفكرها ومصالحها، فتظل محتلة بقوة السلاح أو قوة
القروض أو قوة الاحتياج إلى الغير.
الفكر والمرتكز
ترتكز فكرة التغريب على مقولة إن «الغرب هو
مصدر الحضارة»، وهذه المقولة فيها نظر، فالحضارة تختلف عن المدنية فالمدنية هي
الشق المادي للحضارة، ويشمل الآلة والبناء والنظم والصناعة والزراعة والسلاح
والاختراع، الحضارة لها شق آخر هو الشق المعنوي الذي يشمل الدين والقيم والأخلاق
والتاريخ والتراث والتقاليد.. والغرب لا يقدم شيئًا ذا بال في هذا الشق حيث يحفظ
له الناس فيضًا من العنصرية والوحشية والحروب الدموية الاستئصالية وقليلًا من
التراث الوثني والفنون المعبرة عن الجوع المادي، صحيح أنه يملك الآن أسرار العلم
التي ارتكزت على ما أنتجته الحضارات الشرقية من قبل، ولكنه لا يملك الروح
الإنسانية التي تجعله بريئًا من الآثام والخطايا التي لا تسقط بالتقادم.
والقضية -من وجهة نظري- لا تكمن في التغريب
بقدر ما ترتبط بالاستجابة له، وبقدر مقاومته يتجلى الأمل في المستقبل الطيب القائم
على الحرية والكرامة والعدل والاستقرار، ولدينا أمثلة عديدة على عملية المقاومة
للتغريب أكتفي باثنين فقط:
الأول: في اليابان؛ حيث خرجت من الحرب العالمية
الثانية مدمرة، ولكنها قررت المقاومة وفقًا لتراثها القديم وهويتها الذاتية.
عقب الحرب تنازع اليابان تياران: أحدهما يؤيد
تقليد الغرب تمامًا والتخلي عن الهوية والتراث والآخر يقاوم ويرفض تقليد الغرب،
وقد انتصر الفريق المقاوم الذي اهتم باللغة اليابانية والنظام الملكي والحصول على
العلم من المصادر الغربية بكل الوسائل، لدرجة أن بعض علماء اليابان اشتغلوا خدمًا
لدى بعض العلماء والباحثين في أوروبا ليحصلوا على المعارف الممنوعة.
ومع العزيمة والصبر ومراعاة الأولويات ونبذ الحروب،
استطاع اليابانيون أن يناطحوا الغرب وأمريكا اقتصاديًا وعلميًا وإداريًا، مع
احتفاظهم بهويتهم ولغتهم وتقاليدهم.
المثال الآخر: فلسطين المحتلة؛ حيث استطاع
الصهاينة الغزاة أن يقاوموا الذوبان في الغرب مع أنهم جماعات شتى وثقافة معظمهم في
الأصل غربية؛ لأن أكثريتهم جاءت في ثوب الغزاة من أنحاء أوروبا وأمريكا وروسيا «وما
حولها من العرق الخزري»، لقد بعثوا لغة ميتة هي العبرية عمرها أربعة آلاف سنة،
وجعلوها لغة التخاطب والعلم والثقافة والسياسة والفنون، وأيقظوا العصبية اليهودية،
بحيث صارت مرجعًا للتشريع والعمل والسلوك والقتال والتفاوض، وأغدقوا على من يدرس
الشريعة اليهودية امتيازات مغرية، والمفارقة أنهم صنعوا من شظايا الأساطير
والخرافات تراثًا حضاريًا كما يزعمون يواجهون به العالم.
ومن خلال بناء هوية مستقلة، أمكنهم أن يقيموا
كيانًا قويًا يشبه الكيانات الأوروبية، ولكنه ليس منها لأنه يملك شخصية مختلفة فهو
متقدم علميًا وعسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا، ولكنه يظهر بهوية يهودية، بينما
الآخرون من حوله في وضع المريض الذي يحتاج إلى رثاء حزين.
الغراب والحمامة
الاستجابة على المستوى العربي والإسلامي
للتغريب كانت فاجعة، ما يذكر بالمثل الذي كان يدرس لنا في المرحلة الأولية قبل
سبعين عامًا عن الغراب الذي أراد أن يكون حمامة، فلا بقي غرابًا يحتفظ بخصائصه،
ولا استطاع أن يكون حمامة! لقد نجح الغرب في تصنيع نخب عربية وإسلامية وفق
متطلباته، عملت بهمة ونشاط في التفريط بهويتها ودينها ولغتها وتراثها وتقاليدها،
وسمحت له أن يتدخل في أدق تفاصيل أمورها ومصائرها ومستقبلها، وأن يرسم لها الطريق
الذي يريد هو لا الذي تريد هي، فكانت معرة العالمين.
مع انتهاء موجة الحرب الصليبية التاسعة بإخفاق «نابليون»
في غزو مصر «1798م» نشطت عملية التغريب في مصر والشام وشمال أفريقيا والخليج بحركة
متفاوتة، أسرعها كان في مصر حيث بدت طلائع المستشرقين وإرساليات التبشير «التنصير»
تغزو وادي النيل والشام بصورة مكثفة، وتبدأ في التأليف والتحقيق وإنشاء المدارس
والمستشفيات والجمعيات الخيرية، وهو ما توافق مع البدء في حركة تفكيك الخلافة
العثمانية، من خلال الحركات السرية وجمعيات المعارضة والماسونية والأحزاب
الشيوعية، وتجنيد الوكلاء المحليين الذين يحملون أسماء إسلامية أو طائفية، وساعدت
البعثات إلى أوروبا وانتشار المطبعة والصحافة على حمل معطيات التغريب وعناصره،
وبدلًا من الالتفات لبناء الشق المادي في الحضارة ونقل المسلمين من حال الضعف إلى
مجال القوة انغمست النخب في معارك جانبية كان معظمها يصب في تدمير الشق المعنوي
الذي تملكه الأمة، وفي مقدمته الإسلام للأسف الشديد!
عندما قال الحق تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا
النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: 13)، فقد جعل التعارف بمعناه الأشمل
يتجاوز معرفة الحساب والأنساب، إلى تبادل المنافع والمصالح واكتساب الخبرات، وهو
ما عبر عنه الأثر «اطلبوا الحكمة ولو في الصين» فمعنى الحكمة يتسع ليضم كل ما يعود
بالفائدة على المسلمين، وليس ما يخرجهم من دينهم وهويتهم، فالآية فيما بعد تشير
إلى التفاضل بالتقوى، أي التزام الدين.
ولعل أوضح تطبيق لذلك كان في إنشاء الدواوين في
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقليدًا للنظام الفارسي بعد أن اتسعت الدولة
الإسلامية، وتشعبت مصالحها، واحتاجت إلى تنظيم إدارة الدولة «ديوان المال ديوان
الجند، ديوان البريد ديوان الحسبة..» لم يجد المسلمون في ذلك غضاضة أو مخالفة
لأمور دينهم، ولكن حين تجد من يقول لك علينا أن نمنح الحرية للواط والدعارة
والعلاقة خارج الزواج تأسيًا بما يفعله الغرب المتقدم، فهذا نوع من التضليل
والتدليس، فالغرب ليس متقدمًا في هذا السياق، ثم إنه مخالف للنصوص الإسلامية
القطعية الصريحة، والغريب أنك لا تسمع واحدًا من هؤلاء يتحدث مثلًا عن كيفية
الاكتفاء الذاتي من القمح أو الفول أو الأرز أو اللحوم أو نحوها مما يستوجب العمل
والجهد، وقطع الطريق على دول الابتزاز التي يمكن أن تقتل المسلم جوعًا.
لقد وصل التغريب في أمتنا المنكوبة ببعض النخب
إلى حد جعل الإسلام قرينًا للإرهاب والتشدد والتطرف، وهو ما لا يوصف به معتقد آخر،
في بورما أو الهند أو الدول الأوروبية أو أمريكا التي يمارس فيها الإرهابيون غير
المسلمين نشاطهم على أساس ديني.
مجالات التغريب
ويمكن أن نوجز مجالات التغريب في معظم بلادنا
الإسلامية من خلال نقاط قليلة:
أولًا: في المجال السياسي: صار الإسلام خارج
الوظيفة السياسية، فالعلاقات الدبلوماسية والسياسية بين المسلمين تقوم على أساس
التصوّر الغربي والتقاليد الغربية، وقد عبر أحد السياسيين العرب ذات يوم بقوله:
«لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة ومعنى ذلك أن تقبل أي اتفاق أو معاهدة أو
قانون ولو كان مخالفًا للدين، وللأسف لا تضع دولنا الإسلامية اعتبارًا للثوابت
الإسلامية في العلاقات والتفاوض بينما اليهود يرفعون التوراة في وجه المفاوض
المسلم وغيره، ولا يتزحزحون عنها ولو كانت أساطير زائفة، أما عندنا فأبسط الأمثلة
أن كثيرًا من سفاراتنا الإسلامية في الخارج تقدم الخمور في احتفالاتها، وتسمح بما
يريده الآخرون في هذه الاحتفالات من سلوكيات مرفوضة إسلاميًا.
ثانيًا: التعليم صار التعليم تقليدًا كاريكاتوريًا
لتعليم الغرب، تتداخل فيه البيروقراطية، وتزييف التاريخ والجغرافيا والاستهانة
باللغة القومية، وتهميش الإسلام أو إقصاؤه، وهناك مندوبون من بعض الدول الغربية
يشرفون أو يتابعون المناهج العربية والإسلامية في بعض الدول العربية، وقد نقل عن
صحفي صليبي زار بعض الكتاتيب التي تحفظ القرآن في باكستان، قوله: «هنا تزدهر مصانع
الإرهاب»!
ثالثًا: اللغة العربية أصبحت اللغة العربية
تمثل في الوجدان العام -خاصة الأجيال الجديدة- حالة من الفولكلور السخيف الذي
ينبغي تجاهله، وقد نجحت السينما والدراما والمسرح الكوميدي في تحقيرها وازدرائها
بتصويرها في حالة التقعر والتشدق خاصة حين يستخدم الممثلون ألفاظًا مهجورة لا يفهم
الجمهور معناها، ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والفضائيات، والنزعات
الشعوبية شاع استخدام الألفاظ الأجنبية والعاميات وامتدت إلى الخطب والصحف، وما
يعرف بالشعر الشعبي مما يسهم في إبعاد الجمهور عن الفصحى وتذوق جمالياتها، وكثيرًا
ما تصادف من يحدثك ببعض العبارات الأجنبية المخلوطة بالعامية ازدراء للعربية.
رابعًا: الفنون التمثيلية خاصة السينما والمسرح
والدراما: في هذه الفنون تتسلل القيم بنعومة إلى الجمهور، فمن يرى مثلًا فيلمًا
سينمائيًا، تعيش فيه الشخصيات التي لا تعرف الوضوء ولا السجود، وتسكن بيتًا فيه
ركن للبار والمنكر بوصف ذلك أمرًا عاديًا، وعندما يتأزم الموقف بالبطل لأمر ما لا
يذهب إلى المسجد وإنما يتجه إلى الملهى الليلي «الكباريه»، حيث الشرب والسكر
والعربدة والرقص والمجون، البطل لا يذكر الله ولا يعرف شيئًا عن الإسلام، فيظن
المشاهدون أن الحياة الصحيحة هي حياة البطل الذي يمارس حياة شبه حيوانية تتعرى
فيها النساء اللاتي يقمن علاقات حرة مع الرجال.
خامسًا: الاقتصاد: يأخذ التغريب في هذا الجانب
منحى خطيرًا يكاد يذهب بوجود الدول وتماسكها، فهو اقتصاد ربوي يعتمد على الإقراض
لا الإنتاج، على مستوى الدولة والأفراد، فالغرب الصليبي الاستعماري يشجع الدول
الإسلامية على الاقتراض من دول غنية أو مؤسسات عالمية أو بنوك دولية، ويفرض
المقترض شروطه التي تجعل هذه القروض لا تذهب للشعوب المسلمة المسكينة، بل تتقاسمها
جهات من الدول أو المؤسسات المانحة وجهات ومسؤولين من الجهات والدول المقترضة، وما
يتبقى بعدئذ عليه أن يدبر تسديد الفوائد المركبة التي تتجاوز أحيانًا قيمة القرض
الذي قد يتولاها فاسدون وتجعل البلاد التي تمد يدها تدور في دائرة مفرغة، إلى ما
شاء الله، ولا يفيد المواطنون من القرض شيئًا ذا بال.
إذا تحدثت عن اقتصاد إسلامي يعمل وينتج ويؤسس،
قالوا: كلا، نحن نخضع لنظام عالمي لا نستطيع الفكاك منه.
سادسًا: الثقافة والدعاية تعمل أجهزة الثقافة
والدعاية، التي يقودها شيوعيون وناصريون وليبراليون وطائفيون وأشباههم بإلحاح على
قضايا من قبيل فصل الدين عن الدولة والعلمانية والتنوير والحداثة، وبعث الحضارات
القديمة بوصفها الهوية الأساسية للشعوب الإسلامية وليس الإسلام.. وغير ذلك من
قضايا، والهدف منها هو إقصاء الإسلام، واستئصاله.
إن هذه الأجهزة تبث على مدار الساعة أضاليلها
دون أن يجد المسلمون فرصة للرد والحوار والمناقشة، لدرجة أن مسؤولًا كبيرًا في
مؤسسة إسلامية شهيرة اشتكى أنه لا يستطيع أن يرد على ما يثار حول الإسلام، ولا
تتاح له فرصة الظهور على الشاشات المهاجمة، ويشارك في حملات التغريب نفر من
الطائفيين الذين يجمعون إلى التعصب، قدرة عجيبة على الكذب والتدليس، ومع ذلك تتاح
لهم فرصة التعبير على المنابر التلفزيونية والإذاعية والصحفية وغيرها.
يستفيض الحديث عن التغريب وآثاره المدمرة التي
تنتهي إلى ضياع المسلم فردًا ودولة، وكان «لورنس براون» صريحًا حين قال: «إن الخطر
الحقيقي كامن في نظام الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته، إنه
الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الغربي؛ ولهذا فلا بد من الدعوة إلى أن يطبع
المسلمون بالطابع الغربي».
جذور التغريب في التعليم الحديث
بالعالم الإسلامي
أ.د. حسان عبد الله
أستاذ أصول التربية المساعد بجامعة دمياط مصر
في ظل اهتمام الدولة العثمانية بالتعليم
العسكري، في بدء الاتصال بالغرب لم يتم الالتفات إلى التعليم الديني
المدارس الدينية الإسلامية ظلت تقدم لطلابها
الثقافة الدينية التقليدية اعتمادًا على ما كان لديها من أوقاف
الازدواجية بين التعليم المدني والديني مثلت
إشكالية معرفية واجهت العقل المصري.
الحرب الإيرانية الروسية كان لها دور في توجه
إيران نحو النمط الغربي في وسائل الحرب وفنونها.
ظهر جيل من المثقفين الإيرانيين تبنوا الفكر
الغربي وتمثلوا أفكاره خاصة بالنظرة إلى الدين ووظيفته.
السلطان عبد المجيد عرف بتبنيه لمشروع التغريب
وبدأت مؤسسات الثقافة التركية تبشر بالمشروع المعرفي الغربي
نتناول في هذه المقالة بدايات التغريب في
التعليم الحديث بالعالم الإسلامي، من خلال ثلاثة نماذج شكلت عبر التاريخ الإسلامي
روافد رئيسة للحضارة الإسلامية، هي تركيا ومصر وإيران، في محاولة لتتبع الاختراقات
المعرفية للتغريب في المنظومة القيمية المسؤولة عن تشكيل الشخصية المسلمة.
يبدأ المشهد الفكري من حالة الضعف الذاتي الذي
كانت تعاني منه الدولة العثمانية في القرن الثامن عشر، دون أن يكون هناك إدراك
حقيقي من قبل السلطة الحاكمة لهذا الضعف، ويرجع ذلك لعاملين:
الأول: أن التفوق الأوروبي لم يكن بارزًا
بالصورة التي تشكل خطرًا واضحًا على الدولة العثمانية الذي برز لاحقًا في القرن
التاسع عشر.
الثاني: يتمثل في كون الدولة العثمانية لا تزال
في تصنيف الدول العظمى «أو الإمبراطوريات الكبرى»، هذا التصنيف الذي بدأ بالتراجع
في التاريخ المذكور.
مع تنامي الضعف داخل الدولة العثمانية واستمرار
التفوق المادي الأوروبي في الصعود، لم يجد السلاطين العثمانيون إلا الخيار الأقرب
والأسهل في تصورهم لمعالجة القصور والضعف من ناحية واللحاق بالصعود الأوروبي، أو
تقليل الهوة من ناحية أخرى، وكان هذا الخيار هو «النقل والاقتباس»، أو استيراد
أفكار النهضة والتقدم بدلًا من معالجة المثالب والعيوب الذاتية، وقد بدأ استخدام
هذا النهج فيما يتعلق بالمجال العسكري الذي لاقت فيه الإمبراطورية هزائم متعددة من
الداخل والخارج، وكانت هذه البداية في عهد السلطان مصطفى الثالث «1757- 1773م»،
حيث «تم استحضار النموذج الأوروبي الحديث، واستمر هذا الاهتمام بالمجال العسكري
أساسًا لسلاطين الدولة العثمانية لتستطيع الدفاع عن نفسها وسط إرهاصات التفوق
العسكري الأوروبي، وذلك حتى مجيء السلطان محمود الثاني حيث شملت إصلاحاته جوانب
إدارية وتعليمية أخرى على النظام الأوروبي» (1)[1].
بين التعليم الديني والعسكري
وفيما يتعلق بنظام التعليم المسؤول عن التشكيل
المعرفي للإنسان داخل المجتمع، وفي ضوء التغلغل الواضح لحركة التغريب نجد -كما
يشير «جوستين ماكارثي»- أن التغيير «الناتج عن التغريب» الأكثر تأثيرًا نتج عن
النظام التربوي الأوروبي؛ «فكتب الحساب والمثلثات الضرورية للهندسة العسكرية
والمدفعية كانت مكتوبة باللغات الأوروبية، وخاصة الفرنسية لغة القرن التاسع عشر في
أوروبا، والتعليمات لتشغيل الآلات وكتيبات التصليح كانت أيضًا باللغات الأوروبية»
(2)، كما بدل السلطان محمود التوجه الألسني للحكومة، وأعطيت مكاتب الحكومة تعليمات
بفتح أكثر المدارس نجاحًا: «مثل» مكتب الترجمة التابع لوزارة الخارجية الذي أسس
عام 1833م، ولم يخرج هذا المكتب مترجمين فحسب، وإنما ساهم في تدريب الإداريين
الذين اكتسبوا توجهات غربية وفتحت اللغة أمام الإداريين العثمانيين وكبار الرسميين
باب الثقافة الأوروبية، وبسرعة أصبح خريجو مكتب الترجمة قادة السلطة التنفيذية في
الدولة (3).[2]
ومن ناحية أخرى، نلاحظ أنه في ظل الاهتمام
بالتعليم العسكري في بدء الاتصال بالغرب لم يتم الالتفات إلى التعليم الديني، «فالنظام
التعليمي الحديث تمركز في مجالين: أحدهما عسكري، والآخر مدني هدفه من الجيش
والإدارة بالكوادر اللازمة لهما، وفي حدود حاجة الدولة للعمالة في كل قطاع، وكان
التعليم العسكري أيسر منالًا في ولايات العراق والشام من التعليم المدني الذي كان
القبول فيه يتطلب فرزًا اجتماعيًا دقيقًا جعله مقصورًا على أبناء الأعيان، بينما
ظلت المدارس الدينية الإسلامية تقدم لطلابها الثقافة الدينية التقليدية اعتمادًا
على ما كان لديها من أوقاف تدر عليها من أبناء الطبقتين الفقيرة والوسطى، وظلت تلك
المدارس -في معظمها- تقدم تعليمًا دينيًا لم يتأثر بالاتجاهات الإصلاحية الحديثة
وإلى جانب هذين النظامين قام نظام تعليمي ثالث، قدمته مدارس الإرساليات التبشيرية
على اختلاف مذاهبها (4).
المدارس العلمانية
كما انتشرت المدارس العلمانية التي تخرج أصحاب
المهن اللازمة لتلبية احتياجات الجيش الجديد، الذي كونه باسم العساكر المحمدية
المنصورة واحتياجات المجتمع، كما تأسست المدارس الإعدادية «الرشيدية» لتخريج معلمي
المدارس الابتدائية، والمدارس الفنية لتنشئة الموظفين ومدرسة الحربية لتنشئة
الضباط، وأنشئت المؤسسات التي تهتم بالشؤون الصحية والطبية في الدولة (5).
وأدخلت اللغة الفرنسية إلى المدارس إلى جانب
اللغة التركية في المدارس التي يلتحق بها أفراد الأقليات غير المسلمين والأتراك من
أبناء الأسر الميسورة، وسرعان ما جرى التصريح بإنشاء مدارس وكليات أجنبية فرنسية
في غالبيتها، تدار من جانب المبشرين، وظهرت مؤسسات علمية على نسق أوروبي مثل «مجلس
المعارف» الذي قام على غرار الأكاديميات الفرنسية لإعداد الكتب التي ستدرس في
الجامعة المزمع تأسيسها والغرض الأصلي منها إيجاد شكل أكاديمي يحقق اتصالًا
بالحياة الفكرية والعلمية الأوروبية، وافتتحت الجامعة، وكانت تسمى دار الفنون عام
1286هـ/ 1869م، وسار هذا جنبًا إلى جنب مع التعليم الديني الموجود في المدارس
والكتاتيب، وهو القاعدة بالنسبة للمناطق الريفية البعيدة عن تأثير المثقفين
العثمانيين آنذاك، ومن أهم التغيرات التي أتت بها التنظيمات -أيضًا- استخدام
الأقليات في مجال التعليم مما يعد أمرًا جديدًا في تاريخ الدولة التركية (6).[3]
وفي ظل السلطان عبد العزيز «1861- 1876م»، بدأ
التعليم العام الواسع النطاق لتخريج موظفين وشملت بنيته التعليم الأولي، وكان مخصصًا
من حيث المبدأ للأطفال اعتبارًا من السادسة من العمر مدارس أولية عليا كليات، وقد
أنشئ الليسيه الأول في جالاتا سراي عام 1868م، وكان يجري تدريس الفرنسية فيه،
وأصبح بؤرة لتفريغ مثقفين وموظفين، وسرعان ما جرى التصريح بإنشاء مدارس وكليات
أجنبية فرنسية في غالبيتها وتدار من جانب رهبانيات كاثوليكية، وكان يتردد عليها في
آن واحد أفراد من الأقليات وأتراك من الأسر الميسورة الحال، وقد أتيح للبنات، لأول
مرة الحصول على تعليم حديث على النمط الأوروبي (7).[4]
وكذلك أيضًا حدث في عهد السلطان عبد المجيد «1839–
1861م» الذي عرف بتبنيه الكامل لمشروع التغريب؛ حيث تحولت في عهده مؤسسات الثقافة
التركية إلى مؤسسات تبشر بالمشروع المعرفي الغربي، وتأسست في عهده في إسطنبول أول
جامعة حديثة؛ حيث يحذو تعليم العلوم حذوا أوروبيا كما أمر بإنشاء أكاديمية العلوم
العثمانية «أنجومين– أي دانيش» عام 1850م.
ومن أبرز رموز التغريب ودعاته في تركيا رشيد
باشا «1800- 1858م»، إبراهيم شناسي «1826- 1871م»، ضيا باشا «1825- 1880م»، نامق
كمال «1840- 1888م» مدحت باشا «1822- 1885م»، عبدالله جودت.
الازدواجية والابتعاث
أما في مصر، فنلاحظ أن الإشكالية المعرفية
الكبرى التي واجهت العقل المصري وكانت مصدرًا لمعاناته الفكرية تكمن في تلك
الازدواجية، التي بدأت تتكون مع إيجاد نظامين للتعليم مسؤولين عن تشكيل البنية المعرفية
للعقل المصري، هما:
الأول: التعليم المدني الذي بدأ مع تجربة محمد
علي الذي يقوم على اتباع النمط الغربي.
الثاني: التعليم الديني الذي أصبح بجموده
وانسداد روافد الاجتهاد فيه وفشل محاولات إصلاحه يشكل عبئًا وليس حلًا للواقع
الراهن.
وفي ضوء ذلك «بدأت مصر تعرف ذلك الازدواج
الخطير بين نمطين من الثقافة ثقافة دينية تقليدية جامدة، وثقافة علمية غربية
متجددة، وكان لهذا أسوأ الآثار والشرور التي عانت منها مصر؛ فقد فتتت من وحدة
الفكر بين أبناء المجتمع، وخلقت أخدودًا ثقافيًا قل من كانوا يستطيعون عبوره» (8).[5]
ونتيجة لسياسة الابتعاث إلى أوروبا في ضوء غياب
التحصين المعرفي من جهة، واستقدام الأوروبيين لاستخدامهم في وضع البرامج الثقافية
والتربوية في مصر من جهة أخرى، تكونت في مصر بيئة خصبة للتغريب ظهرت فيها كافة
أفكار ودعوات المشروع المعرفي الغربي، من الدعوة إلى العلمانية وفصل الدين عن
الدولة، وتحرير المرأة والدعوة إلى السفور ومحاربة الحجاب والتبشير بسيادة الفلسفة
المادية، وتبني نظرية دارون في النشوء والارتقاء «شبلي شميل 1850م، وإسماعيل مظهر
1891م وسلامة موسى 1887م».
أما في إيران «الرافد الثالث للحضارة الإسلامية»،
فقد كان للحرب الإيرانية الروسية، وما تبعها من هزيمة للإيرانيين، ومعاهدة «تركمان
جاي» «1828م» -التي سنت بموجبها امتيازات كثيرة للأجانب- دور كبير في التوجه نحو
النمط الغربي في وسائل الحرب وفنونها، ولم يعد لدى الإيرانيين خيار سوى إعداد جيش
على الطراز الحديث، فأنشؤوا مدرسة «دار الفنون» في منتصف القرن التاسع عشر «1851م-
1867 هـ .س» في عهد الدولة القاجارية، ضمت في دورتها الأولى سبعة أقسام هي:
الرياضة والهندسة والطب والجراحة، والصيدلة وعلوم المعارف، وثلاثة أقسام أخرى خاصة
به علوم العسكرية (9).[6]
مدرسة «دار الفنون»
وعلى الرغم من استقدام مدرسين أجانب لهذه
العلوم، وانتقاء الطلاب من غير المدارس الدينية والتحول الإداري والقانوني الذي
شهدته مدرسة «دار الفنون»؛ فإنه لم يعترض أحد من علماء الدين؛ وذلك لرغبتهم في
إعداد جيش قوي يتم به مواجهة الروس مرة أخرى، إلا أنه لم يتم التعايش مع مدرسة «دار
الفنون» من قبل رجال الدين إلا لفترة محدودة، انتهت ببدء الدورة الثانية لهذه
المدرسة «1859م» التي تأسست فيها مجموعة من الأقسام الدراسية الأخرى تهتم بتشكيل
القيم وتتدخل في الثقافة والأخلاق، وهذه الأقسام هي «المسرح والتمثيل»، «النحت
والتصوير»، «الموسيقى».
وفي هذه المرحلة بدأ الصراع بين رجال الدين
كمدافعين عن التعليم التقليدي «الديني»، وما يحمله من قيم وخصائص وفئة المتغربين
الذين درسوا في أوروبا، هذه العلوم الجديدة، وعادوا لتدريسها في مدرسة «دار الفنون»،
وما تبعها من مدارس أخرى على النمط الغربي ذاته فبعد نصف قرن تم إنشاء عدد من
المدارس المشابهة، فأنشئت مدرسة الحقوق والعلوم السياسية عام 1899م، كانت مدة
الدراسة فيها 4 سنوات وتنتمي إلى التعليم العالي، ثم أنشئت في عام 1908م مدرسة
الطب، ومدة الدراسة فيها 5 سنوات، كما أنشئت المدرسة العالية للزراعة والحرف
المهنية عام 1922م ومدرسة المهندسين عام 1926م، والمدرسة البيطرية عام 1932م.
ويعتبر الإيرانيون أن افتتاح دار الفنون
واستقدام معلمين ومناهج ودراسات غربية كان من العوامل المؤثرة والفعالة في انتشار
وترويج الفكر الغربي بإيران، لا سيما فيما يتصل بمنظومة القيم والثقافة، وقد وصل
عدد الخريجين خلال 4 سنوات 1100 طالب، وكان أغلبهم من أسر معروفة وذات نفوذ كبير،
وشغل معظمهم مناصب عليا في الدولة، وكانوا في نفس الوقت يسعون لنشر الثقافة
الغربية (10).[7]
وفي هذه الأثناء ظهر جيل جديد من المثقفين
الإيرانيين، الذين تبنوا الفكر الغربي وتمثلوا أفكاره، لا سيما ما يتعلق بالنظرة
إلى الدين ومهامه ووظائفه في حياة الإنسان، لدرجة وصلت إلى معاداة الدين باعتباره
أساس التخلف، كما فعل التنويريون الغربيون مع الدين المسيحي؛ فقد «تأثر الجيل
الأول من تيار التنوير الإيراني بروحية معاداة الدين والمؤسسة الدينية، التي كانت
سائدة في أوروبا، ومن هنا اتخذ هؤلاء موقفًا معاديًا من الدين وتوجهوا نحو الأصول
القومية، فقفزوا إلى الوراء ليتجاوزوا الإسلام بوصفه مرحلة تاريخية دخيلة من عمر
إيران والإيرانيين، ويعودوا إلى تاريخ الأجداد الساسانيين» (11).[8]
وقد ارتبطت المؤسسات التعليمية الحديثة، ومصطلح
المستنيرين بمن يروجون للفكر الغربي، وباستعداء الدين واستبعاده من حركة النهضة
الإيرانية، ومن ذلك ما كتبه جلال أحمد عن هذه الحالة فيما أسماه «درخمت وخيانة
روشنفكران» «المستنيرون خدمة وخيانة»، والمصطلح يشير بوضوح إلى هؤلاء الذين يميلون
للغرب ويرجحون أفكاره وينقلونها.
[1] (1) إسماعيل أحمد ياغي: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي
الحديث، الرياض، مكتبة العبيكان، 1996، ص 149.
(2) جوستين ماكارثي: سياسات الإصلاح
العثماني ترجمة عبد اللطيف الحارث مجلة الاجتهاد العدد 45-46، بيروت، 2000، ص 64.
[2] (3) المرجع
نفسه، ص 75.
(4) رءوف
عباس: «الإصلاح العثماني الدوافع والأبعاد»، بيروت، مجلة حوار العرب العدد الرابع،
مارس 2005، ص 48.
[4] (7) روبير
مانتران «إشراف»: مرجع سابق، 463.
[5] (8) سعيد
إسماعيل علي: تاريخ التربية والتعليم في مصر القاهرة، عالم الكتب، 1985، ص 337.
[6] (9) مهدى
إشراقي: دار الفنون كفتاری در هویت دار الفنون و جايكاه در تاریخ معاصر إيران
«مكانة وتاريخ مدرسة دار الفنون في الهوية الإيرانية» طهران، مركز التعليم
والتربية 2004م، ص 27.
[7] (10) المرجع
نفسه، ص 53.
[8] (11) انظر:
-
نهاوندي هوشنگ وديكران أمير كبير ودار الفنون، طهران المكتبة المركزية
1999.
-
محمد شفيعي فر: الأسس الفكرية للثورة الإسلامية، ترجمة: محمد حسن زراقط
بيروت، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي 2007، ص ١١٢.
د. عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع الخالدين بالقاهرة لـ«المجتمع»:
لا ندعو للقطيعة مع الحضارات الأخرى لكن نرفض
الذوبان والاستسلام
هناك رغبة أكيدة من الغرب لإضفاء طابعه على
الحياة في سائر الحضارات الأخرى.
نرفض التغريب ونواجهه ولا ندعو للقطيعة مع الحضارات
لكننا نأبى التبعية.
مؤتمر السكان بالقاهرة عام 1994م أحد أهم
الأحداث الفارقة للدلالة على الرغبة في التغريب وفرضه كاملًا.
انتشار المدارس التي تجعل اللغات التي تعلم بها
معيارًا للفكر والفن والثقافة والتاريخ أهم وسائل تغريب مجتمعاتنا.
ليس معنى أن نتخذ موقفًا من التغريب أننا ندعو
للقطيعة مع الحضارات الأخرى، فليس ذلك مقصودًا أبدًا، ولكننا في الوقت نفسه نرفض
الذوبان أو الاستسلام أو التبعية.. بهذه العبارة الدالة الواضحة بدأ د. عبد الحميد
مدكور الأمين العام لمجمع الخالدين بالقاهرة حواره لـ«المجتمع»، حول قضية «التغريب»،
وما يكتنفها من لغط يروج له دعاته بين فينة وأخرى.
أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم
جامعة القاهرة، أكد أن العلاقة بين الحضارات وما يقع بينها من تأثير وتأثر يمكن
تشبيهها بعملية نقل الدم من إنسان إلى آخر، وهذا النقل يقتضي تماثلًا وتجانسًا من
نوع الفصيلة التي سيتم نقلها . فإذا لم يتحقق هذا التماثل أو التجانس، فإنه سيتسبب
بإضرار الشخص الذي سينقل إليه الدم، وقد يؤدي إلى وفاته وهكذا الشأن في علاقة بعض
الحضارات ببعض.
حاوره– إسلام عبد العزيز
بداية، لو أردنا وضع تعريف محدد لمفهوم التغريب
لتنطلق منه في الحكم على مفرداته المختلفة، فكيف يمكننا أن نعرفه؟
-
كلمة
التغريب -في أصلها اللغوي- تدل على معاني النأي والبعد والارتحال بعيدًا عن الوطن
والانتقال من جهة الشرق إلى جهة الغرب، حيث يقال غرّب واغترب وتغرّب عن الوطن
بمعنى نزح عنه، ويقال: أغرب إذا أتى الغرب، وقد تدل على أنه جاء بالشيء الغريب غير
المعهود في الآراء والأفكار ويقال كذلك: أغرب في الأرض بمعنى أمعن فيها وسافر سفرًا
بعيدًا.
وما زال للكلمة صلة وثيقة بهذه المعاني في
الاستعمال اللغوي المعاصر، لكنها تطورت في دلالتها ومضمونها، فأصبحت تستعمل على الألسنة،
وفي الكتابات والآراء بمعنى جديد يتصل بظواهر ثقافية واجتماعية وسياسية في علاقة
العرب والمسلمين وغيرهم من الحضارات والشعوب الشرقية بالحضارة الغربية التي تسعى
بكل الوسائل لإضفاء الطابع والنموذج الغربي على الحياة في سائر الحضارات الأخرى،
ومنها الحضارة العربية والإسلامية.
هل ترون أن هذا الموقف ثابت من الحضارة
الغربية، بمعنى أن لديها رغبة لذلك، أم هو محض افتتان من بعض من يفتتن بها من هذه
الشعوب؟ ولماذا؟
-
بالطبع
هو موقف ثابت تتخذه الحضارة الغربية تجاه العالم، رغبة منها في تأكيد تفوقها
العلمي والصناعي، وتوسيع نطاق هذا التفوق ليشمل الظواهر الإنسانية والاجتماعية
والفكرية.
وبالمناسبة ودليلًا على ما أقوله، فإنها تسلك
لتحقيق ذلك كل سبيل بداية من المعونات الاقتصادية والضغوط السياسية إلى شن الحروب
إذا لزم الأمر، ويرتبط ذلك في العالم العربي والإسلامي بالحقبة الاستعمارية التي
قامت بها أوروبا على هذين العالمين التي كان من أهم وقائعها الحملة الفرنسية على
مصر «1798- 1801م» وما تلاها من المحاولات الغربية لاحتلال العالم الإسلامي.
وهنا ربما يجدر بنا أن نؤكد أنه مما يستدعي
الانتباه ويستوقف النظر ما عرضه «نابليون» على المجمع العلمي الذي أنشأه بمصر في
أول جلسة له، حيث طالب بدراسة وفهم الموقف عمومًا في مصر من ناحية القانون المدني
والجنائي، وتدريس القانون وهل يمكن إدخال تحسينات يقبلها الأهالي.
وعندما دعا الديوان العام الذي شارك فيه بعض
علماء الأزهر إلى الاجتماع عام 1798م، كان من أهم أهدافه أن يعمل الديوان على
إعادة النظر في الإجراءات الجنائية والمدنية وقوانين الملكية والمواريث والضرائب،
وكان من أهم الأسئلة التي عرضها على الديوان: ما القوانين التي يجب سنها وتشريعها
لضمان حق الميراث؟
ولم تكن هذه الأسئلة تمثل مشكلة للمصريين الذين
كانوا يتبعون الشريعة الإسلامية، وما جاء بها من قواعد للميراث والملكية، ولكنها
كانت تمثل رغبة «نابليون» في إزاحة الشريعة عن مكانتها التي كان المصريون يحتكمون
إليها، دون شكوى أو تبرم، كما أن ذلك كان يعني محاولة إضفاء الطابع الغربي على
النظم والقوانين السائدة في مصر، بما يترتب على ذلك من تغير في أنماط الحياة
الاجتماعية التي تترتب على تطبيق هذه القوانين.
وقد خرج «نابليون» وجيشه من مصر دون أن يتمكن
من تحقيق غايته، ولكن الفكرة ظلت قائمة منتظرة الفرصة لتحقيقها في مصر حتى جاء «اللورد
كرومر»، فجعل القانون الأجنبي هو القانون المطبق في المحاكم المصرية كلها ما عدا
قضايا الأحوال الشخصية، وأصبح التغريب هو السائد في نطاق القانون الذي يمثل ركنًا
مهمًا من أركان الحياة الاجتماعية.
لو ابتعدنا قليلًا عن العمق التاريخي لبدايات
محاولات التغريب، وأردنا أن تضع لنا حدثًا تعتبره فارقًا في وسائل هذا التغريب
وطريقة إدارته، فما هذا الحدث؟ وكيف تراه؟
أعتقد هو ما حدث في أواخر القرن العشرين،
وتحديدًا في العام 1994م، حيث استعملوا وسيلة أخرى من وسائل التدخل في شؤون
المجتمعات الإنسانية، تحقيقًا لما يريدونه من تغريب يصبغ المجتمعات غير الغربية
بالطابع الغربي، عن طريق المعاهدات الدولية التي تعمل على تغيير ثوابت المجتمعات.
وأقصد هنا تحديدًا مؤتمر القاهرة للسكان
والتنمية الذي عقد في عام 1994م بإشراف الأمم المتحدة، حيث تدل وثائق هذا المؤتمر
صراحة على أنها تدعو سائر المجتمعات إلى تطبيق النمط الغربي في النظر إلى الحياة
الأسرية والحرية الجنسية وحرية الشذوذ وتتحدث عن علاقات جنسية قبل الزواج، وبدونه،
وتسعى إلى تحقيق أقصى قدر من الإمتاع للفرد على حساب التعاليم الدينية، والقيم
الأخلاقية.
وكان من فضل الله أن الأزهر الشريف والكنيسة
المصرية وقفا بقوة لهذه الوثيقة وقابلاها بالرفض الصريح، ولولا ذلك لسقط ركن آخر
من أركان الأسرة والحياة الاجتماعية، ولدخل المجتمع في وهدة التحلل والفساد الخلقي
اللذين يقضيان على تماسك المجتمع وقيمه الأخلاقية.
على ذكر الوسائل، هل ترون الاستشراق إحدى تلك
الوسائل الناعمة لتحقيق هذا التغريب؟
-
بكل
تأكيد، وذاك تحديدًا يتمثل فيما كان يقوم به فريق من الباحثين في شؤون الشرق من
المفكرين الغربيين الذين يندرجون تحت راية الاستشراق الإنجليزي والفرنسي ثم
الأمريكي، ويشير إلى هذا الجهد المستشرق الأمريكي من أصول عربية إدوارد سعيد، الذي
ذكر أن فريقًا من المستشرقين كانوا ينظرون إلى الاستشراق بوصفه أسلوبًا غربيًا
للسيطرة على الشرق والسيادة عليه وإعادة بنائه على النحو الذي يتفق مع العقلية
الغربية، والإسهام في تكوين فكرة الشرق عن نفسه بما يتفق مع الفكرة الغربية عنه،
وإن كانت مختلفة مع واقع الشرق نفسه.
البعض يقول: إن الاستشراق في جزء كبير منه بهذا
المعنى ما هو إلا تمهيد لتقبل فكرة الاستعمار ذاتها، هل توافقون على ذلك؟
-
نعم،
وهذا ما يقوله إدوارد سعيد الذي يربط بين الاستشراق بهذا المعنى واتجاه الغرب إلى
استعمار الشرق ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، حيث يرى هؤلاء أن تغيير
العقليات والأفكار، وزلزلة الثوابت الدينية والاجتماعية والتقبل لصور الحياة
الواردة يجعل من السهل على هؤلاء تقبل الاستعمار بعد إخضاعهم لغسيل المخ وإعادة
حشوه بالوافد المنتمي إلى الحضارة الغربية ومنظومة أفكارها وطريقتها في العيش
وترتيبها للأولويات والقيم السلوكية.
لكن، ألا ترون أن الأزمة ليست في عمل هؤلاء
بقدر ما هي في أن هناك من بني جلدتنا ممن يوصفون بالنخبة الفكرية والثقافية وهم
أبواق هؤلاء يرون ذلك ويدعون إليه؟ هل تتفقون معي؟
بكل تأكيد هذه هي الأزمة الكبرى، التي تزيد
الطين بلة، عندما تجد مفكرين من أبناء المجتمعات المستهدفة بهذا التغريب ينادون
بمثل ما ينادي به أبناء الحضارة الغربية، حيث يرى بعض هؤلاء -كما يقول طه حسين في «مستقبل
الثقافة في مصر» الذي ظهر في أربعينيات القرن الماضي- أن الطريق إلى النهضة هو
الأخذ بأسباب الحياة الحديثة التي يأخذ بها الأوروبيون في غير تردد ولا اضطراب،
وأنه ليس في الأرض قوة تستطيع أن ترد العرب وغيرهم عن أن يستمتعوا بالحياة على
النحو الذي يستمتع بها الأوروبيون، وأن السبيل إلى ذلك ليس بالكلام المرسل ولا
بالمظاهر الكاذبة والأوضاع الملفقة، وإنما هي واضحة بينه مستقيمة ليس بها اعوجاج
أو التواء، وهي واحدة فذة ليس لها تعدد، وهي أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم
لنكون لهم أندادًا، ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها حلوها ومرها، وما يحب
منها وما يكره، وما يحمد منها وما يعاب ومن زعم لنا غير ذلك فهو خادع أو مخدوع.
ولا يختلف عن ذلك كثيرًا ما يقوله سلامه موسي: «كلما
ازددت خبرة وتجربة وثقافة توضحت أمامي أغراضي، فهي تتلخص في أنه يجب علينا أن نخرج
من آسيا، وأن نلتحق بأوروبا، فكلما زادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي له، وشعوري
بأنه غريب عني، وكلما زادت معرفتي بأوروبا زاد حبي لها وتعلقي بها، وزاد شعوري
بأنها مني وأنا منها».
تخيل هذه مشاعره تجاه الشرق الذي ظهر فيه
الإسلام، وفيه قبلته، وهو في نظره تزداد كراهيته له كلما زادت معرفته بتاريخه
وثقافته، أما أوروبا فهي رمز للتمدن والحضارة والعلم والحرية عنده.
ما سر هذا الافتتان الكبير بالنموذج الغربي من
هذه النخبة؟
الدعوة إلى التغريب كانت تمشي في ركاب التقدم
التقني الذي كانت الحضارة الغربية الأوروبية سابقة فيه لغيرها من الحضارات، وكان
التفوق العسكري للغرب واضحًا ابتداء من القرن السابع عشر، وذاك هو السر الربط بين
هذا ونموذج الحياة وكأن هذا نتيجة لذاك.
وكما يقول المؤرخ الكبير «توينبي»: إن فن الحرب
ما هو إلا أحد وجوه طريقة المعيشة الغربية، وأي مجتمع غريب يرغب في تعلم هذا الفن
دون أن يحاول تبني طريقة العيش نفسها يكتب له الفشل حتمًا، وهو يفسر ذلك بأن جميع
المقومات في حضارة ما من دين وتكنولوجيا لها جذور داخلية، وإذا تخلى أحدهم عن
طريقته التقليدية ليتبنى طريقة أجنبية، فهذا التغيير الذي يبدو عليه أنه سطحي لا
يبقى كذلك، بل يتسرب إلى الأعماق، إلى درجة تصبح معها الحضارة التقليدية في الصف
الثاني، بينما تشق الحضارة الأجنبية لنفسها شيئًا فشيئًا طريقًا بواسطة الشق الذي
خلفه على السطح من الخارج الطريق الأجنبي لذلك كان البدء بالتكنولوجيا مقدمة
سيتبعها بالضرورة باقي العناصر.
هل ترون انتشار المدارس الأجنبية في جنبات
وطننا العربي والإسلامي إحدى وسائل التغريب؟
نعم، خاصة انتشار المدارس التي تجعل اللغات
التي تعلم بها معيارًا للفكر والفن والثقافة والتاريخ، ويقع ذلك فيها دون إشراف
جاد على مناهجها.
ولذلك لا يجد المنتسبون إليها والمتعلمون فيها
ما يؤكد هويتهم، وما يربطهم بتاريخهم وقضايا شعوبهم، بل قد يحظر في بعضها النطق
بالعربية التي هي اللغة الأصلية لطلابها، وكل هذه قنوات يتسرب منها التغريب إلى
المجتمع، ويحدث أثره في تغيير الأفكار والأذواق ونمط العيش وطريقة الحياة، بل قد
يؤدي إلى الانفصال النفسي عن المجتمع والتفكير في الهجرة إلى هذه البلاد التي قد
تكون معارفهم عنها أكثر من معارفهم عن مجتمعاتهم.
لكن بعض هؤلاء لا يرون في ذلك تغريبًا، بل
حداثة وتقدمًا ومدنية وتحضرًا!
-
ولن
تغني عنهم ألفاظهم التي يروجون بها للتغريب شيئًا، فالعبرة بالآثار التي تترتب
عليه، فليسموه مدنية أو تحضرًا أو حداثة أو تقدما أو تنويرًا، لأن هذه الأسماء
مرتبطة -في مضمونها- بالمجتمعات التي نشأت فيها ولكل حضارة مصطلحاتها، ومشكلاتها
وتصوراتها وقيمها ومفاهيمها وغاياتها، وعلى كل مجتمع أن يعالج مشكلاته، ويحدد غاياته
بما يتفق مع ثوابته، وبما يتلاءم مع قيمه، وقد قيل -قديمًا- فيما يتعلق بنسبية
الأخلاق: إن شيئًا ما قد يكون فضيلة على أحد جانبي النهر على حين أنه قد يكون
رذيلة على الجانب الآخر.
-
بل
إن المجتمع الواحد قد تتغير فيه منظومة القيم، ومناهج التفكير من عصر إلى عصر،
وهذا واقع يثبته النظر في أحوال الأمم والشعوب، وقد حملت الحضارة الأوروبية
العلمانية التي تتخذ موقفًا سلبيًا من الدين، لكن شعوبًا أخرى وقفت في وجه هذا
الموقف وقاومته متمسكة بقيمها وأصالتها، ثم حملت الحضارة الغربية إلى العالم مصطلح
العولمة، ولكن شعوبًا كثيرة تصدت لهذه العولمة وقاومتها كذلك، وسعت إلى الحفاظ على
مصالحها، ولم تقبل الذوبان في هذه العولمة التي تنال من هويتها وتقطعها عن
تاريخها، وتنال من خصوصيتها الحضارية، بل إن بعض الدول التي رفعت شعار العولمة قد
تراجعت عنه من الناحية العملية، حتى ولو لم تعلن ذلك على المستوى النظري
والأيديولوجي.
-
لكن
من المهم التأكيد على أن اتخاذ مثل هذه المواقف لا يكون عن طريق الشعارات
والادعاءات التي لا تغني فتيلًا عن أصحابها الذين سيجرفهم الطوفان لو لم يأخذوا
بأسباب القوة التي تمكنهم من المقاومة، وهي القوة الشاملة التي لا تعنى بجانب واحد
من جوانب الحضارة، بل عليها -إذًا أرادت المحافظة على مكانتها- أن تعنى بكل
الجوانب اقتصادية وعلمية وتقنية وسياسية وعسكرية، ويتحول كل هذا إلى واقع يراه
أصحابه ويراه الآخرون أيضًا.
-
لكن
أليس هذا يعني تقوقعًا وقطيعة مع الآخر، وسنن الله في الكون تأبى ذلك، فالحضارات
تتلاقح وتقوم إحداها على ما أخذته من الأخرى، فكيف تريدون لنا أن نقطع صلتنا بتلك
الحضارات؟
-
لا
أبدًا، لم ندع إلى ذلك، ولن ندعو إليه، فليس معنى أن نتخذ موقفًا من التغريب أننا
ندعو للقطيعة مع الحضارات الأخرى فليس ذلك مقصودًا أبدًا، ثم إنه ليس ممكنًا من
جهة أخرى بسبب هذا التواصل الذي لم تعرف البشرية له نظيرًا من قبل، ولكن ذلك لا
يعني الذوبان أو الاستسلام أو التبعية.
ينبغي أن يكون واضحًا أن العلاقة بين الحضارات
وما يقع بينها من تأثير وتأثر يمكن تشبيهها بعملية نقل الدم من إنسان إلى آخر،
وهذا النقل يقتضي تماثلًا وتجانسًا من نوع الفصيلة التي سيتم نقلها فإذا لم يتحقق
هذا التماثل أو التجانس، فإنه سيتسبب بإضرار الشخص الذي سينقل إليه الدم، وقد يؤدي
إلى وفاته، وهكذا الشأن في علاقة بعض الحضارات ببعض.
وليس لدينا في حضاراتنا رفض -من حيث المبدأ-
للتفاعل بين الحضارات فالله تعالى يقول: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ
يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (الزمر: 17)، وفي
الحديث الشريف، قال النبي صلى الله عليه وسلم : «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما
وجدها فهو أحق بها» «رواه ابن ماجة، والترمذي»، وليس يعني ذلك استيراد الحلول
الحضارية أو عن طريق التبعية لحضارات أخرى، وليس هناك عائق يمنع الإفادة من تجارب
الأمم الأخرى التي قد تتضمن كنوزًا من الخبرة الإنسانية في مجالات عدة، ومن ثم
تكون جديرة بالرجوع إليها والإفادة منها، بشرط التجانس كما قلنا وعدم التعارض مع
الثوابت التي لا يصح التفريط فيها.
الثوابت، هذه كلمة ربما كثر حولها الجدل، فهل
يمكن أن تحدد لنا ما تراه أهم هذه الثوابت في موضوع التغريب على وجه الخصوص؟
أعتقد أن اللغة العربية هي من أهم هذه الثوابت
التي يجب الحفاظ عليها، بالنسبة للمجتمع العربي خاصة وللمجتمعات الإسلامية عامة من
حيث هي وعاء العلم، وخزانة الفكر ومستودع التاريخ، وأقوى عناصر توحيد الأمة،
وتوحيد هويتها وتحديد مشاعر أهلها وإشعارهم بقوة الرابطة التي تجمع بينهم.
ثم هي لغة القرآن الكريم والحديث الشريف، وبها
دونت الكتب ووضعت المؤلفات في سائر العلوم العربية والإسلامية، وقد اتسعت للمعارف
الإنسانية التي أبدعتها الحضارات السابقة على الإسلام، وظهر ذلك في حركة الترجمة
الكبرى التي وقعت منذ وقت مبكر من تاريخ العالم الإسلامي، ثم ازدهرت في عصر الدولة
العباسية، وقد حوت بين جنباتها معارف الفرس واليونان والهند والسريان ولغات أخرى،
وهي من أطول اللغات الحية عمرًا، وقد تعلمها وبرع فيها أبناء الشعوب التي دخلت
الإسلام؛ فاتخذوها لسانًا لهم، وألفوا فيها كتبهم، وتغنوا بها في أشعارهم، وكتبوا
بها كتبهم العلمية في الفلك والرياضيات والطبيعيات والطب والصيدلة والفلسفة، فضلًا
عن العلوم العربية والإسلامية.
لكنها تلقى عننا كثيرًا متعدد الجوانب وهي توصف
عند بعض خصومها بأنها لغة بدوية عاجزة عن مواكبة الحضارة الحديثة، بل توصف أحيانًا
بأنها لغة ميتة، وقد كانت كذلك حتى في زمن ظهور القرآن الكريم، وهذا ما أورده
سلامة موسى بالمناسبة في «اليوم والغد».
بعيدًا عما روج له دعاة التغريب، كيف تم
الاعتداء على اللغة العربية من وجهة نظرك؟
مثلًا، تحول تدريس الطب في قصر العيني عندنا في
مصر من اللغة العربية إلى الإنجليزية بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر عام 1882م بسنة
واحدة تخيل.. سنة واحدة! وبدؤوا في محاولة طمس الهوية، وبدأت الدعوة إلى استعمال
العامية بدلًا منها، وكان من الدعاة إليها «ولكوكس» المهندس الزراعي الإنجليزي، ثم
تلقفها غيره من المصريين، بل ودعا بعضهم إلى استعمال اللغة اللاتينية، ولم تعد
العربية لغة العلم في الكليات العملية كالطب والهندسة والصيدلة والعلوم وغيرها.
أيضًا، نشأت المدارس الأجنبية التي تدرس كل
موادها بلغة غير اللغة العربية كالإنجليزية والفرنسية، وخصص لها في برنامج الدراسة
وقت لا يكفي لدراستها، وغاب استعمالها في بعض المؤسسات والشركات واللافتات على
الرغم من بعض القوانين التي تمنع ذلك.
كذلك لم يعد لها الغلبة في الإعلام ولا في
برامجه التي يدار فيها الحوار باللهجة العامية التي قد تخرج أحيانًا ببعض الكلمات
الأجنبية، ثم ظهرت الوسائل المسماة بوسائل التواصل الاجتماعي فاستعملت لغة هجينا
من الكلمات العامية والأجنبية، وحلت الأرقام فيها مقام بعض الحروف، وأصبحت المسافة
بينها وبين العربية شاسعة، وتضافرت هذه العوامل كلها على اللغة العربية وأصبحت
معضلة كبرى.
إذن، ما الحل؟ وكيف يمكننا التعامل مع تلك
المعضلة؟
الأمر يحتاج إلى تدخل الدول لانتشال اللغة من
الوهدة الثقافية التي تعيشها، وذلك بإصدار القوانين لحمايتها والتمكين لها، والعمل
على أن تكون لغة علم كما كانت قرونًا طويلة.
ونحن نقول ذلك توافقًا مع القول المأثور: «إن
الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»، فالدول هي التي تصدر القوانين، وهي التي
تضع مناهج التعليم، وهي التي تستطيع محاسبة من لا يستجيب للقوانين أو النظم
التعليمية.
لكن، دعني أؤكد أن كثيرين يعولون على مؤسسات
المجتمع أكثر مما يعولون على الدول والحكومات لأسباب كثيرة.
هذا صحيح، فالأمر لا يقتصر على الحكومات وحدها،
بل يجب على المؤسسات التعليمية كالجامعات ومراكز البحث العلمي أن تقوم بواجبها نحو
اللغة العربية التي هي اللغة الرسمية في البلاد العربية.
ومن العجب أن أكثر كلياتها لا تتضمن مواد
لدراسة اللغة العربية والطلبة الذين يدخلونها تنقطع صلتهم بهذه اللغة بعد الثانوية
العامة، فليس لها موضع في مناهجها ولو بمواد اختيارية، وأنى لهؤلاء أن يعرفوا هذه
اللغة أو يستعملوها في حياتهم أو أبحاثهم العلمية فيما بعد، وقد ظهرت دعوات لتضمين
اللغة العربية ضمن مناهج الكليات الجامعية منذ عام 1979م، ولكن هذا لا يطبق إلا في
القليل من البلاد العربية.
ويبقى العبء الأكبر طبعًا على مجامع اللغة
العربية، ومنها مجمع اللغة العربية في القاهرة.
على ذكر مجمع الخالدين بالقاهرة ما الذي فعله
المجمع في مواجهة ذلك؟ وهل أنتم راضون عن هذا الجهد؟
أصدر المجمع عددًا من المعاجم المتخصصة تعد
بالعشرات، ثم أصدر عددًا من المعاجم اللغوية كان من أهمها «المعجم الوسيط» الذي
فاز بجائزة الملك فيصل العالمية منذ بضع سنوات.
وهو يعمل الآن بحول الله وطوله لإصدار المعجم
الكبير الذي سيكون -عند إتمامه- أوسع معجم للغة العربية، وقد صدر منه حتى الآن
أربعة عشر مجلدًا، وينتظر أن يصل إلى نحو ثلاثين مجلدًا يتعاون على إصدارها عدد
كبير من أعضاء المجمع وخبرائه ومن يعاونهم من الباحثين الفنيين المؤهلين تأهيلًا
علميًا عاليًا، والمدربين تدريبًا عاليًا كذلك وهم يبذلون أقصى جهودهم لإنجازه في
وقت قريب.
التغريب تيار كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية
وثقافية وفنية يرمي إلى صبغ حياة الأمم بالأسلوب الغربي.
لا هدف من وراء التغريب سوى صبغ حياة المسلمين
باللون الغربي والتغني به باسم التقدم ومنها الحياة الاقتصادية.
التغريب يبدل ثقافة شعوبنا ويقوم على نبذ القيم
الإسلامية وإحلال الغربية مكانها.
قضية التغريب من القضايا التي تفرض نفسها في
الساحة الإسلامية، وتشهد لهيبًا محمومًا في هذه الأيام، خاصة في ظل علمانية في
عالمنا العربي الذين يتقبلون أي دين أو يذهبون إلى وضعية إلا دين الإسلام، ولم يعد
التغريب على الجانب السياسي، بل الجانب الاقتصادي أيضًا.
د. أشرف دوابه
أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول صباح
زعيم
عرفت الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب
المعاصرة التغريب بأنه «تيار كبير ذو أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية وفنية يرمي
إلى صبغ حياة الأمم بعامة والمسلمين بخاصة بالأسلوب الغربي؛ وذلك بهدف إلغاء
شخصيتهم المستقلة وخصائصهم المتفردة، وجعلهم أسرى التبعية الكاملة للحضارة
الغربية».
فالتغريب لا هدف من ورائه سوى صبغ حياة
المسلمين باللون الغربي بحلوه ومره خيره وشره، والدعوة إليه والتغني به باسم
التقدم والحداثة، ومنها الحياة الاقتصادية، مع أن الحداثة بمفهومها الصحيح لا غبار
عليها إذا كانت لا تصطدم بالأحكام الشرعية، فـ«الحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو
أحق الناس بها»، وشتان ما بين التغريب والحداثة، فالأخيرة تعني الانتقال من حالة
قديمة إلى حالة جديدة، تشمل وجود تغيير ما، وتيسر لنا الاستفادة من كل جديد نافع، بينما
التغريب يبدل ثقافة شعوبنا ويقوم على نبذ القيم والثقافة الإسلامية، وإحلال القيم الغربية
مكانها، فهو انسلاخ من حضارتنا وقيمنا، وتكريس للتبعية الغربية المادية فينا.
ولو تطرقنا إلى التغريب في الاقتصاد لوجدنا
الرأسمالية المتوحشة هي سيدة الموقف بويلاتها وأزماتها وثقافتها التي جعلت الربا
أمرًا لا فكاك منه، والمقامرة من مشتقات مالية ونحوها دواء لا بد منه، والاستهلاك
الترفي متاعًا لا بد من التمسك به، وحرية السلع دون الأفراد مسلكًا محمودًا، وفرض
الضرائب وإهمال الزكاة منهجًا، وحصر دولنا الإسلامية في الإنتاج الريعي والتقنية
المتقادمة، وتحويل الدولة من راعية للاقتصاد إلى حارسة له، بل وتفريغ العديد من
البنوك الإسلامية من منهجها بالتحايل المقيت ببيع العينة والتورق المصرفي المنظم.
ومن أشد أساليب التغريب في الاقتصاد أيضًا الركون
إلى المنهج التجريبي وحده دون غيره، والاستسلام لمقولة العقل هو المصدر الوحيد
للمعرفة، ولا مكان للدين والأخلاق سوى التحييد.
إن المعرفة تشمل كل ما يتجمع لدى الإنسان من
المعلومات العامة أو الحقائق القائمة على التجربة أو الإدراك الحسي أو التأمل
الفلسفي أو الجهد الفكري المنظم، والعلم هو المعرفة المنظمة التي تنشأ عن الملاحظة
الحسية التي تعرضت للفحص والتدقيق والتحليل والتجريب بغرض تحديد طبيعة وأسس وأصول
ما تم دراسته، ولا علم بدون منهج، ولا ممارسة للعلم بدون قاعدة علمية وضوابط
منهجية، والمنهج هو الطريقة الواضحة التي ينتهجها العقل للتوصل إلى الكشف عن
الحقيقة التي يريد الباحث الوصول إليها، مستعينًا في ذلك بمجموعة من القواعد
العامة التي يخضع لها العقل في عملية البحث عن طريق بعض أدوات التحليل، ومنها
أدوات التحليل المنطقي التي تضم الطريقة الاستنباطية والطريقة الاستقرائية.. إلخ،
وذلك بهدف التوصل -من خلال عملية التحليل- إلى أفكار ومقولات عامة.
والإسلام يؤمن بالمعرفة والعلم، ويثمن على منهج
البحث في علم الاقتصاد الذي يرتبط بالسلوك الإنساني، وينصرف إلى طرق الدراسة
والتحليل التي تستخدم من خلال الفكر المتتابع والمنتظم عن دراسة موضوع معين بهدف
التوصل إلى قانون عام يحكم الموضوع محل الدراسة، ولكن السلوك الإنساني في الإسلام
ليس سلوكًا عشوائيًا ولا سلوكًا يحكمه التجريب فقط، بل يحكمه العقل والوحي المرشد
لهذا العقل.
النظرية الاقتصادية
والاقتصاد الإسلامي كعلم ينشغل بالسلوك
الاقتصادي للإنسان في إطار الأصول الشرعية والجوانب العقدية والأخلاقية، فهو يتضمن
الأحكام التقريرية «الوضعية»، والتقديرية «المعيارية» معًا فدراسة الجوانب
الواقعية من السلوك الاقتصادي لا تقل أهمية عن دراسة الجوانب المعيارية فيه،
والنظرية الاقتصادية الواقعية هي نظرية علمية يتحدد إطارها بملاحظة الواقع وتفسيره،
مثل قانون الطلب الذي يعكس العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة والسعر، فهي تستند
المعايير واقعية.
والنظرية الاقتصادية المعيارية لا تعني انفصال
النظرية الاقتصادية عن الواقع تمامًا، حيث تصبح هذه المثالية مسألة خيالية خارجة
عن نطاق اهتمام الاقتصاديين، إنما المقصود بالمفهوم المثالي هو ارتباط النظرية
الاقتصادية ببعض الأهداف المرغوبة التي يظن صاحب النظرية أنه ينبغي تحقيقها في
الواقع، فقد تتضمن النظرية الاقتصادية فرض التوزيع العادل للدخل القومي في
المجتمع، بينما أن التوزيع السائد في الواقع غير عادل، وفي مثل هذه الحالة لن يمكن
اختبار النظرية الاقتصادية مثلما هي الحال في المفهوم الواقعي للنظرية، حيث يقتصر
ذلك فقط على تحقق الهدف المثالي على أرض الواقع، حيث يمكن حينئذ اختبار النظرية
وتنتفي منها الصفة المثالية وتصبح واقعية، والواقع أن منهج البحث في العلوم
الاجتماعية يختلف عنه في العلوم الطبيعية والاقتصاد، كعلم اجتماعي محوره الإنسان
ككل في نطاق الإنتاج والاستهلاك والتوزيع إشباعًا لحاجاته، وهو مجال يختلف عن مجال
بحث وأهداف العلوم الطبيعية، وإن كانت جميعها في النهاية تخدم الإنسان، ومن ثم فإن
الدراسة العلمية لا تقتصر على مجال الأحكام التقريرية، وإنما تمتد إلى مجال
الأحكام التقديرية كذلك.
وعلى ذلك، فإن علم الاقتصاد الإسلامي لا يقف
عند دراسة الواقع فقط، بل يتجاوزه إلى دراسته كما ينبغي أن يكون، ثم تحديد الخطوات
العلمية والعملية لتعديل الواقع القائم ليصبح هذا الواقع كما ينبغي أن يكون بمعنى
آخر؛ إن مهمته وهدفه هي مهمة وضعية ومعيارية معًا.
والباحثون في الاقتصاد الإسلامي مطالبون بالنظر
في الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء والعلماء في الكتب الشرعية وكتب الفكر الاقتصادي
وكتب التاريخ ورؤيتهم للظاهرة الاقتصادية في الإنتاج والاستهلاك والتوزيع والنقود
والتجارة الدولية.. إلخ، وكذلك دراسة الواقع من حيث وصفه وتفسيره.
وقد عجزت النظريات الاقتصادية الوضعية التي
يسعى أهل التغريب لجعلها منهجًا لنا عن حل المشكلات الاقتصادية المعاصرة، وركزت
على الماديات وأهملت الروحانيات وحيدت الأخلاق، وسارت في ركب الحياد العلمي
للنظرية الاقتصادية الذي تبنته المدرسة التقليدية الجديدة بمناداتها بتجريد
الظاهرة الاقتصادية عن غيرها من الظواهر الاجتماعية والأخلاقية، بينما النظرية
الاقتصادية الإسلامية تنبع من القيم الإسلامية، وتوازن بين المادة والروح، وهدفها
بناء الإنسان الاقتصادي الصالح الذي استخلفه الله لعمارة الكون بحوافز مادية
وإيمانية وأخلاقية، لا الإنسان الاقتصادي المادي الذي على أساسه تم إقرار تعظيم
الربحية للمنتج وتعظيم المنفعة للمستهلك بحوافز مادية بحتة.
وبناء نظرية اقتصادية إسلامية ينبغي أن يكون في
إطار الثوابت بالاستفادة من دراسة النظريات الاقتصادية الغربية رغم ارتباطها
بفلسفات وبيئات مختلفة، ولكن مع ذلك يمكن البناء عليها بما يلائم واقعنا، ودون
اصطدام مع أحكام شريعتنا، سواء 3 بمفهوم المخالفة إذا كنا مختلفين تمامًا، أو
بمفهوم المشابهة في بعض الأحيان إذا كان هناك تشابه، فنحن لا نبدأ من الصفر ولا
نهدر القوانين الاقتصادية التي ثبت صحتها ولا تصطدم بشريعتنا فالمعرفة تراكمية،
والتعديل والتطوير للنظريات الاقتصادية المعاصرة لا غبار عليه، لا سيما وأننا
نمتلك تراثًا فقهيًا عظيمًا يمكننا من الربط بين الأصالة والمعاصرة.
وإذا كانت النظرية الوضعية تتطلب اختبار فروضها
الاحتمالية بالرجوع إلى الحقائق والمشاهدات التي تؤيد ذلك، فإن النظرية الاقتصادية
الإسلامية لا تحتاج إلى مثل هذا الاختبار على أساس أن الثوابت مسلمات في الاقتصاد
الإسلامي يوقن بها الباحث يقينا لا شك فيه، فحينما يقول الله تعالى: ﴿يَمْحَقُ
اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ
أَثِيمٍ﴾ (البقرة: 276) فهذا من المسلمات ولا مجال لاختباره حتى نثبت صحته.
وعلى هذا الأساس، يمكن القول: إن النظرية
الاقتصادية الإسلامية يمكن أن تحتوي الممارسات المادية بعد تهذيبها وفقًا للمبادئ
الإسلامية، فالعقل ليس المصدر الوحيد للمعرفة، بل العقل والوحي المرشد له، مع
أهمية تفسير النتائج المتأتية منها بعناية، ويجب ألّا تلتبس بشريعة الإسلام
وعصمتها، فالباحثون متفاوتون في المقدرة على الفهم والاستنباط، بل ومتفاوتون في
معرفة هذه الأصول الشرعية والإحاطة بها، فالنظرية الاقتصادية الإسلامية وإن استمدت
مسلماتها وأطرها العامة من الوحي، فإنها ليست في نفسها وحيًا منزلًا وإنما هي
بالضرورة مشتملة على اجتهادات وأفكار وتفسيرات بشرية ضمن مكوناتها الرئيسة، وفي كل
ذلك قد يرد الخطأ، وهذا الخطأ لا يمكن أن يمس عصمة الشريعة فهو مجهود بشري مستنبط
من النصوص ويرجع على قائله ومفسره.
من
ضيق التغريب إلى رحابة الإسلام
المجال التشريعي من أهم الآليات التي استعملها
الغرب لتحقيق أهدافه في تنميط العالم الإسلامي على هواه.
التشريع بالدول المتغربة انحسر بمعناه الغربي
المقتصر على القواعد المنظمة للروابط بين الناس من قبل الدولة.
يمكن
تعريف التغريب بأنه تطبيع الأغيار بطابع الغربيين بهدف استتباعهم للغرب، والغرب
هنا يكاد يتركز في دول أوروبا الكبرى بامتداداتها في أمريكا، باعتبار أن
الأوروبيين هم من استوطنوا أمريكا بعد أن أبادوا سكانها الأصليين من الهنود الحمر،
فإذا كان التغريب في المعاجم العربية يأتي بمعنى النفي عن البلاد، فإن التغريب في
الثقافة الغربية يعني النفي عن الزمان وعن التراث الذاتي والإنساني لأجل تيسير
عملية الذوبان في العصر الأمريكي الأوروبي وحده، سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا.
د.
حازم علي ماهر
باحث
مهتم بدراسة الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في الدساتير والقوانين المعاصرة
لقد
كان المجال التشريعي من أهم الآليات التي استعملها الغرب لتحقيق أهدافه في تنميط
العالم الإسلامي -تحديدًا- على هواه ووفقًا لما يحقق مصالح «الرجل الأبيض»، ولذلك
كان من الطبيعي أن يعمل بجد على تنحية الشريعة الإسلامية عن مرجعية التشريع
والقضاء التي تبوأتها على مدى أكثر من ثلاثة عشر قرنًا، لا سيما وهي -بطبيعتها-عصية
على التطويع والاحتواء، وتمنح المؤمنين بها الصمود والثبات في مواجهة العواصف التي
تحاول أن تقتلعهم من جذورهم حتى لا يصبحوا لقمة سائغة للمتداعين عليهم كما تتداعى
الأكلة على قصعتها!
فقد
استغلت أوروبا الفجوة الكبرى التي حدثت بينها وبين المسلمين في الجوانب المادية
والعسكرية خصوصًا لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على العالم الإسلامي منذ نهايات
القرن الثامن عشر، ثم بدأت في احتلال دول العالم الإسلامي تباعا، وكلما احتلت بلدًا
فيه استبدلت القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية، ليتغرب بذلك التشريع على مستوى
المرجعية والمفهوم والمؤسسات والبيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية،
وذلك على الوجه الآتي:
1-
من حيث المرجعية، تحولت مرجعية التشريع من الشريعة الإسلامية إلى المرجعية
الغربية، فلم يعد نابعًا من الشريعة، بل مما يحدده الغرب ويختاره، فباتت قوانينه
والفقه الآخذ عنها -عمليًا- هما الميزان وهما أصل المشروعية في المجتمع الإسلامي،
وتحولت مصادر التشريع من القرآن والسنة والمصادر الاجتهادية التي ترتد إليهما وفق
القواعد الأصولية والفقهية التي اعتمدها علماء الشريعة على مدى التاريخ الإسلامي،
إلى التقنينات التي تصدرها الدولة ممثلة في الجهة المختصة بالتشريع والمبادئ
العامة للقانون والقانون الطبيعي وقواعد العدالة وغيرها من مصادر القانون.
2- انحسر مفهوم التشريع في الدول المتغربة في معناه الغربي المقتصر
على القواعد المنظمة للروابط بين الناس على وجه الإلزام من قبل الدولة، بعد أن كان
التشريع يتسع في المفهوم الإسلامي ليشمل كل الأحكام الشرعية الإسلامية التي لها
مقتضى عملي في حياة الإنسان بصفة عامة، بما تحتويه تلك الأحكام من عقائد وأخلاق
وعبادات ومعاملات كمنظومة تشريعية متشابكة ومتكاملة، لا ترتبط بالضرورة بالدولة
كجهة إلزام أو رقابة، بل كانت جهة الإلزام بتلك الأحكام هي القرآن الكريم والسنة
النبوية وحدهما.
3- أحل الغرب مؤسساته التشريعية والقضائية محل الجهات المختصة
بالتشريع الإسلامي، فاستبدل الغرب -ووكلاؤه المتغربون- البرلمانات بالفقهاء، وولى
الدولة الحديثة -المستوردة منه والتابعة له- استتباع المؤسسات الدينية المختلفة،
وعلى رأسها جهات التعليم الديني الذي قضى الغرب على تمويله الأهلي عبر نظام الوقف
الإسلامي، فحرم الشريعة من علمائها المستقلين، وسلمهم والأوقاف للدولة وسلطتها
التنفيذية المتغولة بدورها على المؤسستين التشريعية والقضائية، بعد أن تحكمت فيهما
من حيث المنبع والمصب والوظيفة وإطارها.
4- تغيرت البيئة المحيطة بالتشريع، حيث تغرب الواقع الاجتماعي
والأخلاقي والسياسي والاقتصادي والثقافي، وانتقلت العادات الغربية رويدًا رويدًا
إلى بلاد المسلمين، فاختفت الأسرة الممتدة أو غاب الترابط عنها إلا قليلًا، ثم
تبعها تفكيك الأسرة النواة كذلك تأسيًا بالغرب الذي ما فتئ ينشر ثقافته ويفرضها
على مجتمعات العالم فرضًا كي يستتبعها، فإذا بالأخلاق تتحول من الثبات إلى السيولة،
ومن الإطلاق إلى النسبية، وإذا بالاقتصاد تغيب عنه العدالة والغايات الإنسانية
التي كانت تستهدف إشباع ضروريات الإنسان واحتياجاته؛ فتحول إلى اقتصاد ربوي جشع لا
يستهدف غالبًا سوى توفير كماليات يمكن الاستغناء عنها دون عناء، أسهمت في تركيز
ثروات العالم في يد شرذمة قليلين، مما وسع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، بعد أن
هيمنت عليه الشركات الدولية الكبرى التي باتت توجه الثقافة كذلك لتصبح استهلاكية
وتحول الإنسان نفسه إلى كائن استهلاكي، وفي السياسة تحولت ولاءات المسلمين من
الإسلام إلى أراض وحدود إقليمية رسمها «الاستدمار» الغربي للعالم الإسلامي لضمان
التفرقة بين المسلمين، فكان طبيعيًا أن يبتعد الواقع عن الشريعة الإسلامية، حتى
أصبحت غريبة في واقع متغرب.
كيف
نقاوم التغريب ونجري تغييرات عكسية؟
لا
يعد تغريب التشريع قدرًا لا فكاك منه، بل هو بمثابة تحد يقتضي استنفار الجهود
المقاومته بحكمة لا تستهدف إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ومحاكاة الماضي
بحذافيره، ولكن تبتغي إعادة المرجعية التشريعية والثقافية للشريعة الإسلامية
بأسلوب متدرج يبدأ بإعادة فهم الإسلام نفسه وتحريره مما ران عليه نتيجة الجهل
والتقليد الأعمى وضيق الأفق والتوظيف السياسي والاقتصادي الانتهازي لأحكامه.
ومن
أهم معالم هذا التحرير للإسلام إعادة فهمه كدين عالمي لا يخاطب العرب وحدهم،
بل يخاطب الناس جميعًا، لا سيما في عالمنا المعاصر الذي بات بمثابة قرية واحدة
تجمع بين المستكبرين والمستضعفين، والذين اتبعوا والذين اتبعوا، والأغنياء
والفقراء والمتقدمين تقنيًا والمتأخرين.
ومن
معالم هذا التحرير كذلك إبراز الوجه الإنساني الرحيم للشريعة الإسلامية، وتقديم
مقاصدها الكلية السامية على أحكامها العقابية، وقيمها الأخلاقية التراحمية في وقت
أقام فيه الغرب المعاملات بين الناس على أساس تعاقدي لا رحمة فيه.
فالإسلام
يستطيع أن يجبر نقص التشريع الوضعي فيعلي القيم الإنسانية على المصالح المادية،
ويعيد الارتباط بين القانون والأخلاق عبر تقديم نموذجه المعرفي المتفرد الذي يمكن
أن يسترشد به أي نظام تشريعي يريد تحقيق مصالح الأنام، عبر الفهم السديد للتوحيد
الذي يحرر العباد من تسلط البشر، ويدفع الإنسان إلى التركيز على مهامه الأساسية في
هذه الحياة الدنيا، من تزكية واستخلاف وعمران، وإلى استهداف مقاصد عامة تتمثل في
حفظ النفس والعقل والدين والمال والنسل، وإلى الاستعصام بمبادئ حاكمة -مطلقة لا
نسبية، وصلبة لا سائلة- مثل العدل والمساواة والشورى والحرية المنضبطة بنصوص شرعية
قطعية تغريب التشريع ليس قدرًا لا فكاك منه بل هو تحد يقتضي استنفار الجهود
لمقاومته بحكمة لا يمكن لبشر تحويرها أو التلاعب بها.
وهذه
منظومة متضافرة من القيم والمقاصد التي تعلو فوق الدساتير والقوانين، وتمثل ثوابت
تقف عندها سلطة البشر التشريعية بحيث لا تتحكم فيها الأهواء، فتصبغ شرعية على
أفكار وسياسات تقود العالم نحو الهاوية، كما أنه قد آن الأوان لإعادة الربط بين
العقيدة والأخلاق والمعاملات عبر وضع إطار عقدي وأخلاقي لنصوص القوانين حتى يمتثل
الإنسان طواعية للقانون، حتى لا يخالفه كلما أمن العقاب، ويمكن أن يجري ذلك عبر
وضع مذكرة إيضاحية لكل قانون تؤصل له عقديًا وأخلاقيًا، حتى يتقبلها المواطن
وينصاع لها عن اقتناع.
ومن
الناحية العملية لا يستلزم الأمر إلغاء كل التغييرات التي حدثت في التشريع نتيجة
تغريبه، بل يمكن الاستفادة من إيجابيات تلك التغييرات وتجنب سلبياتها، فمن الممكن
أن تبقى سلطة البرلمان في التشريع كما هي مع ضم علماء الشريعة الموثوق بهم إلى أهل
الخبرة والاختصاص في مجالات التشريع المختلفة لضمان أن تصدر التشريعات عبر اجتهاد
جماعي يحرص على موافقتها للشريعة وما تتغياه من تحقيق مصالح الجماعة، مع اشتراط أن
تكون تلك البرلمانات ممثلة للأمة بحق لا للحاكم وحده، فتكون بمثابة «أهل حل وعقد»
في ثوب جديد.
كما
أنه لا ضير في بقاء القضاء بشكله الجديد بشرط تحقيق استقلاليته الكاملة، بحيث «يكون
تقدير كل قاض لوقائع النزاع، وفهمه لحكم القانون بشأنها، متحررًا من كل قيد، أو
تأثير، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل، أو ضغوط أيًا كان نوعها أو مداها أو مصدرها،
وكان مما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية
والتنفيذية، وأن تنبسط ولايتها على كل مسألة من طبيعة قضائية، كما انتهت المحكمة
الدستورية العليا المصرية -في أحد أحكامها-بحق.
كما
ينبغي العمل على إعادة الاستقلالية إلى المؤسسات الدينية الإسلامية بحيث تكون
العلمائها حصانة القضاة المبتغاة، فلا يوضع عليهم أي قيد عند اجتهادهم في استنباط
الأحكام الشرعية وإعلانها، من أي جهة كانت، مما يضمن قيامهم بمهامهم السامية في
إقامة العدل وإعلاء حكم الشرع على ما سواه.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل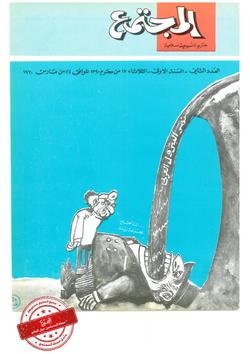
الزيـادة في البيـع والزيـادة فـي الربا.. رؤيــة اقتصاديــة تحليليــة
نشر في العدد 2181
37
السبت 01-يوليو-2023