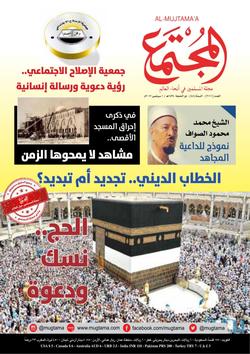العنوان الخطاب الديني.. تجديد أم تبديد؟
الكاتب إسلام عبد العزيز
تاريخ النشر الجمعة 01-سبتمبر-2017
مشاهدات 84
نشر في العدد 2111
نشر في الصفحة 30
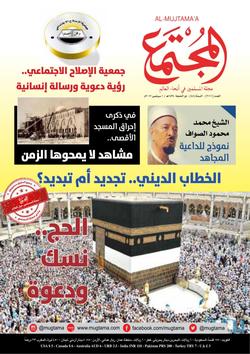
الجمعة 01-سبتمبر-2017
هناك عوامل عديدة تتشارك في تباين الأفهام للنصوص مثل طبيعة البيئة والسياق العام
المطالبة بتجديد الخطاب الديني ربما تكون مطالبة بتغيير بعض الفهوم تجاه النصوص القطعية
العودة: التجديد يجب أن يكون بأيدي رجالات الإسلام وعن طريق المتخصصين الإسلاميين
غنايم: التجديد هو إضافة وتحديث مع الجمع بين الأصالة والمعاصرة
كريشة: مواكبة هذا الخطاب للعصر وقدرته على التأثير الإيجابي وتحريك العواطف
عمر هاشم: نحذر من تحول «التجديد» إلى «تخريب» على يد الموالين لغير المسلمين ممن يدسون السم في العسل
د. أحمد كافي: الحاكم في التجديد قبولاً ورفضاً قواعد الدين ومحكماته وكلياته ومقاصده
«لماذا يتحاشى بعض المسلمين الاعتراف بضرورة التجديد ليبقى كل شيء كما كان يعهد، فليس في الإمكان أفضل مما كان، إيثاراً للإلف وتوجساً وارتياباً من كل حديث وجديد أو مشتق منهما، فهو يفضل أن يبقى فكره وخطابه ولغته وطريقته وعلمه متكلساً مترهلاً مهترئاً ألف مرة على أن تناله يد التجديد، أو تطاله بواعث التحديث وأسبابه؟».
ما سبق، كان هزة رآها البعض قاسية من الداعية السعودي د. سلمان العودة، في جسد المجتمع الفقهي، المصطدم أساساً بتحدّ اسمه «تجديد الخطاب الديني»، تحول، مؤخراً، من قضية بحثية، إلى اجتماعية، فسياسية، بعد إقحامه في مسألة الإرهاب والعنف التي تضرب العالم كله الآن.. وبالتالي أريد له أن يقفز في سلم الأولويات إلى الصدارة، بما لا يدع مجالاً للتعامل معه بأريحية، على الأقل من وجهة نظر الرؤساء والحكام، الذين بات تفاعلهم مع هذا الملف حاضراً وملحاً.
«تجديد الخطاب الديني».. قضية ما تفتأ تخبو حتى تشتعل، ومع اشتعالها يطال لهيبها الكثير من جنبات المجتمعات فيزيدها انقساماً وتهديداً لسلامها العام، المترنح أساساً، في هذه الأيام العصيبة.
ولأن الأمر مرتبط بالدين، فإن اختلاف الآراء سرعان ما يتحول إلى اتهامات متبادلة بالتكفير من جانب أو الرجعية من جانب آخر.
د. سلمان العودة يرى أن عدم الرغبة في الاجتهاد وتجديد الخطاب الديني «مظهر جلي من مظاهر الضعف والخور والهزيمة النفسية، كما أن الارتماء في أحضان كل جديد هزيمة نفسية».
يختزل أصحاب هذه الأصوات مسألة تجديد الخطاب الديني في نقطتين اثنتين بانيتين لمطلبين أساسيين:
الأولى: ترتكز على مسلَّمة أن هذا الخطاب لم يعد يواكب، أو لا يواكب بما فيه الكفاية، ما حملته وسائل الإعلام الجديدة من مزايا كبرى، لم تكن مباحة أو متاحة في زمن الندرة التكنولوجية، حيث كانت «الرسالة» محصورة في المساجد، أو في الحلقات النقاشية الضيقة، أو من بين ظهراني بعض النوادي النخبوية المغلقة، فكان أثرها محدوداً ومفعولها غير ذي وقع كبير بالنفوس والعقول.
أما النقطة الثانية والمنطلقة من مجريات الواقع، فيلاحظ أن الصيغ والقوالب والطرق والأساليب التي ركب الخطاب الديني ناصيتها إلى عهد قريب، لم تستطع مواكبة «الظاهرة الدينية» في حركيتها وتموجاتها، فلم تفرز، ضمن ما أفرزته، إلا تشدداً في الدين، وتقوقعاً حول المذهب، وتطرفاً في الموقف، وتكفيراً للآخر واستباحة لحرية معتقد الناس، أبناء العقيدة المشتركة كما المنتمين لباقي العقائد على حد سواء.
هل هو خطاب ديني واحد أم خطابات متعددة؟
التوقف عند هذا السؤال يشي بأنه ليس ثمة على أرض الواقع خطاب ديني واحد وناظم، بقدر وجود خطابات متعددة ومتباينة لدرجة التناقض في بعض منها، إذ هناك خطابات سلفية موغلة في التشدد، وأخرى محافظة وأقل غلواً، وثالثة وسطية أو معتدلة وأخرى متحررة.
ثم هناك إلى جانب هذا وذاك خطابات نابعة من المؤسسات الدينية الرسمية وأخرى صادرة عن تنظيمات ومجاميع خارج المؤسسات الرسمية.
ثم هناك، في تصنيف ثالث، خطابات تشدد على منطوق الدين وحرفيته، وأخرى تدفع بضرورة الأخذ بروحه ومقاصده، لبناء خطاب ديني يستلهم من الدين قيمه وأخلاقه ومقاصده الكبرى.
القضية إذن تبدو في تنوعها تنوعاً للأفهام؛ وبالتالي فإن المطالبة بتجديد الخطاب الديني ربما تكون مطالبة بتغيير بعض الفهوم تجاه نصوص يتفق الجميع على ثبوتها ثبوتاً قطعياً، لكن الاختلاف حول معانيها التي تضيق وتتسع بحسب الأفهام التي تتعامل مع تجلياتها.
وهنا تبرز عوامل عديدة تتشارك في صناعة تلك الأفهام المتباينة، لعل أهمها طبيعة البيئة التي تنتج فهماً للنص الديني متأثراً بالحالة والسياق العام، ففهم المصري الناشئ في البيئة الزراعية النيلية يختلف عن فهم الحجازي الذي يعيش في بيئة صحراوية، والاثنان يختلفان بالكلية عن فهم المسلم الأوروبي الذي يحيا وسط بيئة مغايرة تماماً من جهات متعددة.
حديث «المائة سنة»
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» (أخرجه أبو داود والحاكم وصححه).
وهذا الحديث يطرح إشكالية أخرى عن المقصود بالتجديد على وجه التحديد.. هل هو الخطاب أم الدين نفسه، في ظل حالة ارتياب من كل دعوة تقصد المساس بما تعارف عليه الناس وظنوه محل إجماع.
وهنا يعلق د. سلمان العودة قائلاً: فقهاء يصفون أنفسهم بالمجددين، يرون في الحديث السابق دعوة واضحة من النبي، صلى الله عليه وسلم، لتجديد الخطاب الديني، والذين يقومون بعمل هذا التجديد جاؤوا بلفظ “مَن” فهو عام يشمل الفرد والجماعة، وفي ظل توسع الأمة واتساع رقعتها والانفتاح العالمي وتضخم الخلل الموجود في واقعها، فإن هذا الواقع يفرض كون هذا العمل التجديدي ليس شأن فرد واحد، بل مجموعات تتكامل فيما بينها، وتؤدي أدواراً مختلفة وتخصصات علمية متباينة وحقولاً معرفية كلها تنتهي عند مصب المصدر الأصلي “الشريعة”.
وهناك فرق، بحسب العودة، بين الخطاب الديني والوحي المنـزل، بمعنى أن الخطاب الديني يعتمد على الوحي في كثير من الحالات، لكنه يبقى في حدود العمل العقلي البشري أو العمل الاجتهادي الذي يرتبط بإمكانيات الإنسان وقدرته وطاقته، فهو مثل خطاب الفقهاء والوعاظ والمصلحين الذي يمثل اجتهاداً من عندهم.
ومفهوم «تجديد الخطاب الديني» يتنازعه طرفان:
الأول: فئة تتحدث عن تجديد الخطاب الديني وهي تصدر من منطلقات غير دينية، وأعتقد أنه لا يمكن تجديد الخطاب الديني من خارج هذا الخطاب الديني نفسه سواء بظروف محلية أو عالمية.
الثاني: بعض القوى الإسلامية الخائفة التي اشتد بها الخوف، فإذا سمعت مثل هذا اللفظ ترامى إلى أذهانها أنها مؤامرة لتحريف الدين أو لتغيير الخطاب.
ولذا فإن تجديد هذا الخطاب، كما يرى العودة، ضرورة فطرية وبشرية؛ لأنه خطاب مفكك وفردي برأيه، بينما يشهد العالم تجمعات وتطورات هائلة في مجال التقنية والمعلومات والاختراعات.
ويعرف العودة التجديد المقصود بقوله: إن هذا التجديد الحي قراءة واعية واعدة للنفس والآخر والواقع، وقراءة قادرة على إيجاد الحلول الشرعية المناسبة لمشكلات الواقع.
ثم يؤكد أنه لا مناص من التجديد قائلاً: إذا لم نؤمن بذلك فأمامنا خياران:
الأول: الجمود ويعني ذلك الإطاحة بحق الحياة وسحقها في عصر تكتنفه الحركة الثائرة من كل جهة.
والثاني: الذوبان، وذلك معناه الإطاحة بحق الدين والشريعة والثقافة والتراث.
إن هذا التجديد يجب أن يكون بأيدي رجالات الإسلام وعن طريق المتخصصين الإسلاميين، ولا أقول بالضرورة: الفقهاء، وإنما المختصون على العموم، ويجب أن تكون أدوات هذا التجديد ووسائله داخلية تلمس مشاعره وتتحدث من داخل إطاره، وعلينا أن نتفق على الضرورات والقواعد الشرعية والمحكمات الدينية الثابتة، كما يسميها ابن تيمية «الدين الجامع».
أما ماهية هذا التجديد فترتيبٌ لسلّم الأوليات وتنظيم للأهم والمقاصد الكبرى للعلم والدعوة والإصلاح واتفاق على ذلك وتسهيل تطبيق ذلك وتوجيهه في أرض الواقع، وإبراز لجانب القيم والأخلاق الإسلامية الإنسانية العامة التي يحتاج إليها الناس كلهم دون استثناء، وتطبيع قيم العدل التي يأمرنا بها الإسلام تجاه الخلق كلهم ومعاملة الناس كلهم بالحسنى، قال تعالى: (وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً) (البقرة: 83)؛ قال ابن عباس: «اليهودي والنصراني».
بين الإصلاح والتجديد
د. محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، يرى أن هناك فرقاً بين «الإصلاح الديني»، و»تجديد الخطاب الديني»، فالأول هو الذي تعرضت له الأديان الأخرى، وقد شاع هذا المصطلح في الغرب؛ لأنه يفترض أن هناك نقصاً يستلزم الهدم وإعادة البناء ورفض الموروث؛ وهذا أمر مرفوض عندنا؛ لأن «التجديد» هو إضافة وتحديث وتفتح مع الجمع بين «الأصالة والمعاصرة»، ونشر العلم الصحيح بين أبناء الأمة، وإعادة بيان دلالات النصوص وإزالة الفاسد الناتج عن الجهل في وقت من الأوقات، وإزالة ما علق بالدين من أخطاء كانت نتيجة الاجتهادات الخاطئة التي تنعكس سلباً في سلوكيات الناس وعقائدهم.
ويضيف غنايم أن الإسلام يمتدح التجديد المنضبط المنطلق من الوصايا العشر في قول الله تعالى: (قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ {151}) (الأنعام)، وهذا التجديد يجعل الإسلام منفتحاً على العالم، ويدعو لإعماره لتحقيق رسالة الاستخلاف والتعمير في الأرض مع العبادة الصحيحة البعيدة عن البدع والتنطع.
ووفقاً لهذا المفهوم، يقول غنايم: إن التجديد الصحيح للخطاب الديني هو الذي يجعل أبناء الأمة يصلحون ولا يفسدون، ويبنون ولا يهدمون، ويجمعون ولا يفرقون، ويتعاونون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، فهذه هي الغاية الكبرى من التجديد المنشود.
تجديد الوسائل
ملمح آخر يؤكده د. طه أبو كريشة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، حينما يؤكد أن التجديد المقصود هو تجديد الوسائل والأدوات التي يتم من خلالها عرض أحكام هذا الدين وتداخلاته مع كل من المجال العام والمجال الخاص.
فلا يعقل أن تظل الوسائل هي هي، والأدوات هي هي عبر العصور، وهذه مساحة تدخل في إطار ما يسميه الأصوليون مساحة العفو، فهي مسكوت عنها في الشريعة لتكون متروكة لكل عصر ومصر يتعامل من خلالها يما يناسب الزمان والمكان والإنسان.
ولذا اعتبر أبو كريشة أن التجديد ضد الجمود ومعناه مواكبة هذا الخطاب للعصر وقدرته على التأثير الإيجابي وهز المشاعر وتحريك العواطف نحو تحقيق رسالة الإسلام بلا إفراط أو تفريط.
ضوابط التجديد
من جهته، حصر د. أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، مفهوم التجديد في بيان حكم الإسلام في النوازل المستجدة وتنـزيل الحكم الشرعي على الواقع المعاصر مع ضرورة مراجعة الفقهاء المعاصرين للتراث الفقهي وتمحيصه وتيسير فهم الدين للناس، قد ورد في الحديث عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الإيمان ليَخْلَقُ في جوف أحدكم كما يَخْلَقُ الثوب، فاسألوا اللهَ أن يُجددَ الإيمانَ في قلوبكم»، والمجددون للدين هم أهل العلم المخلصون المتخصصون الذين أمر الله بسؤالهم حين قال: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {7}) (الأنبياء).
وحث هاشم على أن يكون الهدف والمنطلق الأسمى للتجديد هو الاعتصام بالأصول والثوابت الإسلامية التي لا تقبل التجديد، حيث يطالب البعض بالخروج عن ثوابت الدين وتحليل الربا ورفض الحجاب، والسخرية من إقامة الحدود والدعوة للمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة حتى في الميراث وزواج المسلمة من غير المسلم، ولهذا لا بد أن يعمل التجديد على حماية الدين من تحريف الغالين وتأويل الجاهلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يحملُ هذا العلمَ من كل خلفٍ عُدولهُ، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين»، وقال الإمام النووي تعليقاً على هذا الحديث: «هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه، وأن الله تعالى يوفق له في كل عصر خَلَفاً من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف وما بعده، فلا يضيع».
وحذر الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر من تحول «التجديد» إلى «تخريب» على يد الموالين لغير المسلمين ممن يدسون السم في العسل، وليكن في ذاكرتنا ونصب أعيننا قول الله تعالى: (وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ {120}) (البقرة)، وقد فضح الله هؤلاء جميعاً بقوله: (قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ {118}) (آل عمران).
ولهذا يؤكد هاشم رفضه الدعوة إلى التغيير العشوائي أو الكلي لمناهج التعليم الديني؛ لأنها في الحقيقة تستهدف تجفيف المنابع الدينية عند الناس؛ فيعم الجهل ويضيع الدين ويغرق المجتمع في الفسق والرذائل الأخلاقية.
أكد د. أحمد كافي، أستاذ التعليم العالي للدراسات الإسلامية بالجامعة المغربية، أن تجديد الخطاب الديني سُنة كونية وشرعية لا يمكن إنكارها أو تجاوزها.
وقد دلت النصوص الشرعية، والتجربة التاريخية لأئمة الإسلام، مسيس الحاجة إليه في كل زمان، وأن على أهل الحل والعقد والنظر في الأمة أن ينهضوا بواجب هذا التجديد، ويبرزوا ملامحه، حتى يكون جديداً ييسر التدين، ويحقق مقاصد الدين من الخلق.
وأبرز كافي في تصريحه لـ«المجتمع» أن هذه الدعوة يتم الحديث عنها من طائفتين:
الأولى: طائفة المتخصصين من أهل الإسلام؛ أئمة وعلماء وفقهاء وباحثين شرعيين وغيرهم، يريدون أن ينهضوا بالأمة كي تأخذ مكانها الطبيعي انطلاقاً من هويتها وقواعد دينها ومقاصده وكلياته.
الثانية: طائفة عندها موقف معاداة للدين، وتعتقد أن رفع هذا الشعار كاف للإغارة على الدين وإفساده والتخلص منه بمثل هذه الدعوة، وهؤلاء هم المبطلون الذين يحملون باطلاً لنسف حق ومعارضته والوقوف في وجهه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين».
ومهما يكن من أمر، حسب كافي، فإن الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني، دعوة صحيحة موفقة سامية، غير أنه ليس كل دعوة يراد بها الخير، فكم من الدعاوى التي ينادي بعض الناس بها، وهم من أعدائها في باطن حقيقتهم كما تشهد عليهم تصرفاتهم وأحوالهم، وعن ذلك يقول علي رضي الله عنه: «كلمة حق يراد بها باطل».
وشدد كافي، المتخصص في العلوم الإسلامية، على أن الوجه الصحيح لهذا الموضوع لا يتم ذلك إلا عن طريق مجموعة من الإجراءات العملية، أهمها:
أولاً: الاقتناع بالتجديد؛ إذ لا بد من أن يتشبع أهل الإسلام ومن يتصدرون الشأن الديني أن تكون لهم قناعة راسخة في أن الأمة تحتاج إلى التجديد والمجددين، وأن هذا التجديد ضرورة شرعية، وسُنة كونية، لا يمكن الاستمرار بالأريحية والإيمان بهذا الدين العظيم إلا على وفق هذا الناموس، ناموس التجديد في جميع المجالات، ومنها مجال الخطاب الديني.
ثانياً: أن يقوم بذلك أهل الاختصاص حصراً وقصراً، وليس غيرهم، فإذا كانت كل المهن والوظائف والعلوم ترفض أن يتكلم فيها الجاهلون، ومن عندهم معارف محدودة، أو جرأة زائدة؛ فإن الدين خطاباً وإنتاجاً لا يشذ عن هذه القاعدة التي لا ينكرها عاقل.
إن التجديد لا يقوم به إلا الأكابر من القوم في مجالهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كلّ مائة سنة من يُجَدّدُ لها دينَها» (رواه أبو داود)، وقوله صلى الله عليه وسلم «على رأس كل مائة سنة»؛ إشارة إلى أن الرؤوس الكبيرة هي التي تتحمل تبعات التجديد، وليس أسافل الناس أو حتى متوسطيهم.
ثالثاً: أن يكون الحاكم في التجديد قبولاً ورفضاً، هي قواعد هذا الدين، ومحكماته، وكلياته، ومقاصده؛ إذ لا يمكن الحديث عن تجديد للخطاب الديني من يحمل في صدره وقلمه ولسانه معاداة له، ومعاكسة لحقائقه، واجتهاداً في نقض أسسه وأركانه ومحكماته.
وختم بالقول: إن ما سبق هو بعض ملامح كيفية التجديد، وهي معالم كبيرة تنضوي تحتها ما لا يحصى من الوسائل الإجرائية التي يبدعها العقل المسلم، ومن وضع هذه الثلاثة نصب عمله واجتهاده، فالرجاء كبير أن تكون ممارسته للتجديد تجديداً مبصراً ومنتجاً.>
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل