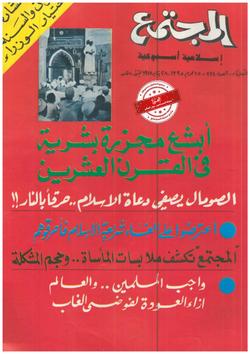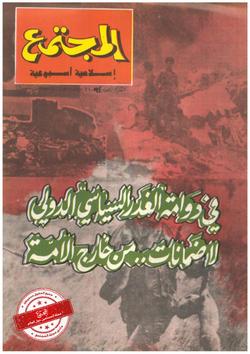العنوان الزواج والطلاق بين العقائد الوثنية والشرائع السماوية (الحلقة الثانية)
الكاتب الأستاذ عز العرب فؤاد
تاريخ النشر الثلاثاء 17-ديسمبر-1974
مشاهدات 15
نشر في العدد 230
نشر في الصفحة 32
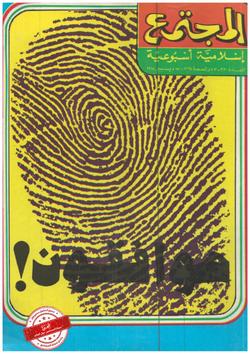
الثلاثاء 17-ديسمبر-1974
الزواج والطلاق
بين العقائد الوثنية والشرائع السماوية
الحلقة الثانية
«أنواع الزواج»
«أولًا: الزواج بالشراء»
وهذا النوع هــــو أكثر الأنواع انتشارًا ليس بين الشعوب البدائية فحسب؛ بل وبين الشعوب التي لها حظ من التمدين كالرومان([ (1) انظر أنواع الزواج عند الرومان في هذا البحث.]).
وكان هذا النوع من الزواج هو المألوف عند الساميين القدماء، وعند الهنود الحمر، والتتر، والمغول والإغريق. لذلك كانوا ينظرون إلى المرأة التي لم يقدم لها شيء من المال نظرة أبناء الوقت الحاضر إلى العاهرة، وذلك واضح عند أهل أستراليا الأصليين.
وكلما قدم للمرأة كثير من المال كلما كانت تشعر بفخر. وللزوج الحق في بيع زوجته لمن يريد متى يشاء، وفي استطاعته أن يرهنها أو أن يؤجرها للغير، كما هو الحال عند قبائل سومطرة.
«ثانيًا: الزواج بالأسر»
وتلك الطريقة كانت نتيجة الحروب التي كثيرًا ما تنشب بين القبائل لأوهن الأسباب؛ بل كثيرًا ما كانت تنشب الحروب لغرض السبي نفسه في القبائل التي تعاني نقصًا في النساء.
وهناك نوع آخر عبارة عن اختطاف رجل لامرأة بعينها في غير أوقات الحرب، فالرجل في هذه الحالة يختطف المرأة التي يرغب فيها رغمًا عن إرادتها. وقد يكون ذلك أمرًا متفقًا عليه بين المرأة والرجل في بعض الأحيان.
«ثالثًا: الزواج بالمؤاجرة»
جرت العادة عند كثير من الشعوب البدائية في حالة عجز الرجل عن دفع مهر المرأة أن يؤجر الزوج نفسه لأبي العروس أو لذوي قرباها مدة من الزمن يقوم فيها بأعمال مختلفة إلى أن يفي بالثمن المطلوب.
«رابعًا: الزواج بالرضا والقبول»
يرجح بعض علماء الاجتماع أن الزواج بالاختيار لم يكن أمرًا قليل الحدوث بين القبائل والشعوب البدائية، بل قال بعضهم بأن هذا النوع من الزواج هو الذي كان شائعًا في الأصل، ثم مر بمرحلة الشراء على يد الأسرة أو العشيرة، ثم عاد كما كان في العصر الحديث بضعف سلطان الأب في الأسرة.
خامسًا: زواج المشاركة الأخوي
ومقتضاه أن يشترك مجموعة من الإخوة الذكور في زوجة واحدة يقسمونها بينهم قسمة زمنية يحددونها ويتعارفون عليها. وكان ينسب أبناء الزوجة إلى الإخوة جميعًا، ثم يتنازل الإخوة للأخ الأكبر عن حق النسب، وبذلك نُسب الطفل إليه نظرًا لكبر سنه وأسبقيته في المعاشرة الزوجية. وكان يحدث هذا النوع من الزواج بين الأقاليم التي يقل فيها عدد النساء عن عدد الرجال بنسبة واضحة.
عقد الزواج عقد ديني
ويتسم عقد الزواج في المجتمعات البدائية عامة والطوطمية خاصًة بصبغة دينية، شأنه في ذلك شأن جميع الأمور الهامة عندهم، وتختلف الطقوس باختلاف الطوطم الذي تدين به الجماعة، ويتلو ذلك كاهن أو ساحر حتى يصبح زواجًا شرعيًّا.
ويتم ذلك بتلاوة صلوات وأناشيد خاصة، ويرمزون إلى رباط الزوجية برموز خاصة يصبح بعدها الرجل والمرأة زوجين.
«الزنا»
بعض القبائل البدائية لا تعتبر الزنا جريمة تستوجب حتى مجرد الاستنكار، بل قد يقدم الرجل لضيفه زوجته، وزيادة في إكرامه قد يرسل الرجل زوجته إلى أحد الأشراف لتحمل منه، ولا يجد في ذلك غضاضة، كما تستنكر بعض القبائل تلك الجريمة وتعاقب مرتكبيها أشـــد العقاب.
«الطلاق»
يقال: إن الطلاق كان مجهولًا عند الصيادين المتأخرين والمزارعين البدائيين، نادر الحدوث في القبائل البدائية، كما أن بعض القبائل تمارس الطلاق بكثرة ولأتفه الأسباب، والغريب أن المرأة في إفريقيا الوسطى لها أن تطلق زوجها إذا لم يستطع حياكة ملابسها.
وللمرأة في حق الطلاق قسط أوفر في المجتمعات البدائية عنه في المجتمعات المتحضرة.
«مركز المرأة»
من الواضح أن المرأة كانت أقل مكانة بكثير من الرجل؛ حيث إنه يحرم عليها لمس الطوطم أو رمزه، أو الاشتراك في الطقوس والشعائر، أو ارتياد الأماكن المقدسة، كما يعتبر من يمسها وهي حائض نجسًا. ولكنها في العشائر التي يحكمها النظام الأمي، كانت أكثر حقوقًا من نظيراتها في العشائر التي يحكمها النظام الأبوي. والمرأة كانت تمارس الفلاحة بوسائلها البدائية، وكانت تحمل هي أولادها مشدودين على ظهرها أثناء عملها في الأرض، وكان على الرجل الصيد برًّا وبحرًا.
«ديانات المصريين القدماء»
كان الدين رموزه وطقوسه عند قدماء المصريين له قدسية كبيرة؛ إذ ترك فيهم أكبر الأثر في حياتهم الخاصة والعامة.
وقد اختلف العلماء في فلسفة الديانة المصرية القديمة.. فذهب البعض إلى أنهم عرفوا الإله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأن التوحيد كان الدين الأصلي عندهم قبل عصر الملك مينا مؤسس الأسرة الأولى بزمن طويل، وأن الذي حمل لهم هذه الديانة إدريس نبي الله عليـه السلام؛ فقد قيل: إنه ولد بمصر «بإدفو»، وقيل: بمنف، وقيل: إنه ولد ببابل([(2) وحدة الدين والفلسفة، المجلد الأول صفحة: 58- 62، تأليف السيد محمد أبو الفيض المنوفي. ])، وهبط هو وأتباعه «الحورشوس» -أو أتباع حوروس- ليدعو المصريين إلى عبادة الله الواحد الأحد، وأن عبادتهم له كانت الصمت والرهبة، وكان وصفه عندهم: «فرد أزلي خالق كان قبل كل شيء، ويبقى بعد كل شيء، لا بداية له ولا نهاية، خالق الأرواح في الأشباح، يمضي الزمان وهو باق».
وقد سماه المصريون القدماء «آتون»، ولهذا الاسم معنيـان.. معنى خفي وهو «أصل كل شيء قام به الوجود»، ومعنى ظاهري وهو «الآتوم الذري المعروف الذي تكونت به السماوات وما فيها من شموس، والأرض وما فيها من مخلوقات»، فإذا اتجه أتوم للوهب والإعطاء سمي «رع»، وإذا ظهر بارزًا بمثاله الشموس سمي «آمون».
وقد وجد في هرم سقارة المدرج من الوثائق ما يدل على أنهم كانوا يعتقدون في إله ذي صبغة خفية؛ لأنه غير منظور.
ووجد أيضًا في هيكل إيزيس بصا الحجر نقش قديم يتضمن الكلمات الآتية: «أنا كل شيء كان، وكل شيء كائن، وكل شيء سيكون، ومحال على من يفنى أن يزيل النقاب الذي تنعت به وجه من لا يفنى».
وقد قال العلامة ماسبيرو من أساتذة فرنسا: «وكان إله المصريين الأول عالمًا بصيرًا لا يدرك، موجودًا بنفسه، حيًّا بنفسه، حاكمًا في السماوات والأرض، لا يحتويه شيء، فهو أب الآباء وأم الأمهات، لا يفنى ولا يغيب، يملأ الدنيا وليس له شبيه ولا حد له، موجود في كل مكان».
وفي رأي هؤلاء العلماء أن الأسماء الكثيرة المختلفة التي كان يقدسها قدماء المصريين ويتقربون لها بالعبادة، ما هي إلا رموز مختلفة لإله واحد، أو صفات مختلفة له، أو آثار من آثاره جديرة بالتقديس.
وقد ذهب بعض العلماء إلى خلاف ذلك، فزعموا أن المصريين القدماء لم يعرفوا التوحيد إلا في عهد أخناتون؛ أما في بقية العهود، فقد كانت للمصريين عبادات كثيرة متعددة، فمنهم من عبد الكواكب، ومنهم من عبد الحيوانات، ومنهم من عبد الملوك الفراعنة.
ومن العلماء من ذهب إلى أنه كانت لكل إقليم من أقاليم مصر القديمة إله أو آلهة خاصة بهذه الأقاليم.
فلم يكن إله طيبة هو إله منف، بل لكل إقليم إله أو عدة آلهة وهكذا.. ونحن نرى أن كلًّا من هذه الآراء فيه كثير من التطرف والقصور، فالثابت أن مصر الفرعونية لم تحرم من رسل من لدن رب العالمين يبصرون الناس بالإله الحق الواحد الأحد، ومن هؤلاء: نبي الله إدريس علیه السلام، ونبي الله يوسف عليه السلام، ونبي الله موسى عليه السلام.
وقد جرت سنة الله منذ خلق آدم ووجوده على الأرض أن يرسل إلى الناس الرسل ليردوهم من الشرك إلى التوحيد الخالص أصل فطرتهم التي فطروا عليها، فيهتدي على أيديهم من يريد الله به خيرًا. ويظل
الناس متأثرين بهؤلاء الرسل فترة من الزمن حتى يتقادم عليهم العهد ويطول عليهم الأمد، فتقسوا قلوبهم وينسون ما عاهدوا الله عليه.
وهكذا يتدرجون في الضلال حتى يشركوا بالله ويستشري الفساد في الأرض، فيرسل الله إليهم رسولًا رحمة بهم.
فالتطور الذي سببه الزمن سنة من سنن الله، ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا﴾ (الأحزاب: 62).
لذلك نميل إلى الرأي القائل ([ (3) کتاب وحدة الدين والفلسفة والعلم، للأستاذ السيد محمود أبو الفيض المتوفى، المجلد الأول من ص
]) بأن الديانة المصرية القديمة قد سارت على سنة التطور.
فقد كانت مصر قبل عهد الملك مينا تعبد الإله الأحد الحق آتون، وقد كان للكهنة في هذا العصر قداسة تجل عن الوصف؛ إذ هم الذين يعلمون الناس أسرار الكون وأسرار الخلق والحكمة والفلسفة وسائر العلوم.
وكان هؤلاء الكهنة يعلمـون تلاميذهم كتمان العلوم وما فيها من أسرار عن العامة حتى لا يتهوموا بها وبكتمانها عن الأشرار، حتى لا يتسلحوا بها.
وظل الكهنة يحكمون مصر حكمًا أتوقراطيًّا دينيًّا إلى سنة ٥٠٠٤ ق. م حيث انتزع الحكم من أيديهم أول ملوك الأسرة الأولى الملك مينا.
وقد ظن المصريون المتأخرون الذين أعقبوا حكم الكهنة أن التماثيل الرمزية التي أقيمت لأتون أو رع أو آمون على هذا الاعتبار آلهة مختلفة فعبدوها، في حين أن أصلها صفات إلهية وليست آلهة. وبذا عرفت مصر الشرك وعبادة الأوثان.
ولما مات مينا عبده قومه كابن الإله فتاح، وعن هذا الطريق خرج الفراعنة أبناء الإله. ثم لكي لا تقطع السلالة الإلهية -على زعمهم- تحتم على من يرقى العرش من أسرة جديدة أن يتزوج من الأسرة التي سبقته في الملك، لينتقل دم مينا من جيل إلى جيل.
ثم زواج الأخ من أخته كما سيأتي عند حديثنا عن الزواج والطلاق بالتفصيل بالنسبة لملوك المصريين القدماء.
وهنا اشترك الملوك مع الآلهة أحياء وأمواتًا، فبينما نرى الملوك في المعابد الكبيرة كالكرنك ماثلين في العبادة أمام آتون أو رع أو آمون؛ إذ بنا نرى في بعض حوائط المعابد الصغيرة صور الفراعنة ولها الصف الأول، حتى قبل الآلهة. بل نراها تتقبل العبادة ولها اختصاصات الآلهة.
وهكذا تطور الدين من عبادة الإله في شخص آتون ورع ثم قرص الشمس في شخص آمون، وبقية مظاهر الطبيعة، ثم الملوك والعظماء.
بل لقد تطورت العبادة حتى شملت أحط الحيوانات وأحقر الحشرات والهوام. والمصريون في ذلك متأثرون بعقيدة تناسخ الأرواح، وأنهم لا يعبدون تلك الحشرات والحيوانات والجمادات لذواتها، بل تقربًا إلى أرواح أجدادهم وذويهم وآلهتهم التي حلت في هذه الأشياء.
الرابط المختصر :
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكلالزواج والطلاق بين العقائد الوثنية والشرائع السماوية (الحلقة الأولى)
نشر في العدد 229
16
الثلاثاء 10-ديسمبر-1974
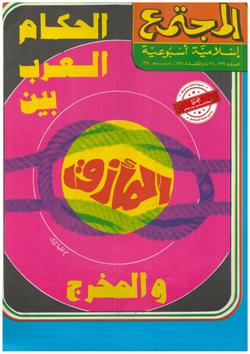
الزواج والطلاق بين العقائد الوثنية والشرائع السماوية - الحلقة 4
نشر في العدد 234
9
الثلاثاء 28-يناير-1975