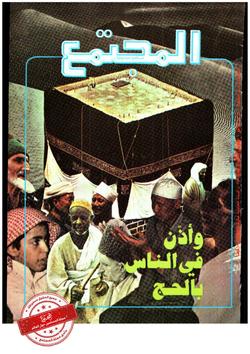العنوان الفرقة بين المسلمين أسبابها وعلاجها
الكاتب محمد الشريف
تاريخ النشر الثلاثاء 21-يوليو-1981
مشاهدات 18
نشر في العدد 537
نشر في الصفحة 32
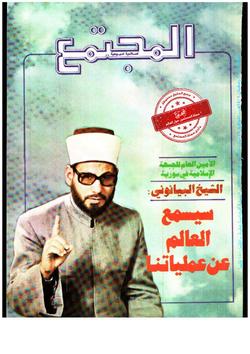
الثلاثاء 21-يوليو-1981
الحمد لله الذي خلق فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة جمعت
بين أبي بكر وبلال، وعمر وعمار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي جمع الأمة بعد
الشتات، ووحد صفوفها بعد التفرق.. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم
تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فإن مما يؤلم المسلم الحريص على دينه ما يراه من فرقة واختلاف
بين المسلمين، يفرقان جماعتهم، ويمزقان ألفتهم، ويشتتان شملهم فأصبحوا كالغنم
المطيرة في الليلة الشاتية، يسهل على الذئب افتراسها، وتمزيقها.
ولم يكتف الشيطان بهذا الاختلاف، وتلكم التفرقة، بل أخذ يغري
بينهم العداوة والبغضاء فأخذت كل فرقة منهم تكيد للأخرى، وتشمت بها إذا حل بها
البلاء، وكأنما انعكست الآية على المسلمين، فبدلًا من أن يكونوا إخوة متحابين،
صاروا أعداء متحاربين.
الاختلاف سنة ربانية
قال الله تعالى ﴿وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗۖ
وَلَا يَزَالُونَ مُخۡتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَۚ
وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمۡۗ وَتَمَّتۡ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمۡلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ
ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ﴾ (هود:118-119)
قال الشاطبي([1])-
رحمه
الله تعالى- فأخبر سبحانه أنهم لايزالون مختلفين أبدًا مع أنه خلقهم
للاختلاف، وهو قول جماعة من المفسرين في الآية([2])، وأن قوله ﴿وَلِذَٰلِكَ
خَلَقَهُمۡۗ﴾ معناه: للاختلاف خلقهم، وهو مروي عن مالك بن أنس
قال: خلقهم ليكونوا فريقًا في الجنة، وفريقًا في السعير، ونحوه عن الحسن،
فالضمير في «خلقهم» عائد على الناس، فلا يمكن أن يقع منهم إلا ما سبق في
العلم، وليس المراد هاهنا الاختلاف في الصور كالحسن والقبيح، والطويل والقصير، ولا
في الألوان كالأحمر والأسود. ولا في أصل الخلقة كالتام الخَلق والأعمى
والبصير، والأصم والسميع، ولا في الخُلق كالشجاع والجبان، ولا فيما أشبه ذلك
من الأوصاف التي هم مختلفون فيها.
وإنما المراد اختلاف آخر، وهو الاختلاف الذي بعث الله النبيين
ليحكموا فيه بين المختلفين، كما قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ
اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا
اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ
الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ (البقرة:213). وذلك الاختلاف في الآراء
والنحل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد به الإنسان أو يشقى في الآخرة
والدنيا. هذا هو المراد من الآيات التي كرر فيها الاختلاف الحاصل بين الخلق. ا.هـ.
التحذير من الفرقة
ومع أن الاختلاف سُنة ربانية، كتبها الله على عباده، ولكنه حذر
المسلمين من الفرقة والاختلاف فقال عز من قائل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا
دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ﴾ (الأنعام:159) وقال
سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ. مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ
دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ﴾ (الروم:31-32) وقال
تعالى: ﴿وَأَنَّ هَٰذَا
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾ (الأنعام:153)، وعن أبي هريرة- رضي الله عنه-
قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على إحدى أو
اثنتين وسبعين فرقة. وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» أخرجه أبوداود وأحمد والترمذي وقال حسن صحيح. وابن
ماجه مختصرًا([3]) وفي رواية لأبي
داود «ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة».. وعن أنس-
رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «لا تقاطعوا، ولا
تدابروا، ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن
يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» (متفق عليه)، ولقد اعتبر الإسلام جريمة شق الصف الإسلامي
جريمة منكرة يستحق صاحبها القتل جزاء بما قدمت يداه. عن عرفجة الأشجعي- رضي الله
عنه- قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنه ستكون هنات وهنات([4]).
فمن
أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنًا من كان» (رواه مسلم
وأحمد وأبو داود والنسائي).
ولم يكتف الإسلام بالتحذير من الفرقة، بل حث المسلمين على
التعاون، والتكاتف، ومواجهة المشركين صفًّا واحدًا، قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ (التوبة:36).
وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ
صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ﴾ (الصف:4)، وقال جل جلاله: ﴿وَاعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (آل عمران:103)، وقال سبحانه
وتعالى: ﴿إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات: 10).
عن أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله-
صلى الله عليه وسلم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، وشبك بين أصابعه»
متفق عليه. وعن النعمان بن بشير- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله-
صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا
أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» (متفق عليه).
بل وما شرع الله الجمع والجماعات إلا ليلتقي فيها المسلمون،
ليتعرف كل منهم على أخيه، وليتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى.
اختلاف واختلاف
والاختلاف المنهي عنه هو الاختلاف في أصول الدين، لا الاختلاف
في فروعه، بل إن الاختلاف في الفروع رحمة بالأمة، ويدل على شمولية الإسلام،
واتساعه لكل رأي ينبني على أساس علمي صحيح، موافق لقواعد الشرع الشريف.
نقل المفسرون([5]) عن الحسن في قوله تعالى ﴿وَلَا يَزَالُونَ
مُخۡتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾ (هود: 118-119). أنه
قال: أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافًا يضرهم، يعني في مسائل
الاجتهاد الديني التي لا نص فيها، ولو كان الاختلاف في الفروع مُضرًّا بالأمة- كما
يزعم بعض الجهلة- لما أقره رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في الصدر الأول من
هذه الأمة، روى البخاري عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى
الله عليه وسلم- يوم الأحزاب: "ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة،
فسار الناس، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها،
وقال بعضهم: بل نصلي ولم يرد منا ذلك، فذكروا ذلك للنبي- صلى الله عليه وسلم، فلم
يعنف واحدًا منهم".
وروى أبوداود والنسائي عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: "خرج
رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا فصليا، ثم وجدا
الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله-
صلى الله عليه وسلم- فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك،
وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين".
وأما اختلاف الصحابة بعد وفاته- صلى الله عليه وسلم- فأكثر من
أن يحصر في بحث مختصر كهذا([6]) .
فسكوت المصطفى- صلى الله عليه وسلم- عن الأمر، وعدم تعنيفه
للمختلفين دليل على إقراره لمثل هذا الخلاف، ليعرف أمته بأن الخلاف لابد أن يقع في
الأمور الجزئية التي لا نَص فيها، وأن هذا الخلاف يجب ألا يكون سببًا لتنازع
الأمة.
ولقد وعى السلف الصالح هذا الأمر، لذا نجدهم يختلفون في الفروع
دون أن يكون ذلك سببًا لتنازعهم ومزقتهم.
بل إن الكثير من السلف الصالح اعتبروا اختلاف الأمة في الفروع
ضربًا من ضروب الرحمة، فعن القاسم بن محمد رحمه الله قال: "لقد نفع الله
باختلاف أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في العمل، لا يعمل العامل بعمل رجل
منهم إلا رأى أنه في سعة".
وعن ضمرة بن رجاء رحمه الله قال: "اجتمع عمر بن عبدالعزيز
والقاسم بن محمد فجعلا يتذكران الحديث، قال: فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه
القاسم، قال: وجعل القاسم يشق ذلك عليه حتى يتبين ذلك فيه، فقال له عمر: لا
تفعل، فما يسرني باختلافهم حمر النعم".
وروى ابن وهب- رحمه الله- عن القاسم أنه قال: "لقد أعجبني
قول عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب محمد- صلى الله عليه وسلم- لا يختلفون،
لأنه لو كان قولًا واحدًا لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل
يقول أحدهم كان سنة"([7]).
رحم الله عمر بن عبد العزيز فلقد كان ينظر بنور من الله، نعم،
لو اتفق الفقهاء في الفروع لوقعت الأمة في حرج، وأي حرج، وأوضح مثال ذلك
الحج، وما يكون فيه من مشقة، وحرج على المسلمين لو اتبعوا فيه فقيهًا واحدًا.
وقد يتساءل متسائل لم هذا الاختلاف بين علماء الأمة، وعندهم
كتاب الله وسُنة رسوله- صلى الله عليه وسلم؟! ويرحم الله علماءنا، الذين لم يتركوا
سؤالًا إلا وأعدوا له جوابًا، سواء أوقع أَم لم يقع، فقد بين علماء السلف رحمهم
الله تعالى أسباب اختلاف الفقهاء بجلاء، ووضوح في أكثر من مصنف مستقل، أو في أبواب
مستقلة في كتب الفقه، والأصول.
ويمكننا أن نلخص الأسباب الرئيسية لاختلاف الفقهاء فيما
يلي([8]):
1- اختلاف القراءات:
القراءات جمع قراءة، وهي في اللغة مصدر سماعي ليقرأ، وفي
الاصطلاح: مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفًا به غيره في النطق بالقرآن
الكريم، مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أَم
في نطق هيئاتها([9]).
والقراءات المتواترة عند جمهور العلماء هي القراءات العشر
المنسوبة للأئمة التالية أسماؤهم: عبدالله بن عامر اليحصبي، عبدالله بن كثير
الداري، عاصم بن أبي النجود الأسدي، أبوعمرو بن العلاء البصري، حمزة بن حبيب
الزيات، نافع بن عبدالرحمن المدني، علي بن حمزة الكسائي النحوي، أبوجعفر يزيد بن
القعقاع القاري، يعقوب بن إسحاق الحضرمي، خلف بن هشام بن تعلب.
وبسبب الاختلاف في القراءات وقع اختلاف بين الفقهاء في بعض
المسائل الفقهية([10]).
2- عدم الاطلاع على الحديث:
من المعلوم أن أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قد تفرقوا
في البلدان بعد فتحها، وأنه كان عند كل منهم من الحديث ما لم يكن عند غيره، وقد
اجتمع حول كل منهم عدد من الطلبة الذين اقتبسوا من علمهم، وأفتوا بقولهم، لذا ترتب
على ذلك وقوع الخلاف بينهم في بعض المسائل الفرعية.
ومن أمثلة هذا الخلاف ما وقع بين الصحابة من خلاف في عدة
الحامل المتوفى عنها زوجها.
ويجب أن ننبه هنا على أن هذا السبب كان له أثر في اختلاف
الفقهاء في صدر الإسلام، قبل تجميع الأحاديث، أما بعد تجميع الدواوين الحديثة فإنه
لم يبق لهذا السبب أثر يذكر في الخلاف، لأن معظم أئمة الحديث- إن لم نقل
كلهم- هم من فقهاء المذاهب الأربعة.
3- الاختلاف في ثبوت الحديث:
لكل إمام من أئمة الفقهاء بعض القواعد الخاصة في الجرح
والتعديل، وبعض الآراء الخاصة في قبول بعض أنواع الحديث أو رده، ينفرد بها عن غيره([11])
مثال
ذلك اختلاف الفقهاء في قبول الحديث المرسل.
وقد ترتب على ذلك الاختلاف في بعض الفروع الفقهية، مثاله الخلاف
في ثبوت الشفعة للجار.
4- الاختلاف في فهم النَص وتفسيره:
قد يرد نَص من كتاب أو سُنة فيختلف الفقهاء في المراد منه، فيتبع
كل في تفسيره إلى ما يراه منسجمًا مع روح التشريع، ومع القواعد العامة للشريعة
الغراء.
وكمثال لذلك الاختلاف في زكاة الخليطين.
5- الاشتراك في اللفظ:
قال الإمام الرازي ([12]): اللفظ المشترك هو اللفظ
الموضوع لحقيقتين مختلفتين، أو أكثر، وضعا أولًا من حيث هم كذلك. ا.هـ.
كالعين تطلق على الباصرة، والجارية، والذهب، والشمس، والجاسوس... إلخ.
والمشترك واقع في اللغة في الأسماء والأفعال والحروف، كما أنه
واقع في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ (التكوير:17)،
فعسعس تعني أقبل وأدبر.. وقد كان وقوع المشترك في الكتاب والسُنة سببًا لوقوع بعض
الاختلاف في الفروع بين الفقهاء، ومن ذلك اختلافهم في عدة المطلقة -إذا كانت
تحيض.
6- تعارض الأدلة:
ومن أسباب الاختلاف بين الفقهاء تعارض الأدلة فيما يتراءى لنا،
أقول فيما يتراءى لنا، لأنه في الحقيقة لا يتعارض بين الأدلة لأنها كلها آتية من
مصدر واحد هو الله تعالى، سواء أكانت واردة في القرآن أَم كانت واردة في السنة ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ
عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء:82). غير
أنه قد تكتنف النصوص عوامل، فتظهر وقد حدث بينهما من التعارض ما يجعل المجتهد يقف
أمامها مرجحًا بعضها على بعض، بحسب ما يظهر له من أدلة أخرى([13]) ومن
المسائل الخلافية المترتبة على هذا السبب، الاختلاف في أقل ما يصح مهرًا في النكاح.
7- الاختلاف في القواعد الأصولية:
نعني بالقواعد الأصولية، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط
الأحكام الشرعية الفرعية والقواعد جمع قاعدة. وهي هنا عبارة عن صور كلية،
تنطبق كل واحدة منها على جزئيات تندرج تحتها، ولكل إمام من أئمة الفقه الإسلامي
قواعد أصولية يستقل بها عن غيره، تميز مذهبه عن مذاهب الآخرين، وهذا السبب هو
من أهم الأسباب المؤدية إلى الخلاف الفقهي، لأن الفروع الفقهية ما هي إلا ثمرة عرض
النصوص الشرعية على القواعد الأصولية. وهذا السبب باب واسع للخلاف وموضوع
طويل، لا يمكننا أن نستقصيه في هذا البحث، ومن أحب الاستزادة فعلية
بكتاب «أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء" للدكتور
مصطفى الخن([14]).
8- عدم وجود نصوص في المسألة:
إن الناظر إلى النصوص الشرعية المتعلقة بالفروع الفقهية يراها
محدودة لا تتجاوز الآلاف، بينما الحوادث المتجددة التي تحتاج الأمة إلى تبين حكم
الله فيها غير محصورة.
وهنا قد يتساءل متسائل، ما هو السبيل إذن إلى حل هذه المشكلة؟!
نقول: إن السبيل تبينه هذه الآية الكريمة ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ
أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (النساء:83). فهذه الآية الكريمة تدلنا على
أن في أحكام الحوادث ما لا يعرف بالنَص، بل يتوصل إليه بالاستنباط وأن الاستنباط
حجة.
والاستنباط هو الاستخراج، يقال استنبط الفقه، إذًا استخرج الفقه
باجتهاده وفهمه([15]).
إذن فهذه الآية توجهنا إلى مصدر هام من مصادر التشريع الإسلامي،
ألا وهو القياس([16])، الذي يعتبر بحق
الميدان الحقيقي لبيان قيمة العلماء، وما يحملونه من فقه، وفهم لروح الشريعة
الإسلامية.
وفي رأي- والله أعلم- أن عدم وجود نَص في المسألة هو
أهم أسباب اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية.
ومن أمثلة الخلاف المترتب على عدم وجود نَص في المسألة الاختلاف
في ميراث الجد مع الإخوة.. هذه هي أهم أسباب اختلاف الفقهاء، والله أعلم.
صور للفرقة المذمومة في مجتمعنا
1- إن أقبح هذه الصور جميعًا ما يعيشه كثير من المسلمين- وأخص
الدعاة منهم- من حزبية ممقوتة، قد تصل إلى حد الفرقة والطائفية.
فترى أن كل مجموعة منهم يتبنون أفكارًا معينة من الإسلام، ثم
يفاصلون الناس على أساسها، بل إن بعضهم قد يعتبر من لا يشاركه في هذه الأفكار
خارجًا عن الإسلام.
2- ومن صورها ما نراه من بعض الناس. الذين يتبنون بعض الآراء
الفقهية الشاذة، المخالفة لإجماع الصدر الأول من الأمة، ولا يكتفون إلى هذا الحد،
بل يحاولون حمل الناس عليها- شاءوا أم أبوا- وإلا اعتبروا مبتعدين،
خارجين على السٌنة، يوشك أن يمطروا بحجارة من السماء.
3- ومن صورها ما نراه من بعض العوام من أتباع المذاهب الأربعة، من
مناجزة لأقوال الأئمة الآخرين.
إن لهذه الاختلافات أسبابًا جوهرية أساسية، وأخرى فرعية، سنحاول
تبينها- إن شاء الله- في حلقات قادمة، وسنحاول- بعون الله
تعالى- أن نبين الحلول الإسلامية لها.
فنسأل الله التوفيق، والسداد في القول والعمل، والحمد لله الذي
بنعمته تتم الصالحات.
الهوامش:
([1]) الاعتصام 2/ 165.
([2]) انظر القرطبي 5/ 114، وابن كثير 2/ 465. والبغوي 2/ 259، والخازن 3/ 258.
([3]) معالم السنن 7/ 3، بذل المجهود 18/ 116. مفتاح كنوز السنة
٥٤٢.
([4]) هَنات يفتح الهاء، وتطلق على كل شيء، والمراد بها هنا الفتن
والأمور الحادثة النووي على ملسم 12/ 241.
([5]) الاعتصام 3/ 169.
([6]) راجع الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي 1/ 199. وأعلام
الموقعين لابن القيم.
([7]) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء/ د. مصطفى
الخن، الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه/ د. سيد محمد موسی توانا الإنصاف/ ابن السيد
البطليوسي «وهو كتاب ببين أثر اللغة العربية في اختلاف الفقهاء». حجة الله
البالغة/ ولي الله الدهلوي، الأنصاف/ الدهلوي، قواعد التحديث/ جمال الدين القاسمي،
رفع الملام عن الأئمة الأعلام/ ابن تميمة.
[8] - نفس المرجع السابق.
([9]) مناهل العرفان/ الزرقاني 1/ 405.
([10]) ومن أحب أن يطلع على بعض الخلاف المترتب على ذلك فليراجع النشر/
لابن الجزري 1/ 29.
([11]) انظر قواعد في علوم التحديث/ للتهانوي تحقيق الشيخ عبدالفتاح
أبو غدة.
([12] المحصول: 1/ 359
([13]) التفسير الكبير / للرازي 9/ 199.
([14]) ولشيخنا الفاضل الدكتور عمر بن عبد العزيز حفظه الله، مذكرة
ممتعة، استفاض فيها في بيان أثر الاختلاف في القواعد الأصولية.
([15]) التفسير الكبير / للرازي 9/ 199.
([16]) قال القرافي «شرح تنقيح الفصول 283». القياس هو إثبات مثل حكم معلوم المعلوم أخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت.