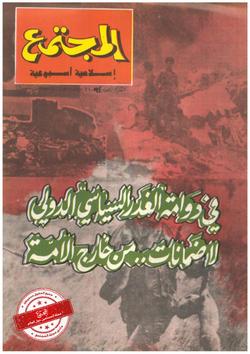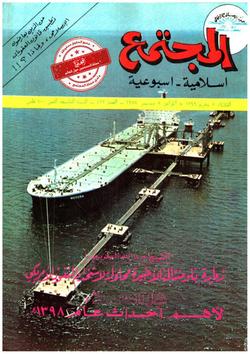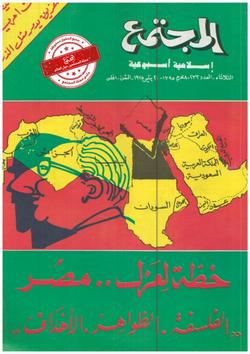العنوان الملحمة في الشِّعْر الإسْلامِيْ المعَاصِر
الكاتب أحمد لطفي عبد اللطيف
تاريخ النشر الثلاثاء 19-أكتوبر-1976
مشاهدات 49
نشر في العدد 321
نشر في الصفحة 20
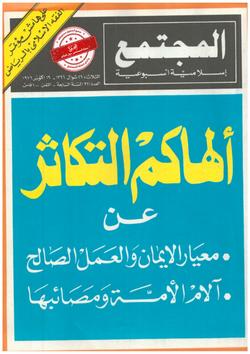
الثلاثاء 19-أكتوبر-1976
الملحمة
في الشِّعْر الإسْلامِيْ المعَاصِر
بقلم: أحمَد لطفي عَبد اللطيف
جاء في اللسان مادة -لحم-:
الملحمة هي الوقعة العظيمة، جاء في الحديث الشريف «اليوم يوم الملحمة» أي الحرب وموضع القتال، والجمع ملاحم مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها، والملحمة أيضًا القتال في الفتنة.
هذا هو معنى كلمة ملحمة وجمعها ملاحم في اللغة، فماذا تعني هذه اللفظة من الناحية الفنية؟
جاء في كتاب «فن الشعر الملحمي» للأستاذ أحمد أبو حاقة، أن الشعر الملحمي قوامه القصص البطولي والأعمال العظيمة الخارقة، والسرد الطويل المتشعب.
وجاء في المعجم الوسيط مادة لحم، أن الملحمة الفنية عمل قصصي له قواعد وأصول، يشاد فيه بذكر الأبطال والملوك وآلهة الوثنيين، ويقوم على الخوارق والأساطير.
***
لقد واجه الأدباء والناقدون في العصر الحديث إثر ترجمة ملاحم اليونان والفرس إلى العربية- قضية طرحوها على الشكل التالي: هل يصلح الشعر العربي للملحمة؟ وهل هناك أثر ملحمي في الشعر العربي؟
ذهب قسم كبير من الأدباء والناقدين العرب إلى أن الشعر العربي خلو من الملاحم، وأنه لا يصلح مطلقًا لهذا اللون من الشعر.
فما الذي دفع هؤلاء إلى الالتزام بهذا الرأي؟
لقد نظر هؤلاء إلى الملاحم المترجمة فوجدوها تقوم على أسس من تمجيد لأبطال أسطوريين، يتعاملون مع آلهة تتصرف تصرف البشر، تحب وتكره وتميل وتحابي...
ولما وجدوا أن تاريخ العرب -وهو تاريخ الإسلام- يقوم على الحقائق، وأن دين الإسلام دین توحيد يحارب الوثنية بلا هوادة، نفوا أن يكون بإمكان الشعر العربي إنتاج الملاحم.
هذه النظرة إلى موضوع الملاحم وإلى كل موضوع في الآداب الغربية، إنما هي نظرة أوشك الذين أرادوا لنا أن نكون عالة على الفكر الغربي، فنأخذ عنه خيره وشره، حلوه ومره ما نحب منه وما نكره، دون أن يكون لنا رأي ودون أن نلائم بين ما كتبوا -وهو ما يناسبهم ويتفق ومعتقداتهم- وبين ما يجب أن نكتب، متفقًا مع ما يناسبنا وما يناسب معتقداتنا.
والواقع أن تعريف الملحمة كما جاء في كتاب الأستاذ أبي حاقة والمعجم الوسيط، إنما هو تعريف للملحمة عند الغربيين والفرس والهنود، وليس من المحتم أن نلتزم بهذا التعريف فلا نحيد عنه، عندما نريد أن ننشئ ملحمة في أدبنا العربي، وإلا فالملحمة بهذا التعريف وبهذه الأسس لا يمكن أن تكون في الأدب العربي.
ولا بد لنا أن نلاحظ أن الملحمة كما جاء في اللسان إنما هي الوقعة العظيمة التي وقعت لدعاة الإسلام التعريف، لو أخذنا به وجعلنا من شروط الملحمة الفنية في الأدب العربي أن تدور حول البطولات العظيمة التي خاضها المسلمون وبنوا عليها صرح أمجادهم، أو أن تدور حول الفتن العظيمة التي دقعت لدعاة الإسلام، وأظهروا فيها صبرًا وجلدًا ومقاومة ومواقف خالدة، وقدموا فيها الشهداء- لكان أقرب إلى الروح العربية الإسلامية من ذلك التعريف الذي جاءنا من الآداب الأجنبية.
وقياسًا على هذا التعريف الذي ارتضيناه فإننا إذا بحثنا في الأدب العربي الحديث عن الملحمة، لوجدناها متمثلة في كثير من الأعمال الأدبية، فعن البطولات الإسلامية والتاريخ الإسلامي، نجد أعمالًا ملحمية مثل:
- ديوان مجد الإسلام «الإلياذة الإسلامية» للشاعر أحمد محرم، وهي مكونة من ٥٢٧٤ بيتًا.
- إلياذة السماوات السبع، وهي قصة آدم -عليه السلام- والجنة إلى انتصار المسلمين على التتار، للشاعر كامل أمين وهي مكونة من ۲۸۰۰ بيت.
3- ملحمة أمير الأنبياء، السيرة النبوية، للشاعر عامر محمد بحيري وهي مؤلفة من ۱۲۰۰ بيت.
4- المعلقة الإسلامية، تاريخ الكعبة والسيرة، للشاعر محمد محمد توفيق، وهي مؤلفة من ألف بيت.
5- القصيدة الجامعة، وهي عن أحداث الخلافة سنة ١٩٢٣م، للشاعر أحمد محرم، وهي مكونة من ٥٧٥ بيتًا.
وعن الفتن التي أصابت دعاة الإسلام، فمثل لها بالملحمة الرائعة التي كتبها الدكتور يوســــــــــــف القرضاوي عن محنة دعاة الإسلام سنة ١٩٥٤م، وهي مؤلفة من ٢٩٣ بيتًا.
وسوف نتناول في حديثنا في هذه الصفحات ملحمة الدكتور القرضاوي بالدراسة والتحليل، لتعطي صورة عن المحنة التي أصابت دعاة الإسلام في هذا العصر.
وأود أن أسجل النقاط التالية بين يدي الحديث عن هذه الملحمة، وذلك لعلاقتها الوثيقة بما سنكتبه.
أولًا: مثل الإخوان المسلمون منذ سنة ۱۹۲۸ الوجه الحقيقي للإسلام، فكانوا كأفراد نموذجًا حيًا للمسلم في حياته وفي معاملاته وفي عبادته، وكانوا كجماعة مثلًا للتنظيم والعمل الجاد المخلص، في سبيل الوصول بالأمة إلى الهدف المنشود وهو إقامة المجتمع الإسلامي كما أراده الله.
ثانيًا: قدم الإخوان المسلون نماذج للبطولة التي تصلح لأن تكون موضوعًا لملحمات رائعة، كان ذلك في جهادهم في فلسطين سنة ١٩٤٨ وسنة ١٩٦٧م، أو كان ذلك في جهادهم في قناة السويس سنة ١٩٥٢م.
ثالثًا: تعاقبت على دعاة الإخوان المسلمين فتن متوالية ومحن متعاقبة منذ ظهورهم كجماعة لها تأثيرها في أحداث المنطقة، فعاد المجاهدون من فلسطين سنة ١٩٤٨، لتتلقاهم السجون والمعتقلات الملكية، ثم اغتالت الحكومة الملكية الإمام الشهيد حسن البنا سنة ١٩٤٩م، بعد أن حلت الجماعة وصادرت أملاكها ومؤسساتها، ثم حدثت الفتنة الثانية سنة ١٩٥٤ م وهي أشد من الأولى وأعتى، فأعدم ستة من قادة الجماعة وقتل عشرات في المعتقلات، وأودع عشرات الألوف في غياهب السجون وأعماق المعتقلات، ثم الفتنة الثالثة سنة ١٩٦٥م، فأعدم الكاتب الإسلامي الكبير الشهيد سيد قطب واثنان من إخوانه، وزج بالآلاف في المعتقلات والسجون.
رابعًا: أشارت التصريحات والتلميحات لبعض المسئولين عن هذه الفتن بأن للإنجليز يدًا في الفتنة الأولى، وأن للأمريكان يدًا في الفتنة الثانية، وأن للروس يدًا في الفتنة الثالثة، بحيث أصبحت أميل إلى أن أنسب هذه الفتن إلى محركيها، فأقول الفتنة الإنجليزية والفتنة الأمريكية والفتنة الروسية.
ولا شك بأن جميع أعداء الإسلام قد اهتزوا طربًا وطاروا فرحًا لما حدث للفئة التي كانت تقف لهم بالمرصاد، فترد كيدهم وتكشف مؤامراتهم.
خامسًا: سلط على الإخوان المسلمين موجات من أعنف الحملات الإعلامية في الصحف والإذاعات، وفي خطب الزعماء الغوغائية، ومنعوا من الرد عليها، وحرموا من الدفاع عن مواقفهم، لذا فإن كثيرًا من الفئات والمجتمعات العربية خاصة، تجهل تاريخ الإخوان الحقيقي، وكونت فكرتها عنهم من أبواق أعدائهم، لأنها لم تسمع غيرها، لذا فإن على الإخوان المسلمين أن يوضحوا مواقفهم، ويشرحوا أسباب محنهم بكل الوسائل المتاحة، كلما سنحت لهم الفرصة، وإن لم يفعلوا فقد قصروا بحق أنفسهم وحق الإسلام الذي يمثلونه، وذلك لأن الإسلام ونظامه ارتبط إلى حد كبير بدعوة الإخوان المسلمين، في فترة طويلة من التاريخ المعاصر.
والملحمة التي نتحدث عنها اليوم تتناول الفتنة الثانية سنة ١٩٥٤م وتصورها بجميع جوانبها، وتمتاز هذه الملحمة بأنها قيلت في أقبية السجون وزنازين المعتقلات، وتنوقلت بين السجناء شفاهًا، وخرجت من السجن بالرواية الشفوية مع الذين كانوا يخرجون بين الحين والآخر، وتمتاز من ناحية أخرى بأن قائلها الدكتور يوسف القرضاوي قد عاش المحنة بنفسه، فهو يتحدث عن أحداث أحس بها وشاهدها وعاشها، وبهاتين الميزتين تكون هذه الملحمة أصدق صورة عن هذه المحنة.
ولا بد لنا أن نبادر إلى القول بأن ملحمتنا هذه لا تخلو من الأثر الشخصي للشاعر، أو ما يسمونه بالعنصر الغنائي، وذلك لأن الملحمة وان كانت تتحدث عن الجماعة وما قاسته في محنتها، فإن الشاعر قد شارك في هذه المحنة وأصابه ما أصاب الجماعة، يتحدث عنها من الداخل، وهي نتيجة الإحساس بضغط الفتنة عليه وعلى إخوانه الذين يصطلون بنارها على مشهد منه ومسمع.
هذا بالإضافة إلى أننا لا نستطيع أن نخلي العمل الأدبي أو الفكري من الأثر الشخصي، وذلك لأن العمل الأدبي أو الفكري، إنما هو مرآة صاحبه وقطعة من نفسه يعرضها على الآخرين.
وملحمة الدكتور القرضاوي، وإن لم تخل من العنصر الغنائي، إلا أن الحديث عن الجماعة وما أصابها يطغى عليها، فهي ملحمة فنية متكاملة بمفهومنا للملحمة وبالمفهوم الآخر في بعض جوانبه.
والدكتور يوسف القرضاوي شاعر من أبرع شعراء الدعوة في العصر الحديث، له إنتاج شعري كثير مبعثر في المجلات الإسلامية الكبرى، كالمسلمون والشهاب وحضارة الإسلام، وله مسرحية شعرية عن يوسف الصديق -عليه السلام- طبعت بمصر، بالإضافة إلى مجموعة جيدة من الشعر المخطوط، وقد كف الدكتور القرضاوي عن قرض الشعر مؤخرًا، وانصرف بكليته للفقه والإفتاء والتأليف حول أوضاع الدعوة والموضوعات الإسلامية الكبرى، هذا بالإضافة إلى عمله رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية في جامعة قطر.
***
لقد بدأت المأساة بالغدر بالجماعة التي وقفت مع ثورة ١٩٥٢م، راجية أن تكون الأمل الذي يحقق للأمة أملها في إقامة شرع الله، بدلًا من قوانين العبيد، حتى يسود الناس العدل وينعموا بالحرية والطمأنينة، وفي ليلة سوداء كان الطغاة يدفعون بعشرات الآلاف من المؤمنين إلى غياهب السجون، ويعاملونهم بكل ما عرف الطغاة من قسوة ووحشية، فقتلوا العلماء وأذلوا الشرفاء وعذبوا وأجاعوا الأطفال، حتى فاقت مظالمهم كل تصور، وأضحت أمامها المظالم السابقة شيئًا هينًا إذا قيست بما اجترموا.
ويوضح الشاعر بأن ملحمته تصور أحداث هذا العهد المظلم وأفعاله:
أحداث عهد عصابة حكموا بني
مصر بلا خلق ولا قانون
أنست مظالمهم مظالم من خلوا
حتى ترحمنا على نيرون
وفي غيهب السجن يسترجع الشاعر في نفسه التاريخ الحافل للدعاة، وما احتملوا في سبيل دعوتهم، ويسأل نفسه عما إذا كان ما يقاسيه الدعاة اليوم اختبارًا أم عقوبة تطهير تعدهم للمهمة التي تنتظرهم.
إن الشاعر يحسن الظن بالله دائمًا، فيلفت إلى الفكرة الثانية في تورية رائعة وبراعة عظيمة، حين يذكرنا بسجن يونس -عليه السلام- في جوف الحوت، وذلك في سياق وصفه لهذه الملحمة النونية:
نونية، والنون تحلو في فمي
أبدًا، فكدت يقال لي «ذو النون»
والشاعر يهيئ القارئ للجو القاتم الذي سيحدثه عنه، فهو سيحدثه بحقائق ولكنها أشبه بالخيال، وهو سوف يصف أحوالًا يطير لها القلب فزعًا، وهو في سبيل تصوير أحداث يشيب منها الولدان، وهذه الأحداث لا تمس نتائجها مصر وأبناءها فحسب، بل تمس المشرق الإسلامي وتقوده إلى هاوية سحيقة:
أمسك بقلبك أن يطير مفزعا
وتول عن دنياك حتى حين
فالهول عات والحقائق مرة
تسمو على التصوير والتبيين
والخطب ليس بخطب مصر وحدها
بل خطب هذا المشرق المسكين
كيف بدأت وقائع هذه النكبة؟ وما هي الصورة التي يرسمها هذا الشاعر البارع؟ إنه يصور لنا هجمة رجال المباحث على الرجال الدعاة في حلكة الليل، كأنهم كلاب الصيد انقضت على فريستها وعادت بها مستبشرة، إلى الصائدين المنتظرين بتلهف لالتهام هذا الصيد السمين:
في ليلة ليلاء من نوفمبر
فزعت من نومي لصوت رنين
فإذا كلاب الصيد تهجم بغتة
وتحوطني عن شمأل ويمين
فتخطفوني من ذوي وأقبلوا
فرحًا بصيد للطغاة سمين
وإلى أين يذهب بهؤلاء الشرفاء؟ إنهم يساقون إلى ظلمات السجون، ومن أقسى هذه السجون، ذلك السجن الذي اكتسب سمعة رهيبة لما اقترف فيه من جرائم وما غيب فيه من أهوال، حتى أصبح اسمه مجردًا يثير الرعب في قلوب أشد الناس ثباتًا وأكثرها صبرًا وجلدًا إنه -قفص العذاب الهون-.. إنه الحربي..
وعزلت عن بصر الحياة وسمعها
وقذفت في قفص العذاب الهون
في ساحة الحربي حسبك باسمه
من باعث للرعب قد طرحوني
ما كدت أدخل بابه حتى رأت
عيناي ما لم تحتسبه ظنوني
ويقدم لنا الشاعر صورة لما يجري في هذا السجن واضحة كمشاهدة العيان، إن الشاعر نفسه وقف أمام هذه المشاهد في أول دقيقة دخل فيها هذا الأتون الملتهب، حتى ظن نفسه في حلم مفزع، أو أمام شريط يحكي قصة خيالية مرعبة.
في كل شبر للعذاب مناظر
يندى لها -والله- كل جبين
فترى العساكر والكلاب معدة
للنهش طوع القائد المفتون
هذي تعض بنابها وزميلها
يعدو عليك بسوطه المسنون
ومضت علي دقائق وكأنها
مما لقيت بهن بضع سنين
يا ليت شعري ما دهاني ما جرى
لا زلت أحيا أم لقيت منوني
عجبًا.. أسجن ذاك أم هو غابة
برزت کواسرها جياع بطون
أأرى بناءً أم أرى شقي رحًى
جبارة للمؤمنين طحون
واهًا أفي حلم أنا أم يقظة
أم تلك دار خيالة وفتون
إن هؤلاء الزبانية يديرون هذا السجن الرهيب أبعد ما يكونون عن البشر، إنهم وحوش كاسرة جائعة، إنهم جمادات وآلات تتحرك لا عقل لها ولا شعور، هذه الوحوش والآلات يحركها رجل مأفون، أضل نفسه وقومه وأحلهم دار البوار:
فيه زبانية أعدوا للأذى
وتخصصوا في فنه الملعون
متبلدون، عقولهم بأكفهم
وأكفهم للشر ذات حنين
لا فرق بينهم وبين سياطهم
كل أداة في يدي مأفون
وفي سجنهم لا فرق بين صغير وكبير، عالم وجاهل، شيخ محطم وفتي يافع سقيم وصحيح، رجل وامرأة، إن هذا التمييز يحتاج إلى عقل، وهؤلاء الأشباه قد سلبوا نعمة العقل...
لا يقدرون مفكرًا ولو أنه
في عقل سقراط وأفلاطون
لا يعبأون بصالح ولو أنه
في زهد عيسى أو تقى هارون
لا يرحمون الشيخ وهو محطم
والظهر منه تراه كالعرجون
لا يشفقون على المريض وطالما
زادوا أذاه بقسوة وجنون
وفي السجن الحربي لا يعترفون بقانون، إنما القانون هو ذلك الشخص الذي نصب قائدًا للسجن، فكلمته هي القانون النافذ، فما أجدره باسم جلاد السجن لا قائده!
من ظن قانونًا هناك فإنما
قانوننا هو حمزة البسيوني
جلاد ثورتهم وسوط عذابهم
سموه زورًا قائدًا لسجون
وكأنما يخشى الشاعر أن يقترف هذا المأفون جرائمه ثم يختفي ويفلت من العقاب، فنراه يسجل أوصافه الخلقية والنفسية، حتى يتعرف عليه الناس في يوم العقاب المرجو.
وجه عبوس قمطرير حاقد
مستكبر القسمات والعرنين
في خده شج ترى من خلفه
نفسًا معقدة وقلب لعين
متعطش للسوء في الدم والغ
في الشر منقوع به معجون
وفي أسلوب رائع وإيجاز بليغ، يعرض علينا الشاعر صورًا من ألوان العذاب التي كانت تقترف في السجن الحربي وغيره من سجون الطغاة، إنه يعرضها في إشارات سريعة، لأن كل صورة منها تحتاج إلى ملحمة مستقلة...
أسمعت بالإنسان ينفخ بطنه
حتى يرى في هيئة البالون؟!
أسمعت بالإنسان يضغط رأسه
بالطوق حتى ينتهي لجنون؟!
أسمعت بالإنسان يشعل جسمه
نارًا وقد صبغوه بالفزلين؟!
أسمعت ما يلقى البريء ويصطلي
حتى يقول: أنا المسيء خذوني؟!
أسمعت بالآهات تخترق الدجى
رباه عدلك! إنهم قتلوني..
إن هذه الصور التي يعددها الشاعر متلاحقة، فتهف الأنفاس وراءها لهولها وبشاعتها، لتحمل تحتها وبين حروفها قصصًا واقعية أليمة يحس بها القارئ، وكأن الشاعر في كلماته المعدودة قد سجل أحداثًا كاملةً وسرد فصولًا طوالًا...
وعلى هذا فإن الشاعر يختار لنا موقفًا ومشهدًا، يصوره لنا كنموذج لما يلقاه الدعاة من عذاب وهول، وكيف يقابل الدعاة هذا الهول بالصبر والجلد، فيموت الداعية محتسبًا ما قدم صابرًا على ما يلقى، موصيًا إخوانه بالثبات والصبر وهم أهله وأبناؤه، مقررًا أنه كان طوال حياته مجاهدًا في سبيل الله، والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى، ليس بأقلها جهاده في القناة وفلسطين.
إن البراعة التي سجل بها الشاعر هذا المشهد، تنقل القارئ إلى الجو المشحون بالرعب، وتجعله يعيش اللحظات التي عاشها هذا الشاب الذي يمثل الآن الشباب الذين اصطلوا بلهيب الطغاة:
ومضت ليال والعذاب مسجر
لفتى بأيدي المجرمين رهين
لم يعبأوا بجراحه وصديدها
لم يسمعوا لتأوه وأنين
قالوا: اعترف أو مت فأنت مخير
فأبى الفتى إلا اختيار منون
وجرى الدم الدفاق يسطر في الثرى
يا إخوتي! استشهدت فاحتسبوني
لا تحزنوا، إني لربي ذاهب
أحيا حياة الحر لا المسجون
وامضوا على درب الهدى لا تيأسوا
فاليأس أصل الضعف والتوهين
قولوا لأمي: لا تنوحي واصبري
أنا عند خالقي الذي يهديني
أماه حسبك أن أموت معذبًا
في الله لا في شهوة ومجون
ما خنت ديني أو حماي ولم أكن
يومًا على حرماته بضنين
فليسألوا عني القناة ويسألوا
عني اليهود فطالما خبروني
ثم يتساءل الشاعر بتكرار ينبئ بالاحتجاج والثورة عن السبب في كل هذه الأعمال الوحشية، ولحساب من يعذب الفتية الأطهار والعلماء الأبرار، ولحساب من يعلق المجاهدون على أعواد المشانق.. إنه لا يمكن أن يكون لحساب مصر أو لحساب الإسلام، لأن هؤلاء المعذبين هم قادة الإسلام أو جنده، والصفوة الأخيار الذين يدافعون عن أوطانهم ودينهم.. لحساب من إذن؟
لحساب من هذا؟ أتدري يا أخي
لحساب الاستعمار والصهيون
أرضى بنا الطاغوت سادته لكي
يعدوه بالتثبيت والتأمين
إنه إذن لحساب الاستعمار بكل أشكاله، ولحساب اليهود الذين احتلوا أرضنا ومقدساتنا، لقد قام الطواغيت بالنيابة عن أعدائنا بإبعاد الدعاة عن الميدان، ليقوم الأعداء بالمقابل بتثبيت عروش الطغاة وكراسيهم، ولكن هيهات هيهات.
ثم لماذا هذا الحرص من الاستعمار والصهيونية على ضرب الدعاة؟! إن الشاعر يوجز الإجابة بصراحة ووضوح، فالقوم يخشون الإسلام وأهله، يخشون أن يظهر نهم أبطال مسلمون يزلزلوا أقدامهم ويثلوا عروشهم:
فالقوم يخشون انتفاضة ديننا
بعد الجمود وبعد نوم قرون
يخشون يعرب أن تجود بخالد
وبكل سعد فاتح ميمون
يخشون إفريقيا تجود بطارق
يخشون کردیًا کنور الدين
يخشون دين الله يرجع مصدرًا
للفكر والتوجيه والتقنين
إن كل هذه الفصول التي مثلت لإطفاء شعلة الدعاة المرتفعة عاليًا، قد انتهت إلى الفشل، فالدعوة كامنة في صدور رجالها، والشعلة جاهزة لترتفع ثانية، والحق واله إلى انتصار، هذا اليقين يحمله الشاعر كما يحمله كل مؤمن، لذا فإن الشاعر قد أكده قبل عشرين عامًا والمحنة في عنفوانها، وتحقق ما أكده، لأنه اليقين الذي لا يتبدل ولا يتغير.
وظننت دعوتنا تموت بضربة
خابت ظنونك فهي شر ظنون
بليت سياطك والعزائم لم تزل
منا كحد الصارم المسنون
إنا لعمرى إن صمتنا برهة
فالنار في البركان ذات كمون
تالله ما الطغيان يهدم دعوة
يومًا، وفي التاريخ بر يميني
هذا العرض الموجز لملحمة الدكتور يوسف القرضاوي، إنما قصدت به أن أبين حقيقة وأن أذكر بحقيقة، أما الحقيقة التي أردت تبيانها، فهي أن الشعر العربي المعاصر غني بالملاحم بمفهومنا لها، والحقيقة التي أردت أن أذكر بها فهي أن الدعوة إلى الله باقية منتصرة، وأن الطغاة إلى انتكاس وزوال مهما علوا واستكبروا.
وملحمتنا هذه بعد هذا كله مليئة بالصور البيانية الأخاذة، والمواقف الإنسانية الرائدة، واللفتات المختصرة في بيان، وهذه الأمور كلها وأمور غيرها فيها تحتاج إلى دراسات أخرى، لعل لها مجالًا آخر إن شاء الله.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل