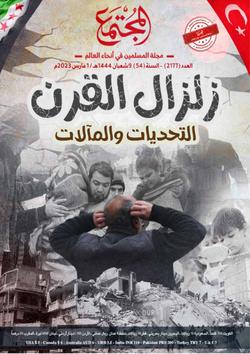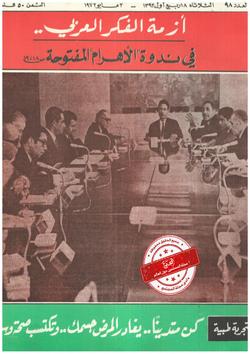العنوان النظام في الإسلام
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 24-يناير-1978
مشاهدات 56
نشر في العدد 383
نشر في الصفحة 36
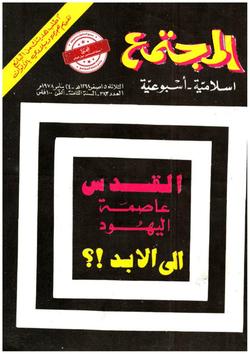
الثلاثاء 24-يناير-1978
- الغربيون لا يغشونك لتستمر في التعامل معهم
- في الصلاة تتجسد أعظم صورة للنظام
- المسلمون لا يغشون لطهارة بواطنهم ونقاوتها
قد يظن البعض خطأ أن النظام من مبتكرات الحضـارة المعاصرة، ويحمله على ذلك أمران:
- ما يرى عليه حال المسلمين مما يتنافى مع النظام لا يستثني من أمورهم شيء، بل نجد حالهم هو الفوضى بعينها، فوضى في التصور ينتج عنها فوضى في الاعتقاد، وينتج عنها فوضى في السلوك.
- ما وجد عليه حالة الحضـارة الغربية من نظام يشمل كل أمـور حياتهم، هذا ما هو ظاهر، لمن لا يرى رؤية متفحص، أما الحقيقة فهي غير ذلك.
فلنحاول أن نتأمل ديننا الإسلامي هل يدعو إلى النظام، أو أنه يستحسن النظام، أو أنه يتنافى مع النظام.
لا نقول: إن الإسلام يدعو إلى النظام فحسب، بل إن الإسلام نفسه ما هو في حقيقته - اعتقادًا وسلوكًا - ما هو إلا النظام نفسه، بل إنه قمة النظام، وإليكم بيان ذلك:
لنبدأ أولًا تحليل هذه الكلمة «النظام» لغويًا حتى نسير في بحثنا على هدى، وعلى أساس متين جاء في مختـار الصحـاح: نظم اللؤلؤ جمعه في السلك، وبابه ضرب ونظمه تنظيمًا مثله، ومنه نظم الشعر ونظمه، - النظام - الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ، ونظم - من لؤلؤ، وهو في الأصل مصدر و - الانتظام - الاتساق.
من هذا نفهم أن من معنى النظام الأخذ بسلسة الأسباب، لأننا بذلك نجعل الشيء متسقًا ومنسجمًا، ونضع الشيء في موضعه.
المعاملات الإسلامية نظام ما بعده نظام
الإيمان نظام والكفر فوضى:
قلنا إن الإيمان ما هو إلا قمة النظام وتفسير ذلك: في العقيدة: عندما تؤمن بالله ربًا تكون بذلك قد فكرت تفكيرًا منظمًا، فأنت بهذا تبدو منظمًا، والصورة التي تنشأ من هذا الاعتقاد تكون غاية في النظام، أي أن هذا التفكير قد انعكس عليك أولًا، ثم انعكس على ما يحيط بك في هذا الكون، لأنك حين تعتقد بوجود إله هو الذي خلقك فقد رسمت صورة منظمة ومتسقة، حين جعلت لوجودك مصدرًا هو الإله الذي خلقك، فيظهر الأمر في صورة منظمة: إله هو الذي خلق، ومخلوق هو نتيجة لإرادة هذا الإله الذي أراد أن يخلق.
وحينما نعكس القضية يبدو الأمر في غاية التنافر، إذا قلنا إن هـذا الخلق قد وجد من تلقاء نفسه، أو أوجد نفسه، أو وجد من دون موجد أوجده، فإنه صورة نشاز تنشـأ عن هذا التصور: وهكذا في إيماننا بالملائكة وبالرسل وباليوم الآخر، فلو سلمنا بوجود إله ووقفنا عند هذا التصور لا نتعداه وقلنا: نؤمن بأنه هو الذي خلق، ولكنا لا نؤمن بوجود الملائكة، فنكون بذلك قد آمنَّا بوجود السلسلة وأنكرنا وجود الحلقات، دع عنك ترابطها؛ لأن هذا الاعتقاد يؤدي إلى اعتقاد خاطئ مضمونه أن الله خلق الخلق، وانتهى الأمر عند مجرد الخلق، فتركهم دون أن يكون له حكمة في هذا الخلق، وهذا يتنافى مع النظام، أما النظام فيقضي بأن الله إذا كان موجودًا أو إذا كان هو الذي خلق الخلق فلا بد أن يهديهم لما يريد منهم، ولما فيه صالحهم، فكيف يكون ذلك إذا لم يكن هناك ملائكة؟ من ذا سيبلغنا ماذا يريده الله منا؟ لا شكَّ أن الله قادر أن يبلغنا بوسيلة أخرى، ولكنه اختار ذلك على هذه الصورة، وإذا آمنا بوجود الله وبوجود الملائكة، ولم نؤمن بوجود الأنبياء، فلا يكفي وجود الملائكة لإبلاغنا ما يريد الله، لأنه تعالى خلق الملائكة فـي صورة لا نستطيع أن نراهم بها هذا من جهة، ومن جهة أخرى سيكون من البعيد أن تتصل الملائكة بكل إنسان فلا بد من وجود الرسل، لينقلوا عن الملائكة ما يريده الله منا، وقد جعل الله الرسل في درجة يستطيعون بها أن يتلقوا عن الملائكة ما لا نستطيع نحن أن نتلقاه عنهم، فكل ذلك ملحوظ فيه الأخذ بسلسلة الأسباب، وبه يبدو الكون متسقًا ومنظمًا.
والإيمان باليوم الآخر، كذلك منتهى النظام، فلو تصورنا وجودنا علـى هذه الأرض ينتهي بموتنا لكان ذلك منافيًا للنظام، بل إنها الفوضى بعينها،
والعبث بعينه: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (المؤمنون: 115) تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.
فإذا كان الإنسان لا يؤمن بوجود الله فلا بد أن يظلم نفسه ويظلم غيره، وكل ذلك يتنافى مع النظام، الذي هو الاتساق والانسجام، وإذا كان لا يؤمن باليوم الآخر كذلك، فلا بُدَّ أن يعيث في الأرض فسادًا، وذلك هدم للنظام.
فأتضح إذن أن الإيمان الذي هو قضية القضايا في الإسلام هو نظام وينشأ عنه نظام، نظام في التصور ينشأ عنه نظام في الاعتقاد، ينشأ عنه نظام في السلوك.
في العبادات: ولننظر الآن في قضية العبادات، ولنبدأ بأهمها، وهـي الصلاة.
إن مجرد أدائها كل يوم وليلة من أول العمر إلى آخره هو نظام، وإن جعلها خمسًا وليست كيفما اتفق نظام، وأن تخصيص أوقاتها فلا يصح أن يؤديها الإنسان متى شاء، وهذا نظام واجتماع المسلمين لأدائها في وقـت واحد، فالمسلم الذي في أقصى المشرق والمسلم الذي في أقصى المغرب، كلهم يؤدون هذه الصلاة في وقت واحد، هذا نظام، وتأديتها جماعة بعد إمام واحد يقوم فيقومون، ويركع فيركعـون، ويقرأ فيسمعون، ويسلم فيسلمون، أليس هذا منتهى النظام؟ وتسويـة الصفوف أليس نظامًا ما بعده نظام، ولأن الإسلام كله نظام قال: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج واختيار الإمام بأن يكون أقرأهم، أليس هذا نظامًا؟ والحث على أن لا يؤم المسلمين أحد وهم له كارهون، هذا أيضًا للمحافظة على النظام وعدم عـودة الإمام إلى القعود، إن قام ناسيــًا في التشهد الأوسط فيطرح المسنون بجانب الواجب، أليس هذا هو النظام ولزوم متابعة المؤتمين للإمام حتى في حالة إخلاله بمسنون، أليس هذا نظامًا أما إذا فعل الإمام ما يفسد الصلاة، فحينئذ على المؤتمين أن يفارقوه وهذا من أجل النظام، والصلاة لو كانت قيامًا فقط، أو ركوعًا فقط أو سجودًا فقط كانت مجهدة أو مملة، وهذا ما يتنافى مع النظام، ولم يترك أمر الصلاة للصدف، بل جعل لها وقتًا معلومًا وعين لها مؤذنًا يدعو الناس بصيغة معلومة هي الأذان، وهذا هو النظام، ولم يترك الناس بحيث يأتون المسجد وهم محملون بأوساخهم وآثار العمل عليهم، بل أمر المسلم أن يتوضأ قبل الصلاة، ولا صـلاة إلا بوضوء، فلا يدخلوا المسجد إلا في مظهر نظيف، وهذا هو النظام بعينه، وكذلك الغسل والتطيب يوم الجمعة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحاقن، إذ الصلاة في هذه الحالة ستكون قلقة مضطربة، وهذا يتنافى مع النظام، كذلك إذا كان الطعام حاضرًا فقد دعي المسلم إلى أن يبدأ بالطعام قبل الصلاة، كل ذلك لئلا تؤدى الصلاة في شكل غير هادئ، وهو ما يتعارض مع النظام والتقاء الناس في الجامع خمس مرات فـي اليوم والليلة، والتقاء عدد أكبر منهم يوم الجمعة، والتقاء الجميع يوم العيد أليس نظامًا؟ وأنت عندما تصلي في الليل في الظلام ربما يمر بك أحـد فيدوس عليك أو يصطدم بك، لذلك كانت صلاة الليل جهرية، أفليس ذلك هو النظام، أما في النهار فأنت تصلي في نور الشمس فليس هناك من حاجة في أن تكون الصلاة جهرية، بل كانت صلاة النهار سرية، أليس هذا أيضًا من النظام، ووجـود جماعتين في وقت واحد لا يصح لأنه يتنافى مع النظام، وصلاة الإنسان منفردًا والجماعـة قائمة يتنافى مع النظام، وإذا أقيمت الصلاة فـلا صلاة إلا المكتوبة محافظة على النظام، وأمر القارئ أن لا يشغل المصلـي حفاظًا على النظام، ومنع الناس من نشدان الضالة أو البيع والشراء في المسجـد للمحافظة على النظـام، وجعل المسلمين يتجهون إلى الكعبة في صلاتهم، بحيث لا يصلي هذا في جهة وذاك في جهة أخرى، كل ذلك محافظة على النظام، إلى غير ذلك، فكم في الصلاة من أشياء لا تحصى كلها مظهر من مظاهر النظام.
والصيام: أليس في فرضه في شهر معين نظام؟ وتحديده بوقت من الفجر إلى الغروب، فلا يصح لكل أن يصوم متى شاء ويفطر متى شاء، كل ذلك دليل على النظام، وفرضه علـى المسلمين جميعًا بحيث يصوم من في إندونيسيا ومن في المغرب في وقـت واحد، كل ذلك ليظهر المسلمون في صورة منظمة، وكما أن نهار الصائمين واحد فليلهم واحد، وهذا مظهر من مظاهر النظام، وبعد الصوم يكون العيد عيد الفطر، عند جميـع المسلمين ويحرم صوم يوم العيد، لئلا ينفرط النظام.
والزكاة: لئلا يظهر المسلمون في شكل متنافر فمنهم من يجد كل ما يريد ومنهم من لا يجد ما يأكل، بل يظهرون إن لم يكونوا في شكل واحد ففي شكل متقارب، وهذا نوع من النظام، وجوب الزكاة على كل مسلم غني في بلاد المسلمين نوع من النظام، وزكاة الفطر كذلك.
والحج: كذلك له وقت محدد ومكان محدد وعلى كل قادر، كل هذه مظاهر تدل على النظام، وتساوى المسلمين في المظهر بثوب الإحرام ومكشوفـي الرؤوس كل هذا يجعلهم يبدون في شكل منظم، ووقوفهم بجبل عرفات والطواف وكل أعمال الحج تدل على النظام، وحكمة الحج تعارف المسلمين فيما بينهم، وتدارس أمورهم كل هذه مظاهر تدل على النظام، وتؤدي إلى النظام، وعيد الأضحى والأضحية كلها أمور تدل على النظام.
في المعاملات: التساوي أمام الحاكم بلا فرق بين كبير وصغير كل هذه تظهر المسلمين في صورة منظمة، وتحريم الرشوة التي تعطي المبطل حق غيره فيختل النظام، وطاعة ولي الأمـر لتسير أمور المسلمين بصورة منظمة وقتل من يفرق أمر المسلمين، وهم جميع محافظة على النظام، والحدود ما شرعت إلا للمحافظة على النظام والقصاص كذلك، والأخذ بمبـدأ الشورى ليس إلا لتوطيد النظـام، وتوزيع المال بين الورثة كل ذلـــك نظام بديع، وتوزيعه بالمقاديـر التي حددها الله كذلك فيه نظام دقيق، إذ لو أعطيت المرأة التي هي أكثر حياتها عالة على غيرها، لو أعطيت مثل أخيها الذي لن يعوله أحد لكان ذلك مجافيًا للنظام.
ولماذا حرمت خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم كل ذلك حفاظًا على النظام، وكذلك إذا باع المسلم على بيع أخيه المسلم.
تحريم الغيبة والنميمـة وشهادة الزور والغصب كل ذلك مـن أجل المحافظة على النظام، وتحريم الغش والكذب والغل والحسـد كذلـك، وتحريم المحاقلـة والمزابنة والنجش وتلقي الجلوبة كذلك.
في الأخلاق والآداب: إفشاء السلام وصلة الرحم وإطعام الطعام وتوقير الكبير ورحمة الصغير، وأن تدعو أخاك بأحب الأسماء إليه كل ذلك ليظهر المسلمون في مظهر منسجم ومنظم.
التيامن والبسملة في بداية كل أمر ذي بال، كذلك نظافة البدن والملبس وحسن المظهر كذلك، ولذلك استنكر النبي عليه الصلاة والسلام رجلًا أتاه ورأسه منتفش الشعر فقال: يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؛ لأنه أتاه بمظهر غير منظم.
وإماطة الأذى عن الطريق التـي جعلت شعبة مـن شعـب الإيمان، واجتناب الملاعن وحقوق الجـار، وإكرام اليتيم وإكرام الضيف، كل هذه ليبدو المجتمع المسلم في شكل منسجم ومتناسق، وطاعة الوالدين كذلك، وحث الرسول عليه الصلاة والسـلام على إتقان العمل، رحم الله امرأ عمل عملًا فأتقنه كل ذلك من مظاهر النظام.
وإذا سافر ثلاثة فيؤمروا أحـدهم، كل ذلك هو للمحافظة على النظام، ونهي المسافر أن يسافر وحـده، والمسافرين أن يسافرا وحدهما، كذلك إذ قال عليه الصلاة والسلام: المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب، أتريد أن تعرف هل الإسلام هو دين النظام، وأنه لا يوجد دين أو مبدأ يشتمل على النظام كمـا يشتمل عليه دين الإسلام، إن وقفـة قصيرة مع الحديث توضح لنا الأمر جليًا لماذا كان المسافر شيطانًا؟ لقـد أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحذر الإنسان من المجازفة بنفسـه، فلو أصابه مكروه في السفر وهو وحده من ذا يعينه؟ بل من ذا يخبر عنه وعما جرى له؟ لا أحد، أليس ذلك صورة حية للفوضى والبعد عن النظام، هذا المسافر وحده فما بال الإثنين حـين يسافران وحدهما؟ لنفرض أن اثنين سافرا وأصابهما، أو أصاب أحدهما مكروه من مرض أو نحـوه، ولـزم إسعافـه فماذا يعمل الرفيق وحده لا هل يبقى لديه، أو يذهب ليستدعي من يسعفه أو يعينه على إسعافـه، أليست هذه فوضى ما كان ينبغـي لهما أن يقعا فيها؟ أما الثلاثة فالأمر يختلف: لو أصاب أحدهـم مكروه فأحدهما سيبقى عنده، والآخـر سيذهب ليستدعي مـن يسعفه أو يعينهما على إسعافه، أي صـورة رائعة للنظام يرسمها هذا الحديث، فهل بعد هذا يعجب أحد حين قلنا إن الإيمان نظام والكفر فوضى؟
ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن السفر ليلًا، أليس نظاماً؟ بل ونهيه عن أن يصل المرء المسافر إلى أهله ليلًا، أليس كذلك صورة مـن صور النظام؟
ولا نستطيع أن نوفي الموضوع حقه لأننا سنحتاج إلى أن نسوق الإسلام كله بكلياته وجزئياته في هذا البحـث، وليس ما ذكرنا إلا مثـلًا بسيطًا، وإلا فما تركناه أكثر بكثير مما ذكرناه، والجهاد في سبيل الله مثلًا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه هي في نفسها من مظاهر النظام، وهي وسائل لفرض النظام.
النظام السطحي والنظام العميق:
وإذا كانت الحضارة الغربية تدعي أو يظن أنها هي مبتكرة النظام، فما ذلك ناشئ لا عن مظهرهـا الخادع من جهة، وما بلغت إليه حالة المسلمين من جهة أخرى، لا سيما بعد انتشار الصوفية التي أكثرها دخيل، والتي تهتم - كما تزعم - بالباطن، وتهمل الظاهر، مع أن من طبيعـة الإسلام التوازن، فهو لا يهمل جانبًا ويهتم بجانب آخر، ولا يغلب جانبًا على جانب، ولا يطغى فيـه جانب على جانب، فهو يهتم بالظاهر كما يهتم بالباطن:- ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (البقرة: 143)، وهذا أيضًا يعطيـه صورة منظمة لأن الإفراط والتفريط، كلاهما يبدوان في شكل مشوش غير منتظم.
أما الحضارة الغربية فهي تهتـم بالحِسِّيات ولا تهتم بالمعنويات، أي تهتم بالظاهر ولا تهتم بالباطن إطلاقًا، فهم لا يغشون في البيع والشراء، لا لأنهم يتمتعون بطهارة في الباطـن، بـل إن اهتمامهم بعدم الغش لأمر حسي أي مادي، فهم لا يغشون لماذا؟ لأن الرجل الغربي يعرف إنك إن عثرت منه على غش فلن تتعامل معه. وهذا هو ما يهمه.
أما الإسلام فهو يطلب منك أن يكون باطنك نقيًا، وإذا كان باطنك نقيًا، فيجب أن تظهر نقاوة الباطن في الظاهر، أي أن ينعكس ما في الباطن على ما يظهر من أعمالك، وهذا هو الفرق، وهو فرق - كما نرى - كبير.
الإنسان الغربي لا يتبرع لمشروع خيري ليقال إنه تبرع، أو ليدفع عن نفسه ضرًا أو شرًا، أمـا المسلـم فمطلوب منه أن ينفق، ومطلوب منه أن يخلص النية، فلا يكون ذلك ليقال، بل إنه كلما كان عمله بعيدًا عن التظاهر كان أزکی- ورجل ينفق بيمينه لا تعلم شماله -.
فالرياء في الإسلام مذموم، بـل ومحبط للعمل، لماذا؟ لأنك تنقلب من شخص يهتم بالباطن إلى رجل يهتم بالظاهر فالإنسان، حينما يؤدي عبادة من العبادات، وهو يقصد بذلك رثاء الناس، هو في الظاهر مؤد للعبادة، ولكنه في الحقيقة كمن لم يعمل شيئًا، لأنه أهمل الباطن واهتم بالظاهر، وكأنه بهذا لم يبق في إطار أهل الإيمان، بل أصبح أسلوبه أسلوب رجل الغرب الذي يهتم بالظاهر، وبهذا يكـون العمل غير منظم فالعمل الذي فيه رياء هو عمل غير متقن، فهو عمل غير منظم في حقيقته، وإن بدا في الصورة عملًا منظمًا، بل إنه عمل ينافي النظام لأن الباطن اختلف عن الظاهر، فدخل في العمل اختلال أبعده عن صورة النظام المطلوب، وحوله إلى عمل فوضوي.
الغربي حينما يعدل ويعامل غيره بالعدل لا لأنه يجد في باطنه ما يدفعه إلى ذلك، بل لأنه يجد في ذلك منفعة دنيوية إما الدعاية، وإما خوف نتائج الظلم الدنيوية التي تؤدي إلى اعتداء الناس بعضهم على بعض، أو نحو ذلك.
أما المسلم فهو يعدل لأن الله أمر بذلك وسواء عاد عليه هذا العـدل بنفع أو ضرر، فالحافز فيها أجل، بل قد يؤدى به هذا العدل إلى ضرر في الظاهر: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135)، مع أن المنفعة الدنيوية هي في الغالب ثمرة من ثمار العـدل وإحقاق الحق، ولكنها ليست هدف المؤمن الوحيد.
والشعوذة والخرافات، لماذا هي مذمومة؟ لأنها تتنافى مع النظام، النظام الذي هو عبارة عن الأخذ بسلسلة الأسباب، فمثلًا حينما يصيبك صداع فتعالجه بتعليق تميمة فيها طلاسم أو ما أشبه ذلك، هنا تكون أهملت الأسباب، لأن الصداع شيء حسي له أسباب حسية، فقد يكون سببه وجود إمساك، وقد يكون سببه ارتفاع ضغط الدم، وقد يكون لوجود مرض الزهري، وقد يكون لوجود مرض ملاريا، وقد يكون بسبب إصابة برد، فإذا عرفنا السبب عالجنـاه وبذلك يزول الصداع، وبهذا نكـون أخذنا بالأسباب أي بالنظام، أمـا حينما نعلق تميمة أو نشرب قهوة، فنكون قد عالجنا الشيء بغير إدراك سببه، وعالجناه بغير علاجه وعدلنا عن النظام، وترك النظام هو الفوضى.
وكثير من الأمور التي نهانا عنها ديننا، حينما نفكر في الحكمة من ذلك نجد أن ما نهينا عنه يؤدي إلى الخلاف وحصول الخلاف يعكر النظام، كثير من أمور البيع والشراء التي نهينـا عنها، كبيع المجهول مثلًا، وكذلك النجش وبيعتان في بيعة، لماذا؟ لأنها غالبًا تؤدي إلى الخلاف والخلاف- كما قلنا يعكر النظام.
فنرى الإسلام هو دين النظام، ولا نقول: يدعو إلى النظام، بل إنه هو النظام بعينه؟
فلا يجهل أحدنا قيمة النظام، ويظن أنه من مبتكرات الكفار، أو أنه تشبه بالكفار، ولا يظن أحد أن الزهد في الدنيا يعني عدم المبالاة بالنظام.
وبعد الذي سردناه يتبين أن ديننا هو النظام، وأن علينا أن نكون أول القائمين على النظام، والحريصين عليه، وبعد أن فهمنا أن أهم شيء في الإسلام وهو العقيدة، فهمنا أنه هو النظام بعينه.
- ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (الأنبياء: 22)، فهذه الآية ماذا تقول؟ تقول: أنه لا بُدَّ من إله، ولا بد أن يكون هذا الإله واحدًا لا شريك له؛ لأنه لو كان له شريك أو شركاء لفسدت السماوات والأرض أي اختلال النظام.
فالآيات نظام، والكفر فوضى ما بعدها فوضى، فلنحرص على النظام إن كنا مؤمنين ولنحذر الفوضى إن كنا نكره الكفر، وآخـر دعوانا أن الحمـد لله رب العالمين.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل