العنوان حول الفن الإسلامي
الكاتب د. نجيب الكيلاني
تاريخ النشر الثلاثاء 17-نوفمبر-1970
مشاهدات 84
نشر في العدد 36
نشر في الصفحة 12
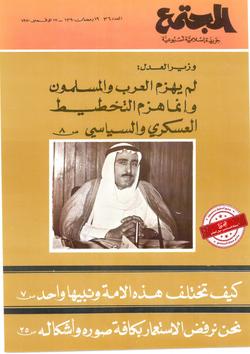
الثلاثاء 17-نوفمبر-1970
حول الفن الإسلامي
بقلم نجيب الكيلاني
لم تعد القصيدة أو الخطبة وحدهما أداة للتبشير بالإسلام والدعوة إليه..!
الفنون والآداب قد تكون نوعًا من الخمر أو المخدر وقد تكون غذاءً شهيًّا.. ونبعًا صافيًا طاهرًا..!
مقدمة
الحركة الإسلامية في حاجة إلى المزيد من الوعي والتكامل، وأعني بالوعي الجهد المستمر الدائب في مجال الفهم والإثراء الفكري، والاستفادة من التجارِب المريرة التي خاضتها وتخوضها، وقد يقول قائل هذا أمر مفروغ منه، أو تحصيل حاصل، وإنما الحقيقة التي لا مراء فيها، إن رجال الدعوة الإسلامية قد استدرجوا إلى معارك جانبية، وخلافات شخصية، استنفدت الكثير من جهدهم، وأضاعت الكثير من وقتهم، وجرفهم التفكير الهادئ، والانفعال المتزن.
وأعني بالتكامل: التوسل بشتى الأساليب قديمها وحديثها للوصول إلى عباد الله، والاستفادة من تجارِب العصر في المجالات النفسية والإعلامية والفنية... فالدعاة إلى الإسلام في عصرنا لم يعطوا الفنون حقها في التأثير والتوجيه، ولم يكونوا جادين في حمل عقيدتهم وكلماتهم على متن الفنون والآداب، ولعل كثيرين من الدعاة المسلمين قد ساء رأيهم في الفنون وأصحابها لما تتضح به الفنون المعاصرة من دعارة ومجون واستهتار وإثارة وضلال، ولعل اليأس قد أصاب البعض الآخر نظرًا لرواج هذه البضائع، وإقبال الجماهير الأرعن عليها، وجريه وراءها، ودفع ما يطلب منه للحصول عليها، والبعض الآخر رأى أن الفنون داء وبيل، وأنه لا نجاة من شرها إلا البعد عنها، ومقاطعتها، وفرض حصار على ذويه حتى لا يتلوثوا بهذا المورد الموبوء، ونسي أو تناسى أن هذه الألوان تطل عليه من النافذة، وتواجهه في الشارع والمكتب، وتتصدى له على صفحات المجلات والجرائد، وتواجه أبناءه في المدارس والجامعات، وفي الإذاعات والتليفزيونات.
إن تكامل أدوات الدعوة الإسلامية في العصر الحديث لا يتم إلا بتطويع هذه الفنون والآداب، وتطهيرها في ينابيع القيم الإسلامية العريقة، وإعطائها ما تستحقه من الاهتمام والدراسة، والتوسل بها -في أطهر أحوالها- إلى جماهير الناس.
إن بضعة أمتار من الحرير تستطيع المرأة أن تصنع منها ثوبًا ضيقًا قصيرًا، يبرز مفاتنها ويجذب إليها العيون الفضولية، ويحيطها بجو من الإغراء والفساد.
وإن بضعة أمتار أخرى تستطيع امرأة ثانية أن تصنع منها ثوبًا محتشمًا، عليه سيما الفضيلة والوقار، والفنون والآداب قد تكون نوعًا من الخمر أو المخدر، وتتضح بالإثم والفجور والانحلال، وقد تكون غذاءً شهيًا، ونبعًا صافيًا طاهرًا، وباعثة للقيم الفاضلة، ومثيرة لما يكمن في قلب الإنسان وعقله من خير وبر وجهاد، ولسانًا معبرًا لأشرف الدعوات وأقدسها، الفن ليس غاية كما يزعم عبدة الأصنام والحالمون، الفن وسيلة لما هو أعظم، وأداة في يد الإنسان الحر الذي ينشد الخير للناس قاطبة.
ولقد أصبح الفن في عصرنا الحديث أقوى أدوات التأثير، وأشدها خطرًا، ولكي تتكامل وسائل الدعوة الإسلامية، وتلبي احتياجات العصر، وتتكلم مع ناسه بلغتهم، فلا بد من الاهتمام بالفنون.. والفن ليس خبثًا كله.
وفي هذه الدراسة الموجزة نتكلم عن الفنون والآداب في ظل المفهوم الإسلامي، ونتعرض لصلة الدين بالفن، ودور الفن في العصور الإسلامية الأولى، وما تعرَّض له الأدب العربي أو الإسلامي من محاولات للهدم والتدمير.
ولتكن هذه الكلمات الموجزة شحذًا لهمم الفنانين والأدباء المسلمين كي يشاركوا في هذا الجهد، بالرأي وبالإنتاج، لعلنا نستطيع أن نفتح الطريق أمام فن إسلامي أصيل، والله أسأل أن يوفقنا لما فيه الخير والرشاد.
نجيب الكيلاني
حول الفن الإسلامي
عالمنا الحديث يُلزمنا بالتحديد، وأجياله يريدون خطوطًا واضحة المعالم، ميسورة الفهم، عميقة الإقناع، كي تتقبلها، وتمشي على نهجها، أو تنفعل بها، وتتمثل مضامينها، ليس في مجال السياسة والاقتصاد والقانون والأوضاع الاجتماعية فحسب، بل في مجالات الفنون أيضًا.
والحركات الإسلامية على ما يبدو قد أهملت جانب الفنون في كثير من الأحيان، فالمتصفح لمجلاتها ونشراتها وصحفها وكتبها، يراها تركز على الجوانب العقائدية وحدها في مجال البحث والدراسة، وتشغل نفسها أكثر وأكثر بالرد على مناوئيهـا السياسيين، والمفكرين المنحرفين، وهذا في حد ذاته أمر لا غبار عليه، تفرضه ضروريات المعارك المتصلة بين الحركات الإسلامية وأعدائها، غير أن إغفال جانب الفن في أتون ذلك الصراع الأزلي، يجر إلى أضرار محققة، وخسائر أكيدة، إذ ليست الدراسات وحدها، أو البحوث المستفيضة وحدها، بقادرة على حمل لواء الدعوة، فإن أساليب الدعوة في عصرنا الحديث قد تنوعت وتعددت، وأصبح الوصول إلى المتلقي، أعني جماهير الناس، فنًا بذاته يحتاج إلى كثير من الخبرة والدراية، وإلا قصرت وسائلنا في الدعوة إلى الإسلام عن تأدية واجبها المقدس، وأصبح اللوم الأكبر يقع على عاتقنا نحن، ولا أقول اللوم فقط، بل والوزر أيضًا، لقد أصبح الفن هو الخير الأكبر في سياسة الإعلام، وأصبحت المذاهب الفكرية والسياسية تقدم نفسها إلى الناس في أثواب الفنون المختلفة.
وهذه حقيقة لم يجهلها أجدادنا الكرام، وهم يرفعون لواء الدعوة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، كانت تواكب سلوكها المميز، وأخلاقهم الفريدة، وكانت تسير جنبًا إلى جنب مع مهارتهم الحربية، وتفانيهم في الجهاد الأعظم، وانطلاقهم إلى العالم في ظل العقائد والمثل التي يقرأونها في كتاب الله، وحديث نبيهم وسيرته، فتشكل سلوكهم، وتصبغ كلماتهم بصيغتها، وقد يقول قائل: إذا كان أجدادنا الأوائل في فجر الدعوة الإسلامية قد أدركوا هذه الحقيقة المهمة، فأين هو تراثهم من المسرح والرواية والرسم وغيرها من الفنون؟
لكل عصر فنه
لكي نجيب على هذا السؤال يجب أن ندرك أيها الإخوة، أن لكل عصر أسلوبه وفنه، ولو كان في عصر الرعيل الأول اختراعات كالتلفزيون أو السينما أو الإذاعة لما تردد المسلمون في استعمالها، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرحب بكل جديد نافع حتى في كافة الشئون:
لم يتردد في حفر«الخندق» حينما أشار به سلمان الفارسي في غزوة الأحزاب، وهو شيء لم يفعله العرب من قبل، بل أضفى على سلمان الفارسي مجدًا عظيمًا حينما قال عنه «سلمان منا أهل البيت»، ولم يتوان صلى الله عليه وسلم عن ابتكار أساليب جديدة في الحرب والسياسة، بل إن الدعوة الإسلامية كلها كانت خروجًا على كل القيم العفنة، والتقاليد الموروثة في حياة العرب، مما جعل طريق الدعاة وعر المسالك، مليئًا بالصعوبات والمشاق، محتاجًا لكل جديد في العرض والأسلوب.
وكان الأدب آنذاك هو فن العصر سواء الشعر أو النثر؛ كانت القصيدة أو الخطبة هي لسان الدعاة والمتحدثين، وكان شاعر القبيلة أو خطيبها هو أعلاهم ذكرًا، يحوطونه بالرعاية والإكبار، ويغدقون عليه المال والمتاع، ويقدمونه على كل من عداه في المحافل والمسامر، بل إن روائع القصائد كانت تعلق في أقدس مكان عرفه العرب، وهو الكعبة، وكانت كلمات الحكماء من العرب تحظى بقداسة لا مثيل لها.
وحينما جاء الإسلام لم يفرط في استخدام فنون العصر في بث دعوته، والرد على أعدائه، كان القرآن أول كل شيء قمة البيان، وفخر الفصاحة والبلاغة، معجزًا في شكله ومضمونه، معبرًا أصدق تعبير وأحسنه عن المبادئ الإلهية التي بثها الله في كلماته، ولم يستطع العرب أن يتحدوا هذه الروعة الإلهية البيانية، انبهر أمامها الشعراء والفصحاء، وخروا ساجدين، لم يكن القرآن نثرًا، ولم يكن شعرًا، ولكنه قرآن على حد تعبير الدكتور طه حسين، هذه الصورة الفريدة كان لها أعمق الأثر وأبلغه في نشر الدعوة وجذب الناس إليها، وامتلأ القرآن بقصص الأولين والآخرين، بل إن فيه لونًا من القصص التاريخي، يفوق بالتأكيد أحدث ألوان الفن القصص والروائي، مثل قصة يُوسُف وبلقيس ملكة سبأ، وقصص بني إسرائيل، وهي كثيرة، وغيرها من قصص الأقوام والأنبياء المؤثرة البليغة.
إذن كان القرآن بشكله الفني الرائع، وألوانه التعبيرية العظيمة، فتحًا في عالم التعبير والتأثير والإيحاء، وشجع الرسول الشعراء -برغم انبهارهم أمام فصاحة القرآن وبلاغته- شجعهم على إنشاد الشعر في المناسبات المختلفة، والرد على خصوم الدعوة، وتصوير الأيام الخالدة، والمعارك الرائدة، مما تذخر به كتب السيرة والغزوات.
لا أنكر أن العصور التالية قد جمدت على هذه الأشكال فترة غير قصيرة من الزمن، لكنها فتحت الطريق أمام القصص الإسلامي، والقصص الديني الذي كان يدبجه الوعاظ في المساجد، ولم يتردد الأدب الإسلامي في قَبُول ألوان مبتكرة من القصص المترجمة عن الآداب الفارسية والهندية وغيرها، ولم يعقم الأدب الشعبي بدوره عن نسج آلامه وأحلامه في حكايات وأساطير جذابة، اكتظت بها روايات السير الشعبية، مثل سيف بن ذي يزن اليماني، والأميرة ذات الهمة، وأبي زيد الهلالي وغيرهم، ويلاحظ القارئ في تلك السير الشعبية.
امتزاجها بالتقاليد الإسلامية والقيم العربية الأصيلة، متأثرة في روحها العامة بالنزعة الدينية، ومعاداة الروح الصليبية الحاقدة، مما لا يتسع المجال لذكره، واختيار مقتطفات له، ولقد أثرت عوامل عدة في عدم تفوق فن الرسم والتصوير، وعدم بزوغ عصر المسرح في مجال الفكر الإسلامي.
وأيًا كان الأمر فإن دور الفن عمومًا هو تشكيل الوجدان بما يبثه فيه من عطاءات فكرية وعاطفية، وإذ كنا حريصين على تنمية وتبصير ما يسمى «بالوجدان الإسلامي»، فلا بد من التوسل بألوان الفنون المختلفة من إذاعة وتليفزيون وسينما ومسرح وقصص ورسم، بأساليبها الحديثة، وقواعدها الفنية المتعارف عليها، وأن نساهم في إثراء هذه الفنون وتجديدها.
سارتر والقساوسة
لم تعد القصيدة أو الخطبة وحدهما أداة للتبشير بالإسلام والدعوة إليه، لقد استطاع «سارتر» الوجودي بقصصه ومسرحياته أن يؤثر في الملايين أكثر من أكبر قسيس في أوروبا، بل شاع ذكره عن طريق مسرحياته أكثر مما شاع عن طريق فلسفته، وإذا كان قراء البحوث أو الفلسفات قلة، فإن مشاهدي الروايات السينمائية أو المسرحيات وقراء الشعر والقصة يعدون بالملايين، وليس أثقل على نفوس أجيالنا المعاصرة من الكلام المباشر، والوعظ المجرد، إن محاضرة لعالم بارز لا يحضرها سوى بضع عشرات، ولكن فيلمًا سينمائيًا مثل «کوفادیس» أو «المصارعون»، يشاهده الملايين في شتى أنحاء المعمورة، لا أريد أن أطيل في شرح هذه القضية البديهية، ولكني أريد أن يسلم بها دعاة الحركة الإسلامية، وأن يرصدوا لها من جهدهم ووقتهم ومالهم ما تستحقه من اهتمام ورعاية، حتى يمكننا أن نصل إلى قلوب الناس وعقولهم بأحب الوسائل إليهم، وأبعدها تأثيرًا فيهم، وأحدثها أسلوبًا لديهم.
وإذا كنا نريد أن نتصدى للركام الهائل من الفنون المنحرفة المدمرة، إلى تشيع الإباحية والإلحاد والتمزق، فلا يكفي الصراخ والكلمات المحمومة، والخطب الهادرة، وإنما لابد أن نواجه الفن المنحرف بفن أصیل، قادر على أن يثبت في المعمعة، بل لابد أن نقدم البديل للناس، فهم لا يستطيعون أن يعيشوا في فراغ، أو يرفضوا ببساطة وسائل الإمتاع والتسلية التي تقدم لهم السم في الدسم، لمجرد مقالة أو خطبة تؤكد لهم أن فيها ضررًا بالغًا على حضارتهم ومستقبلهم، وفيها -منافاة لمبادئ دينهم الحنيف.
اتهام الأدب الإسلامي القديم
ولقد توهم بعض أدبائنا ونقادنا أن الأدب العربي القديم، أعني الأدب الإسلامي بتعبير أدق، كان أدب مدائح للملوك والأمراء، وسجلًا للتهاني والمراثي والهجاء العنصري أو الشعوبي أو العقائدي أو الشخصي، وكانت القصيدة العربية مجرد قوالب جامدة ميتة.. هكذا يزعمون.
والحق أنه افتراء محض يعوزه الدليل، بل يكذبه الواقع والتاريخ، لقد كان شعراؤنا أحرارًا بمعنى الكلمة، عبروا عن كل ما يجول في خواطرهم، نحن نجد الشاعر الزاهد إلى جوار الشاعر الزنديق، بل نجد الاثنين في شاعر واحد كأبي نواس، ولقد بلغت الحرية ببعضهم أن تعرض لبعض القيم الدينية، مما دعا بعض علماء الدين لرميه بالكفر والزندقة، ولم يكن الاضطهاد قادرًا على صرف الشعراء من الإدلاء برأيهم في أحلك أيام الظلم، مما جعل بعضهم يضحي بحياته عن طيب خاطر، من أجل نقد لحاكم، أو مهاجمة لوضع فاسد، أو تعرض لمن يتسترون بالدين، ويرتكبون الحماقات، والحق أن أبا العلاء المعري لعب دورًا بارزًا، في عمق النقد وحرية الرأي، وتطويع الفلسفة لبحور الشعر وأغراضه، إنه بلا شك عملاق من عمالقة الفكر الإسلامي الحر، وهو في نفس الوقت مجدد عالمي في كتابه «رسالة الغفران» برغم القوالب الصعبة، أو لزوم ما لا يلزم في شعره، وهو نوع من الترف الفكري، والتحدي بالإبداع والقدرة، تحدى انحرافات عصره، وتحدى عاهته التي رمته بها الأقدار، وتحدى الكفاءات المتنوعة التي ذخر بها عصره، ولولا ضيق المقام لكان لأبي العلاء مئات بل آلاف من الصفحات، برغم كل ما يقال عنه، ولقد كان بعض شعرائنا ملتزمين بكل معنى الكلمة، لقد نجا عدد كبير منهم من الارتزاق بالشعر، أو السير في موكب الحاكمين، والتزم بقضية فكرية أو قضية سياسية معينة، نرى الشعراء المؤيدين لأهل البيت، ونرى شعراء الخوارج، وغيرهم من الطوائف والمذاهب المختلفة، ولست بصدد تأیید مذهب على مذهب، أو نصرة طائفة على طائفة وإنما يهمني هنا وجود مجموعات كبيرة من الشعراء تتبنى رأيًا، أو تؤيد فكرة، محاولة أن تعطي مفاهيمها مَسْحَة الإسلام الصحيح، وهؤلاء الشعراء الملتزمين قاسوا الكثير من الأهوال والتضحيات، كانوا يناصرون فئة مطاردة، أو زعيمًا محكومًا عليه بالموت، وكانوا معبرين عن الشجاعة الحقة، والرأي الحر دون خوف أو ملل، رفضوا إغراءات الحكم والمال والسلطة، ولم يرهبوا الوعد والوعيد، كانوا بالمصطلح الحديث «عقائديين» وبالمصطلح الفني «ملتزمين».
ونرى الشاعر كالمتنبي يخاصم أميرًا كسيف الدولة الحمداني، ويهاجر إلى مصر، ويحمل راية النقد والتحدي، فإذا ما تبين حياة الزَّيف والانحراف لدى كافور، حاكم مصر انقلب عليه، وهاجمه بكل عنف وشدة، وأتى بآيات الإبداع في رضاه وسخطه، في حبه وكراهيته، كان معبرًا عن ذات نفسه، وعن آلام المخاض في مجتمعه، وعن تعقبه لكل فساد سياسي أو أخلاقي.
وفي شعرنا القديم تراث عاطفي ضخم، تناول أدق مشاعر الإنسان، وعلاقات الحب والكراهية، والفراق والهجران، والظمأ الروحي، معطيًا صورًا حية لبيئات ومجتمعات متباينة، وما تزخر به من تقاليد وقيم وصراع.
وفي شعر التصوف ومضات مذهلة تشهد بعلو قدره، وعمق نبعه، وغوصه إلى أبعاد النفس، والفكر والوجدان، واليقين.
وتواكب شعر الطبيعة والوصف متميزًا بشتى الصور والرؤى، وأعطى قدرات باهرة في مصر والأندلس والمغرب والحجاز، ودمشق وبغداد وفارس والهند وغيرها.
ولم يكن شعر الوصف والعاطفة وقفًا على الوصف الظاهري والمشاهد العيانية، وإنما امتزج بنفس الشاعر، وأبان عن همومه وأحلامه وآلامه، فانعكست في شعره، وفاضت بالإيحاءات المختلفة.
ولم يكن شعرنا القديم مفتقدًا للوحدة العضوية للقصيدة دائمًا، ففي كثير منه ارتباط وثيق، متنوع الأساليب، متصل الحلَقات، ومن الظلم الفادح أن يوصم ذلك التراث كله بافتقاده لوحدة القصيدة، وترابط أجزائها.
وذخر شعرنا وأدبنا عامة باللمحات النفسية العميقة، وكان هذا أوضح ما يكون في شعر الحب العذري، والتصوف والخلافات السياسية.
وليس خافيًا أن آدابنا القديمة قد ارتبطت بقضايا عصرها، فصورت ما نشب من حروب وما تواتر على الأمة من نكبات سواء إبان الخلافات الطائفية والمذهبية الدامية، أو في الغارات الكاسحة من تترية ومغولية وصليبية، وفتن كقطع الليل، ولم يغفل جانب الحياة الاجتماعية بما فيها من رغد وسعادة، وما فيها من بذخ ولهو، وما يكتنفها أحيانًا أخرى من فقر وظلم وضياع، ولقد اصطبغت معاركهم -كما صورها الشعر- بصبغة الدين، وارتبطت بقيمه وهذا هو المهم، يقول شاعر وهو يخوض المعمعة الضارية:
أقول لها وقد طارت شعاعًا
من الأبطال ويحك لن تراعي
فإنكِ لو سألت بقاء يومٍ
على الأجل الذي لك لن تطاعي
فصبرًا في مجال الموت صبرًا
فما نيل الخلود بمستطاع
وأرى أن شاعرًا كهذا أصدق تعبيرًا، وأقرب إلى نفوسنا من عشرات القصائد التي تنشد في معركتنا اليوم مع إسرائيل، والشاعر لا ينكر هنا خوفه كبشر، وحرصه على الحياة كإنسان، لكنه يناقش نفسه نقاشًا قويًا مقنعًا عن الأجل الذي لن يطيله الحرص، وعن الخلود الذي لا وجود له، مستلهمًا تعابيره وقيمه من صُلْب العقيدة التي يؤمن بها، وما أقوى قول الشاعر محذرًا ومنذرًا وناقدًا:-
بني أمية هبوا طال نومكم
إن الخليفة يعقوب بن داوود
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا
خليفة الله بين الزق والعود
ولا يقف الشعر صامتًا والأندلس
يتهددها الفناء، والفرنجة يحيطون بها من كل جانب بل يصرخ في لوعة: أدرك بخيلك خيل الله أندلسًا
إن الطريق إلى منجاتها درسًا
ولا ينكر شعرنا القديم تفرغ فئة من شعرائه لمدح الملوك والعظماء، فمثل هؤلاء الشعراء موجودون في كل عصر، نراهم في ركاب كل حاكم من الحكام، يتوجونه بالأناشيد ويحلون صدور صحفه بالأماديح، ويعادون من يعادي، ويصادقون من يصادق، ومثل هذه الآفات التي لا يخلو منها عصر من العصور، لا يمكن أن تتخذ مقياسًا للتراث كله، ففي ذلك غبن وسوء نية، وهؤلاء الفنانون المنحرفون ليسوا فنانين بالمعنى الحقيقي للكلمة، وإنما هم مجندون لولي النعمة أو مساقون بسياط الرهبة والوعد والوعيد.
إن خطأنا الأكبر هو أن نطلب من أدبنا القديم أن يعبر عن عصرنا الحالي، وهو تعسف يشبه تمامًا من يطلب من أدبنا الحديث أن يعبر عن واقعنا بعد ألف عام مثلًا، والفن مرآة عصره، ينفعل بما هو واقع، أو يمتزج بالقيم والعقائد التي آمن أو يؤمن به الناس، والفن قد يجمع في طياته التعبير عن آلام الناس وآمالهم، فهو رفيق وهو قائد، وهو مكتشف شديد الحساسية لما ينبض به المستقبل القريب، وهو أمين على التراث الإنساني الأصيل، وهو ناقد ومجدد يرتاد التجارِب، ويغذي وجدان الإنسان على مر العصور بالأشواق الملائمة، وإذا كان الشكل الفني قد أصابه شيء من الجمود، فإنه كان دائمًا حي المضامين، متوتر النبضات، حاد الانفعال، باهر الإيحاء، وحينما وجدت الفرصة لظهور أشكال جديدة كالمسرح أو الرواية أو القصة القصيرة والتمثيلية التليفزيونية أو الإذاعية، استطاع أن يقدم روائعه، برغم ما كمن فيها من مروق فكري، وخداع عقائدي، وتوجیه سيئ.
لم يكن الأدب الإسلامي هروبيًا
نخلص من هذا كله إلى أن الأدب الإسلامي القديم لم يكن بالصورة التي حاول المغرضون والحاقدون تصويره بها، ولم يكن أدبًا هروبيًا خائنًا لقضايا التاريخ والإنسان، ولم يقصر جهوده على الأماديح والقوالب المصبوبة، لم يكن عبدًا مطيعًا للسادة والحاكمين، بل تمرد ونقد وحارب وخاض المعركة شجاعًا وتحمل تبعة هذه الشجاعة، وضحى الأدباء بحياتهم أحيانًا من أجل القيم العليا التي آمنوا بها.
ولقد وجد في عصر واحد آداب عدة، لكل نوع مسحته المحلية، في الحضر أو البادية، في المشرق أو المغرب، في هذا القطر أو ذاك من أقطار الإسلام وفي هذا انصياع للصدق الفني، والتعبير الذاتي، ورغم هذا التباين إلا أن أقلام الشعراء كانت تنغمس في النبع الفياض الذي يعمر بأمجاد الإسلام، وصفحات النضال المؤمن، كان معبرًا في غزلياته وأماديحه وزهدياته وخمرياته وعذرياته كانت صورة حية للعصور المتعاقبة برغم علوه أحيانًا وإسفافه أحيانًا أخرى، والآن ما هي الخطوط العامة لما يمكن أن يسمى أدبًا إسلاميًا؟
لقد قلنا في البداية إن عالمنا يطالب مفكريه دائمًا بالتحديد والوضوح، وأن أجيالنا إذا ما أصابت قدرًا وفيرًا من الاقتناع استطاعت أن تقود خطى لتحول إلى الأفضل، وأن تمسك من جديد براية: «الخلاص»، والريادة، ذلك الدور الذي قرره الله لها.
ولا أكتكم الحديث أيها الإخوة، إن الأمر يكتنفه قدر من الصعوبة والعسر، ومن ثم فإن المجال يجب أن يرتاده كل من يجد لديه الكفاءة في إلقاء الضوء على هذا الأمر، الذي نحاول عرضه في إطار الوثبات الفنية التي سادت فنوننا المعاصرة.
ما هو الأدب الإسلامي
سبق أن تناولت هذا السؤال بالإجابة في بعض المقالات الإذاعية أو الصحفية، وفي كتابي «الإسلامية والمذاهب الأدبية» وتناوله عددًا آخر من الكتاب أذكر منهم صاحب کتاب «منهج الفن الإسلامي».
ومن حسن الحظ أن الإسلام لم يحدد «شکلًا»، فنيًا معينًا يلزمنا به، بحيث ندور في إطاره، فلا نتعدى رسومه، وإنما حدد الإسلام «المضمون» أو الفكر الذي يتناوله الفنان في الشكل الذي يختاره.
لذلك نحن لا نختلف مع مؤلف «منهج الفن الإسلامي» حينما قرر أن الفن الإسلامي هو تعبير فني عن الكون والإنسان والحياة من خلال تصور إسلامي، فللإسلام نظرة خاصة لهذه الأشياء كلها، ولعلاقاتها وصراعاتها، وصلتها بالإنسان المسلم فالإنسان سيد الكون والمخلوقات، وبالتالي فالمخلوقات من حيوان وجماد سخر لهذا الإنسان، وخلافة الإنسان في الأرض تجعل منه السيد المتصرف في هذه الكائنات والمخلوقات في الحدود التي رسمها الدين، والطبيعة في نظر المسلم مشهد من مشاهد الجمال، ومصدر من مصادر التأمل والاستفادة والاستمتاع، وليست إلهًا يعبد وترتل حوله الترانيم والطقوس التعبدية.
والإسلام يختلف عن غيره من الفلسفات الإنسانية، فمن الفلسفات من يرى أن الإنسان طبيعته الشر، وأن الأصل في الحياة الكذب والنفاق والجبن، حتى قيم الشجاعة والكرم والصدق ما هي إلا رياء ونفاق، وأنها تخفى خلفها أضدادها، هذا واضح في «الواقعية السوداء» كما يسمونها، وهناك فلسفات أخرى لا تضع الإنسان موضع السيادة فحسب، بل تجعل منه إلهًا بذاته، منه وحده تنبع كل القيم والمبادئ، هو حر في تصرفه، لا يربطه بهذا العالم إزاء هذه الحرية المطلقة إلا تحمل المسئولية، كما يرى «الوجوديون»، وفي ذلك ضرب من الأنانية والتعالي والتمرد على كل دين وقيمة، بل رفض لكل القيم القديمة إطلاقًا.




