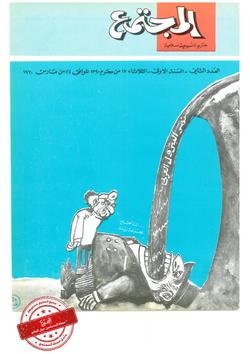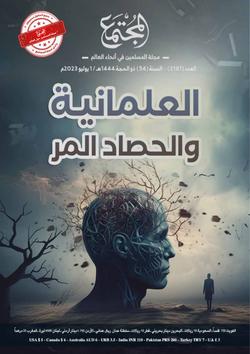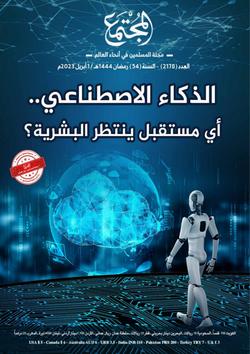العنوان دراسة فكرية.. المنهج الإسلامي بين الوسيلة والغاية (العدد 92)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 21-مارس-1972
مشاهدات 64
نشر في العدد 92
نشر في الصفحة 12
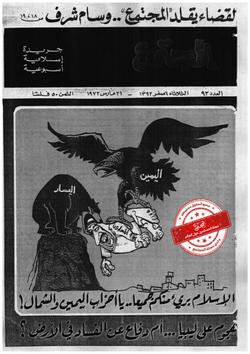
الثلاثاء 21-مارس-1972
دراسة فكرية
المنهج الإسلامي بين الوسيلة والغاية
يكتبها: أبو سمية
الحلقه السادسة
كيف نفهم المنهج الإسلامي؟
يجب أن يعترف «الإنسان» سلفًا ببعض الحقائق، وإلا فإن السير معه في الطريق خداع ومغالطة.
يجب أن يعترف «الإنسان» بأنه أقل من أن يحيط بالكون المحيط به لسبب بسيط.. لأنه جزء بسيط جدًا في هذا الكون، ولأن إقامته محدودة على هذا الكون، ولأن المصباح الذي فـي أعماقه لا يكفي لاستكشاف كل أبعاد الطريق.. بل إن في الطريق مراحل لا يمكن الاستدلال عليها بوسائل مادية بالمرة كمرحلتي ما قبل الوجود وما بعده.
«والجهد الفلسفي» الذي يحفل به الفكر الإنساني، هو بعض تراث الإنسان الهام، لكنه لا يفعل شيئًا في الطريق لأنه -بدوره- جزء من ذلك المصباح الخافت الكامن في أعماق الإنسان.
ومن هنا فالعلمية كل العلمية تتطلب ألا ينفي الإنسان شيئًا، لأنه لم يدركه أو لأنه لا يستطيع إدراكه.. وليس له بالتالي أن يرفض «الإجابات الأعلى» التي تساق إليه، والتي لم يكن يستطيع -بمفرده- الحصول عليها، وهذه التي أسميها «الإجابات الأعلى» هي أول أعمال الإسلام.
الإيمان بالله.. وقدرته على الخلق.. بالملائكة.. بالوحي.. بالآخرة والبعث والحساب والجنة والنار، إلى آخر هذه الغيبيات.
الإيمان بكل هذه الغيبيات وغيرها.. هو التصور الإسلامي لبعدين من أبعاد قصة الوجود.. وهو المكمل لقصة الوجود، وهو -وحده- القادر على إعطاء هذه القصة انسجامها وحبكتها، بل ومبررات خلقها وإبداعها.
وسواء رضي المنهج الذي يسمى «علميًا» بهذا الإيمان أو لم يرض، فإن قصوره الأبدي عن الوصول إلى حل لهذه المشاكل الأزلية الكبرى، يجعل عدم قبوله للتصور الإسلامي لونًا من التحجر.. أضف إلى هذا أن المنهج العلمي نفسه لم يجد حلولًا «علمية» لكثير من مشاكله هو.. فلا يزال يستعمل كلمات لا يستطيع التأكد من كنهها بطرائقه المحسوسة، ومن هذه الكلمات مصطلحات «الطاقة، القوة، الجاذبية، الارتقاء، قانون الطبيعة... إلخ» إنه فقط قد اصطلح على استعمالها للوصول إلى أغراضه.
فليس من حق هذا المنهج -وهذا شأنه- أن يحجر على «التصور الإسلامي» الذي ينطلق من بعض المسلمات -الحقيقية في تصوره- بل ليس من حق هذا المنهج «العلمي» كذلك أن يتكلم في تفسير التاريخ وتفسير الإنسان، لأنه لا يملك إلا بعدًا واحدًا من أبعاد التاريخ وأبعاد الإنسان.. إن البعد الزمني الذي يتناول الإنسان الموجود، أو بتعبير آخر «الإنسان التاريخي» المشاهد، لكن تفسير ما وراء «الظاهرة الإنسانية» قبلًا أو بعدًا أكبر من أن يحيط به أو يتكلم فيه هذا المنهج «العلمي»، حتى وإن كان هذا المنهج قد تكلم وأصدر أحكامًا طائشة لا رصيد لها من اليقين، على أن الإسلام -الذي هو كلمة الله الأخيرة إلى الأرض- هو الذي يملك وحده ما لا يملكه العلم، لأنه يستطيع أن يتكلم منطلقًا من كل الأبعـاد، ومستوعبًا كل كيان الإنسان.
إن الإسلام لا يستطيع فحسب الإجابة على سؤال الوجود الخطير.. إنه نفسه جاء -أولًا وقبل كل شيء- للإجابة على هذا السؤال.
* * *
لعل القارئ سيلحظ أني قد عمدت إلى أن أتخطى في هذه الدراسة تلك الوقفات الجزئية، التي يصر بعض المفكرين التقليديين على الوقوف عندها، ويضخمونها لدرجة تحجب بقية البناء الإسلامي عن أداء دوره، وتختلف هذه الوقفات بحسب الأهواء والنزعات.
فالذين غلبوا على أمرهم أمام المادية الغربية، وما تشيعه في المناخ الفكري العالمي من شعارات خلابة.. يبحثون في الإسلام عما يؤكد هذه الشعارات، دون مراعاة للحجم الطبيعي لهذه الشعارات في الإسلام، ودون مراعاة لمدى اتصال هذه الشعارات بالقيم الإسلامية الأخرى.
والذين ينتمون إلى لون حضاري -أكثر مادية- «كالماركسيين مثلًا» يروحون بالتالي يبحثون في الإسلام عن تأكيد هذا الجانب المادي، دون أخذ في الحسبان للاعتبارات الضرورية الأخرى التي ذكرناها.. إن هؤلاء وأولئك حين يقرأون الإسلام، يقرأون ما في نفوسهم وأفكارهم الخاصة ولا يتمكنون من قراءة الإسلام نفسه.
لن نتكلم إذن عن الحرية في الإسلام، ولا عن المساواة في الإسلام، ولا عن «الاقتصاد الإسلامي»، ولا عن «المنهج الاجتماعي» في الإسلام.
لا نعرض لهذا أو ذاك، فإن هذه وغيرها مجرد لبنات صغيرة في البناء الإسلامي الكبير.. ونحن هنا إنما نتحدث عن «البناء الكبير» أي عن الإسلام.
* * *
لم يأت الإسلام ليكون «نظرية» تخضع للتطـور التاريخي ولاختلاف الزمان والمكان، فالإسلام ليـس «وجهة نظر» ذات بعد خاص، وذات رأي جزئي ينطلق من إيمان بعنصر معين، وليس كل عمله أن يفضل هذا العنصر على عناصر أخرى.
إن الإسلام «قانون» يسير مع الزمان والمكان كقواعد كلية تترك للزمان والمكان حرية التطبيق في حدود هذه القواعد.
وإذا كان الإسلام أساسا قد ألزم بوجوب الإيمان، ببعـض الكليات التي تفوق طاقة العقل البشرى، فإن هذا لا يعني «الحجر» على هذا العقل أو فرض «معميات» عليه.. وكل ما هنالك أن هذا هو مركز الإنسان وهذه هي طاقته.. وإن ترك الإنسان ليسير في دروب مظلمة، تبديد لطاقته العقلية فيما لا يجدي.
فالعقل في الإسلام مطالب بأداء دوره في حدود «مرحلة الوجود التاريخـي»، ومطالب بأداء دوره في فهم إمكانية وجود هذه المرحلة، ومطالب بأداء دوره في مشروعية وجود مرحلة ما بعد الوجود المشاهد.. ومطالب بأداء دوره في فهم كثير من تفصيلات مرحلة الوجود الزمني التـي يعيشها.
فالعقل -كما نرى- يعمل في كثير من مجالات قضية الوجود بأبعادها الثلاثة.. وليس ثمة مجالات تُفرض عليه إلا تلك التي لا يستطيع بطبيعة حجمه أن يستوعبها.
* * *
إن الإسلام يعتبر الوجود المشاهد المحسوس مرحلة هامة وحيوية، وهي وثيقة الصلـة بمرحلة ما بعد الموجود.
والأديان على وجه العموم -والإسلام على وجه الخصوص- هي التي تناولت قضية ما بعد الوجود، أما المذاهب الوضعية والفلسفات المادية والأرضية، فإنها تعلن رفضها لهذه المرحلة.
ومنذ مراحل ساحقة ومنطق الماديين واحد ﴿وَقَالُوٓاْ أَءِذَا ضَلَلۡنَا فِي ٱلۡأَرۡضِ أَءِنَّا لَفِي خَلۡقٖ جَدِيدِۢ بَلۡ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمۡ كَٰفِرُونَ﴾.. أما منطق الإيمان أو الأساس الديني فهو ﴿۞قُلۡ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلۡمَوۡتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ تُرۡجَعُونَ﴾.
وعلى أساس هذه العودة الحتمية إلى الله بعد انتهاء مرحلة الوجود، يبني الإسلام كل أحكامه، فكل أحكامه تمهيد لهذه العودة الحتمية.
﴿وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ﴾ -أولًا- ثم بعد ذلك ﴿وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ﴾، وفي النهاية ﴿وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ﴾.
وفي الطريق إلى تصور هذه العودة، يلاحظ أن الإسلام لا يتصور الإنسان في معاملته له بعيدًا عنها.. فالحياة الرخيصة المحدودة لا يمكن أن تكون كل حدود الوجود الإنساني.. ذلك أن الوجود الإنساني تنتابه علامات استفهام كثيرة ناقصة، تنتظر هذه العودة لتحقيق إجاباتها الكاملة.
والمظلوم والمقتول.. والقاتل والظالم.. لا بد أن يلتقيا.. والمرتشي والغاش.. والمزوّر والمتاجر في الآثام.. هؤلاء وغيرهم من الذين يفلتون -في كثير من الأحايين- من يد القانون البشري لا بد أن يكون لهم عقاب يوم القيامة، وهتلر وموسولینی وستالین والذين حولوا طرقات مدن كبرى إلى أنهار تمتلئ بالدماء البشرية.
هؤلاء لا بد أن يؤدبهم الله على إهدارهم لحياة لم يخلقوها، وليس من حقهم إعلان نهايتها.
ولأكثر من سبب، يطرح الإسلام قضية الآخرة على أنها قضية حتمية، وعلى أنها الشطر الأكبر المكمل لحركة التاريخ الإنساني.
وعمومًا، فالدنيا والآخرة نصفان يكمل أحدهما الآخر، وهذه الحقيقة التي تمثل قضية من أبرز قضايا الإسلام.. من أبرز الخيوط التي توضح معالم المنهج الإسلامي، وهو يسير في طريقه من الوسيلة إلى الغاية.
أبو سمية «يتبع»
تصویب
في عدد ماض، ورد خطأ تعبير: الإسلام يجعل الحياة غاية، والصحيح هو: الإسلام يجعل للحياة غاية.