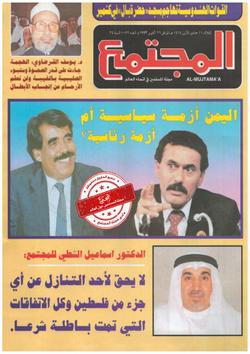العنوان في فقه الدعوة(٢٢).. اتزان التوسع
الكاتب محمد أحمد الراشد
تاريخ النشر الثلاثاء 24-أكتوبر-1972
مشاهدات 15
نشر في العدد 123
نشر في الصفحة 24
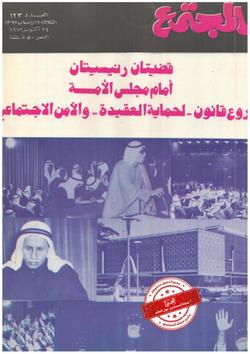
الثلاثاء 24-أكتوبر-1972
أول ثمرات العزة الإيمانية التي يحسها المؤمن: إدراكه ما في الإسلام من قوة الحقيقة التي يكفي لكي تعلن عن نفسها - أن تتمثل في فرد واحد، وما في الآراء الجاهلية المخالفة من زيف الباطل، واحتياجها إلى سواد كثير وعدد كبير من الأفراد، يأسر منظرهم كل ساذج، فيغتر، وينطلي زيف الباطل عليه، دون أن يدرك ما هم فيه من الضلال.
ومن ها هنا رأينا تُمثل الأمة الإسلامية أكثر من مرة بمؤمن واحد فقط، كما قال الله تعالى:
﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (النحل: ١٢٠).
قال ابن تيمية: «أي كان مؤمنًا وحده وكان الناس كفارًا جميعهم». (١)
وفي صحيح البخاري أنه قال لزوجه سارة: «يا سارة: ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك». (۲)
ثم كما تمثلت حينا بمحمد -صلى الله عليه وسلم- وحده.
ومن ها هنا أيضًا انسد باب شعور المؤمن بالغربة، فهو -لأنه يمثل الإيمان والحقيقة- يشعر بأن الناس جميعًا وهم في ضلالهم هم الغرباء التائهون.
ولذلك، فإنه لمّا توهم واهم فوصف عبد الوهاب عزام بالغربة، كان جوابه سريعًا، فقال:
قال لي صاحب: أراك غريبًا بين هذا الأنام دون خليل
قلت: کلا، بل الأنام غريب.. أنا في عالمي، وهذي سبيلي. (۳)
أما غربة الغرباء الذين ذكروا في الحديث الشريف: «طوبى للغرباء» فهي غربة بالنسبة للواقع، أي لندرتهم وقلتهم بين غثاء ضال، أما في عالم الضمير والشعور فإن للمؤمن الفرد من إيمانه أنیسًا ورفيقًا وخليلًا يبعد الغربة.
ليس علينا غير البلاغ
وهذا التباين في شعور الداعية إلى الإيمان عن شعور الداعية إلى الباطل جعل دعاة الباطل في تعب دومًا، وفي تبديل لصور باطلهم حين لا تنطلي على الناس، ويبررون ذلك بالتطور الفكري والديالكتيك ويرون -بعقلية تجارية بحتة تضع حساب الأرباح والخسائر المادية فحسب- أن من يتكلم ويكتب لإشاعة فكرة معينة ولا يستجيب له الناس عليه أن يسارع إلى تبديلها بأخرى تجد لها تصريفًا.
أما الداعية المسلم فهو يعتقد بأن عليه تحري القول الصائب الموافق للشرع، واتباع الأسلوب الملائم حسب اجتهاده، ثم الله هو الذي يتولى ما بعد ذلك، فإن لم يستجب أحد فلحكمة ربانية، ولو شاء الله لهداهم، ولكن كره الله انبعاثهم مع الدعاة، ولا يسع الداعية المسلم إلا الثبات على ما يعتقد.
وبهذا الوعي لهذه الحقيقة الإيمانية أجاب يوسف القرضاوي من اعترض عليه، فقال:
عجبت لهم قالوا: تماديت في المنى
فأقصر ولا تجهد يراعك إنما
فقلت لهم: مهلًا، فما اليأس شيمتي
إذا أنا أبلغت الرسالة جاهدًا
وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعب ستبذر حبًّا في ثرى ليس بالخصب
سأبذل حبي والثمار من الربِّ
ولم أجد السمع المجيب فما ذنبي؟ (٤)
وهذا من قوانين الدعوة الإسلامية.
إننا إذا لم نصل إلى ما نبغي ونريد، فحسب عملنا أن يشجع الجيل اللاحق على مواصلة السير، فإن النجاح في الابتداء دليل على إمكان الانتهاء، أو كما يقول الرافعي:
«البدء في تحقيق الشيء العسير: حسبه أن يثبت معنى الإمكان فيه». (٥)
ووجوده هذه النماذج الجيدة من دعاة الإسلام في كل مدينة من مدن الإسلام حسبه أن يثبت معنى إمكان تطبيق المثل العليا الإسلامية من خلال تجمع حركي في وسط جاهلي مظلم قاتم.
وهذا الإثبات هو منطلقنا لمواصلة السير، والإكثار من تربية مثل هذه النماذج، حتى نصل حدًّا عدديًّا كافيًا لهداية الجاهلية التي من حولنا.
فإن لم يستطع الدعاة اليوم اقتلاع هذه الجاهلية فحسبهم أنهم كانوا -كما يقول سيد قطب: «إجراء عند الله، أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا: عملوا وقبضوا الأجر المعلوم! وليس لهم ولا عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، فذلك شأن صاحب الأمر؛ لا شأن الأجير». (٦)
نريد أن نكون أئمة
وإنما ذاك ما يقتضيه الإيمان.
وإلا فإن في الفطرة ميلًا إلى كثرة الأنيس، والعين تحب أن تقر بتسلط الإيمان على الكفر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
وهذا ما يجعل الداعية حريصًا كل الحرص على تعلم فنون الدعوة، لينجح في نقل مزيد من الشباب من التيه إلى الطريق المستقيم، وتراه ينتشي ويبلغ أقصى اللذة حين يأخذ بيعة جديدة، ويكون من أحب أدعية القرآن لديه أن يقول:
﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (الفرقان: ٧٤).
وما دعاؤه هذا من الاستشراف للمسؤولية والتزعم وحب الظهور بحيث يكون مكروهًا، بل كما قال ابن القيم: "هو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إمامًا، يقتدي به المتقون، كما اقتدى هو بالمتقين".
فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلًا، وفي قلوبهم مهيبًا، وإليهم حبيبًا، وأن يكون فيهم مطاعًا لكي يأثموا به ويقتدوا أثر الرسول على يده: لم يضره ذلك، بل يحمد عليه، لأنه داعٍ إلى الله يحب أن يُطاع ويُعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونًا على ذلك موصلًا إليه، ولهذا ذكر –سبحانه- عبادة الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (الفرقان: ٧٤).
فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته، فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة، فإنما سألوه ما يعينون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين». (۷)
سعة التجميع تتناسب مع طاقة التربية
ولكن حب الإمامة في الدين يجب ألّا يخرجنا إلى نوع تساهل في الصفات الإيمانية والطبيعية التي نشترطها لمن يريد أن يكون مع الركب، ويجب أن يكون هناك -على طول الخط- تناسق وتوازن بين سعة التجميع وسعة طاقة التوجيه التربوي التي تملكها، فإن من أخطر الأخطاء أن تتوغل الدعوة في تجميع واسع قبل أن تكون هناك صفوة من الدعاة قادرة على أن تتولى تربية كل الذين يتجمعون حولها، بل يجب أيضًا أن يبقي رجال الصفوة بعض أوقاتهم لمواصلة تربية أنفسهم هم بالعلم والعبادة، وإلا قست قلوبهم من بعد لذة الابتداء، وإذا قست القلوب فقدت شيئًا من معاني الأخوة.
هذا التوازن ليس بخاص في بداية الدعوة، وإنما يجب أن يكون هو المسيطر على سعة التجميع في أدوار الدعوة كلها، وإلا تسرب الخطر.
ومن هنا فإن الخطة لا تتصور احتمال حيازة رجل الشارع واستقطاب الجماهير الواسعة، بل لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا خرجنا إلى نوع تساهل في الشروط، ومن المزالق أن تسير الدعوة وراء رجل الشارع حريصة عليه قبل حصول المقدار اللازم من الوعي الإسلامي والعدد الكافي من أصحاب التربية الصلبة.
إن المتولعين بالسياسة من الدعاة يريدون للدعوة أن تدخل في سباق مع الأحزاب لاكتساب رجل الشارع، في الوقت الذي أبان رجل الشارع في البلاد الإسلامية كلها عن طبيعته في قلة استعداده للسير الطويل مع جماعة معينة.
رجل الشارع «*»، والغوغاء، والدهماء، والمصفقون: هم مادة الأحزاب الجاهلية الأرضية وعنصر حياتها، لأن هذه الأحزاب تستطيع أن تبدل وتحور برامجها وفق طلبات هؤلاء وتبعًا لاستهلاك السوق.
أما الدعوة الإسلامية فما بمثل هؤلاء تنتصر، وما بمثل هؤلاء تغير مجرى الحياة من الجاهلية إلى الإسلام.
إن التجميع القطيعي ممكن، لكنه لا يستمر طويلًا.
هذا فضلًا عن أن التجميع الواسع ينتقل بالدعوة إلى وضع جديد تحتاج فيه إلى كفايات ضخمة تستخدمها في الإدارة، وإلى قدوات عالية المستوى لإدامة بقاء التجمع في رحاب الحياة الروحية أثناء انغماس الجميع بكثرة الأحداث.
وإذا لم توجد مثل هذه الكفايات والقدوات قبل بدء التجميع الواسع والعمل مع رجل الشارع فإن الدعوة تكون قد عملت على إيجاد جماهير تنتسب إلى الإسلام، لكنها ذات رغبات ساذجة تنفر من الخطوات الحكيمة وتندفع اندفاعات غير موجهة ولا هادفة، وربما طوعت الإسلام لقبول ما ليس منه وحملت مفاهيم مشوبة بنظريات الكفر وعقائد مختلطة بالبدع.
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٣٦/١١
(٢) صحیح البخاري ١٧١/٤
(۳) ديوان المثاني / ٣٤
(٤) مجلة «المباحث المصرية» عدد 31 لسنة ١٩٥١
(٥) وحي القلم ۲۱/۱
(٦) معالم في الطريق /۱۸۱
(۷) الروح لابن القيم /٢٥٢
• الدعوة إلى الله ينبغي أن توجّه لكل الناس.. فمن بين صفوف الناس العاديين تخرج نماذج رفيعة تسبق من حمل إليها الهدى.. في طريق العمل والسمو الروحي.. ولقد عاتب الله -سبحانه- نبيه محمدًا -صلى الله عليه وسلم- في حادث ابن أم مكتوم (وهو رجل أعمى وفقير ومن عامة الناس) حين جاء يطلب من الرسول أن يعلمه مما علمه الله فانشغل الرسول -عليه الصلاة والسلام- بأمر جماعة من كبراء قريش، انشغل بهدايتهم وعرض الإسلام عليهم.. وأعرض عن ابن أم مكتوم... هنالك جاء الوحي على عجل يحمل هذا العتاب: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ (عبس: ١١).
وبهذا تقرر توجيه الدعوة إلى عامة الناس -حتى في فترة النشأة والتكوين- والعمل داخل صفوفهم.. فلعلهم يزكون.. أو يذكرون.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل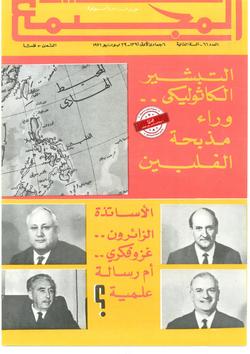
ماذا دار بين الدكتور القرضاوي والسكرتير الأول للسفارة الأمريكية بالدوحة
نشر في العدد 1081
13
الثلاثاء 28-ديسمبر-1993
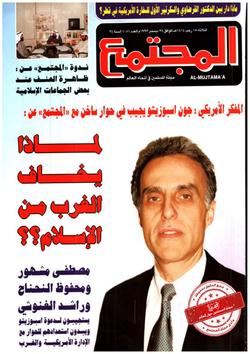
د. يوسف القرضاوي «للمجتمع»: الهجمة جاءت على قدر الصحوة وستبوء الصليبية بالخيبة ولن تعقم الأرحام عن إنجاب الأبطال
نشر في العدد 1072
16
الثلاثاء 26-أكتوبر-1993