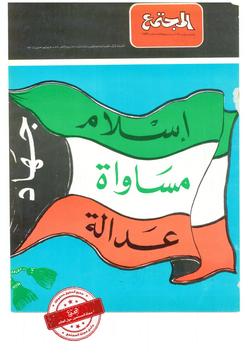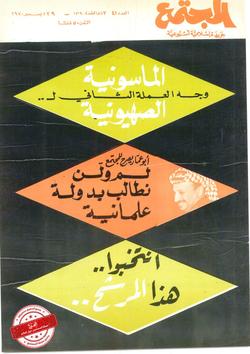العنوان قرأت لك كتاب منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب
الكاتب علي عبد العزيز
تاريخ النشر الثلاثاء 17-سبتمبر-1974
مشاهدات 11
نشر في العدد 218
نشر في الصفحة 40
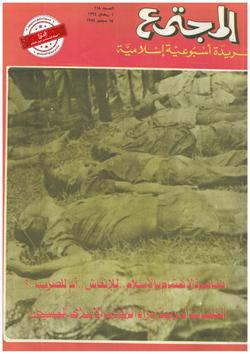
الثلاثاء 17-سبتمبر-1974
التكامل والتوازن في التربية الإسلامية
معًا.. الوسائل والأهداف
الفردية والجماعية.. والسلبية والإيجابية
۱- تعریف: هذا الكتاب منهج كامل مستمد من كتاب الله وسنة رسوله وهو منهج فريد إذ إن كل المناهج الأرضية تسعى إلى تكوين المواطن الصالح لكن الإسلام يسعى إلى الإنسان الصالح.
ووسيلته في هذا هي أن يأخذ الإنسان ككل بحيث ينفذ إليه من جميع منافذه ليحرك كل أوتار كيانه فهو يربي روحه وعقله كما يربي نفسه وجسمه كل ذلك بالقول والعمل والقدوة والقصة والعادة والحدث والمنمة والممنة وهكذا حتى يتشكل الفرد الصالح ثم المجتمع الصالح ثم الأمة الصالحة التي عناها الله بقوله: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران: 110)
۲- الوسائل والأهداف: هذا المنهج لا يقول كما قالت «المكيافلية الإيطالية»: «إن الغاية تبرر الوسيلة» وإنما يقول: إنه لا يمكن تقويم الهدف بدون الوسيلة ولا تقويم الوسيلة بمعزل عن الهدف، وإن كان الكثير من الوسائل لا يحكم بذاتها على المنهج؛ لأن الوسيلة قد تكون واحدة ومع ذلك تتعدد الغايات.
فالرياضة البدنية وسيلة تربوية ولكن يمكن ألا تحدد منهجًا ولا ترسم طريقًا، فهي يمكن أن تتخذ ذريعة لتربية الطاعة والنظام كما كانت في «ألمانيا النازية»، ويمكن أن تربي التعاون والروح الجماعية كما يقصد بها في «إنجلترا» وهكذا وهكذا.. إلخ. وهكذا القصة وسيلة للتربية، ولكنها يمكن أن تربي في النفس الحس المرهف والذهن الصافي.
وكذلك يمكن أن تتخذ للعبرة والتثبيت، وأيضًا أن تتخذ للتسلية وهكذا وهكذا.. إلخ. فالوسيلة الفاسدة يمكن أن تضيع الهدف الصالح وتحيد بأصحابها عن الطريق المستقيم.
٣- الروح: عني الإسلام أول ما عني به الروح؛ لأنها طاقة في الإنسان مجهولة محجوبة عن الإنسان تمامًا كالإدراك والتذكر والأثير والكهرباء وما إلى ذلك من طاقات لا يمارس أحد في آثارها وإن عجز عن ذاتها وكنهها وماهيتها ﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾، ﴿هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾ إنها من أمر الله ولا يمكن أن يكون لها غذاء تعيش به وتحيا عليه إلا من الأصل الذي خلقت منه وصدق الله إذ يقول: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ﴾.
إذن فلا حياة للروح الإنساني قيمة ومثلًا وخلقًا وأسلوبًا وسلوكًا إلا بهذا الكتاب؛ لأنه: ﴿يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾
٤- العقل: هو اللطيفة الربانية والأداة التي يربط بها الإنسان أفعاله وهو مناط التكليف في الإنسان ولولاه لسقط التكليف عنه طيلة الحياة بدليل رفع القلم عن الطفل حتى يرشد وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وغير هؤلاء وأولئك ممن لا يكلفهم الشرع مالا يطيقون كصاحب الإغماء وصاحب البنج والسكران «يغض النظر عن وقوعه في الحرمة» وما شابه ذلك من حالات.
لذلك نرى النصوص تخاطبه بمختلف الأساليب تقديرًا وتكريمًا.
فتارة بالدعوة إلى النظر وأخرى بالدعوة إلى التفكر وأحيانًا بالدعوة إلى التذكر وأحيانًا أخرى بالدعوة إلى التعقل، بل يوضح الإسلام أن السبب الوحيد لدخول الناس سخط الله دوار العقاب هي عدم استعمال هذه الأداة وإغفالها كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ والإسلام يربي العقل عن طريق وسيلتين:
الأولى: أن يبدأ بتفريغه من كل المقررات السابقة التي لم تقم على يقين ثم يوصله بعد ذلك إلى مرتبة التثبيت في كل أمر قبل اعتقاده به واقتفائه فيقول سبحانه: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾
(سورة الإسراء: 36)
الثانية: وهي تدير نوامیس الكون بحيث يطبع العقل بطابع من الدقة والتنظيم، فهو يرى نوامیس الكون تجري في دقة عجيبة ونظام لا يختل «وأنه فوق ما يوحيه ذلك للقلب البشري من تقوى الله والتوجه إليه في كل أمر» فإنه يعود العقل على دقة النظر وانضباط الأحكام وصدق الله إذ يقول: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ (سورة النساء: 105).
ثم يوجه العقل بعد ذلك إلى رحابة التشريع وحكمة التشريع وشمول التشريع، ففي القصاص حياة وفي الحدود روع، وفي التعزير فرصة وفي الصيام حكمة وفي الخمر عبرة وفي الطلاق أناة وفي القرض صدقة وفي الزواج مسكن وفي الشهادة حفاظ وفي التحريم رحمة وفي المباح فضل... إلى غير ذلك من أمور يطول الشرح لعرضها.
كل ذلك لكي يستطيع البشر أن يعوا حكمة التشريع وإلا فلن يطبقوه على تمامه ولن يطبقوه على وضعه الصحيح.
٥- الجسم: حين يتحدث الكاتب عن الجسم لم يقصد عضلاته فحسب وإنما يقصد الطاقة الحيوية المنبعثة عن هذا الجسم؛ ذلك لأن هناك اتصالًا وثيقًا بين النفس والجسم وتفاعلًا مشتركًا بينهما يتمثل ذلك في مشاعر النفس ثم النزوات والرغبات والدوافع إلخ..
والإسلام في تربيته للجسم يراعى الجسم من حيث هو جسم ليصل منه إلى الغاية وهي النفس ومن هنا يقول رسولنا- صلى الله عليه وسلم-: «إن لبدنك عليك حقا».. حتى يمكن أن يقوم بواجبه في الحياة نتيجة الطاقة المتولدة عن هذا الجسم الذي نال حظه من إطعام ثم راحة ثم نظافة ثم كذا ثم كذا.. إلخ.
إن الإنسان خلق في هذا الوجود مزدوج الطبيعة مزدوج النظرة مزدوج الاتجاه، فهو من طين وروح وهو مخير بين اتجاهين وعلى هذا الأساس جعل الله له من رحمته غذاء لكل قسم من طبيعته، فكما جعل للروح غذاءها من أمره سبحانه، جعل للجسم غذاءه من أصل خلقته؛ ذلك لأن الروح لا تقوم بواجبها إلا إذا أخذت بحظها من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- كذلك الجسم لا يقوم بوظيفته في هذه الحياة ما لم يتزود من طعام وشراب وما إلى ذلك أمور.
وقد روى أن خالد بن الوليد -رضي الله عنه- قال لخادمه يومًا عندما عاد من بعض طلعاته في الحرب ولم يجد طعامًا قد أعد بعد فسأله عن الطعام فقال الغلام: إنك صاحب رسول الله وإنك تجاهد في سبيل الله فكيف يشغلك شيء من هذه الحياة؟ فنهره خالد -رضي الله عنه- بقوله: ثكلتك أمك: ألم تسمع قول الله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ (سورة الأنبياء: 8).
وليس معنى ذلك أن الإنسان يأتي على كل شيء في هذه الحياة من متاع وضياع ولكن هناك أمرين لا ثالث لهما وهما: الضبط ، والكبت فالضبط ليس كبتًا والعكس كذلك فالضبط هو امتناع واع عن الإتيان لأي عمل غريزي، ولذا فهو ضروري لحفظ الكيان الفردي أو الجماعي، ومثال ذلك:
إني جائع من حقي الأكل والشراب وليس في رغبة الطعام عيب ولكن ليس معنى ذلك أن آكل حتى التخمة؛ لأن ذلك يفسد معدتي ثم يجعلني بعد ذلك عرضة لنهم دائم لا يشبع، وليس معنى ذلك أن أذل كرامتي لأكل، وليس معنى ذلك أن أسرق لآكل، وليس معنى ذلك أن أعيش لآكل؛ لأن في الحياة أهدافًا أخرى وعلى هذا الأساس قس سائر الأمور من جنس واحتلال وإبقاء على الذات إلخ..
أما الكبت وإن تشابه مع الضبط في الامتناع إلا أنه مغاير تمام المغايرة للضبط- فليس الكبت إذن هو الامتناع عن إتيان العمل الغريزي.. الامتناع الواعي المقصود «كما سبق شرحه» وإنما الكبت هو استقذار الدافع الغريزي واستنكاره وعدم اعتراف الإنسان بينه وبين نفسه بأنه يحق له أن يشعر بوجود ذلك الدافع أو يخطر له على بال، وهذا المعنى لا يوجد في الإسلام أصلًا؛ لأنه من قبل الخالق الذي يعلم ما في الإنسان من ملكات وقدرات ورغائب: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾
لقد قال «فرويد» الذي أفنى حياته في الحديث عن «الكبت»: «هناك فرق بين هذا الكبت اللاشعوري وبين الامتناع عن إتيان العمل الغريزي، فهذا مجرد تعليق للتنفيذ».
٦- الخوف والرجاء: خطان متقابلان من خطوط النفس يوجدان فيها متجاورين مزدوجي الاتجاه؛ لأن النفس بطبيعتها «كما ركبها وخلقها وصنعها صاحبها» لتخاف وترجو، تخاف الظلمة وتخاف السقوط وعلى العكس ترجو النور وترجو النجاح.. إلخ وصدق الله إذ يقول: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ (سورة البلد: 10) ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (الإنسان: 3) ﴿كُلًّا نُّمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ﴾
(سورة الإسراء: 20) ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ (سورة الحجر: 29). فهذان الخطان إن لم يراع الإنسان التوازي دائمًا قولًا وعملًا وسلوكًا وأسلوبًا لهذين الخطين وقع لا محالة في بعض الاضطراب؛ ذلك لأن الإسلام يعمد إلى خطي الخوف والرحابة فينفض عنهما كل خوف فاسد وكل رجاء منحرف ثم يعمد عليهما فيوقع عليهما الإيقاع الصحيح.
فلا يصح أن يخاف الإنسان من الموت؛ لأن الخوف لا يقدم ولا يؤخر في شيء من المكتوب فضلا عن الإرهاق الزائد على كاهل الإنسان، ثم ينفض عنه أيضًا الخوف من الرزق؛ لأن الرزق مثل الأجل أمران لا ينفع معهما الخوف لحتمية الكفالة الإلهية لهما فضلا منه سبحانه ورحمة.. وعلى هذا قس سائر الأمور من قضاء وقدر، وهكذا نفس الصورة مع الرجاء أن الإسلام يبدأ بتحويل الرجاء والآمال الكاذبة؛ ليوجهها الى الرجاءات والآمال الحقيقية الصادقة.
الإنسان يرجو الكثير من ألوان النعيم من مال وبنين وشهوة وقوة وجاه وسلطان إلى آخر ما هو في الحياة من متاع وضياع فلا بأس من ذلك بشرط ألا يكون هناك إيغال هذا فتصير حجابًا له عن اللــه ورضائه، ومن هنا يقول القرآن:
﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا﴾
٧- الحب والكره: هذان خطان حران من خطوط النفس المزدوجة مقابلة منع الإسلام فيهما ما صنعه الخطين السابقين فيحكم أولًا بارتباط الوترين المتجاورين ثم يوقع علي كل منهما بلا تراخ ولا توتر شديد، فالإنسان يحب نفسه حبًا مفرطًا ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾
حب الاستمتاع بكل ألوان الملذات الحسية والمعنوية، ثم تجده أيضًا يكره الكره كل عقبة تقف في سبيل هذا الاستمتاع وبالتالي يكره كل ما يؤذيه أو يسبب له ضررًا ماديًا أو أدبيًا، تلك نغمات تصدر عن وتري الحب والكره بعضها لا شك صالح يثير منها طالح، وهنا فقط يأتي الإسلام لا ليحارب الفطرة ولكنه ليدربها ولا ليكتب الدوافع ولكن لسبطها: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ إن الحب فطرة في الإنسان غير أن الإسلام يوجهه لحب الخير، فحب النفس لا بأس به بشرط ألا تكون أنانيًا، وحب المال لا بأس به بشرط ألا تكون بخيلًا على نفسك وشحيحًا على نفسك، وحبك فطرة بشرط ألا تنسى نصيبك من الدنيا، وحبك للكون فطرة بشرط ألا يصير معبودك من حيث جماله أو فنائه إلى آخر ذلك من أمور.
والكره أيضًا في الإنسان فطرة أنه لا بد أن يسير في مساره المستقيم، فلا بأس أن تكره الشر وتكره ضده، ولا بأس أن تكره الشر ولكن لا تكره ضده، ولا بأس أن تكره ألوهية الأشياء ولكن لا تكره عبوديتك لله وهكذا وهكذا حتى تسير الخطوط المتقابلة في النفس متوازية وغير ذلك لابد وأن يقع الاضطراب في النفس في الداخل والخارج مع سائر الموجودات.
٨- الواقع والخيال: هاتان طاقتان متقابلتان في نفس الإنسان، فجاء الإسلام ليوفق بينهما حتى لا تطغى الواقعية البغيضة في دنيا الناس عليهم وتستعبدهم من دون الله وكي لا يستبد الخيال أو كما يسمونه أصحابه «بالرومانتيكية» على حياة الناس فتبعدهم عن طريق الله.
فالواقع بالنسبة للإنسان ضرورة لحياته وبقائه بل هو حقله، خلق لعمارته ووجد لخلافته وأعطي من الطاقات ما يصير سيده ولكن ليس معنى ذلك أن ينسى مشاعره وحسه وخياله وفكره وتطلعاته وأمله تلك فطرة لابد من رعايتها والحفاظ عليها، فإن الله لم يكتف أن يخلق الجبال مادة جامدة بل جعل فيها جمالًا رائعًا وثلوجًا باردة وغابات وزروعًا ناضرة وكذلك حين خلق النبات جعل فيه جمالًا في زهرة وأريجا في درره ونضرة في طلعه إلى غير ذلك من المخلوقات كالسحاب والحيوان حتى قال عنه: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾.
لذلك فهو يشغل طاقة الخيال بأشياء تناسبه کالرقي والسمو والتزكية يشغلها بتحليق النفس إلى الكمال؛ لكي تهفو لإصلاح الواقع ومحاولة الوصول به إلى شيء من الكمال وأيضًا يرفعها عن قيود الواقع المحدود: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ﴾
٩- الحسية والمعنوية: هذان الخطان أيضًا متقابلان غير أن كلًا منهما مكمل للآخر وكل منهما يعمل في اتجاه فالطاقة الحسية هي طاقة الجسد المتصلة بالأعصاب والحواس.
أما الطاقة المعنوية فهي لا يدري أحد مكانها أو ماهيتها غير أنها تدرك بآثارها كالتفكير في الخير والشر وكالإدراك للفضيلة والرذيلة وما إلى ذلك من معان.
لذلك فالإسلام يستغل الطاقة الحسية فيما يعود على صاحبها بالنفع العام ويقيه من الضرر التام فلا يصح أن يلقى بنفسه إلى التهلكة إذا أيقن ذلك من شيء محرق أو صاعق أو كذا أو كذا، وكذلك لا يثنيه عن شيء نافع لجسمه أو روحه ما دام مباحًا، وكذلك الطاقة المعنوية: «وهي التي تعتبر إنسانية بحتة لا يشاركه فيها الحيوان».
يحتفل بها الإسلام فيمنحها العقيدة والفضيلة والخير والجمال بحيث تكون في الاتجاه الصحيح وبذلك يرتبط الخطان «الحسي والمعنوي» في واقع الحياة كما هما مرتبطان في داخل دوافع نفس الإنسان؛ ليؤديا معًا واجب العمارة والخلافة في هذه الحياة.
۱۰- الفردية والجماعية: من الخطوط البارزة والمتناقضة في كيان الإنسان هذان الخطان وهذه الظاهرة ذات أثر بالغ في الحياة البشرية ومن هنا كان كيان المجتمع كله قائمًا على محاولة التوفيق بين هذين المتناقضين في الظاهر ومدى النجاح في عملية التوفيق، فالرأسمالية قائمة على أساس فردية الإنسان إلى الحد الذي يصل فيه إلى إزاء نفسه، والشيوعية قائمة على أساس جماعية الإنسان إلى درجة فنائه وتلاشي شخصيته في المجتمع.
أما الإسلام فيوفق بين هذين الخطين في يسر وسهولة وأناة، فالإنسان باتصاله بربه يصير فردًا إيجابيًا ويشعر بمسئولية فردية تجاه ربه وشرعه فلا يصطدم بمجتمعه، بل يعطيه أكثر ما يأخذ منه، وهكذا الجماعة عندما تكون موصولة بربها شكلا وموضوعا فإنها تعمل على الاقتراح الكامل بينها وبين لبناتها هكذا كانت الجماعة مع عمر- رضي الله عنه- ومع خالد بن الوليد.
إن عمر- رضي الله عنه- الذي نزل القرآن على لسانه في أكثر من موضع له يمنع ذلك الجماعة من أن تقول له: «الزم غرزك يا عمر» وإن خالدًا الذي يعتبر سيف الله المسلول لم تمتنع الجماعة رغم ذلك أن تعزله من منصبه فيصير مأمومًا بعد أن كان إمامًا.
فالعلاقة إذن بين الفرد والجماعة حب وإخاء لا تلاش وفناء فالبذل التام بالنفس والنفيس من جهة الفرد والحرص التام على الأفراد من قبل الجماعة فذمة الله برئت من جماعة يبيت فيها فرد جوعان ودم الإنسان يعتبر هدرًا إذا فارق الجماعة فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
۱۱- الالتزام والتطوع: الالتزام فطرة فهناك في طبيعة الإنسان ميل غريزي للالتزام حتى أن الإنسان الذي يحيد عن جادة الطريق لا يلبث أن يجد نفسه ملتزمًا بأمور ما أنزل الله بها من سلطان.
فهناك من ألزم نفسه بعبادة معينة وهناك من ألزم نفسه بسلوك معين وهناك من ألزم نفسه بقانون معين وكذلك التطوع فطرة لا يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه من الانعطاف أو التبرع أو التنازل بكل ما لديه من نفس ومال وجاه وما إلى ذلك من أمور.
لذلك جاءت الرسل لتهدي الناس إلى الصورة المثلى في حياتهم حتى يعلم الإنسان ما هو الالتزام الحق من الباطل والتطوع الحق من الباطل بحيث يكون الالتزام نافعًا دنيا ودينًا وعاجلًا وآجلًا وكذلك التطوع كالالتزام من حيث الاستقامة والاعتدال حتى لا يعض الإنسان يوم القيامة أنامل الندم.
۱۲- السلبية والإيجابية: السلبية في الإنسان تتضح من سلوكه، فإذا أحسن الناس وإذا أساءوا أساء والإيجابية غير المنضبطة عند الإنسان تتضح من سلوكه حين يتبجح فيقول: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾
لذلك جاء الإسلام ليعلم الإنسان ألا سلبية بل تجارب وتفاعل بمعنى أن الناس إذا أساءوا أن تتجنب إساءتهم، وكذلك يعلمه الإيجابية الله بالعبودية ومع الناس بالحسنى ومع الكون بالانتفاع.
ومن هنا يصير الإنسان مع الله سلبيًا ومع الكون كله «العاقل منه وغير العاقل» إيجابيًا وبذلك تصلح النفس وتستقيم الحياة، ومن هنا كانت وقفة أبي بكر-رضي الله عنه- في وجه قوى الأرض مجتمعة بمفرده وبدون معين وبلا سلاح فنصره الله وحول شعوره المؤمن إلى وقائع وأحداث وتاريخ.
هذه نظرة عاجلة في تلك الطاقات المتباينة والتي تشكل خطرًا جسيمًا في حياة الإنسان إذا حادت عن الصراط المستقيم فقد عالجها الإسلام في شيء من اليسر والتبسيط ثم عرض المؤلف بعد ذلك لوسائل التربية الناجحة كما وضحها الإسلام كالتربية بالقدوة والقصة والعادة والعقوبة والموعظة والعادة وتفريغ الطاقة وملء الفراغ والأحداث وما إلى ذلك من وسائل كلها أنفع للنوع وأنجع في العلاج من كل ما يضعه الإنسان من إبداع وابتكار وصدق الله إذ يقول: ﴿لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (سورة الأنبياء: 10) والذكر هنا بمعنى الشرف.
الرابط المختصر :
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل