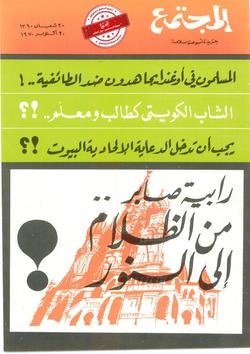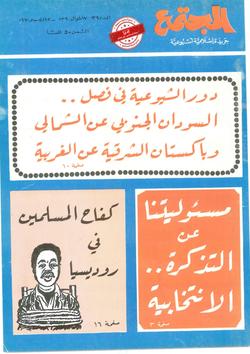العنوان قصة التمرد في منظمة فتح
الكاتب جمال الراشد
تاريخ النشر الثلاثاء 31-مايو-1983
مشاهدات 20
نشر في العدد 623
نشر في الصفحة 19
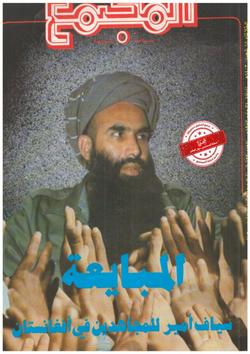
الثلاثاء 31-مايو-1983
•
المجتمع تضع بين أيدي القراء وقائع المؤامرة التي تديرها أطراف عربية ضد
المقاومة الفلسطينية.
• دور سورية واضح في تمزيق فتح، والمطلوب
من المقاومة أن تأخذ إجازة.
• الذين يقفون وراء «التمرد» هل هم
حريصون على تحرير فلسطين؟
• تمزيق «فتح» يعني انتهاء الثورة
الفلسطينية، ثم ماذا بعد؟
حينما ولدت النواة الأولى
لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» في أواسط الخمسينيات؛ رفعت شعار «عدم التدخل
في الشؤون الداخلية للبلاد العربية»، واشترطت على من ينتسب إليها من الأفراد
التخلي عن حزبيته -إن كان ينتظم في حزب من الأحزاب- والاندماج في الحركة الجديدة باعتبارها
حركة تحرر وطني تستهدف تحرير فلسطين فمن آمن بهذا الهدف -كائنة ما كانت أيديولوجيته-
فعليه أن ينضم إلى الحركة باعتباره فردًا من الأفراد، وليس ممثلًا عن فئة من الفئات.
ولذلك فقد ضمت الحركة
-ومنذ البداية- عناصر كثيرة من الشباب غير المنتمي إلى حزب من الأحزاب أو جماعة من
الجماعات، كما ضمت الكثير من الحزبيين الذين خلعوا رداء الحزب من أجل فلسطين.
إلا أن حزبيين آخرين
عز عليهم التخلي عن أحزابهم؛ فطالبوا بإنشاء «جبهة» تحرر وطني، تضم كافة الأحزاب المؤمنة
بتحرير فلسطين، بدلًا عن «حركة» التحرر الوطني التي تعني مجموعة أفراد.
ولكن هذا المطلب فشل
أمام إصرار النواة الأولى لـ«فتح»، ومن ثم تظاهر بعض الحزبيين بالتخلي عن حزبيتهم،
وانضموا إلى «فتح» على أمل أن يخدموا الأفكار الحزبية كلما سمحت الظروف بذلك، وعكف
حزبيون آخرون على إنشاء تنظیمات منفصلة، والأحزاب غير الإسلامية التي كانت موجودة في
الساحة في ذلك الوقت هي الحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، ثم حركة القوميين
العرب فيما بعد.
أما الإسلاميون الذين
دخلوا حركة «فتح» كأفراد فما أكثرهم، بل إن الكثيرين منهم كانوا من المؤسسين، عملوا
بعيدًا عن الأضواء، غايتهم النصر أو الشهادة في سبيل الله: ﴿فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ
نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ (الأحزاب:23)، ولا
نود هنا أن نذكر أسماء سواء للأحياء أو للأموات، فحسبهم الله ونعم الوكيل.
ولما كان الخطر الحقيقي
على الكيان اليهودي في فلسطين هو من الإسلاميين تحديدًا؛ فقد أخذ الضغط يشتد عليهم
في الوقت الذي أعطى الضوء الأخضر لأعداء الإسلام من الشيوعيين والبعثيين والقوميين
بالتواجد في الساحة منافسين لـ«فتح»، أو عاملين من خلالها مهيمنين على أجهزة الإعلام-
التي يجيدون العمل فيها- متسلقين على المؤسسات النقابية، اتحاد الكتاب والصحفيين باذلين
كل جهودهم للسيطرة على الهيكل التنظيمي لـ«فتح»، أو المجلس الثوري، متجنبين إلى حد
بعيد خوض غمار العمل العسكري على اعتبار أن المقاتل الذي يضع نصب عينيه مقارعة الصهاينة
بالسلاح لا يلتفت إلى مقولات کارل مارکس، أو ماو أو جيفارا، أو حتى المعلم ميشيل، أو
الحكيم جورج.
وعلى اعتبار أن هذا العمل
العسكري هو تابع للعمل السياسي الذي لابد من التمهيد له بالإعلام، ثم إن العمل العسكري
فيه موت (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ) (البقرة:96)؛ لأن الحياة
الدنيا هي الحياة الوحيدة التي يؤمنون بها.
وبالفعل فقد استطاعوا أن يسقطوا شعارات «فتح»
(تحرير فلسطين من البحر إلى النهر)، و«ثورة حتى النصر» لتحل محلها شعارات «الدولة الديمقراطية
العلمانية».
ولعمري إن ذلك كان أخطر
انحراف في مسيرة الثورة الفلسطينية، وبداية الإجهاز عليها سياسيًا بعد أن عجزوا عن
ذلك عسكريًا.
ومن المفارقات العجيبة
أن هؤلاء الحزبيين غير الإسلاميين الذين دفعوا «فتح» دفعًا في تجاه الصلح مع إسرائيل-
هم أنفسهم الذين يقاومون اليوم هذا الصلح، وهم حين اعترضوا على الكفاح المسلح لتحرير
فلسطين في البداية، وحين يعترضون اليوم على مسيرة الصلح مع إسرائيل، إنما هم عملاء
أولًا وأخيرًا، توجههم قوى عربية أكثر عمالة منهم، وسواء كانت هذه الجهات العربية مرتبطة
بالشرق أو بالغرب فالحال سواء، وهو العداء للإسلام والمسلمين، والعمل من أجل تثبيت
أقدام إسرائيل في المنطقة، وهو ما لا يختلف عليه شرق ولا غرب، كما لا يعترض عليه في
الحقيقة حزب شيوعي، أو علماني، أو نظام تابع للشرق أو الغرب، وإنما المعترض الحقيقي
على وجود الكيان اليهودي في فلسطين وغير فلسطين هم الإسلاميون؛ لأنهم ملتزمون بما جاء
في كتاب الله، وسنة رسوله الكريم، وهم المستعدون دومًا للجهاد من أجل تحرير فلسطين،
وسيصلون -بإذن الله- إلى هذا الهدف حتى وإن امتلأت اليوم سجون الطغاة بهم.
العناصر المندسة من الحزبيين
-وإن استطاعت السيطرة إلى حد ما على بعض أجهزة الإعلام وبعض العناصر التنظيمية- إلا
أنها ظلت بعيدة عن أهم جهازين من أجهزة «فتح»، وهما الجهاز العسكري، والجهاز المالي؛
ولذلك ظلت محاولاتها للسيطرة على «فتح» بدون هذين الجهازين محاولات لم يكتب لها النجاح.
وإذا كانت المحاولات
الخارجية للقضاء على الثورة الفلسطينية متمثلة في «فتح» قد بدأت في معركة الكرامة؛
حيث هرب الشيوعيون والقوميون والبعثيون بحجة أن جيفارا قال: إن حرب العصابات تعني الكر
والفر، وليس الالتحام مع العدو الأكثر عددًا وعدة، وبقي في الميدان رجال «فتح» الخلص
من أبناء فلسطين، الذين لم يتلوثوا بأفكار غريبة.
ولم تعد إسرائيل تعيد
المحاولة بعدما تبين لها فداحة الخسائر الناجمة عن مواجهة هؤلاء الناس
وكانت المحاولة الثانية
عام (۱۹۷۰)، ولكن هذه المحاولة لم تقض على الثورة الفلسطينية، وإن أدمتها،
وأوجعتها، واضطرتها إلى الانتقال.
ثم كانت الضربة الثالثة
في تل الزعتر، وما سبقه، وما لحقه على يد القوات السورية والكتائبية، ولكن الثورة الفلسطينية
بقيت في الساحة.
ثم كان إنشاء دولة «سعد
حداد» بحماية إسرائیل لإبعاد ثوار فلسطين عن التماس مع اليهود إلى أن كان الغزو الإسرائيلي
للبنان، وحصار بيروت من أجل القضاء النهائي على الثورة الفلسطينية بتواطؤ واضح لبعض
الأطراف العربية.
حيث أخلت القوات السورية
مواقعها في الجبل لتمر منها طوابير الدبابات الإسرائيلية، وتحكم الحصار على بيروت،
ثم أحكم النظام السوري الحصار على المقاومة الفلسطينية، فمنع وصول المتطوعين، والأسلحة،
والأغذية، والأدوية، وترك الفلسطينيين لمصيرهم «المحتوم» ومن بعيد أخذ العقيد الليبي
يصرخ ناصحًا المقاومة الفلسطينية بأن تنتحر.
ولما استطاعت هذه المقاومة
-بعد قتال عنيف سيسجل ضمن أروع المعارك غير المتكافئة في التاريخ- أن تخرج من الحصار
بسلام إلى حد ما رغم كل ما نتج عن ذلك من مذابح؛ كان لابد للتحضير لمذبحة أخرى تنهي
البقية الباقية منهم في البقاع اللبناني.
ولقد تحسس الفلسطينيون
المؤامرة فاستعدوا لها؛ مما اضطر المخططين لتصفية الثورة الفلسطينية إلى الاتجاه إلى
داخلها، فوجدوا ضالتهم المنشودة في العقيد محمد موسى (أبو موسى)، ونحن لا نغمط الرجل
حقه، فقد قاتل في بيروت قتال الأبطال، ولكن اعتراضه على قرارات أصدرها القائد العام
ياسر عرفات بإجراء عدد من التنقلات بين قادة الوحدات العسكرية استغل من قبل المتربصين
الحاقدين على استقلالية القرار الفلسطيني من أمثال أبو صالح، الذي فرضته سوريا عضوًا
في اللجنة المركزية لفتح، بعد موت القائد السابق لقوات العاصفة.
فحاول أبو صالح استغلال
الوضع لعودته إلى اللجنة المركزية التي طرد منها، وسرعان ما تحرك أبو نضال -وهو الذي
سبق أن انشق عن فتح- فانضم إلى «المتمردين» الذين رفضوه، وجاء بعد ذلك أحمد جبريل الضابط
السابق في الجيش السوري الذي تموله ليبيا، ليعلن انضمامه إلى «الحركة التصحيحية» وفي
ذهنه عبارة قالها ذات يوم لأبي إياد (صلاح خلف) أنتم ساعدتم «أبو العباس» على الانشقاق
عني، وسأساعد كل من يحاول الانشقاق عنكم، وقد تجاوبت مع «أبو موسى» في البداية كتيبتان
من قوات اليرموك، وهي القوات التي انضمت إلى فتح من الجيش الأردني على إثر أحداث أيلول.
وعندما وجهت القيادة
العسكرية لفتح نداء لأفراد الكتيبتين بالالتزام استجاب للنداء ثلثا الأفراد، وبقي الثلث
الآخر الذي أخذت تنفخ فيه الإذاعة الليبية، ثم لم تلبث السلطات السورية أن أعلنت عن
حمايتها للمتمردين.
ومن المعروف أن اتصالات
جرت وتجري بين طرف عربي، وبين النظام السوري منذ مدة، وخاصة بعد فشل المفاوضات التي
جرت بين ياسر عرفات والملك حسين، والتي كان للنظام السوري دور واضح في إفشالها؛ حيث
هدد بإنشاء منظمة تحرير بديلة وبسحق كل من يؤيد عرفات.
وبعد أن فشلت مفاوضات
عرفات - حسين بدأت الاتصالات السورية مع بعض الأطراف، ثم حدث تمرد «أبو موسى»، وما
أعقبه من مساندة سوريا وليبيا.
المؤامرة كبيرة على الثورة
الفلسطينية ومتشعبة الأطراف، وكافة المتآمرين يحملون راية فلسطين، فعبدالحليم خدام
مثلًا وزير خارجية سوريا يقول إن سبب الخلاف بيننا وبين منظمة التحرير الفلسطينية إننا
«فلسطينيون أكثر من الفلسطينيين»، وبعض العرب يرددون دائمًا إنهم حريصون على ألا تضيع
الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الأبد.
وحتى ريغان لا يتورع
عن أن يردد أنه لابد من تجاوز منظمة التحرير من أجل مصلحة الفلسطينيين كافة:
وكل يدعي إرضاء[1]
ليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا
فإلى أي مدى تستطيع
«فتح» أن تصمد وسط هذه الأنواء العاتية؟ يقول ياسر عرفات «يا جبل ما يهزك ريح»، ويعلن
في أحد مخيمات اللاجئين قرب طرابلس أنه «تمخض الجبل فولد فأرًا»، ثم يذكر أن باب الحوار
مع الأردن لم يغلق، وهي محاولة واضحة لشد أزر أنصاره من الفلسطينيين، وإحباط أي صفقة
محتملة تديرها دمشق تكون من نتيجتها عقد صلح مع إسرائيل دون اعتبار لمنظمة التحرير
الفلسطينية.
وعلى كل حال فالمؤامرة
أكبر من الفلسطينيين، وهي تستهدف تركيع الأمة العربية بأسرها لتجثم تحت أقدام إسرائيل،
ولا نعتقد أن عربيًا واحدًا فيه ذرة من كرامة يقبل بهذا.
فهل تصحو هذه الأمة من
رقدتها، وتعيد النظر في حساباتها قبل فوات الأوان؟ أم يضطر الفلسطينيون إلى العودة
إلى نقطة الصفر مرة أخرى، ولكن بمنهج جديد وفكر جديد؟ والإسلاميون ليسوا بغافلين عما
يجري في الساحة العربية، وهم المستهدفون أولًا وأخيرًا بتهويد فلسطين وسيادة إسرائيل،
والمسؤولون أولًا وأخيرًا عن تحريرها باعتبار القدس هي الأرض التي بارك الله حولها،
وإنها أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين؟
الشيوعيون يغدرون بالمسلمين
في لبنان
• في الساعة الثالثة عصر يوم السبت
في 7- 5 -83، بينما كان الطالب الشهيد محمد الجزار يمر أمام مركز الحزب الشيوعي بالنجمة
استوقفه حراس المركز، ونهروه مدعين أن نظراته إليهم كانت بازدراء.
ثم أقدموا على إدخاله
عنوة مركز الحزب واحتجزوه بالقوة، مستخدمين الضرب والسباب إليه، ثم نزعوا منه مسدسه،
ووجهوا إليه ضربة أدمت رأسه؛ مما أحدث جرحًا بليغًا فيه، فسارعوا في محاولة يائسة لإيقاف
النزف الدموي منه.
وحين وصل الخبر إلى مركز
الجماعة الإسلامية في صف البلاط اتصل أحد مسؤولي الجماعة بالحزب الشيوعي، وعنف مسؤول
الحرس فيه، الذي اعتذر عن فعلة الحراس، ووعد بترك الشهيد حرًا على الفور، هنا خرج الشهيد
بالفعل غاضبًا، وتعذر على مسؤول الجماعة محادثته.
وكان مسؤول الحرس مازال
يردد اعتذاره، ويصرح بالاحتفاظ بمسدس الشهيد، ووعد بتسليمه فيما بعد.
وأبلغ مسؤول الجماعة
إخوانه هاتفيًا بإنهاء المشكلة بناء للاتصالات التي أجراها، وطلب منهم استقبال الشهيد،
وتهدئة أعصابه حين يعود.
وما هي إلا دقائق حتى
أعيد الاتصال بمسؤول الجماعة لينقل إليه خبر هرب الناس من النجمة، وهم يصيحون: قتلوه،
قتلوه!
وهنا يكمن التصميم على
تنفيذ الجريمة البربرية من قبل مسؤول الحرس ورفاقه، إذ كيف يترك الشهيد دون تأمين الحماية
اللازمة له حين خروجه، وهو أعزل من كل سلاح بعد أن حفظ مسدسه لديهم، فهل يذهب دمه هدرًا؟
وهل يبقى هؤلاء الأوغاد وسط المسلمين يتحكمون بالناس والمارة والآمنين؟