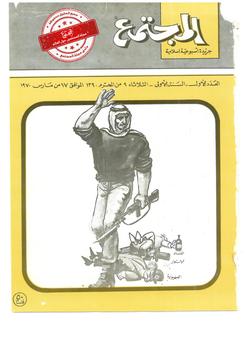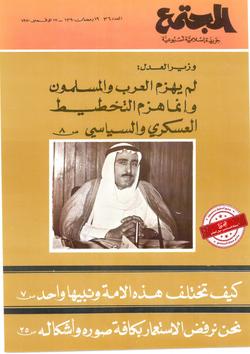الثلاثاء 17-نوفمبر-1970
لعقلك وقلبك
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيم
النفس كما يصورها القرآن الكريم
إن القرآن الكريم قد جمع بين دفتيه ما يسعد الإنسانية، في الدنيا والآخرة ﴿إِنَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي لِلَّتِي هِيَ أَقۡوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ أَجۡرٗا كَبِيرٗا﴾ (الإسراء: ٩) ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (سورة إبراهيم: ١) والقرآن الكريم حينما يعالج مشكلة، أو يعرض لأمر، إنما يتناوله تناولًا حكيمًا يتواءم مع طبيعة الحياة وصالح الأحياء.
فمن الموضوعات التي تناولها القرآن، موضوع النفس الإنسانية، ذلك الموضوع الذي أولاه الإنسان في عصرنا الحاضر عنايته، فأنشأ فيه علمًا خاصًا سماه «علم النفس» اختلفت فيه آراء الباحثين وتشعبت، ولم تخرج كلها أو جلها عن كونها نظريات قابلة للخطأ والصواب، ولكن خالق النفوس العليم بها قد عالج النفس الإنسانية من أدوائها، وأخذ بيدها إلى الاطمئنان والسعادة، ﴿أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ﴾ (الملك: ١٤)
يقول تعالى وهو أصدق القائلين:
﴿وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا، وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا﴾. (الشمس: ٧ـ١٠) ونستطيع أن نفهم من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى الذي خلق النفوس، قد بين لنا بوضوح أن فيها قابلية الخير والشر، إذ إن الخير والشر من الله إيجادًا، ومن العبد اكتسابًا، وإن على الإنسان أن يتولى هذه النفس بالتربية والترويض على الخير، وأن يجنبها الشر، ينأني بها عن كل قبيح، حتى نعتاد فعل الخير وحده، فيصبح من مألوفها حتى يصير الإنسان خيرًا يسير على الأرض، خيرًا في قوله وفعله، خيرًا لنفسه وأهله وبني جنسه، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا﴾ (الشمس: ٩) فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة، وأما من ترك النفس تسير على هواها، وتفعل ما يحلو لها من غير رادع من دين، أو وازع من خلق، فسوف يصبح من طبعها فعل الشر، وإيقاع الأذى بالغير، وبالتالي يصبح الإنسان شرًا يسير على الأرض، شرًا على نفسه وأهله وبني جنسه، وهذا معنى قوله تعالى ﴿وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا﴾ (الشمس: ١٠) خيبة في الدنيا وخيبة في الآخرة، وفي هذا يقول البصيري رحمه الله في بردته:
والنفس كالطفل إن تهمله شب على
حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم
كم حسنت لذة للمرء قاتلة
من حيث لم يدر أن السم في الدسم
فراعها وهي في الأعمال سائحة
وإن هي استملت المرعى فلا تسم
وأوضح من هذا وأروع ما بينه القرآن الكريم بأسلوب قوي، فيه من التأكيدات المتعددة ما يجعل القارئ يقف متأملًا: ما هذا المعنى الذي حرص القرآن الكريم على أدائه بهذا الأسلوب المؤكد؟ وحين يطرق هذا القول مسامعنا نقف أمامهم خاشعين حذرين من هذا الخصم الذي يحذرنا الله منه، يقول جل من قاتل:
﴿إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ﴾ (يوسف: ٥٣) فكأن القرآن يقول لنا: احذروا هذا الخصم، فهو لا يأمر بخير، ولا يحث على معروف.
ولكن كيف تفعل النفس كل هذا بصاحبها، لماذا تأمره بالسوء وتدعوه إلى الضلال؟ نقول على عجل: لا تعجبوا فهذه حال النفس قبل أن يصقلها الإيمان، ويسمو بها اليقين وتهذبها إشراقة التقوى، فكم من جرائم وقعت، وكم من دماء أريقت، وليس لها من دافع إلا النفوس التي خبثت، والقلوب التي قست من جرّاءِ ما ران عليها من ارتكاب المعاصي، واتباع الهوى، وصدق الله العظيم حيث يقول: ﴿وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطٗا﴾. (الكهف: ٢٨)
تحول النفس
أما من لم يتبع هوى نفسه، ولم يصبح عبد شهواته، بل راقب نفسه، وهذبها بالتقوى وأشغلها بمراقبة الله، والخوف من عقابه، فإن نفسه بهذه التربية، وتلك المراقبة ستتحول من أمارة بالسوء إلى لوامة على السوء، وهنا تصبح جديرة بأن آ أُقۡسِمُ بِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ، وَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلنَّفۡسِ ٱللَّوَّامَةِ يقسم بها بارئها، وأن يقرنها بيوم عظيم، قال تعالي:
﴿لَآ أُقۡسِمُ بِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ، وَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلنَّفۡسِ ٱللَّوَّامَةِ﴾ (القيامة: ١ـ٢) فإذا ظل الإنسان سائرًا على هذا النهج، مستقيمًا على طريق الحق متعاليًا على ذاته وترابه، مراقبًا ربه يطيعه يشكره فلا يكفره، يذكره ولا ينساه فسوف تطمئن نفسه للخير وحده وهنا تسمو هذه النفس، فتستحق ذلك النداء الخالد:
﴿يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ ٱرۡجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٗ مَّرۡضِيَّةٗ، فَٱدۡخُلِي فِي عِبَٰدِي وَٱدۡخُلِي جَنَّتِي﴾ (الفجر: ٢٧ـ٣٠) فلا علاج للنفوس بغير الإيمان، ولا اطمئنان ولاسعادة بغير التقوى: ﴿أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ﴾ (الرعد: ٢٨)
ونحن نعلم أن تقديم الجار والمجرور يفيد القصر؛ أي لا تطمئن ولا تسعد بغير ذكر الله وتقواه، فهل غاب عنا ما فعل الإيمان في النفوس المؤمنة من الرعيل الأول أمثال عمر رضي الله عنه، ألم نعلم أن عمر قد وأد ابنته حية قبل أن يتغلغل الإيمان في قلبه؟ ولكن هذه النفس عندما انصهرت ببوتقة الإيمان صار التاريخ يسمعنا على لسان الخليفة الثاني رضي الله عنه قوله:
«والله لو عثرت دابة في العراق أو الشام لخشيت أن يسألني الله عنها لأني لم أسو لها الطريق» ما أبعد الشقة بين نفس عمر المؤمنة، ونفسه غير المؤمنة، وما ذلك إلا بعد أن عمل الإيمان عمله في نفسه فحولها من أمارة بالسوء إلى لوامة على السوء، ثم إلى مطمئنة بالخير والحق والعدل.
ولقد جاشت العزيمة من وحي هذا الموضوع بهذه الأبيات فأحببت أن أضع بعضها بين يدي القارئ العزيز ليرى أثر الإيمان في النفس الإنسانية.
عمر العظيم بغير دين محمد
وأد البريئة في التراب الحامي
لكنه بالدين أصبح عادلًا
ويخاف أن تكبو دواب الشام
ويقول لو أني وضعت طريقها
سهلًا لما عثرت بجنح ظلام
الدین صيره إمامًا عادلًا
ومحطم الأغلال والأصنام
أبو بلال
اسألني.. أجبك
طلقت امرأتي للمرة الثالثة، فهل يجوز أن أراجعها بعد أن يتزوجها آخر تحليلًا لي حسب فهمي للآية الكريمة:
﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ (البقرة: ٢٣٠)
س. ع. الكويت
المقصود في العقود معتبرة، نية التحليل في الزواج تفسده، لأنها أخرجت عقد الزواج من معناه ومبناه، ألا وهو الدوام أو التأييد، وهذه الصورة التي سردتها يا أخي محرمة فقد روى أحمد والنسائي والترمذي وصححه، والخمسة إلا النسائي من حديث على مثله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لعن الله المحلل والمحلل له» وروى ابن ماجة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له».
أما إذا تزوجها الثاني زواجًا حقيقيًا لا صوريًا وصحيحًا، ودخل بها ثم حدث الطلاق لأمر عارض ليس فيه تبييت نية من أول الزواج، يجوز بعد انقضاء عدتها أن يتزوجها الأول بعقد جديد.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل