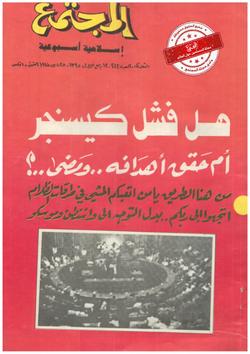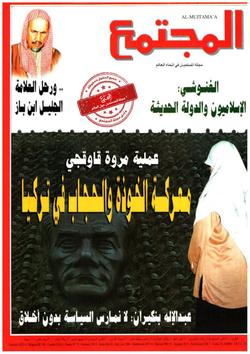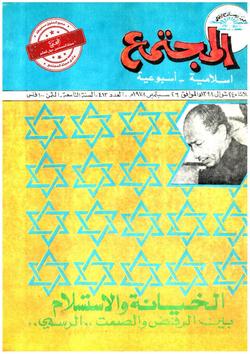العنوان لماذا النبوة؟
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 01-أغسطس-1972
مشاهدات 84
نشر في العدد 111
نشر في الصفحة 10
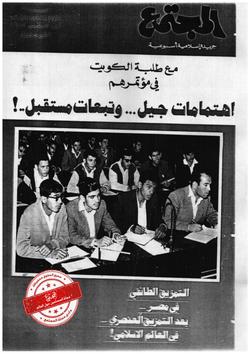
الثلاثاء 01-أغسطس-1972
بُعث نوح عليه السلام إلى قومه وهم يعبدون غير الله، يعبدون ودًا وسواعًا، ويغوث ويعوق ونسرًا، أسماء لأصنام سماها القوم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، ولعلهم أشركوا هذه الأصنام بالله، والله لا يرضى أن يشرك به سواه فهو أغنى الشركاء عن الشرك.
وإذا شئنا أن نكون أكثر دقة في وصف العلاقة بين الناس من قوم نوح وأصنامهم الحجرية تلك؛ فعلينا أن نذكر أنهم لم يكونوا يعبدونها حق العبادة، إنما كانوا -والله أعلم- يقدمون لها بعض القرابين، ويؤدون قربها بعض الطقوس، مبعدين بذلك عن أنفسهم شبهة عبادة بشر مثلهم، أما الحقيقة التي لا مراء فيها؛ فهي أنهم كانوا يعبدون كبراءهم من البشر: ﴿قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا﴾ (نوح: ٢١)
والاتباع الوارد في الآية هو العبادة الحقيقية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النصارى وهو يفسر قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (التوبة: ٣١)
قال صلى الله عليه وسلم: «حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم».
وأرسل لوط إلى قومه وهم يعتبرون الطهر وعدم إتيان الفاحشة جريمة يستحق مرتكبها النفي والإبعاد: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ «٨٠» إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ « ٨١ » وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ (الأعراف: ٨٠ - ٨٢).
وفي وصف حال قوم لوط غرائب تشد الذهن إليها، فهم يأتون الفاحشة يبتدعونها قبل الجنس البشري كله، ولا أظلمهم إذا قلت: إنهم لم يبتدعوا تلك إلا وقد ملوا كل الفواحش المعروفة في زمانهم سواها، وهم فوق ذلك يسرفون في ارتكاب تلك الفاحشة وفي سواها، ومسرفون في عدائهم لله وعنادهم لنبيه الكريم لوط عليه السلام، وأعود لصفتهم الأولى وهي اعتبار الطهر جريمة، إنهم ليسوا كقومنا يفلسفون الفواحش ويغلفونها بأغلفة وردية لإغراء الناس، ولا يحاولون تشويه الفضيلة بتسميتها بغير اسمها، كأن يطلقوا على العفة عقدة نفسية، وعلى الغيرة جنونًا «كما يفعل قومنا» بل هم يسمون الأشياء بأسمائها الصحيحة، فهم يطالبون لوطًا بفعل الفاحشة بضيوفه، ويسمون «بكل وضوح» عكس الفاحشة طهرًا، نعم طهر وباسمه الحقيقي، ولكنهم تواطأوا بما لديهم من شجاعة أو وقاحة على رفض الطهر، وحكموا على لوط المطهر بالنفي من أرضهم التي لوثوها، فلم تعد تحتمل طهر الأنبياء ودعاة الحق، وفكرة أخرى تخطر بالبال وهو يتأمل جبروت قوم لوط وجرأتهم على الحق: هل يمكن أن يصلوا إلى هذا الحد إلا وقد انعدم صوت الحق عندهم نهائيًا؟! ولكن لماذا التساؤل وهذا نبي الله لوط يخاطب قومه: ﴿أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ﴾( هود : ٧٨)
فلو كان بينهم رجل رشيد واحد ما نزلوا إلى ذلك الدرك الهابط، وما تجرأوا على الله وعلى الفضيلة تلك الجرأة دون حساب لصوت واحد يرتفع كصوت مؤمن آل فرعون.
ولشعيب عليه السلام مع قومه أهل مدين قصة أخرى من قصص النبوة، وهي تعالج فساد الإنسان وتحاول أن تعيده إلى فطرته، وتقيم أمره بالقسط، جاء شعيب قومه، وهم يبخسون المكيال والميزان: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ (84) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (هود ٨٤ - ٨٥) هذا ما طلبه شعيب من قومه حقوقهم وأن تعود لهم فماذا كان جواب القوم؟!
﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ﴾ (الأعراف : ٨٨) (۱) نعم، الإخراج، إنه نفس الحكم الذي حكم به قوم لوط على نبيهم، بل هو الحكم الذي واجه أكثر الأنبياء.
وفرعون ضرب ليس شاذًا في حياة البشرية، حين تأله لكن الشاذ في قصته هو مجاهرته بأنه إله على غير عادة المستبدين من أكابر الأرض إذ قال: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (القصص: ٣٨) (۲) ويبدو أن فرعون كان يجعل لنفسه كل حقوق الله، من تشريع وتوجيه واستعلاء وانفراد بالرأي، فهو يقول لقومه: ﴿يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾(غافر : ٢٩)
(۳) وهذا القول يذكرني بأقوال كثيرين من قادة هذه الأمة في هذه الأزمان، وتأمين أقوامهم على ما قالوا، فهم وحدهم يرون الصواب الذي كثيرًا ما أعطى نتائجه المعروفة!! وهم يهدون سبيل الرشاد! وهم أدرى من الله -بزعمهم- بما يصلح هذه الأمة، وهم يريدون أن يكونوا كالله لا يسألون عما يفعلون وهم يسألون: يا ليت قومي يستحون!!
هذه أمثلة من أحوال أقوام أُرسل إليهم أنبياء، تشابهت جميعًا في بعدها عن الفطرة، وكفرها بالله، وعبادتها أهوائها، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كواحد من أنبياء الله وخاتم رسل الله، لا يمكن أن يكون إرساله عبثًا أو في غير موعده هذا ما يقوله العقل والمنطق، فهل يثبت الاستقراء التاريخي هذا أم ينفيه؟ وقبل المضي في إجابة هذا السؤال؛ يجدر التنبيه إلى أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلف عن غيره من رسل الله من حيث العقيدة إطلاقا ولا يختلف عنهم كثيرًا من حيث التشريع، ولكنه يختلف عنهم من حيث البعد المكاني والزماني للرسالة الإسلامية، فقد كان من قبله من الأنبياء يبعث لقومه خاصة، ويعمل برسالته لفترة زمنية محددة، وبُعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليكون كافة للناس بشيرًا ونذيرًا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «بُعثت لكل أسود وأحمر»؛ فشملت دعوته كل بشر تصل إليه في ذلك الزمان، وهي بعد ذلك، الدعوة الخاتمة، لا دعوة بعدها، فهي ممتدة على الزمان ما كان زمان، وممتدة على المكان ما كان مكان، ولكن هذه الميزات التي امتازتها دعوة النبي الأمي لم تغنها عن أن تنزل في نفس الظروف التي تنزلت بها دعوات الأنبياء من قبل.
الدعوة الإسلامية دعوة إنسانية عامة، من هنا كان يجب أن تكون البشرية كلها محتاجة لها وقت نزولها، وإذا ما صح هذا «وهو صحيح» (٤) على البشرية عامة؛ فهو من باب أولى سيصح على البيئة الأولى التي تنزلت فيها الدعوة، والبيئة الأولى هي الأمة العربية.
بُعث عليه الصلاة والسلام إلى العرب وهم كأسوأ ما تكون الأمم حالًا، وقد يضيق المجال بذكر جوانب حياتهم تفصيلًا أو إيجازًا؛ لذا فإني سأمر على معالم حياتهم البارزة: لا بد لكل أمة من مثل تهتدي بها، وغايات بعيدة تعيش من أجلها، وقد كان للعرب ككل الأمم غايات، ولكنها ليست كغايات الأمم، وذكرها المجرد يغني عن التعليق عليها، يقول طرفة بن العبد البكري الشاعر العربي الشاب مفلسفًا الحياة محددًا غاياته منها:
فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى (۱)
وجدك لم أحفل متى قام عودي (۲)
فمنهن سبق العاذلات بشربة
کمیت متی ما تعل بالماء تزبد
وكري إذا نادى المضاف محنبًا
كسيد الغضا، نبهته، المتورد
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب
ببتهكنة تحت الخباء المعمد
هذه غاياتهم، إنها ثلاث: الخمرة والحرب والمرأة !!!
أما علاقاتهم فيما بينهم، ففي قول حكيمهم زهير بن أبي سلمى ما يشفي فيها غليل الباحث إذ يقول: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم (٥)
فهو السيف وهي القوة بل قل إنها شريعة الغاب.
ولذا كان هناك مقياس ثابت تقاس به الأمم على اختلاف الزمان والمكان فيعرف به مكانها بين الأمم وموقعها من مدرج التاريخ، ومنه يعرف اتجاه خطها التاريخي للأمام هو أم للخلف يسير، فذلك المقياس هو نظرة الأمة إلى العرض، وطريقة ممارستها للجنس.
وللعرب في هذا المقام خبر وأي خبر!! يروي عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته (٦) «إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء؛ فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها (۷) أرسلي إليّ فلان فاستبضعي (۸) منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها؛ أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح رابع؛ يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها، جمعوا لها، ودعوا لهم القافة (1)، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالثاط به (۲)، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك».
فهل بعد من مزيد؟ أباحوا الزنا، وأحلوا الدياثة، وتعارفوا على الإباحية، فهل سبقهم في الأمم سابق، أو لحق بهم في مسيرة الدنس لاحق؟
لا أظن، بل لا أظن أن أوروبا القرن العشرين قد انحدرت إلى هذا الدرك.
أما عبادة العرب فليقل عنها القائلون ما قالوا، إنها لم تكن غير عبادة لوجهاء القوم وعليتهم ذات المصالح التي تستعبد السوقة، لتسيّر لها بعض مصالحها، فلم يكن للعرب رب غير أبي جهل «عمرو بن هشام» كلمته هي الأولى وهي الأخيرة، وهو عندهم واهب العزة والمعاقب بالإذلال، فالعزة كل العزة لمن يسمح له بالجلوس في صدر نادي أبي جهل، والذل كل الذل لمن يطرد من ذلك المجلس، وإذا كان أبو جهل المدعو عمرو بن هشام هو رب مكة وحدها، فإن في كل قبيلة من قبائل العرب «أبو جهل» باسم آخر لا يختلف في كثير أو قليل عن أبي جهل قريش.
وقد تظنني مبالغًا إذا قلت إن أبا جهل في قريش كان مصدر الأحكام والتشريع، وكان أمره الأمر ونهيه النهي وإن في آثار القوم ما يصدق هذا.
روى ابن جرير: التقى الأخنس بن شريق بأبي جهل فخلا به فقال: يا أبا الحكم (۳) أخبرني عن محمد: أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس ههنا من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا، فقال أبو جهل: ويحك! والله إن محمدًا لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟؟ هذا هو اعتراف أبي جهل للأخنس، وكأنه يقول له: إني أعلم أن محمدًا صادق، ولكنني أريد أن أكذبه وأن تكذبوه معي! فماذا كان جواب الأخنس أمام هذا الاعتراف، أسلم وصدق؟ بل كذب وأطاع أبا جهل وكذلك كانت كل كبراء العرب وعامتهم.
ولكن من من البشر يرضى أن يقال عنه إنه يعبد إنسانًا مثله؟ وهنا لا بد لأمة كهذه من عبادة شكلية تواري بها عبوديتها لإناس منها تمامًا كما قيل قبل قليل في قوم نوح، الذين اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارًا، أما ألسنتهم فكانت تقول: ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ (نوح : ٢٣)
أجل كان للعرب أصنام يعبدونها تحمل نفس الأسماء التي حملتها أصنام حصيد الطوفان وزادوا عليها الكثير، وقبل المضي في الكلام عن أصنام العرب لا بد أن نتذكر أنها لا تختلف عن لعبة كرة القدم في هذه الأيام، أو ملوك الأزياء، أو ربات الأصوات وعازفي الأوتار، الهدف واحد والنتيجة واحدة.
أما الهدف فإشغال القوم وإلهاؤهم عما يجري حولهم، أو تخديرهم بألعاب وشواغل؛ حتى لا يطلبوا حريتهم ويخرجوا من عبادة إناس مثلهم.
والنتيجة واحدة، هي السقوط، سقوط الأمة كلها في هوة العبودية للأفراد أو العصابات، وفقدان الأمة لكل مظاهر الإنسان بين صفوفها بل بين شعثها، وهروب الحياة نهائيًا من جسمها المخدر المهين.
وفي تعدد آلهة العرب الحجرية المعروفة بأسمائها ما يؤكد أنها لم تنل احترامهم ولم تأسر قلوبهم، وإلا لقصروها على واحد أو اثنين، أما أن تصل إلى ثلاثمائة وستين في كعبة مكة وحدها فهو أمر يثير الدهشة، وقد اجتمعت العرب «اجتماعًا غير كامل» على تقديس تسعة وعشرين صنمًا هي: إساف ونائلة والأقيصر، وباجر، وذو الخلصة، ورضاء ورئام، والسجة وسعد وسعير وسواع وذو الشرى، وعائم، والعزى، وعميانس والفلس، وذو الكفين واللات ومناة ومناف ونسر، ونهم وهبل، وود، واليعبوب ويعوق ويغوث.
وقد تسموا بهذه الأصنام؛ فقالوا: عبد العزى وعبد مناف وعبد يغوث.. إلخ
وذكروها في أشعارهم، ولكنه ذكر لم يبلغ الحناجر، يذكر أحدهم صنمه في صدر البيت فتزور الكلمات في حلقه، ويضطرب فؤاده، ويعود لفطرته من ذلك، قول أوس بن حجر حالفًا: وباللات والعزى ومن دان دينها وبالله أن الله منهن أكبر، ويبدو أن التبرؤ من دين الأصنام كان شائعًا عندهم، حتى أصبح مضرب المثل لشيوعه من هذا قول عمرو بن الجعيد:
فإني وتركي وصل كأس لكالذي
تبرأ من لات وكان يدينها
ومن عادات العرب أنهم كانوا يستقسمون بالأزلام عند الأصنام، فإن وافق الرأي هواهم أطاعوه، وإن لم يوافق تأولوا له يقول صاحب كتاب الأصنام (۱) وكان من تلك الأصنام ذو الخلصة، وكان مروة بيضاء منقوشة، عليها كهيئة التاج، وكانت بتبالة بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة، وكان سدنتها بنو إمامة من باهلة بن أعصر، وكانت تعظمها وتهدي لها خثعم وبجيلة وازد الشراة ومن قاربهم من بطون العرب من هوازن «ومن كان ببلادهم من العرب» بتبالة قال رجل منهم:
لو كنت يا ذا الخلص الموتورا
مثلي وكان شيخك الغيورا
لم تنه عن قتل العداة زورا
وكان أبوه قتل فأراد الطلب بثأره؛ فأتى ذا الخلصة فاستقسم عنده بالأزلام، فخرج السهم منها ينهاه عن ذلك؛ فقال هذه الأبيات ومن الناس من ينحلها امرأ القيس بن حجر الكندي أ هـ.
ويروي أيضًا: وكان لمالك وملكان ابني كنانة بساحل جدة، وتلك الناحية صنم يقال له: «سعد»، وكان صخرة طويلة فأقبل رجل منهم بإبل له ليقف عليه يتبرك بذلك فيها، فلما أدناها منه نفرت منه، فذهبت في كل وجه وتفرقت عليه، وأسف فتناول حجرا فرماه به وقال: «لا بارك الله فيك إلهًا أنفرت عليَّ إبلي» ثم خرج في طلبها حتى جمعها وهو يقول:
أتينا إلى سعد ليجمع شملنا
فشتتنا سعد فلا نحن من سعد
وهل سعد إلا صخرة مبثوقة
من الأرض لا يدعى لغي ولا رشد (۲) هـ
ومن أعمالهم المضحكة أن أحدهم إذا سافر في الصحراء وحل بمكان بحث عن أجمل أربعة حجارة حوله؛ فجعل ثلاثة منها أثافي لقدره وجعل الرابع إلهه، بل إن أحدهم كان يصنع إلهه من التمر حتى إذا جاع أكله.
فهل بعد هذا يقال إن العرب كأمة عبدوا الأصنام قبل الإسلام، وبعد إبراهيم يومًا واحدًا أو ساعة واحدة من ليل أو نهار
ابن الشرق
١ - الأعراف ۸۸ - (٢) القصص ۳۸ - (۳) غافر ۲۹
٤ - يراجع في هذا المجال بحث تيه وركام من كتاب الأستاذ سيد قطب «خصائص التصور الإسلامي».
١ - هذه من معلقة طرفة بن العبد - ۲ - كناية عن الموت - ٣ - كناية عن الخمرة - ٤ - البكنة: المرأة الشابة الغضة، ٥ - هذا البيت من معلقة زهير بن أبي سلمى والتي يبدؤها: أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم
٦ - جاء هذا الخبر في صحيح البخاري - كتاب النكاح
٧ - الطمث دم العادة الشهرية عند المرأة - ٨ - البضع: جماع الرجل والمرأة.
١ - القافة: جمع قائف، أصلها الخبير بالآثار وقصد بها هنا مستقصي المعرفة لمعرفة القرابة.
٢ - ألصق به نسبًا -أبو الحكم هو أبو جهل نفسه وهكذا كان يسمى قبل الإسلام.