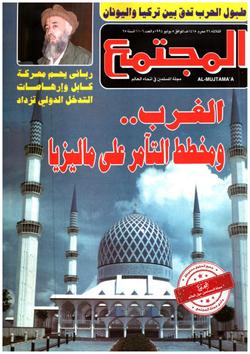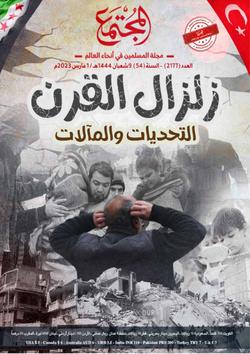العنوان مصادر التشريع الإسلامي وتطور الفقه في ظلها (الحلقة الأخيرة)
الكاتب د. محمد الصادق عرجون
تاريخ النشر الثلاثاء 15-ديسمبر-1970
مشاهدات 16
نشر في العدد 39
نشر في الصفحة 24
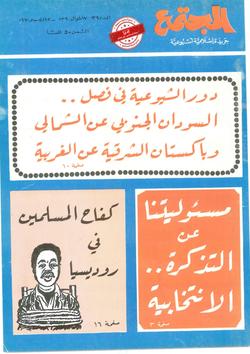
الثلاثاء 15-ديسمبر-1970
مصادر التشريع الإسلامي وتطور الفقه في ظلها
محاضرة الشيخ الدكتور محمد الصادق عرجون
الحلقة الأخيرة
«الإسلام اليوم يحتاج إلى جهود متضافرة، تجمع قوى علمائه ليكمل بعضهم بعضًا حتى تتكون منهم جبهة دراسية موحدة للنظر والبحث، تكون بمثابة إمام واحد في ظل المصادر الأصلية لهذه الشريعة الخالدة تعطي للوقائع والأحداث أحكامها»
محاضرة علمية قيمة ألقاها بجمعية الإصلاح الاجتماعي فضيلة الشيخ محمد صادق عرجون. و«المجتمع» حريصة على أن ينتفع المسلمون بهذا الفيض الكبير من المعرفة والعلم من أستاذ عرفته الأمة الإسلامية وتخرج على يديه وفود من الأساتذة والمعلمين.
ومن اجتهادات عمر ما رواه مالك في الموطأ أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له حتى النهر الصغير من العريض، فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة، فأبى محمد بن مسلمة فقال له الضحاك: لم تمنعني، وهو لك منفعة، تشرب به أولًا وآخرًا، لا يضرك، فأبى، فكلم الضحاك فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فأبى، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك وهو لك نافع، تشرب به أولًا وآخرًا؟ قال محمد بن مسلمة: لا والله، فقال عمر: والله ليمرن ولو على بطنك فأمره عمر أن يجريه.
صلابة موقف عمر
ومن أشهر ذلك وأثبته صنيع عمر- رضي الله عنه- في سواد العراق، وقد رواه أبو يوسف في كتاب الخراج، وأبو عبيد في كتاب الأموال، وملخص القصة أن سائر الجيش الذي فتح العراق وفيهم كبار الصحابة أمثال عبد الرحمن بن عوف وعثمان وطلحة وبلال؛ كانوا يرون أن أرض العراق غنيمة، فيجب أن تقسم بينهم تقسيم الغنائم والفيء، ولكن عمر- رضي الله عنه- كان يقول وهو متوقف عن القسمة: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء، ما هذا برأي، ولما كثر الإلحاح على عمر واشتد عليه بلال وصحبه؛ حتى كان يقول عمر: اللهم اكفني بلال وصحبه، استشار عمر الناس من المهاجرين والأنصار في قسمة الأرضين التي أفاء الله على المسلمين، وقال لهم: قد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها، وأضع عليهم الخراج، وفي رقابهم الجزية يؤدونها، فتكون فيئًا للمسلمين المقاتلة والذرية، ولمن يأتي بعدهم، أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها؟ أرأيتم هذه المدن العظام کالشام، والجزيرة، والكوفة، والبصرة، ومصر، لا بد أن تشحن بالجيش وإدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج، فقالوا جميعًا بعد البحث والمشاورة: الرأي رأيك، فنعم ما رأيت وما قلت، فقال عمر: قد بان الأمر، وقرر بقاء الأرض بأيدي أهلها، وضرب عليهم الخراج.
ومن شواهد الاجتهاد والعمل بالرأي؛ تحقيقًا للمصلحة العامة في عهد الصحابة ما وقع من خالد بن الوليد، حين أراد التوجه إلى اليمامة بعد أن فرغ من أسد وغطفان في حروب الردة، فقد توقفت الأنصار عن متابعته في وجهه ذلك، وقالوا: ما عهد إلينا الخليفة بذلك، فقال لهم خالد: لو لم يأتني كتاب من الخليفة، وكنت إن أعلمته فأتتني الفرصة لم أعلمه، ولذلك لو ابتلينا بأمر ليس فيه من الخليفة عهد لم تدع أفضل ما يحضرنا ثم نعمل به، وأنا سائر إلى وجهي، ولا أُكره أحدًا منكم على السير معي، فراجعت الأنصار نفسها وتشاوروا فيما بينهم، فرأت الذي رأى خالد، ولحقوا به وساروا معه.
وهذا الاجتهاد بالرأي من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لتحقيق مصالح العباد في أحكام الشريعة؛ هو الأساس الذي اعتمد عليه الأئمة المجتهدون فيما أصلوه لاستنباط الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح، فيدخل فيه القياس بأنواعه الصحيحة، ويدخل فيه الاستحسان، والمصالح المرسلة، واستصحاب الأصل، ولا ضرر ولا ضرار، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والضرر يزال بما لو يحدث ضررًا أزيد منه أو مثله، وسد الذرائع، وغير ذلك من القواعد والأصول التي استخرجها الأصوليون.
وعلى هذه الأصول قامت مرثية الاجتهاد والاستنباط من الأئمة -المجتهدين الذين جاءوا بعد عصر الصحابة والتابعين، وبلغوا في علوم القرآن والسنة شأوا أعدهم للنظر في أسرار الشريعة ومعانيها ومقاصدها لاستخراج أحكام الحوادث المتجددة والوقائع الحادثة التي لم تكن تقتضي الحياة وقوعها من قبل، بما أصلوه من تلك القواعد التي استندوا فيها إلى مقاصد الشريعة العامة.
وهذا بحر لا ساحل له في سعة التشريع الإسلامي؛ لو وجد لسفنه ربابنة قادرين مخلصين، وسبيل الاتساع فيه تحرير العقل المسلم من قيود الجمود والتقليد البليد، مع براعة العلم، ورقة الفهم، وفقه النفس، ومراقبة الله تعالى وخشيته، مما كل ما يكون سياجًا منيعًا عن الانزلاق مع الأهواء والدعاوى الزائفة.
وليس لهذه المرثية الاجتهادية استقلال في التشريع، وإنما تابعة تبعية مطلقة لنصوص القرآن الحكيم وبيان السنة المطهرة، ومن ثم فهي ليست ملزمة للأخذ بما تأتي به من أحكام، يقول السيد رشيد رضا في الجزء الأول من تفسير المنار مفصلًا لما أجمله القرافي في قواعده: «إن الأحكام الاجتهادية التي لم تثبت بالنص القطعي الصريح رواية ودلالة لا تجعل تشريعًا عامًا إلزاميًا، بل تقوض إلى اجتهاد الأفراد في العبادات الشخصية والتحريم والتحليل الديني الخاص بهم، وإلى اجتهاد العدول والثقاة من أولي الأمر من الحكام وأهل الحل والعقد في الأمور السياسية والقضائية والإدارية، وبناء على هذه القاعدة لم يقبل الإمام مالك رحمه الله تعالى من المنصور أولًا، ولا من هارون الرشيد ثانيًا أن يحمل المسلمين على العمل بكتبه، ولا بالموطأ الذي هو أصح ما رواه من الأخبار المرفوعة وآثار الصحابة، وواطأه عليه جمهرة من علماء عصره.
وهذه المرتبة الاجتهادية هي معجز التشريع الإسلامي الباقية المتجددة التي لا تزال تصحب الأمة الإسلامية في حياتها الفقهية التشريعية، وتمده- بحاجتها في إسعاف الوقائع والأحداث المتجددة بأحكامها على يد كل من بلغ مكانتها في العلم والمعرفة والتفقه في الدين متأهلًا لمرثية الاستنباط والاجتهاد، ولن يغلق بابها، ولن يسد طريقها ما كان القرآن الكريم في صدور الذين أوتوا العلم، يتلونه حق تلاوته، ويبلغون الجهد في فهمه واستخراج أحكام الحوادث منه ومن مواقع خطابه في أوامره ونواهيه، وقصصه، ووعده ووعيده.
ولن يغلق باب مرتبة الاستنباط والاجتهاد، ولن يسد طريقها ما كانت السنة النبوية محفوظة من دنس الوضاعين وكذب الكذابين، ووهن الضعفاء وغفلة البله المغفلين، ولن يغلق بابها ولن يسد طريقها ما دام العقل الإنساني سابحًا منطلقًا في أجواز الشريعة المطهرة مهتديًا بأصول الدين، لا تقيده أغلال التقليد والعصبية المذهبية، ولن يغلق بابها ولن يسد طريقها ما كانت خشية الله تملك على أهل العلم أحاسيسهم ومشاعرهم، وتقبض على أزمة ضمائرهم فلا يقولون ما لا يعلمون، ولا يقولون للناس ما لا يفعلون.
على هذه الأسس القوية الرصينة الحكيمة قامت دعائم الفقه الإسلامي في عصر الصحابة والتابعين، ولما اتسعت الدولة الإسلامية، وانتشرت دعوة الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجًا، وتعددت الحوادث وكثرت الوقائع، وانبث العلماء وأئمة الشريعة في أقطار الإسلام، واختص كل قطر بطائفة منهم كانوا يستفتون فيفتون، ويسألون فيجيبون، ويستخبرون عن أحكام الوقائع الحادثة فيخبرون بما عندهم من علم عماده القرآن والسنة وما أثر عن الخلفاء الراشدين وعلماء الصحابة وكبار التابعين.
وفي القرن الثاني والثالث للهجرة زحفت على الأمة الإسلامية أفكار ومذاهب في العقائد والأخلاق والعادات، حملها معهم الذين ولجوا إلى ساحة الإسلام من أبناء الأمم والشعوب التي استجابت لدعوته، وكان ذلك نتيجة الامتزاج بالمصاهرة والولاء، والتشابك في المحافل والمجتمعات والاشتراك في الدرس والبحث في مساجد الإسلام ومدارسه ومعاهده والتلاقي في ميادين الجهاد ومجالس المناظرات ودواوين الحكم ومكتبات العلم.
وقد استدعت تلك الأفكار والمذاهب الوافدة مواجهتها بالنظر والبحث والنقد، وعرضها على أصول الإسلام العقدية والنظامية للمواءمة بينها وبين شرائعه، وتقبل ما وافقها ورد ما لم تتوافر له عناصر التوفيق.
فانتهض لها فريق من العلماء والأئمة الباحثين وأهل النقد والنظر للكشف عن حقائقها ومراميها، وكان أكثر ما أهمهم من هذه الأفكار والمذاهب ما يتعلق بالعقيدة حتى شغلهم ذلك عن النظر في الفقه والتشريع، لأنهم رأوا أن حماية العقيدة والمجتمع من الأفكار الهادمة المدمرة أحق وأوجب من النظر في أحكام الحوادث الجزئية والوقائع الفرعية، وأن حماية النص القرآني باعتباره أصل أصول الإسلام ودستوره الذي ترد إليه سائر أصوله، وأن تمحيص السنة رواية ودراية، وتدوین نصوصها، وغربلة مروياتها، وتنقيتها من الشوائب باعتبارها الأصل؛ النص الثاني بعد القرآن، يجب أن يكونا في مقدمة ما يصرف إليه العلماء والأئمة عزائمهم في البحث والتدوين.
ومن هنا بدأت مرحلة التخصص في الدراسات الإسلامية عند علماء الإسلام، فاهتمت طائفة بجمع الحديث وتمحيص روايته، وطائفة بتفسير القرآن ودرايته، وطائفة بعلم الكلام والتوحيد وفلسفته.
وبقي علم الحلال والحرام- وهو ما عرف الاصطلاح بالفقه والتشريع- واقفًا عند الفتاوى الشفوية لمعرفة أحكام الوقائع الطارئة دون تدوين إلا ما يدخل في فقه السنة تبعًا لمباحث الحديث النبوي الشريف، ولكن طائفة من علماء الأمة رأت أن حياة الأمة العملية في معاملاتها ونظام معايشها أحوج إلى ضبط الأحكام التشريعية النصية والاجتهادية وتدوينها لتكون معالم يهتدي بها الناس في معرفة أحكام وقائعهم وأحداثهم.
وقد كان في طليعة المهتمين بتدوين علم الحلال والحرام المتخصصين في أصول التشريع وفروعه الأئمة الأربعة، مالك بن أنس، وأبو حنيفة: النعمان بن ثابت ومحمد بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل وتلاميذهم.
وكان إلى جانب هؤلاء إخوة لهم من أئمة الإسلام مجتهدون لا يقلون في الفضل والعلم عنهم، بل فيهم من يعد في نظر معاصريهم أفقه منهم، كالليث بن سعد، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والأوزاعي، وسفيان الثوري وابن عيينه، وداود بن علي الظاهري، وعبد الله بن المبارك، وكثير غيرهم، وكان لكل إمام منهم كثرة من التلاميذ، يأخذون عنه العلم، وينشرون طريقته ومذهبه.
بيد أن هؤلاء الأعلام من الأئمة سوى الأربعة؛ لم يقدَّر لهم أن تدون مذاهبهم، وتضبط آراؤهم، وتحفظ اختياراتهم وأصول اجتهادهم في كتب ومؤلفات تختص بهم، وكان من حظ مذاهب الأئمة الأربعة أن دونت أصول اجتهادهم، وحفظت مذاهبهم، وعرفت اختياراتهم، وقام تلاميذهم بنشرها في أقطار الإسلام، وعكفوا على تفريع مسائلها والدفاع عنها، وإفتاء الناس بها، وتحرير مخارجها وأدلتها مما أبقاها محفوظة متداولة، وتركت مذاهب غيرهم على كثرتها فلم يبقَ منها إلا ما يذكر في كتب الخلافات هنا وهناك.
وبهذا الوضع الذي لعب فيه الإهمال دورًا عظيمًا بدأ التقليد والتعصب المذهبي يأخذ طريقه إلى حياة المسلمين، ووقفت حركة التحرر العلمي، واحتبست الأفكار، وقيدت العقول، وركدت ريح البحث والنظر في الأصول والمصادر الأصيلة للفقه والتشريع، وتقاصرت الهمم عن ميادين الاجتهاد والاستقلال بالرأي وقد ازدادت كثرة الوقائع والأحداث، واتسع مداها، وتعددت صورها باتساع رقعة الإسلام، واتساع شقة اختلاف الأعراف- والعادات وأشكال المعاملات ونظم الأخذ والعطاء وتبادل المصالح بين الأفراد والجماعات في الأمم والشعوب التي استظلت بظل الإسلام، وألحّت الوقائع والحوادث المتشابكة تطلب أحكامها من الشريعة ولكنها لم تجد من المفكرين أهل الاجتهاد والناظرين في أصول التشريع من ينهض بعبء استنباط الأحكام مما حمل ولاة أمور المسلمين وحكامهم في أقطار الإسلام على هجر الشريعة المطهرة، وإطراح تشريعها، وإحداث أوضاع قانونية جرت على المسلمين وبالًا وبيلًا وشرًا طويلًا، وليس هذا بجديد في عصرنا الحاضر كما نراه ماثلًا لعيوننا في جميع أوطان الإسلام، ولا سيما في المصالح المتشابكة مع الدول الأجنبية التي تدين بالإسلام، بل هو داء قديم، انتاب الأمة الإسلامية منذ توقف المد الإسلامي عن الاجتهاد والتفكير المتحرر من أغلال التقليد، وكان هذا سبيًا من أكبر أسباب تخلف الأمة الإسلامية عن ركب التقدم الحضاري المسلم، وفي مثل حالنا اليوم يقول الإمام ابن القيم واصفًا حال الأمة الإسلامية في عصره، وهو عصر اضطربت فيه حال الأمة، وتخلى عنها علماؤها، وتركوها نهبًا لتشريعات لا تقيم وزنًا للقيم الخلقية والفضائل الإنسانية، قال ابن القيم في كتابه: (الطرق الحكمية): وهذا مقام ضنك ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرأوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة، لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها من الآراء والقوانين والسياسات، وسدوا على أنفسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعًا أنه حق مطابق للواقع، والذي أوجب ذلك لهم نوع تقصير في معرفة الشريعة، وتقصير في معرفة الواقع، وتنزيل أحدهما على الآخر، فلما رأى ولاة الأمور والحكام ذلك، وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمور وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة؛ أحدثوا من أوضاع سياستهم شرًا طويلًا وفسادًا عريضًا، فتفاقم الأمر، وتعذّر استدراكه، وعزّ تخلص النفوس من ذلك، واستنقاذها من المهالك.
وأفرطت طائفة من أهل الجرأة على دين الله، فقابلت هذه الطائفة المقلدة، فسوَّغت من الأحكام ما يُنافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين- المقلدة والمجترئة على دين الله- أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله، وأنزل به كتابه الحليم. وقال ابن القيم يرد على المقلدين الجامدين في كتابه العظيم (أعلام الموقعين): إن المقلدين حكموا على الله قدرًا وشرعًا بالحكم الباطل جهارًا؛ المخالف لما أخبر به رسوله، فأخلوا الأرض من القائمين لله بحججه، وقالوا لم يبق في الأرض عالم منذ الأعصار المتقدمة... إلى أن قال: وعند هؤلاء الأرض قد خلت من قائم الله بحجة، ولم يبق فيها من يتكلم بالعلم، ولم يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله ولا سنة رسوله لأخذ الأحكام منها، ولا يقضي ولا يفتي بما فيها حتى يعرضه على قول مقلده ومتبوعه، فإن وافقه حكم به، وأفتى به، وإلا رده ولم يقبله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويصدق قول رسول الله: إنه لا تخلو الأرض من قائم بحجج الله، ولن تزال طائفة من أمتي على محض الحق الذي بعثه به، وإنه لا يزال يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها.
وهذا الكلام- كما سمعتم وكما تقرأون إذا شئم في كتابي هذا الإمام- صورة تمثل حالة المسلمين التي يعيشونها اليوم؛ وتمثل لنا نفس الأسباب والدواعي التي جعلت الأمم الإسلامية في الماضي وفي الحاضر تحكم بقوانين وتشريعات غير إسلامية فقد قصر العلماء قديمًا منذ عصر ابن القيم، ولا يزال التقصير والقصور يلازم حياة المسلمين إلى يومنا هذا، القصور عن إدراك أهداف الشريعة الإسلامية ومراميها وأسرارها ومرونتها، والتقصير في العمل على حمل عبء النهوض لمعرفة تلك الأهداف والمقاصد؛ التي تدور على تحقيق العدل عند المشاحنة، وتحقيق الرحمة عند المسامحة، بقول ابن القيم: (ومن له ذوق في الشريعة وإطلاع على كمالاتها وأنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، مجيئها بغاية العدل الذي يفصل بين الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، لا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح عرف أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها مواضعها، وحسن فهمه فيها، لم يحتج معها إلى سياسة غيرها ألبتة).
ولقد كان كثير من أئمة الهدى وأعلام العلماء المتحررين من ربقة التقليد قبل عصور الجمود الفكري لهم هذا الذوق في فهم الشريعة والاطلاع على كمالاتها، وقد بلغوا من دقة النظر وفقه الدين، ومعرفة مقاصد الشريعة؛ حدًا جعلهم لا يقفون عند حرفية النصوص، بل عبروا بأنظارهم في كتاب الله وسنة النبي- صلى الله عليه وسلم- واجتهادات الصحابة رضوان الله عليهم، أجواز الأحداث والوقائع المتجددة ووضعوها مواضعها من أحكام الشريعة، ولم تمضِ حادثة عرضت لهم إلا وقد أخذت حكمها المطابق لمقاصد الشريعة وروحها.
يروي ابن القيم هذه القصة التي تصور قوة الحياة الفكرية في محافل العلماء ومجالسهم ومحاوراتهم، وتبين ما كان يشغل أولئك الأئمة من أمر الدين والتشريع، قال: إن الإمام ابن عقيل- وهو أحد أفذاذ العلماء من أئمة الحنابلة ذكر في كتاب «الفنون» محاورة جرت بين العلماء في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية، وأنه أمر هو الجزم، ولا يخلو من القول به إمام، فقال عالم شافعي المذهب: لا سياسة إلا ما وافق الشرع، فقال ابن عقيل:
السياسة ما كان فعلًا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي، فإن أردت بقولك: إلا ما وافق الشرع؛ أي لم يخالف ما نطق به الشرع؛ فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط، وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن، ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف، فإنه كان أمرًا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة، وتحريق علي- رضي الله عنه- الزنادقة في الأخاديد، ونفي عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- لنصر ابن حجاج.
وقد علق ابن القيم على هذه القصة وما جرى فيها تعليقًا مطولًا، إلى أن قال: (فإن الله تعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه).
والأمة الإسلامية اليوم؛ ومنذ أعصر الجمود الفكري قبل عصر ابن القيم، فقدت الصفوة من أحرار التفكير ذوي التدين المخلص، والضمير المراقب لجلال الله من أهل العلم والتقوى الذين تتوافر فيهم شرائط الاجتهاد واستنباط الأحكام من أصولها النصية والمصلحية المطابقة لقواعد الشريعة، المحققة لمقاصدها في غير تقصير أو غرور، أو تزلف إلى ذوي السلطان، أو تملق الجماهير، أو التطلع إلى زخارف الدنيا ووظائفها. إن الإحساس بالداء ومحاولة تشخيصه في صدق ورغبة هو الخطوة الأولى نحو تقبل للعلاج على مرارته، ونحن اليوم نحس أكثر من أي وقت مضى بمرض القصور والتقصير نحو ديننا وشريعتنا؛ التي لا يوجد منها بين أيدي المسلمين إلا هذه المظاهر التعبدية الجوفاء، التي يؤدونها في صور وأشكال هامدة لا تحمل من روح الإسلام شيئًا.
ولقد انتهز بعض المغرورين فرصة هذا العجز الكسيح الذي أصاب تفكير علماء المسلمين فاقتحموا بجهل الغرور والتغرير ميادين الفتوى في التشريع، وزعموا أو زُعِم لهم أنهم تبوأوا ذروة الاجتهاد، فأفتوا بما ينافي حكم الله ورسوله، مراغمة لأصول الشريعة وإهدارًا لمقاصدها.
إن هذه الجرأة الجاهلة على دين الله وشريعته؛ هي التي كان يخافها صالحو العلماء من أئمة الإسلام، حينما توقفوا عن القول بالاجتهاد، وها هو ذا قد وقع الذي خافوه على الأمة؛ منذ العصر الذي كان يعيش فيه ابن القيم وأقرانه إلى يومنا هذا، وليس هذا بمخل أولئك العلماء من مسئولية التقصير الذي فتح للمغرورين باب الادعاء والتقول على الله بغير حق.
ولا شك- عندنا- أن الخطأ في توقف الاجتهاد أخف ضررًا من فتح بابه لكل والج ووالج من المحرفين المنحرفين وفي كل شر، وليس في الشر اختيار.
ونحن على قدر ما وسعه اتصالنا بالحياة العلمية الإسلامية على يقين أنه لا يوجد على أرض الإسلام اليوم فرد- نعلمه- قيّمًا بالاجتهاد المطلق في شريعة الإسلام، ولكننا على يقين أن في علماء الإسلام هنا وهناك في مختلف أوطان الإسلام أفرادًا متخصصين في فنون العلم الإسلامي تخصصًا يعدهم جماعيًا لحمل راية الاجتهاد.
والذين قالوا من العلماء بتوقف الاجتهاد؛ إنما قالوه حيث لم تتوافر شرائطه في الأفراد، ولما كانت المذاهب الأربعة المعروفة هي التي ضبطت أصولها ودونت فروعها، ونالت ثقة الناس، رأى أتباعها من العلماء والاقتصار على تقليدها خشية أن يدعي مرتبة الاجتهاد من لم يتأهل لها في علمه ودينه.
يقول القاضي عياض في كتابه «المدارك»: إن حكم المتعبد بأوامر الله ونواهيه، المتشرع بشريعة نبيه- صلى الله عليه وسلم- طلب معرفة ما يتعبّد به، وما يأتيه ويذره، ويجب عليه ويُحرّم، ويُباح له، ويرغب فيه من كتاب الله- تعالى- وسنة نبيه-صلى الله عليه وسلم- فهما الأصلان اللذان لا تعرف الشريعة إلا من قبلهما تم إجماع المسلمين مرتب عليهما، فلا يصح أن يؤخذ وينعقد إلا عنهما، إما عن نص عرفوه، ثم تركوا نقله، أو من اجتهاد مبني عليهما، وهذا كله لا يتم إلا بعد تحقيق العلم بذلك، ومعرفة الأدلة الموصلة إليه من نقل ونظر، وجمع وحفظ وعلم ما صح من السنن واشتهر، ومعرفة كيف تفهم من علم ظواهر الألفاظ وهو علم العربية والفقه وعلم معانيهما ومعاني موارد الشرع ومقاصده، ونص الكلام وظاهره، وفحواه وسائر مناهجه، وهو المعبر عنه بعلم أصول الفقه.
وهذا كله يحتاج إلى مهلة، والتعبد لازم لحينه، ثم الواصل إلى الاجتهاد قليل، وأقل من القليل بعد الصدر الأول والسلف الصالح، وإذا كان هذا فلا بُد لمن لم يبلغ هذه المنزلة من المكلفين أن يتلقى ما يتعبّد به وكلف من وظائف شريعته ممن ينقله له ويعرفه به واثقًا في نقله وعلمه، وهذا هو التقليد.
وبعد؛ فهذه لمحة تشير إلى الأطوار التي مر بها الفقه الإسلامي في صورة مجملة موجزة: حياة جياشة بالقوة الفكرية، والتحرر العقلي في إطار الأصول والقواعد الشرعية لا تمليها الأهواء، ولا تنحرف بها الأغراض وحيوية خصبة مخصبة وسع بها هذا الفقه حياة الناس من كل جنس ومشرب، ونهضة قوية غامرة، أمسكت بزمام الحضارة الإنسانية فوجهتها وجهة التقدم الفكري والاجتماعي.
ثم انحسار وجمود، ثم ماذا هذا- أيها الإخوة- هو السؤال الذي ينتظر من علماء الإسلام في هذا العصر الموَّار بالثورات الفكرية والتوثبات العقلية، والمذاهب الاجتماعية، الجواب عنه، فهل لديهم الجواب؟.
نعم، إن الجواب عن هذا السؤال يجب أن يكون في بيان الطريق؛ الذي يُعيد الفقه الإسلامي إلى حياته الأولى الجياشة القوية الخصبة، المتحررة من قيود التقليد البليد، وأغلال الجمود الفكري، ليستعيد الفقه والتشريع الإسلامي كرامته وقداسته، فلا يدخل حرمه إلا كل متأهل له بالعلم والمعرفة، العلم بأصول الشريعة ومقاصدها، والمعرفة بمذاهب المفكرين الأولين من رواد التشريع الإسلامي، مع الديانة والفضل، ويجب أن يذاد عن محرابه ضد أهل الجرأة الخاوية من المعارف الإسلامية الأصيلة، وأهل الجرأة الجوفاء الخاوية من وازع الضمير ومراقبة الله وخشيته.
هذا من الوجهة النظرية والتفكير المسعف المتعجل، أما من الوجهة العملية التي تبرز هذه الحقائق؛ لتكون عملًا مائلًا بين أيدي المسلمين، يهديهم ويهدي بهم، فهذا ما لا يستطيع فرد؛ أيًا كان مكانه ومقامه، أن يُخطط له ولا أن يقوم به وحده، وإنما أمره كأمر الاجتهاد في استنباط الأحكام من أصولها النصية والمصلحية، فكما يحتاج الاجتهاد إلى تضافر قوى العلماء والمفكرين في سائر أوطان الإسلام، يحتاج إلى التخطيط، إلى إبراز هذه الحقائق، إلى تضافر قوى المصلحين من العلماء وذوي الرأي من قادة المسلمين، ليجمعوا أمرهم ويتدارسوا فيما بينهم ما يرونه كفيلًا بإخراج عمل تشريعي متكامل، يكفل للمسلمين استقلالهم التشريعي، ويضعهم من الحياة التقنينية في المكان الذي كانوا يحيون فيه، يوم أن كان تشريعهم ينبع من ذات شخصيتهم المسلمة، تلك الشخصية التي أعطاها الإسلام مقوماتها الذاتية، وعناصرها الفكرية، وخصائصها الاجتماعية.
نعم، إن الاجتهاد لم توصد أبوابه، وهي مفتوحة على مصاريعها لكل من يحمل جواز المرور إلى هذه الساحة الشريفة المنيفة، ولكن أين هم المجتهدون الذين يعمرون هذه الساحة بالدرس الصبور، والبحث العميق والفكر الدقيق، ليجددوا لأمة الإسلام دينها؟
إن الإسلام اليوم لا يحتاج إلى هذه النزعات- وكدت أقول: النزعات- الفردية المغرورة التي تخبط في دين الله خبط العشواء الضالة، تبريرًا لأهواء الأفراد والجماعات من ذوي الأغراض المريضة، والمذاهب المنحرفة بحجة التمشي مع روح العصر، وصرخات التجديد، واستجابة لميول من في أيديهم لعاعات الدنيا وشهواتها، ولو أدى ذلك إلى هدم أصول الفقه وقواعد التشريع.
وإنما الإسلام اليوم يحتاج إلى جهود متضافرة، تجمع قوى علمائه ليكمل بعضهم بعضًا؛ حتى تتكون منهم جبهة دراسية موحدة للنظر والبحث، تكون بمثابة إمام واحد في ظل المصادر الأصيلة لهذه الشريعة الخالدة، تعطي للوقائع والأحداث أحكامها.
أيها الأخوة: لم يبقَ في هذا العصر؛ الذي أحال السير إلى طفرة، قيمة للحواجز الزمانية والمكانية، فقد أصبح البعيد فيه قريبًا، وإذا صدقت النيات، وصفت الضمائر، وتحرك الساكنون، ونطق الساكتون كان التوفيق من الله تعالى حليف من ينهض بهذا العبء مخلصًا لدينه وأمته.
ويا سعادة من يصطفيه الله ليبدأ السير، ويا خيل الله اركبي، ويا جنود الإسلام حي على الفلاح ﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحج:40)
والسلام عليكم ورحمة الله.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل