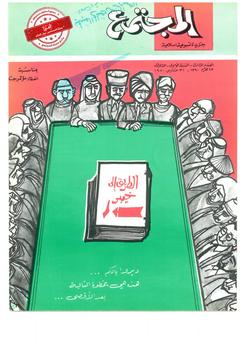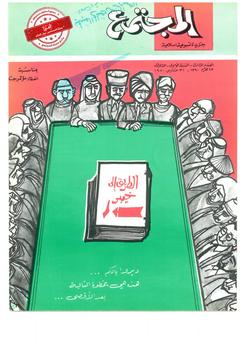العنوان مقال الأسبوع.. حول ترشيح المرأة للمجالس النيابية
الكاتب د. يوسف القرضاوي
تاريخ النشر الثلاثاء 25-مايو-1993
مشاهدات 18
نشر في العدد 1051
نشر في الصفحة 34

الثلاثاء 25-مايو-1993
المرأة إنسان مكلف مثل الرجل، مطالبة بعبادة الله تعالى، وإقامة دينه، وأداء فرائضه واجتناب محارمه والوقوف عند حدوده، والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل خطابات الشارع تشملها، إلا ما دل دلیل معين على أنه خاص بالرجال، فإذا قال الله تعالى: «يا أيها الناس» أو (يأيها الذين آمنوا) فالمرأة داخلة فيه بلا نزاع. ولهذا لما سمعت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أيها الناس» وكانت مشغولة ببعض أمرها هرعت لتلبية النداء، حتى استغرب بعضهم سرعة إجابتها فقالت لهم: أنا من الناس.
والأصل العام: أن المرأة كالرجل في التكليف إلا ما استُثني، لقوله تعالى: ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ (آل عمران: 195)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما النساء شقائق الرجال» (رواه أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي).
والقرآن الكريم يحمل الجنسين الرجال والنساء جميعًا مسؤولية تقويم المجتمع وإصلاحه، وهو ما يعبر عنه إسلاميًّا بعنوان: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، يقول الله تعالى: ﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَـٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡض یَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَیَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَیُقِیمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَیُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَیُطِیعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۤ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ سَیَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُ﴾ (التوبة: 71).
ذكر القرآن في هذا المقام سمات أهل الإيمان بعد أن ذكر سمات أهل النفاق بقوله: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾ (التوبة: 67).
فإذا كانت المنافقات يقمن بدورهن في إفساد المجتمع بجانب الرجال المنافقين، فإن على المؤمنات أن يقمن بدورهن في إصلاح المجتمع بجانب الرجال المؤمنين، وقد قامت المرأة بدورها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن أول صوت ارتفع في تصديق النبي عليه الصلاة والسلام كان صوت امرأة هي خديجة رضى الله عنها، وأول شهيد في سبيل الإسلام كان امرأة هي سمية أم عمار رضي الله عنها. حتى إن منهن من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في «أحد» و «حنين» وغيرهما. وحتى جاء في تراجم البخاري: «باب غزو النساء وقتالهن». والناظر في أدلة القرآن والسنة يجد أن الأحكام فيهما عامة للجنسين إلا ما اقتضته الفطرة في التمييز بين الزوجين الذكر والأنثى وما أعد له كل منهما، فللمرأة أحكامها الخاصة بالحيض والنفاس والاستحاضة والحمل والولادة والإرضاع والحضانة ونحوها، وللرجل درجة القوامة والمسؤولية عن الأسرة، ولها عليه حق الإنفاق والرعاية. وهناك أحكام تتعلق بالميراث جعل فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، والحكمة فيها واضحة، وهي مبنية على تفاوت الأعباء والتكاليف المالية بين الرجل والمرأة، وأحكام أخرى تتعلق بالشهادة في المعاملات المالية والمدنية، وقد جعلت شهادة المرأتين فيها كشهادة رجل، وهي أيضًا مبنية على اعتبارات واقعية وعملية رُوعي فيها الاستيثاق في البينات احتياطًا لحقوق الناس وحرماتهم. لذلك وُجد من الأحكام ما تُقبل فيه شهادة امرأة واحدة كما في الولادة والرضاع.
تنبيهات مهمة
وأود أن أنبه هنا على جملة أمور مهمة:
الأول: إننا يجب ألا نلزم أنفسنا إلا بالنصوص الثابتة الصريحة الملزمة. أما ما لا يثبت من النصوص كالأحاديث الضعيفة أو ما كان محتملًا في فهمه لأكثر من وجه، وأكثر من تفسير «مثل ما جاء في شأن نساء النبي»، فليس لأحد أن يلزم الأمة بفهم دون آخر وخصوصًا في الأمور الاجتماعية العامة التي تعم بها البلوى وتحتاج إلى التيسير.
الثاني: أن هناك أحكامًا وفتاوى لا نستطيع أن نفصلها عن عصرها وبيئتها ومثلها قابل للتغير بتغير موجباته، ولهذا قرر المحققون أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والعرف. وكثير مما يتصل بالمرأة من هذا النوع، فقد أصابه التشدد والتغليظ حتى حرم عليها الذهاب إلى المسجد، برغم معارضة ذلك للنصوص الصحيحة الصريحة، ولكنهم قدموا الاحتياط وسد الذريعة على النصوص بناء على تغير الزمان!
الثالث: أن العلمانيين اليوم يتاجرون بقضية المرأة ويحاولون أن يلصقوا بالإسلام ما هو براء منه، وهو أنه جار على المرأة وعطل مواهبها وقدراتها، ويحتجون لذلك بممارسات بعض العصور المتأخرة وبأقوال بعض المتشددين من المعاصرين.
نظرة في الأدلة
على هذا الأساس يجب أن ننظر في موضوع دخول المرأة في المجالس النيابية ومشروعية ترشيحها، ومشروعية انتخابها لهذه المهمة.
آية «وقرن في بيوتكن»:
فمن الناس من يرى ذلك حرامًا وإثمًا مبينًا، ولكن التحريم لا يثبت إلا بدليل لا شبهة فيه، والأصل في الأشياء والتصرفات الدنيوية الإباحة، إلا ما قام الدليل على حرمته، فما الدليل على التحريم الذي يسوقه هؤلاء؟ بعضهم يستدل هنا بقوله تعالى: «وقرن في بيوتكن»، فلا يجوز للمرأة أن تدع بيتها إلا لضرورة أو حاجة.
وهذا الدليل غير ناهض:
أولًا- لأن الآية تخاطب نساء النبي كما هو واضح من السياق، ونساء النبي لهن من الحرمة وعليهن من التغليظ ما ليس على غيرهن، ولهذا كان أجر الواحدة منهن إذا عملت صالحًا مضاعفًا، كما جعل عذابها إذا أساءت مضاعفًا أيضًا.
وثانيًا- إن أم المؤمنين عائشة مع هذه الآية خرجت من بيتها وشهدت «معركة الجمل» استجابة لما تراه واجبًا دينيًّا عليها، وهو القصاص من قتلة عثمان، وإن أخطأت التقدير فيما صنعت كما ورد عنها رضي الله عنها.
وثالثًا- إن المرأة قد خرجت من بيتها بالفعل وذهبت إلى المدرسة والجامعة، وعملت في مجالات الحياة المختلفة، طبيبة ومعلمة ومشرفة وإدارية وغيرها، دون نكير من أحد يعتد به، مما يعتبره الكثيرون إجماعًا على مشروعية العمل خارج البيت للمرأة بشروطه.
ورابعًا- إن الحاجة تقتضي من المسلمات الملتزمات أن يدخلن معركة الانتخاب في مواجهة المتحللات العلمانيات اللائي يزعمن قيادة العمل النسائي، والحاجة الاجتماعية والسياسية قد تكون أهم وأكبر من الحاجة الفردية التي تجيز للمرأة الخروج إلى الحياة العامة.
وخامسًا- إن حبس المرأة في البيت لم يُعرف، إلا أنه كان في فترة من الفترات -قبل استقرار التشريع- عقوبة لمن ارتكبت الفاحشة ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (النساء: 15)، فكيف يظن أن يكون هذا من الأوصاف اللازمة للمرأة المسلمة في الحالة الطبيعية؟
ؤ
وهناك من ينظر إلى الأمر من زاوية أخرى، هي زاوية «سد الذرائع»، فالمرأة عندما ترشح للبرلمان ستتعرض في أثناء الدعاية الانتخابية للاختلاط بالرجال وربما الخلوة بهم، وهذا حرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام. ولا شك أن سد الذرائع مطلوب، ولكنالعلماء قرروا أن المبالغة في سد الذرائع كالمبالغة في فتحها قد يترتب عليها ضياع مصالح كثيرة أكبر بكثير من المفاسد المخوفة. وهذا الدليل يمكن أن يستند إليه من يرى منع المرأة من الإدلاء بصوتها في الانتخاب خشية الفتنة والفساد، وبهذا يضيع على الإسلاميين أصوات كثيرة كان يمكن أن تكون في صفهم ضد اللادينيين، ولا سيما أن أولئك يستفيدون من أصوات النساء المتحللات من الدين. وقد وقف بعض العلماء يومًا في وجه تعليم المرأة ودخولها المدارس والجامعات من باب سد الذرائع، حتى قال بعضهم: تعلم القراءة لا الكتابة، حتى لا تستخدم القلم في كتابة الرسائل الغرامية ونحوها! ولكن غلب التيار الآخر ووجد أن التعلم في ذاته ليس شرًّا، بل ربما قادها إلى خير كثير. ومن هنا نقول: إن المسلمة الملتزمة إذا كانت ناخبة أو مرشحة يجب أن تتحفظ في ملاقاتها للرجال من كل ما يخالف أحكام الإسلام من الخضوع بالقول أو التبرج في الملبس أو الخلوة بغير محرم أو الاختلاط بغير قيود، وهو أمر مفروغ منه من قِبل المسلمات الملتزمات.
المرأة والولاية على الرجل
وهناك من يستدلون على منع المرأة من الترشيح للمجلس النيابي بأن هذا ولاية على الرجال، وهي ممنوعة منها، بل الأصل الذي أثبته القرآن الكريم أن الرجال قوامون على النساء، فكيف نقلب الوضع وتصبح النساء قوامات على الرجال؟
وأود أن أبين هنا أمرين:
الأول: أن عدد النساء اللائي يرشحن للمجلس النيابي سيظل محدودًا وستظل الأكثرية الساحقة للرجال، وهذه الأكثرية والتي تملك القرار، وهي التي تحل وتعقد، فلا مجال للقول بأن ترشيح المرأة للمجلس سيجعل الولاية للنساء على الرجال.
الثاني: أن الآية الكريمة التي ذكرت قوامية الرجال على النساء إنما قررت ذلك في الحياة الزوجية، فالرجل هو رب الأسرة وهو المسؤول عنها، بدليل قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّ ٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡض وَبِمَاۤ أَنفَقُوا۟ مِنۡ أَمۡوَ ٰلِهِم﴾(النساء: 34)، فقوله بما «أنفقوا من أموالهم» يدلنا على أن المراد القوامة على الأسرة، وهي الدرجة التي مُنحت للرجال في قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (البقرة: 228 ). ومع قوامية الرجل على الأسرة ينبغي أن يكون للمرأة دورها، وأن يؤخذ رأيها فيما يهم الأسرة، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في مسألة فطام الرضيع: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ (سورة البقرة: 233). وكما جاء في الحديث الذي رواه أحمد: «آمروا النساء في بناتهن» أي استشيروهن في أمر زواجهن. أما ولاية بعض النساء على بعض الرجال خارج نطاق الأسرة، فلم يرد ما يمنعه، بل الممنوع هو الولاية العامة للمرأة على الرجال، والحديث الذي رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة»، إنما يعني الولاية العامة على الأمة كلها، أي رئاسة الدولة. كما تدل عليه كلمة «أمرهم»، فإنها تعني أمر قيادتهم ورياستهم العامة، أما بعض الأمر فلا مانع أن يكون للمرأة ولاية فيه، مثل ولاية الفتوى أو الاجتهاد أو التعليم أو الرواية والتحديث أو الإدارة ونحوها، فهذا مما لها ولاية فيه بالإجماع، وقد مارسته على توالي العصور، حتى القضاء أجازه أبو حنيفة فيها تشهد فيه، أي في غير الحدود والقصاص، مع أن من فقهاء السلف من أجاز شهادتها في الحدود والقصاص، كما ذكر ابن القيم في «الطرق الحكمية»، وأجازه الطبري بصفة عامة، وأجازه ابن حزم مع ظاهريته، وهذا يدل على عدم وجود دليل شرعي صريح يمنع من توليها القضاء وإلا لتمسك به ابن حزم وجمد عليه، وقاتل دونه كعادته. وسبب ورود الحديث المذكور يؤيد تخصيصه بالولاية العامة، فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرس بعد وفاة إمبراطورهم ولّوا عليهم ابنته بوران بنت کسری فقال: «لن يفلح قوم...» الحديث.
شبهة وردها
ومن الشبهات التي أثارها بعض المعارضين لترشيح المرأة في المجالس النيابية قولهم: إن عضو المجلس أعلى من الحكومة نفسها، بل من رئيس الدولة نفسه، لأنها -بحكم عضويتها في المجلس- تستطيع أن تحاسب الدولة ورئيسها، ومعنى هذا أننا منعناها من الولاية العامة، ثم مكناها منها بصورة أخرى. وهذا يقتضي منا إلقاء الضوء بالشرح والتحليل لمفهوم العضوية في المجلس الشوري أو النيابي. ومن المعلوم أن مهمة المجالس النيابية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة ذات شقين، هما: المحاسبة والتشريع، وعند تحليل كل من هذين المفهومين يتضح لنا ما يأتي:
معنى المحاسبة: المحاسبة في تحليلها النهائي حسب المفاهيم الشرعية ترجع إلى ما يعرف في المصطلح الإسلامي بـ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبـ «النصيحة في الدين» وهي واجبة لأئمة المسلمين وعامتهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة مطلوبة من الرجال والنساء جميعًا، والقرآن الكريم يقول بصريح العبارة: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (التوبة: 71)، والرسول صلى الله عليه وسلم حين قال فيما رواه مسلم: «الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم»، لم يجعل ذلك مقصورًا على الرجال وحدهم. وقد رأينا المرأة ترد على أمير المؤمنين عمر في المسجد، فيرجع عن رأيه إلى رأيها ويقول: «أصابت المرأة وأخطأ عمر» كما رواه ابن كثير وجوَّد إسناده. وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في غزوة الحديبية فأشارت عليه بالرأي السديد، وقد بادر إلى تنفيذه فكان من ورائه الخير. وما دام من حق المرأة أن تنصح وتشير بما تراه صوابًا من الرأي وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول: هذا صواب وهذا خطأ بصفتها الفردية، فلا يوجد دليل شرعي يمنع من عضويتها في مجلس ملزم بهذه المهمة، والأصل في أمور العادات والمعاملات الإباحة، إلا ما جاء في منعه نص صحيح صريح. وما يقال من أن السوابق التاريخية في العصور الإسلامية لم تعرف دخول المرأة في مجالس الشورى، فهذا ليس بدليل شرعي على المنع، فهذا مما تدخل في تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال، والشورى لم تنظم في تلك العصور تنظيمًا دقيقًا لا للرجال ولا للنساء، وهي من الأمور التي جاءت فيها النصوص مجملة مطلقة وترك تفصيلها وتفنيدها لاجتهاد المسلمين حسب ظروفهم الزمانية والمكانية وأوضاعهم الاجتماعية. ونحن الآن نتيح للمرأة أعمالًا لم تكن معروفة من قبل وننشئ لها المدارس، والكليات تضم الملايين من الفتيات وتخرج معلمات وطبيبات ومحاسبات وإداريات وبعضهن مديرات لمؤسسات فيها رجال. فكم من معلم في مدرسة بنات تديرها امرأة، وكم من أستاذ في كليات بنات عميدتها امرأة، وكم من موظف في شركة أو مؤسسة تديرها امرأة أو تملكها امرأة، وقد يكون زوج المرأة نفسه مرؤوسًا لها في المدرسة أو الكلية أو المستشفى أو المؤسسة التي تديرها وهي مرؤوسة له إذا عادت إلى البيت. والقول بأن مجلس الشعب أو الشورى أو الأمة -حسب تسمياته المختلفة- أعلى مرتبة من الحكومة أو السلطة التنفيذية نفسها، ومنها رئيس الدولة لأنه هو الذي يحاسبها، قول غير مسلم على إطلاقه؛ فليس كل محاسب أعلى منزلة ممن يحاسبه، إنما المهم أن يكون له حق المحاسبة وإن كان أدنى منه. فمما لا ريب فيه أن أمير المؤمنين أو رئيس الدولة أعلى منزلة وأعلى سلطة في الدولة، ومع هذا نجد أن من حق أدنى فرد في رعيته أن ينصح له ويحاسبه ويأمره وينهاه على نحو ما قاله الخليفة الأول: «إن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني»، وما قاله الخليفة الثاني: «من رأى منكم فيَّ اعوجاجًا فليقومني». ولا ينكر أحد أن من حق المرأة أن تحاسب زوجها -وهو القوام عليها- في شؤون البيت والنفقة وتقول له: لم اشتريت هذا؟ ولم أكثرت من هذا؟ على أننا لو سلمنا بأن سلطة المحاسب أعلى ممن يحاسبه فهذا إنما يثبت للمجلس بصفته الجماعية، فالمجلس بهذا الوصف أعلى من السلطة التنفيذية فيما هو من حقه واختصاصه، وما دام المجلس مكونًا في أغلبيته من الرجال فلا محل للقول بأن المرأة أصبحت لها ولاية على الرجل بذلك، إنما يصدق هذا القول لو كان المجلس كله أو جله من النساء.
جانب التشريع في المجلس
والشق الثاني من مهمة المجلس النيابي يتعلق بالتشريع: وبعض المتحمسين يبالغون في تضخيم هذه المهمة، زاعمين أنها أخطر من الولاية والإمارة؛ فهي التي تشرع للدولة وتضع لها القوانين، لينتهوا إلى أن هذه المهمة الخطيرة الكبيرة لا يجوز للمرأة أن تباشرها. والأمر في الحقيقة أبسط من ذلك وأسهل، فالتشريع الأساسي إنما هو لله تعالى، وأصول التشريع الآمرة الناهية هي من عند الله سبحانه، وإنما عملنا نحن البشر هو استنباط الحكم فيما لا نص فيه أو تفصيل ما فيه نصوص عامة، وبعبارة أخرى عملنا هو «الاجتهاد» في الاستنباط والتفصيل والتكييف. والاجتهاد في الشريعة الإسلامية باب مفتوح للرجال والنساء جميعًا، ولم يقل أحد إن من شروط الاجتهاد -التي فصل فيها الأصوليون- الذكورة، وإن المرأة ممنوعة من الاجتهاد. وقد كانت أم المؤمنين عائشة من مجتهدات الصحابة ومن المفتيات بينهن، ولها مناقشات واستدراكات على علماء الصحابة جُمعت في كتب معروفة. صحيح أنه لم ينشر الاجتهاد بين النساء في تاريخنا انتشاره في الرجال؛ وذلك راجع إلى عدم انتشار العلم بين النساء لظروف تلك العصور وأوضاعها على خلاف ما عليه الحال اليوم، فقد أصبح عدد المتعلمات من النساء مساويًا أو مقاربًا لعدد المتعلمين من الرجال، وفيهن من النوابغ ما قد يفوق بعض الرجال، والنبوغ ليس صفة للذكور فرُب امرأة أوتيت من المواهب ما يعز على بعض الرجال الحصول عليه. وقد حكى لنا القرآن قصة ملكة سبأ وما أوتيت من سداد الرأي والحكمة في موقفها من سليمان عليه السلام منذ تلقت رسالة من الهدهد، وكيف استشفت من رسالته الموجزة الجدية والالتزام، وكيف جمعت الملأ من أشراف قومها على طريقتها في الحكم «ما كنت قاطعة أمرًا حتى تشهدون»، وكيف فوض الرجال الأشداء الأمر إليها مختارين لتتصرف فيها بحكمتها: ﴿قَالُوا۟ نَحۡنُ أُو۟لُوا۟ قُوَّة وَأُو۟لُوا۟ بَأۡس شَدِید وَٱلۡأَمۡرُ إِلَیۡكِ فَٱنظُرِی مَاذَا تَأۡمُرِینَ﴾ (النمل:32)، وكيف تصرفت بعد ذلك بمنتهى الذكاء والأناة مع نبي الله سليمان حتى انتهى أمرها إلى أن أسلمت «معسليمان لله رب العالمين». وحكاية هذه القصة في القرآن الكريم ليس عبثًا، بل يدل على أن المرأة قد يكون لها من البصيرة وحسن الرأي والتدبير في شؤون السياسة والحكم ما يعجز عنه كثير من الرجال. ومما لا جدال فيه أن ثمة أمور في التشريع تتعلق بالمرأة نفسها، وبالأسرة وعلاقاتها ينبغي أن يؤخذ رأي المرأة فيها وألا تكون غائبة عنها، ولعلها تكون أنفد بصرًا في بعض الأحوال من الرجال. والمرأة التي ردت على عمر رضي الله عنه في المسجد كان ردها متصلًا بأمر تشريعي يتعلق بالأسرة، وهو تحديد المهور بحد أقصى، وكانت مناقشة المرأة سببًا في عدول عمر عن إصدار قانونه بتحديد الصداق. وهناك قوانين أو قرارات أصدرها عمر رضي الله عنه كان للمرأة يد في إصدارها، مثل قانون عدم تغييب الزوج في الجيش عن زوجته أكثر من ستة أشهر، فقد سأل ابنته حفصة: ما أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: أربعة أشهر أو ستة أشهر. وكان قد أفزعه شعر تلك المرأة التي أرقتها الوحدة، وأقلقتها الوحشة، فأنشدت وهي نائمة على سريرها:
تطاول هذا الليل واسودَّ جانبه
وأرَّقني ألَّا حبيب ألاعبه
فو الله لولا الله تُخشى عواقبه
لحُرك من هذا السرير جوانبه!
وكذلك قانونه الذي فرض به عطاء لكل مولود في الإسلام، بعد أن كان لا يفرض إلا لمن فطمته أمه. كانت الأمهات يعجِّلن بفطام أطفالهن قبل الأوان رغبة في العطاء، فلما سمع يومًا بكاء طفل متواصلًا شديدًا وسأل أمه عن سر هذا البكاء، فقالت له وهي لا تعرفه: إن أمير المؤمنين لا يفرض العطاء إلا للفطيم، لذا فطمته مبكرًا فهو يبكي. فقال عمر: ويح عمر! كم قتل من أطفال المسلمين! وأعلن بعدها تعميم العطاء لكل مولود. على إننا حين نقول بجواز دخول المرأة في المجالس النيابية، لا يعني ذلك أن تختلط بالرجال الأجانب عنها بلا حدود ولا قيود، أو يكون ذلك على حساب زوجها وبيتها وأولادها، أو يخرجها ذلك عن أدب الاحتشام في اللباس والمشي والحركة والكلام، بل كل ذلك يجب أن يُراعَى بلا ريب ولا نزاع من أحد. وهذا مطلوب من المرأة في مجلس الشعب والمرأة في مجلس الجامعة، والمرأة في مجلس الكلية، والمرأة في عملها خارج البيت أيًّا كان هذا العمل. ومن المطلوب في دولة تراعي آداب الإسلام أن يكون للنساء موقعهن الخاص في المجلس، صفوف خاصة، أو ركن خاص لهن، أو نحو ذلك مما يوفر لهن جوًّا من الطمأنينة والبعد عن أي فتنة يخافها المتوجسون.
تعليقات وردود:
بعد كتابة الصفحات السابقة حول ترشيح المرأة للمجالس النيابية أطلعني بعض الفضلاء على فتوى قديمة لبعض علماء الأزهر، انتهت إلى تحريم الحقوق السياسية كلها على المرأة وأولها حق الانتخاب والشهادة لمرشح بقول «نعم» أو «لا»، ومن باب أولى منعها عن الترشيح للمجالس النيابية ما دامت قد مُنعت من مجرد التصويت.
موقف نساء النبي وتطلعهن إلى الزينة
ومما استندت إليه فتوى هؤلاء المانعين للمرأة من مزاولة الحقوق السياسية قولهم: إن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت لأجلها، وهي مهمة الأمومة وحضانة النشء وتربيته، وهذه قد جعلتها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة. ولا تعوزنا الأمثلة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة من خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها، فقد دفعت هذه الغرائز المرأة في أسمى بيئة نسوية إلى تغليب العاطفة على مقتضى العقل والحكمة. وآيات من سورة الأحزاب تشير إلى ما كان من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتطلعهن إلى زينة الدنيا ومتعتها، ومطالبتهن الرسول أن يغدق عليهن مما أتاه الله من الغنائم حتى يعشن كما تعيش زوجات الملوك ورؤساء الأمم، لكن القرآن قد ردهن إلى مقتضى العقل والحكمة في ذلك: ﴿يَا أيّها النبيّ قُلْ لأزواجكَ إنْ كنتنّ تُردنَ الحياةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَها فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الأحزاب: 28 – 29) (۱) سبب نزول الآية ومن باب أولى سبب ورود الحديث يجب أن يرجع إليه في فهم النص، ولا يؤخذ عموم اللفظ قاعدة مسلمة.
يؤكد هذا في هذا الحديث خاصة أنه لو أخذ على عمومه لعارض ظاهر القرآن، فقد قص علينا القرآن قصة امرأة قادت قومها أفضل ما تكون القيادة، وحكمتهم أعدل ما يكون الحكم، وتصرفت بحكمة ورشد أحسن ما يكون التصرف، ونجوا بحسن رأيها من التورط في معركة خاسرة يهلك فيها الرجال، وتذهب الأموال، ولا يجنون من ورائها شيئًا، تلك هي بلقيس التي ذُكرت قصتها في سورة النمل مع نبي الله سليمان، وانتهى بها المطاف إلى أن قالت: ﴿رَبِّإِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ (۱).
كما يؤكد صرف الحديث عن العموم الواقع الذين شهده، وهو أن كثيرًا من النساء قدموا لأوطانهم خيرًا من كثير من الرجال، وإن بعض هؤلاء «النساء» لهو أرجح في ميزان الكفاية والمقدرة السياسية والإدارية من كثير من حكام العرب والمسلمين «الذكور» ولا أقول «الرجال».
الثانية: أن علماء الأمة قد اتفقوا على منع المرأة من الولاية الكبرى أو الإمامة العظمي، وهي التي ورد في شأنها الحديث ودل عليها سبب وروده، كما دل عليها لفظة ولوا أمرهم وفي رواية «تملكهم امرأة»، فهذا إنما ينطبق على المرأة إذا أصبحت ملكة أو رئيسة دولة ذات إرادة نافذة في قومها، لا يرد لها حكم، ولا يبرم دونها أمر، وبذلك يكونون قد ولوها أمرهم حقيقة، أي أن أمرهم العام قد أصبح بيدها وتحت تصرفها ورهن إشارتها. أما ما عدا الإمامة والخلافة وما في معناها من رئاسة الدولة، فهو مما اختلف فيه. فيمكن بهذا أن تكون وزيرة، ويمكن أن تكون قاضية، ويمكن أن تكون محتسبة احتسابًا عامًّا.
وقد ولى عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد الله العدوية على السوق تحتسب وتراقب، وهو ضرب من الولاية العامة.
الثالثة: أن المجتمع المعاصر في ظل النظم الديمقراطية حين يولي المرأة منصبًا عامًّا كالوزارة أو الإدارة أو النيابة أو نحو ذلك فلا يعني هذا أنه ولاها أمره بالفعل، وقلدها المسؤولية عنه كاملة. فالواقع المشاهد أن المسؤولية جماعية والولاية مشتركة تقوم بأعبائها مجموعة من المؤسسات والأجهزة، والمرأة إنما تحمل جزءًا منها مع من يحملها. وبهذا نعلم أن حكم (تاتشر) في بريطانيا أو «أنديرا» في الهند أو «جولدا مائير» في فلسطين المحتلة ليس هو عند التحقيق والتأمل حكم امرأة في شعب، بل هو حكم المؤسسات والأنظمة المحكمة، وإن كان فوق القمة امرأة، إن الذي يحكم هو مجلس الوزراء بصفته الجماعية وليست رئيسة مجلس الوزراء. فليست هي الحاكمة المطلقة التي لا يُعصى لها أمر، ولا يرفض لها طلب، فهي إنما تترأس حزبًا يعارضه غيره، وقد تجرى هي انتخابات فتسقط فيها بجدارة، كما حدث لأنديرا في الهند، وهي في حزبها لا تملك إلا صوتها، فإذا عارضتها الأغلبية غدا رأيها كراي أي إنسان في عرض الطريق.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل