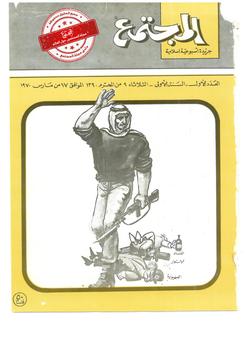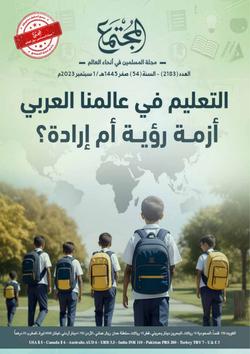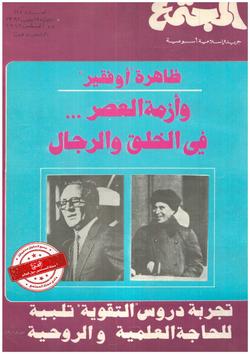العنوان وجوب الدعوة إلى.. الله
الكاتب محمد أحمد الراشد
تاريخ النشر الثلاثاء 18-يوليو-1972
مشاهدات 15
نشر في العدد 109
نشر في الصفحة 26

الثلاثاء 18-يوليو-1972
رياض المؤمنين
في فقه الدعوة
يكتبها: محمد أحمد راشد
وجوب الدعوة إلى.. الله
إنها رهبة تفزع المسلم حقًا، تقذفها تلك التهديدات التي خاطب الله تعالى بها من يصمت ويتخارس ويدع النهي عن المنكر.
ويظل الأخرس قلقًا أبدًا، محرومًا من الطمأنينة والسكينة الإيمانية، فإنها حكر خالص لأصحاب اللسان الناطق بالحق، الذين يبشرون الناس بالجنة، وبسماحة الإسلام وعدله، وينذرونهم عذاب جهنم وقانون التماثل في العقاب الرباني، فيرثون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما وصفه الله تعالى، حين قال إنه أرسله بشيرًا ونذيرًا. أو بالاصطلاح الآخر: الذين يدعون إلى الله. أو باصطلاح بعض الفقهاء: الذين يحتسبون، أي يقومون بمهمة الحسبة، أي احتساب الأجر عند الله في أداء النصيحة والأمر والنهي.
وقد تعرض ابن تيمية رحمه الله لتعريف الدعوة، فقال:
الدعوة إلى الله: هي الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت به رسله، بتصديقها فيما أخبروا به، وطاعتهم فيما أُمروا» (۱)
الدعوة والدعاة في اللغة والاشتقاق
وكلمة «الدعوة» هذه هي مصطلح إسلامي، وهناك «علاقة وثيقة بين مدلول اللفظ في الأصل اللغوي، وبين استعمال اللفظ كمصطلح إسلامي صرف، ليس لبقية المعتقدات ناقة فيه ولا جمل.
وأول ما ننظر إلى كون اللفظة فعلًا، وهو «د ع و» على زنة «فعل»، وفي العربية، إذا سبق حرف العلة «الواو» حرف مفتوح قلب الواو ألفا، فتصبح «دعا».
ونجد أن هذا اللفظ لا يحمل إلا معنى واحدًا، وهو: أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك. انظر معجم مقاييس اللغة ۲۷۹/۲.
والإمالة هنا مقتصرة على شيئين: الصوت، والكلام، اللذين يخرجان من محدثهما، وحين ذاك لا يكون لهذا اللفظ مدلول آخر، فأنت حين تقرأ قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إلى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾. (فصلت: ٣٣).
تفهم أن الله تعالى فضل من دعا إليه بأنه أحسن «قولًا» ممن لم يدع إليه.
ومشتقات هذا الفعل لم تخرج في مدلولاتها عن هذا المعنى أبدًا، فالمصدر منه مثلًا هو: دعاء، والأصل: دعاو، لأنه- كما هو معروف- من دعوت، إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف قلبت همزة. وقد يأخذ المصدر أشكالًا أخرى من الأبنية. يقول الجوهري: «يقال: كنا في دعوة فلان ومدعاة، وهو في الأصل مصدر، يريدون: الدعوة إلى...».
ويقول صاحب المحيط: «دعا دعاء ودعوى»، أي الإمالة والترغيب.
فمن مجموع ما تقدم نفهم أن الصلة وثيقة بين مدلول الفعل دعا في اللغة، وبين مدلوله فيما اصطلح عليه القرآن الكريم، فقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إن رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾. (النحل.: ١٢٥). يدل على الإمالة والترغيب.
والذي يقوم بأمر الدعوة ويحمل عبأها ليبلغها إلى الناس هو الذي يطلق عليه الإسلام: «الداعي» أو «الداعية»، والداعي اسم فاعل من الفعل دعا يدعو، أما الداعية فهو بناء اسم الفاعل أيضًا مع تاء تلحق في آخره لتدل على المبالغة والتكثير، وإذا أردنا الجمع قلنا «دعاة» والجمع السالم «داعون» و«داعيات» (۲).
الدعوة وظيفة الرسل وأتباعهم
«والرسول صلى الله عليه وسلم قام بهذه الدعوة، فإنه أمر الخلق بكل ما أمر الله به، ونهاهم عن كل ما نهى الله عنه. أمر بكل معروف، ونهى عن كل منكر». (۳).
«والواقع أن الدعوة إلى الله هي وظيفة رسل الله جميعًا، ومن أجلها بعثهم الله تعالى إلى الناس، فكلهم بلا استثناء دعوا أقوامهم ومن أرسلوا إليهم إلى الإيمان بالله، وأفراده بالعبادة، على النحو الذي شرعه لهم. قال تعالى عن نوح عليه السلام: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾. (الأعراف: ٥٩).
وهكذا جميع رسل الله دعوا إلى الله، إلى عبادته وحده والتبرؤ من عبادة سواه. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾. (النحل: ٣٦).
فرسل الله هم الدعاة إلى الله، وقد اختارهم الله لحمل دعوته وتبليغها إلى الناس». (٤).
«وكل ما أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب، من باطن وظاهر، فمن الدعوة إلى الله: الأمر به. وكل ما أبغضه الله ورسوله، من باطن وظاهر، فمن الدعوة إلى الله: النهي عنه. لا تتم الدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه الله، ويترك ما أبغضه الله، سواء كان من الأقوال أو الأعمال الباطنة أو الظاهرة» (٥).
ما ورد في القرآن الكريم من آيات الدعوة والأمر والنهي
ووردت في القرآن آيات كثيرة توجب الدعوة إلى الله، منها ما تخاطب النبي- صلى الله عليه وسلم، فتدخل أمته في الخطاب تبعًا له، ومنها ما خاطبت الأمة مباشرة.
فمن الآيات التي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ﴿لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۖ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ ۚ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾. (الحج: ٦٧).
وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾. (القصص: ٨٧).
وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أن أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ﴾. (الرعد: ٣٦).
«وهذه الآيات يدخل فيها المسلمون جميعًا، لأن الأصل في خطاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دخول أمته فيه إلا ما استثنى، وليس من هذا المستثنى أمر الله تبارك وتعالى له بالدعوة إليه، ومعنى ذلك أن الله تعالى أكرم هذه الأمة الإسلامية وشرفها أن أشركها مع رسوله الكريم في وظيفة الدعوة إليه» (٦). وأما الآيات التي تخاطب الأمة وتوجب عليها أن تأمر وتنهي فكثيرة، لا تدع عذرًا لمتقاعد متخوف، كقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إن اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾. (التوبة: ٧١).
قال القرطبي: «فجعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين، فدل على أن أخص أوصاف المؤمنين: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورأسها: الدعاء إلى الاسلام». (٧).
وقد سرد الغزالي رحمه الله هذه الآيات، وعقب عليها تعقيبات قيمة. قال: «قال تعالى: ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾. (آل عمران: ١١٣ - ١١٤).
فلم يشهد لهم بالصلاح بمجرد الإيمان بالله واليوم الآخر؛ حتى أضاف إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». (۸)
« وقال تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾. (المائدة: ٧٨ - ٧٩).
وقال عز وجل: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. (آل عمران: ١١٠).
وهذا يدل على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ بيَّن أنهم كانوا به خير أمة أُخرجت للناس.
وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾. (الأعراف: ١٦٥).
فبيَّن أنهم استفادوا النجاة بالنهي عن السوء، ويدل ذلك على الوجوب أيضًا.
وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ إن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾. (الحج: ٤١).
فقرن ذلك بالصلاة والزكاة في نعت الصالحين والمؤمنين، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أن تَعْتَدُوا ۘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إن اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾. (المائدة: ٢).
وهو أمر جزم، ومعنى التعاون: الحث عليه وتسهيل طرق الخير وسد سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان.
وقال تعالى: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾. (المائدة: ٦٣).
وقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾. (هود: ١١٦).
فبيَّن أنه أهلك جميعهم إلا قليلًا منهم كانوا ينهون عن الفساد.
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾. (النساء: ١٣٥).
وذلك هو الأمر بالمعروف للوالدين والأقربين.
وقال تعالى: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾. (النساء: ١١٤).
وقال تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إن اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾. (الحجرات: ٩).
والإصلاح نهي عن البغي وإعادة إلى الطاعة، فان لم يفعل فقد أمر الله تعالى بقتاله فقال: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ﴾. (الحجرات: ٩). وذلك هو النهي عن المنكر». (٩).
وإذن، فإن الحريص على إيمانه، الطالب للفردوس وعليين، يحرص أشد الحرص على أن ينطق بالحق، معطيًا راحته ووقته وماله، بل روحه ودمه، ثمنًا لما يطلب، فإن الدعوة إلى الله واجبة، لا يعذر منها أحد، إلا من كان مستضعفًا من عوام الناس، البسطاء السذج الذين لا يحسنون النطق وتدبير الأمور.
وكما أوجب الله على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقوم فينذر ويدعو إلى الله، فكذلك «الدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه، وهم أمته يدعون إلى الله، كما دعا إلى الله ».
وكذلك يتضمن أمرهم بما أمر به، ونهيهم عما ينهى عنه، وإخبارهم بما أخبر به، إذ الدعوة تتضمن الأمر، وذلك يتناول الأمر بكل معروف، والنهي عن كل منكر». (١٠).
«وهذا الواجب واجب على مجموع الأمة، وهو الذي يسميه العلماء: فرض كفاية، إذا قام به طائفة منهم سقط عن الباقين، فالأمة كلها مخاطبة بفعل ذلك، ولكن إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين». (۱۱)
« فمجموع أمته تقوم مقامه في الدعوة إلى الله، ولهذا كان إجماعهم حجة قاطعة، فأمته لا تجتمع على ضلالة، وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله.
وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه؛ إذا لم يقم به غيره، فما قام به غیره: سقط عنه، وما عجز: لم يطالب به.
وأما ما لم يقم به غيره وهو قادر عليه فعليه أن يقوم به، ولهذا يجب على هذا أن يقوم بما لا يجب على هذا. وقد تسقط الدعوة على الأمة بحسب ذلك تارة وبحسب غیره أخرى، فقد يدعو هذا إلى اعتقاد الواجب، وهذا إلى عمل ظاهر واجب، وهذا إلى عمل باطن واجب، فتنوع الدعوة يكون في الوجوب تارة، وفي الوقوع أخرى.
وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم، لكنها فرض على الكفاية، وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره، وهذا شأن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتبليغ ما جاء به الرسول، والجهاد في سبيل الله، وتعليم الإيمان والقرآن.
وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإن الداعي طالب مستدع مقتض لما دعا إليه، وذلك هو الأمر به، إذ الأمر هو طلب الفعل المأمور به، واستدعاء له ودعاء إليه، فالدعاء إلى الله: الدعاء إلى سبيله، فهو أمر بسبيله، وسبيله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر». (۱۲)
معنى الكفاية
ورد أوهام القاعدين الصامتين
ويتوهم الكثيرون أنهم قد أذن لهم بالقعود حين قرر الفقهاء أن الدعوة فرض على الكفاية، ويختارون أنفسهم في الطائفة المتخارسة، اغترارًا بأن الدعوة إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وليس الأمر كما فهموا، كما هو واضح في النص السابق، فإن لفظ القيام بها يعني حصول الشيء المأمور به في عالم الواقع وتطبيقه، واتعاظ الطائفة المأمورة فعلًا، فإذا بقية الطائفة المأمورة سادرة في غفلتها، متبعة لشهوتها، والغة في عصيانها: بقي جميع المسلمين تحت هذا التكليف، وعليهم أن يعينوا الدعاة إلى الله الذين يأمرون بالمعروف، ويزيدوا قوتهم، ويكثروا سوادهم، إلى الدرجة التي يكتسبون فيها الهيبة والتأثير الكافي لامتناع الطائفة العاصية من أفراد الأمة عن عصيانها ومخالفتها للشريعة، فإذا امتنعت فعلًا لزم وجود عدد من الأمرين: الدعاة يديمون حالة الامتناع هذه، ووسع البعض الآخر أن يسكتوا، أما قبل ذلك فلا. ومن يستطلع حالة المسلمين اليوم يجد أن الجهود المبذولة في الدعوة إلى الله لا زالت أقل من المقدار اللازم لامتناع من يرتكب المعاصي منهم، ورأس المعاصي: الحكم بغير ما أنزل الله، وبآراء العقول والأهواء والأفكار المستوردة، ومن ثم فإنه لا يسع المسلم اليوم أن يقعد عن الدعوة إلى الله، ونصرة الدعاة، والاشتراك معهم في جهودهم لاقتلاع السوء والمعاصي، وأهل السوء والمعاصي، وإحلال الخير وأهل الخير والتوحيد محل ذلك.
«فالدعوة إلى الخير- وأعلاها: الدعوة إلى الله- واجبة على كل مسلم بقدر استطاعته، لأن هذه الدعوة من صفات المؤمنين، ولأن الحديث الشريف أمر كل مسلم ومسلمة بإزالة المنكر حسب استطاعته، فإذا حصل المقصود بفرد أو أفراد: لم يطالب الآخرون بإعادة المنكر لإزالته، ولا يؤاخذون لأنهم لم يزيلوه، والشأن في المسلم المبادرة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون انتظار إلى غيره، فقد لا يقوم به الغير فيقع في الإثم. والمسلم يدعو إلى الله باعتباره مسلماً مؤمنا بالله ورسوله، كما قال تعالى ﴿ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إلى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾. (يوسف: ١٠٨).
فلا بد للمسلم أن يدعو إلى الله، ولكن لو قدر أنه لم يدعُ شخصًا معينًا إلى الله أو لم يدعُ في وقت، وقام بالدعوة مسلم آخر، فان الداعي يؤجر دون الأول، ولكن لو ترك المسلم الدعوة إلى الله تركًا دائمًا مستمرًا متعمدًا فإنه لا ينضوي تحت مفهوم قوله تعالى ﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إلى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيۖ﴾. (يوسف: ١٠٨).
لأن أتباع الرسول- صلى الله عليه وسلم- هم الذين يدعون إلى الله.
هذا ومن معاني الفرض الكفائي أنه متوجه إلى المسلمين جميعًا بان يعملوا لتحقيق هذا الفرض، وعلى القادر فعلًا أن يقوم بهذا الفرض مباشرة، فيكون معنى الآية ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾. (آل عمران: ١٠٤).
أن يقوم المسلمون بإعداد هذه «الأمة»، أي الجماعة المتصدية للدعوة إلى الله، وأن يعاونوهم بكل الوسائل ليتحقق المقصود من قيامهم، وهو إقامة دين الله ونشر دعوته، فإن لم يفعل المسلمون ذلك أثم الجميع؛ المتأهل للدعوة وغيره.
ويقال أيضًا: إن الدعوة إلى الله، حتى لو قلنا إنها تجب على البعض دون البعض الآخر، باعتبار أنها من الفروض الكفائية، فإن الشرط للخروج من عهدة الفرض الكفائي حصول الكفاية بمن يقوم به، ولما كانت الكفاية غير حاصلة، فيجب أن يقوم بهذا الواجب كل مسلم حسب قدرته». (۱۳)
(١) مجموع الفتاوى ١٥٧/١٥
(۲) من مقال الشاعر الأستاذ رشيد الأعظمي في مجلة التربية الإسلامية ٤٧١/٥ مع بعض حذف.
(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية ١٦١/١٥
(٤) أصول الدعوة ٢٦٨
(٥) مجموع فتاوى ابن تيمية ١٦٤/١٥
(٦) أصول الدعوة ٢٦٩
(۷) تفسير القرطبي ٤٧/٤ نقلًا عن أصول الدعوة /۲۷۰
(۸) (۹) إحياء علوم الدین ۳۰۷/۲
(۱٠) (۱۱) (۱۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ١٦٦/١٦٥/١٥
(۱۳) أصول الدعوة ٢٧٥
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل