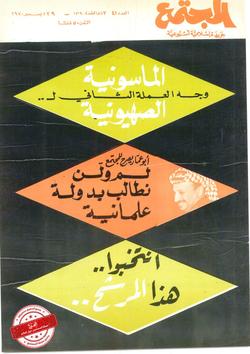العنوان وقفة مع: محمد أركون من خلال دعوته إلى علمنة الإسلام
الكاتب المهدي المغربي
تاريخ النشر الثلاثاء 28-يونيو-1988
مشاهدات 28
نشر في العدد 872
نشر في الصفحة 36
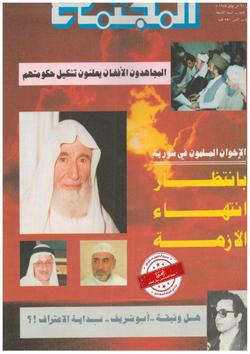
الثلاثاء 28-يونيو-1988
تشهد الساحة الثقافية في البلاد العربية والإسلامية صراعات وتفاعلات شتى بين تيارات متباينة وأفكار مختلفة وأيديولوجيات متقابلة، وليست هذه الصراعات وهذه التفاعلات إلا سمة من سمات المخاض الذي يعبر عن اشتداد الأزمة الثقافية الفكرية التي هي بدورها انعكاس للأزمة السياسية والاقتصادية التي ما أنفك عالمنا العربي الإسلامي يعاني منها، وفي هذا الخضم وبعد انحسار الموجة الشيوعية والماركسية عالميًا، شعر أهل اليسار في بلادنا العربية الإسلامية بضرورة الإسراع في إعادة النظر في برامجهم وطروحاتهم قبل أن يفوتهم الركب لا سيما وقد لاحظوا أن المد الإسلامي يتقدم ويكتسح المعاقل اليسارية «والدليل ما يحدث في السودان وتونس ومصر» فراحوا يقدمون مشاريع لإعادة القراءة للتراث بما فيها الوحي والسنة من منظور مادي علماني؛ لقطع الطريق على كل رجوع سليم للشعوب العربية الإسلامية إلى طريق الحق الواضح إلى أصول الدين الإسلامي وشريعة الله السمحة. ومن أبرز المفكرين والدعاة إلى هذا الطريق الجديد والذي كان منذ الخمسينيات مرشحًا له باسم الاجتهاد في الدين وإعادة القراءة للموروث بما فيه القرآن والسنة المفكر الجزائري المنشأ محمد أركون.
وفي نطاق هذا المقال المحدود لا يمكننا أن ندخل كل أروقة الفكر الأركوني، ولا يمكننا أن نتعرض بكل ما يصدمنا به هذا المفكر من مصطلحات واستنتاجات تدعي العلمية وينزلها صاحبها في إطار البحث العلمي والجاد والمنهجية الحديثة، ولكننا لا نرى فيها سوى أدوات جديدة لهدم أركان الدين وزعزعة الثقة في المعتقدات الإسلامية. وحسبنا أن نقف مع محمد أركون وقفة واحدة من خلال فصل في كتابه الأخير المعنون «تاريخية الفكر العربي الإسلامي» الذي كان يحمل قبل أن يضيف إليه بعض الفصول عنوانًا لأخر هو «نحو نقد للعقل الإسلامي»أما الفصل الذي سنقف عنده ضمن هذا الكتاب فهو بعنوان علمنة الإسلام، وهذا العنوان في حد ذاته يحمل على الاستغراب والاستنكار؛ لأن صاحبه جمع فيه بين نقيضين لا يلتقيان، فماذا يعني الدكتور أركون بعلمنة الإسلام؟ وما الذي يهدف إليه من وراء هذه العلمنة؟
قبل الإجابة على هذه الأسئلة والوقوف على حقيقة «علمنة الإسلام» المدعو إليها، رأينا أن نقحم بين هذه السطور ترجمة قصيرة للدكتور أركون للتعريف به ولو بعجالة، حيث لم يسبق لنا أن كتبنا عنه، وحيث يمكن أن تكون هذه الترجمة خلفية للقارئ الذي لم يسمع عن محمد أركون، وهي كذلك ضرورية من باب ربط الصلة بين الانتاج والمنتج والمثل العربي يقول: الشيء من مأتاه لا يستغرب.
من هو محمد أركون؟
الأستاذ محمد أركون مفكر جزائري مولود في تاوريرت ميمون بمنطقة القبائل الكبرى المعروفة بمناهضتها للتعريب والمتمسكة ببربريتها، تعلم بوهران، وبالجزائر العاصمة، ثم أتم تعليمه العالي بباريس حيث حصل سنة ١٩٥٥ على شهادة التبريز في اللغة العربية والأدب العربي، عمل مدرسًا بثانويات فرنسا ثم عمل أستاذًا مساعدًا بجامعة السربون ما بين ١٩٦٠ و ١٩٦٩ ، حصل محمد أركون على دكتوراة الدولة حول موضوع الأنسية العربية في القرن الرابع الهجري من نفس الجامعة المذكورة عام ١٩٦٩، درس الحضارة الإسلامية كأستاذ محاضر بجامعة ليون الثاني وباريس الثامنة ولوفان لانوف ببلجيكا.
ألقى عدة دروس ومحاضرات في جامعات ومدارس كبيرة مثل الرباط وفاس وتونس والجزائر ودمشق و بيروت وطهران وبرلين وأمستردام وهارفارد و برانستون وكولومبيا ولوس أنجلوس وغيرها . يشغل حاليًا كرسي تاريخ الفكر الإسلامي بجامه السربون الجديدة، وهو مدير معهد الدراسات العربي والإسلامية بها.
من أهم مؤلفاته وأعماله:
- ترجمة كتاب «تهذيب الأخلاق» لمسكويه .. الفرنسية - دمشق ١٩٦٩.
- محاولات في الفكر الإسلامي، وهو عبارة عن مجموعة من المقالات والمحاضرات تتعلق بالعالم الإسلامي.
-الفكر العربي ترجمة إلى العربية عادل العوا.
- الإسلام: الأمس والغد - بالمشاركة مع لويس غاردي بالفرنسية
-الإسلام دين ودنيا بالمشاركة مع ماريو أوروز والمستشرق موريس بورمانس.
- قراءات للقرآن ۱۹۸۲.
-نحو نقد للعقل الإسلامي على غرار نقد العقل الخالص لإيمانويل كانط أو نقد العقل الجدلي لجاك بول سارتر، صدر هذا الكتاب في طبعة عربية تحمل عنوان تاريخية الفكر العربي الإسلامي بترجمة هاشم صالح، والطبعة العربية تختلف عن نص الكتاب الفرنسية حيث حذفت في الطبعة العربية الفصول الثلاثة الأخيرة وعوضت بفصلين هما:
الخطابات الإسلامية، الخطابات الاستشراقية للفكر العلمي.
الإسلام والعلمنة.
- السمة العامة لكل الكتر كونية هي تشكيك المسلمين في أقطاب دعاته وعلمائه بوصفهم بأصحاب «الخطاب السلفي ».
الجدير بالذكر أن كل أعمال محمد أركون كتبها باللغة الفرنسية، ونحن نتساءل مثلما يتساءل القراء المسلمون لِمَ لم يباشر أركون الكتابة بالعربية وهو يقول أن هدفه «توجيه عامة المسلمين نحو الطرق المستحدثة في التفكير والاتصال بالتاريخ يسهم ما يجري في مجتمعاتنا المعاصرة» علاوة على أنه عربيًا ينتمي إلى دولة عربية ومتخصصا في اللغة العربية وآدابها؟
التحليل الذي يقدمه أركون حول تساؤلنا هذا «تخلف اللغة العربية عن الركب الحضاري في ميدان العلوم الاجتماعية الحديثة ومحافظتها على تعابير دينية، ونتف من الفقه والنحو والأدب مفصلة عن المعاجم العلمية الثرية التي أحدثها أركرون والأدباء والعلماء في عصور الازدهار» ولكن كلام أركون هذا مردود عليه بدليل أنه هو نفسه ارتضى ترجمة عربية لبعض كتبه وزكاها، وبدليل أن العديد من المفكرين العرب لم يمنعهم استخدامهم للمناهج الغربية الحديثة والعلوم المستجدة من الكتابة والتأليف باللغة العربية، وتبقى هذه المسألة لتعزز الشبهات حول الطرح الأركوني ودعوته العلمانية.
العلمنة كما يقدمها أركون:
يحرص الأستاذ محمد أركون على أن يقدم لنا العلمنة على أنها رؤية وممارسة عقلانية للحياة وعلى أنها تنبثق من إلحاح الفهم لدى الإنسان والرغبة في الكشف والتعقل، وبالتالي فهي تأخذ بأخر ما أوصلت إليه العلوم من طرق ومنهجية حديثة دون اتكاء على أية خلفيات أيديولوجية، ولكنه في نفس الوقت لا ينكر أن العلمنة لا يمكن أن تتخلص تخلصًا مطلقًا من الأيديولوجيا، وإذا كانت العلمنة هي تطبيق النظريات العلمية على كل ما يتصل بالإنسان فإن أركون كشأن كل العلمانيين لا يستثني من ذلك الرسالات السماوية والوحي من أجل زعزعة معتقداتنا أركون يقدم العلمنة على أنها رؤية وممارسة عقلانية للحياة!!
وكل ما يتعلق بالمعتقدات وحتى بفكرة الإله نفسها. إن تقديم العلمنة على أنها عقلنة الفهم النابع من توق لدى الإنسان للكشف والتعقل يضفي عليها بريقًا أخاذًا، ولكنه خادع في نفس الوقت لأننا إذا انزلقنا مع دعاة العلمانية حيث يجروننا إليه، فإننا حتمًا سنزعزع معتقداتنا ونخلخل إيماننا وننقض العلاقة الفطرية بيننا وبين خالقنا، ومنشأ البريق المذكور ما أوصلت إليه المدنية الغربية من تقدم علمي وتقني بعد أن وقع الفصل بين الدين المسيحي والدنيا في البلاد الغربية، حيث ألصقت كل تهم التخلف برجال الكنيسة الذين كانوا يحولون دون كل سبل التنوير ودون كل تفتح فكري أو كشف علمي، لأن الكنيسة كانت صاحبة سلطة قوية وخشيت من الفتوح العلمية الجديدة على سلطتها فحاربت العلماء وتعسفت على الشعوب وظلمت وقهرت، ومن هنا جاءت ردة الفعل قوية، وكان من نتاجها العلمانية التي تفصل بين الدين والدنيا،« فما لله لله وما لقيصر لقيصر» وما زال العداء بين الدين والعلم في المجتمعات الغربية قائمًا إلى اليوم؛ نتيجة الظروف التاريخية التي مرت بها الشعوب الغربية، ولكننا نتساءل هل مرت الشعوب العربية الإسلامية بظروف مشابهة؟ وهل عرف المسلمون تسلط الأئمة ورجال الدين؟ وهل حارب الإسلام التفتح الفكري والكشف العلمي؟! أبدًا ومع ذلك يتجرأ محمد أركون على القول بإن «مع العلمانية وبقوة» ويضيف «ولكنني أرفض أن يمنع المتطرفون العلمانيون دراسة الأديان بصفتها ظواهر ثقافية كبرى عاشتها البشرية خلال قرون وقرون» إنه ينظر إلى الأديان بما فيها - الإسلام - على أنها ظواهر ثقافية مثل بقية الظواهر، ومن يقول ظواهر يعني بأنها لا تلبث أن تختفي ويطويها الزمن رغم طول المدة التي عاشتها. كيف لا، وهو يقول في مكان إنه لا شيء فوق التاريخ أي أن: كل شيء يتصل بالإنسان حيثما كان يمكن تفسيره تاريخيًا.
والعجيب في أمر محمد أركون أنه يقر بأن مسألة الصراع بين الإيمان والعقل «لم تحسم بشكل كامل حتى في البلدان المتقدمة لمصلحة العقلانية، ومع ذلك هو يصر بأن تأخذ بهذه الرؤية وهذا المنهج الذي لم يثبت بعد نجاحه حتى في البنية التي ولد فيها.
ينتهي أركون في تحليله للعلمانية إلى أن للإنسان حاجات ودوافع متزامنة تتجه عمومًا في اتجاهين أساسيين مترابطين عبر عنهما بمرتبة الرغبة مع كل القوى الملحقة بها، وتشمل كل رغبات الإنسان المتنوعة حتى قوله: «الرغبة في الله» ومرتبة إلحاح الفهم والتعقل أي الحاجة الكامنة في أعماق الإنسان للفهم والتقشف والمعرفة، ثم يقول إن المرتبة الأولى تصطدم مع المرتبة الثانية و«على هذا المستوى ينبغي موضعة ذلك التوتر الداخلي الذي يمتاز به الإنسان أيًا كان الوسط الثقافي الذي ينتمي إليه. هذا التوتر الداخلي يمكن أن يعاش بدرجات ووسائل ثقافية مختلفة. لا يهم».
ونحن نتساءل لماذا لا يهم أن لب القضية هو هذا التوتر الذي ذكره أركون كيف لا يهم؟ كيف يقفز أركون على هذه الإشكالية وهي قاعدة الإيمان وسنده، فالإيمان هو الذي يسد الفراغ ويذهب التوتر، ونحن على يقين بأن الأمر سيظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، أم أن الأستاذ أركون يريدنا أن نعيش على غرار العلمانيين الدهريين تائهين حيارى فنغرق في الرذائل والخبائث وكل مستنقع آسن؟
تركيا ولبنان مثال مزدوج للعلمنة:
يطالب الأستاذ أركون بإعادة النظر من جديد إلى كل التراث الإسلامي من منظور علماني، وهو ما يسميه بإعادة قراءة التراث «وإعادة قراءة القرآن»، وقد تحدث عن ذلك في فصل كامل في كتابه تاريخية الفكر العربي الإسلامي، تحت عنوان حول الأنثروبولوجيا الدينية نحو إسلاميات تطبيقية مدعيًا أن المسألة ضرورية وملحة جدًا في عالمنا العربي الإسلامي، وذلك من أجل تشكيل الدولة بالمعنى الحديث لكلمة دولة، ولتوضيح نظريته يتحدث عن نموذجين للعلمنة هما تركيا ولبنان.
يقول عن تجربة كمال أتاتورك إنها ثورة علمانية حقيقية. ولكنه لا يجد تفسيرًا لفشل هذه التجربة إلا قوله «لكنها لم تكن في الواقع إلا كاريكاتير للعلمنة، رافقته بعض التطرفات، كما حدث ذلك في فرنسا سابقًا. ويختتم حديثه عن التجربة الكمالية بقوله: إنه لمن الممتع أن نطيل التأمل في هذه التجربة التي جرت كليًا في أرض الإسلام.
أما بالنسبة للتجربة اللبنانية فإنه يقول بعد الحديث عن الأحداث المأساوية وظواهر التطرف التي تبلغ مداها هناك «نجد في لبنان إذًا أن التوترات والمشاعر الهادئة تبلغ حدًا أقصى لدرجة أن العلمنة تبدو فعلًا، وكأنها الحل الوحيد له.
وهذان المثالان في الحقيقة لا يعززان المقولات العلمانية بقدر ما يضعان نقاط استفهام كبيرة أمامها.
ففي تركيا أفشل المسلمون الأتراك التجربة العلمانية الكمالية التي طبقت عليهم عنوة، ولم تتقبل النفوس التركية المسلمة والعقول التركية المؤمنة بذور العلمنة ولفظتها، وها هو المد الإسلامي يقضي على البقية المتبقية من الآثار العلمانية. أما في لبنان فمع إدراكنا بأن عوامل كثيرة ساعدت على تفجير الصراع الطائفي فيها والخارجي منها أكثر من الداخلي، فإن التجربة العلمانية كذلك لم تقم على الصمود ولو كانت ثبتت في النفوس ورسخت في العقول ما كنا نشاهد هذا التطاحن الطائفي الذي على الساحة اللبنانية، ولا تشذ عن الحقيقة إذا قلنا إنه ليس للعلمانية في المستقبل المنظور مكان في لبنان.
شبهات حول القرآن باسم الحداثة والتجديد:
السمة العامة لكل الكتابات الأركونية هي تشكيك المسلمين في أقطاب دعاته وعلمائه بوصفهم بأصحاب «الخطاب السلفي» المتمتع بقوة التجييش الهائلة، ولكن العادي من الصحة العلمية والجاهلين بالعلوم الغربية الحديثة والتشكيك كذلك في قدسية القرآن الكريم والسنة النبوية وفي كل الأحداث الإسلامية في القرنين الأول والثاني للهجرة، إن المنهج الأركوني يضرب على أوتار الشك بذكر الشخصيات القلقة في التاريخ الإسلامي والإشارة إلى الأحداث التي اختلفت حولها أوجه النظر، وهو يصفعنا بأسئلة عديدة حائرة دون أن يقدم لنا أسباب طرح هذه الأسئلة، اللهم إلا إذا كان هدم الإيمان وإحلال التوتر ولا الإجابة عليها.
يقول أركون: «نحن نشهد اليوم وللمرة الأولى في تاريخ الإسلام أسئلة من هذا النوع تطرح في هذا الاتجاه: اتجاه الشك المستمر. يذكرنا هذا التعبير بذلك العصر الكبير للشك الذي افتتح في القرن التاسع عشر من قبل ماركس ونيتشه لم يعهد الإسلام في تاريخه أبدًا شيئًا من هذا الشك.»
- مقولات أركون حول النص القرآني مجرد شبهات لا يسندها دليل ولا برهان.
الأسئلة التي أشار إليها أركون هي أسئلة كثيرة جدًا تثير الشكوك حول حقيقة الوحي حقيقة الرسالة، وحقيقة الأحداث التاريخية الإسلامية كما وصلت إلينا. بل إن أركون تجاوز آخر كتبه مرحلة إثارة الأسئلة التشكيكية إلى الصريح بما يؤمن به ويتنافى مع المعتقدات الإسلامية حيث يقول مثلًا:
الفكر الإسلامي لا يمكنه أن يتهرب طويلًا بصد التهرب من تطبيق المناهج الغربية الحديثة له» إن فعل الإيمان الأرثوذكسي المحتسب دومًا على التأكيد بأن الدين يرتكز على الوحي الذي أنزله الله على الناس بواسطة الأنبياء، وبالتالي فإن الدين فوق المجتمع، لكن الواقع في الحديث ينزع إلى فرض فكرة أن الدين كله للمجتمع، الله بذاته بحاجة إلى شهادة الإنسان، و يقول في حوار أجرته معه مجلة الوحدة.
الأمر يتعلق بطرح مفهوم كلام الله طرحًا آليًا ضمن التوجهات التي فتحها العلم المعاصر كطرح مفهوم الكتابات المقدسة للمرة الأولى في الأديان خارج نطاق أية أسبقية تيولوجية»
الأستاذ أركون متخفى وراء الأسلوب العلمي المطرح ليشكك في القرآن، وفي كيفية جمعه كله فبعد أن يسرد ما وقع بعد وفاة الرسول يذكر الصراع على السلطة السياسية يقول:
الخليفة الثالث عثمان «أحد أعضاء العائلة الفردية لعائلة النبي» يتخذ قرارًا نهائيًا بتجميع الأجزاء المكتوبة سابقًا والشهادات الشفهية ما أمكن التقاطها من أفواه الصحابة الأول، هذا التجميع عام ٦٥٦ م إلى تشكيل نص كامل فرض نهائيًا بصفته المصحف الحقيقي كلام الله كما كان وقد أوحي به إلى محمد، الخلفاء اللاحقون كل الشهادات الأخرى التي تريد تأكيد نفسها «مصداقيتها» مهما أدت استحالة أي تعديل ممكن للنص المشكل في عثمان».
انتهى في آخر تحليله إلى القول: ينبغي أولًا إعادة قصة تشكل هذا النص بشكل جديد كليًا.
- إن القصة الرسمية للتشكيل التي رسخها التراث المنقول نقدًا جذريًا. هذا يتطلب منا في الرجوع إلى كل الوثائق التاريخية التي أتيح لها أن تصلنا سواء كانت ذات أصل شيعي أو خارجي أم سني. هكذا نتجنب كل حذف تيولوجي لطرف ضد آخر».
إن هذا الكلام يستدعي منا أن نقف عنده لنلاحظ ما يلي:
۱ - إن محمد أركون لم يأت بجديد عندما أثار هذه الشبهات حول النص القرآني، وطالب بإعادة قراءته من منظور علماني مادي غربي، وقد سبق إلى ذلك بعض المستشرقين المتحايلين أمثال لويس ماسينيون، وعلى هذا الأساس يصدق وصف الدكتور أركون بأنه مستشرق مستعرب رغم أنه يرفض هذه التسمية مكتفًيا باللقب الذي أطلق عليه أمثاله من العلمانيين «وهو المفكر الإسلامي المجتهد»
۲ - إن مقولات أركون حول النص القرآني هي مجرد شبهات لا يسندها دليل ولا برهان، ولا تعززها أية وثيقة أو شهادة تاريخية من نوع كانت، ولو أمسك الدكتور أركون بشهادة واحدة على ما يقول للوح بها منتصرًا لأفكاره، والمفهوم من كلام أركون الذي يريد أن يكون علميًا ومنطقيًا، إنه قد يوجد مستقبلًا من الوثائق ومن الأدلة ما يوثق كلامه و يؤكد طروحاته، ولنفترض أن ذلك سيحدث في يوم ما، ولماذا يسيق أركون الأحداث؟ ولماذا يراهن على المجهول؟ إن لم يكن متحاملًا على هذا الدين منكرًا في قرارة نفسه لنزول الوحي.
3- إذا كان محمد أركون ينفي القدسية عن القرآن، ويفسر كل شيء وبدون استثناء تفسيرًا تاريخيًا حسب المناهج الغربية المستحدثة، فماذا تراه يقصد بعلمنة القرآن؟ سوى إعادة النظر في كل المسلمات الإسلامية باعتبارها من إفراز التاريخ لا من عند الله، وهو القائل كل شيء في التاريخ ولا شيء فوق التاريخ أي أن كل شيء له تفسير مادي، ولا شيء يستعصي عن هذا التفسير بعد تقدم العلوم الإنسانية التي قلبت مفاهيم كثيرة كالألسنية التي قلبت مفاهيم اللغة، وعلم النفس الذي قلب مفاهيم السلوك الإنساني، والسيكيولوجية التي قلبت مفاهيم التطورات والتحولات الاجتماعية.
٤ - إذا كانت العلمنة في بيئاتها وفي معاقلها لم تستطع باعتراف أركون نفسه أن تحسم الصراع بين الإيماني والعقلي أو بين المادي والروحي، فكيف يؤمل لها أن تلقى نجاحًا في الساحة الإسلامية لا سيما بعد الصحوة الإسلامية المتنامية التي يقر بها غير المسلمين قبل المسلمين.
العلمانية تلتقي مع الماسونية:
يبقى أن تقول في الأخير إن الأفكار الأركونية في معظم القضايا والمسائل الإسلامية هي بنفس الإثارة وتحدث لدى القارئ المسلم نفس الصدمة، ليس لأنها نابعة من منظور علماني بل لأن أحدًا قبل أركون لم يتجرأ على التصريح بها، فهو ادعى أن الحديث « ليس إلا اختلافًا مستمرًا فيما عدا بعض النصوص القليلة التي يصعب تحديدها وحصرها، وزعم أن مبادئ الشريعة الأربعة:
القرآن والحديث والإجماع والقياس غير قابلة للتطبيق! واعتبر القياس هو الحيلة التي لجأ إليها المسلمون لإضفاء القدسية على القوانين الوضعية.
وهو زعم أن كل الدول الإسلامية هي دول علمانية واقعًا بدءًا بالدولة الأموية وانتهاءً بكل الدول الإسلامية الحالية ونظرًا لضيق المجال نحيل القارئ لمزيد من الاطلاع على كتاب محمد أركون «تاريخية الفكر العربي الإسلامي ».
إن ما يتجلى عن هذا الطرح الأركوني أن الدعوة إلى علمنة الإسلام ليست سوى دعوة جديدة لهدم أركان الإسلام، وهذا دائمًا كان ولا يزال هدف الماسونية العالمية. إنها خدعة جديدة ولكنها مفضوحة من قبل رجل ذي جذور إسلامية لمحاصرة الصحوة الإسلامية والانحراف بها عن طريق رجوعها إلى الأصول.
إن العلمانية مهما حاولت أن تتبرقع ببرقع العلوم الصحيحة والبحث العلمي الجاد، تبقى دعوة للإلحاد والمادية والدهرية التي قال القرآن عن أصحابها: ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ﴾ (الجاثية:24). ولا يخفى على المسلمين أن هذه الدعوة تكرس مركزية الدول الغربية وهامشية الدول الإسلامية ما دام المنهج والطريقة وأداة البحث قد شكلت في الخارج لتعامل بها مادة أجنبية عنها تمامًا.
فهل يستطيع أركون أن ينجح حيث فشل غيره من اليساريين والعلمانيين العرب المتمسلمين؟
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل