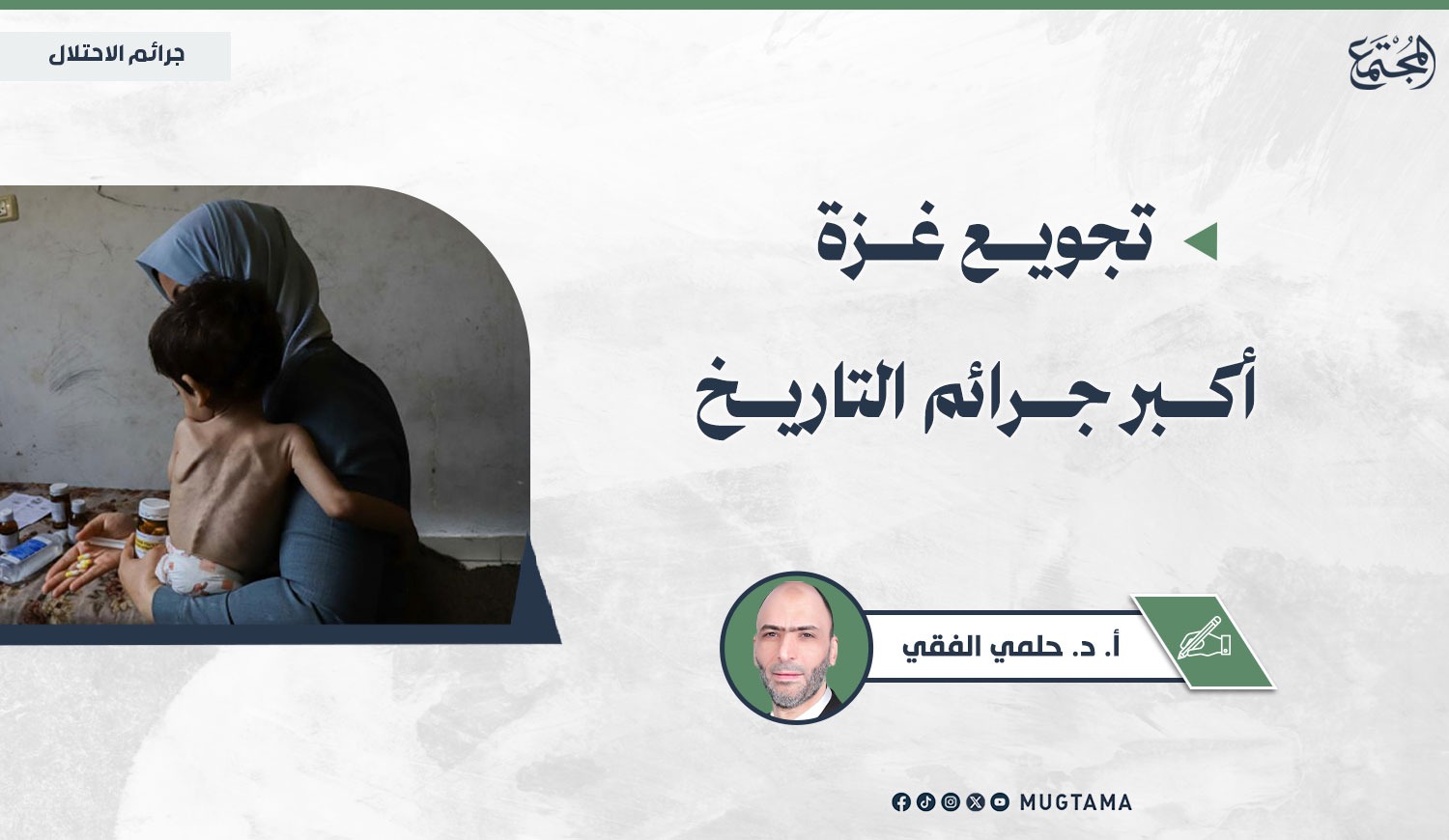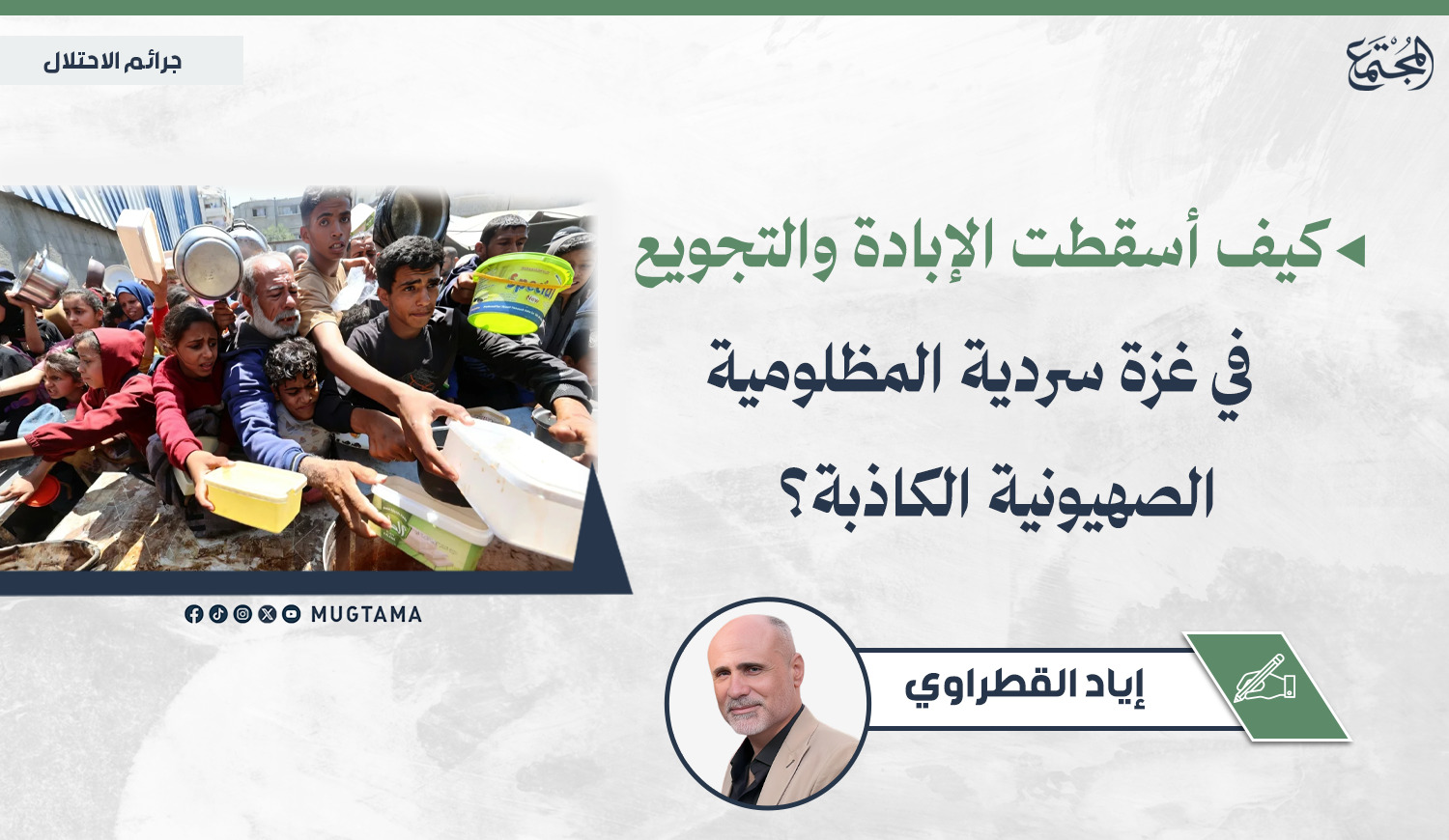تجويع غزة بين النظر الفقهي والموقف القانوني
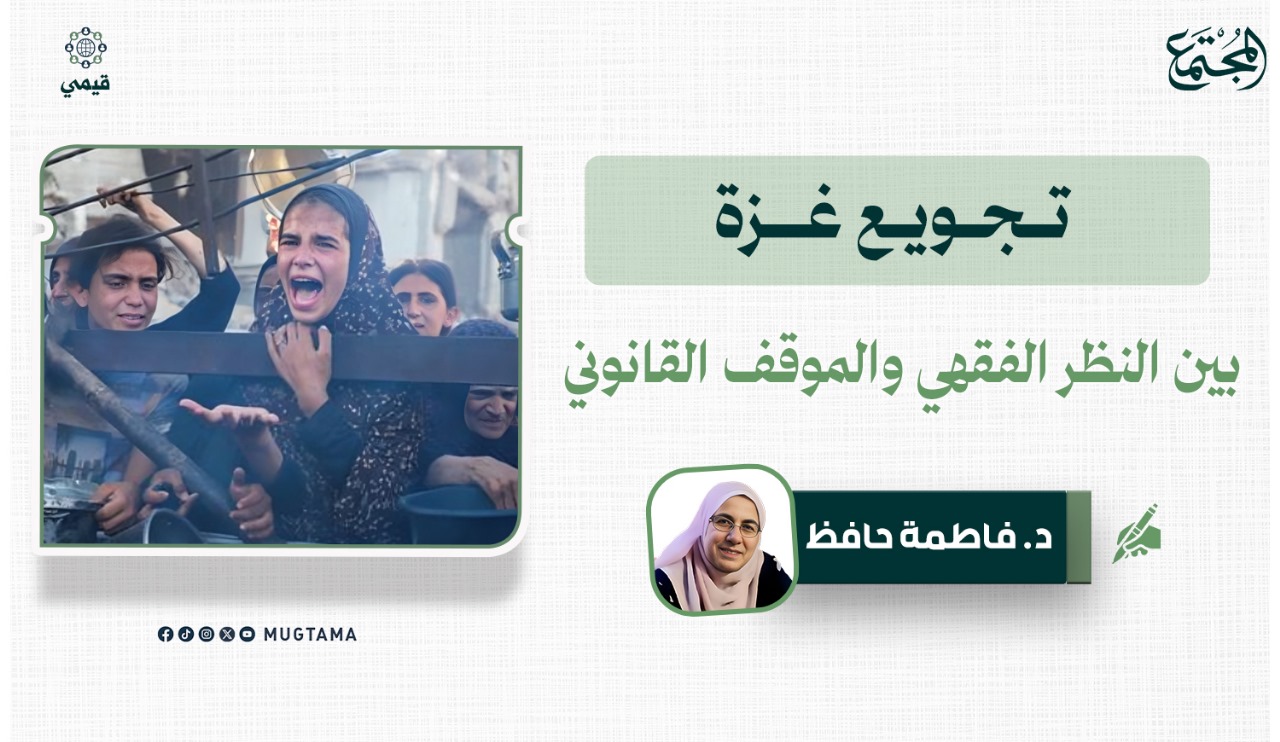
التجويع
هو أحد أقدم الوسائل التي لجأ إليها البشر لهزيمة أعدائهم. فقد استخدمه الإسبرطيون
ضد أثينا، واستخدمه الرومان ضد القرطاجيين، ومارسه القرشيون بحق المسلمين في شعب
أبي طالب. واستمر استخدامه في العصور الحديثة، بل تم تقنينه مع إصدار الرئيس
الأمريكي إبراهام لينكولن قانون ليبر عام 1863 الذي اعتبر تجويع المحارب، سواء كان
مسلحًا أم أعزل، "عملًا قانونيًا". ولم تتخل الولايات المتحدة عن مبدأ
التجويع إلا عام 2015.
كما
أن معظم الدول الغربية انتهجت التجويع بحق أعدائها خلال الحربين العالميتين وما
بعدهما، ولا يزال التجويع يمارس حتى يومنا هذا في ميانمار وغزة والسودان وغيرها.
وهذا
الاستخدام المكثف لنهج تجويع الخصوم يثير سؤالًا حول كيفية النظر إلى مسألة الحد
من التجويع.
وهنا
نحن إزاء رؤيتين أو بالأحرى معالجتين: الأولى إسلامية، يعبّر عنها الأخلاقيات
والفقه الإسلامي، والثانية هي القانون الدولي، ممثلًا في التشريعات الصادرة عن
الهيئات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية وغيرها.
الرؤية الإسلامية
اهتم
الإسلام بالطعام بوصفه حاجة إنسانية ملحة، حتى إنه خص سورة من سوره بتناول فلسفة
الطعام وأحكامه وهي سورة الأنعام. واعتبر الجوع ابتلاءً، كما جاء في قوله تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ)،
وقد تعوّذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، وحثّ على إطعام الطعام، خاصة
في حال المجاعة.
وجاءت
معالجة الإسلام لمسألة الجوع على مستويين:
• مستوى التوجيه
الأخلاقي: وتعبر عنه نصوص كثيرة تحمل معنى الحث على الإطعام
ونجدة الجائع، ومنها قوله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ
الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا)، وقوله صلى
الله عليه وسلم: "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم
به."
• مستوى الفقه: الذي
صاغ سلسلة متضافرة من الأحكام تتعلق بكلٍّ من: ولي الأمر، ومن يتعرضون للمجاعة،
والمسلمين المجاورين للمجاعة.
أما
ما يخص ولي الأمر، فقد بيّنت له الشريعة أولًا أنه لا يجوز له اللجوء إلى التجويع
لمعاقبة الجناة والمعارضين. وبيّنت له ثانيًا كيفية التصرف للحد من وطأة المجاعة،
حيث منحته سلطة فرض تدابير وإجراءات استثنائية لمواجهة آثارها، وسلطة فرض إعاشة
الناس بعضهم بعضًا زمن المجاعة، وسلطة إجبار الناس على بيع ما لديهم، مثل من عنده
طعام لا يحتاج إليه، والناس في مخمصة، فإنه يُجبَر على بيعه للناس بقيمة المثل،
كما ذهب ابن تيمية في "الطرق الحكمية". كما بينت أن له الحق في تعليق
بعض الأحكام والحدود الشرعية، كما فعل عمر بن الخطاب في عام الرمادة حين أبطل حد
السرقة.
وأما
ما يخص من يعانون المجاعة، فقد اتفق الفقهاء على وجوب إطعام المضطر. فإذا أشرف على
الهلاك من الجوع أو العطش ومنعه مانع، فله أن يقاتل ليحصل على ما يحفظ حياته. لما
روي عن الهيثم أن قومًا وردوا ماءً فسألوا أهله أن يدلوهم على بئر فأبوا، فسألوهم
أن يعطوهم دلوًا فأبوا، فقالوا لهم: "إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت أن
تتقطع"، فأبوا أن يعطوهم، فذكروا ذلك لعمر رضي الله عنه فقال لهم عمر:
"فهلا وضعتم فيهم السلاح؟"
كما
سنت الشريعة أحكامًا استثنائية تطبّق حال المجاعة ومنها:
• جواز تناول أكل
الميتة لمن لا يجد ما يسد رمقه:
وذلك مصداقًا لقوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ
لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)، والمجاعة من أعلى درجات
الاضطرار.
• جواز أخذ طعام
الغير عند الخوف على الحياة:
لكنه في المقابل يضمن قيمة
الطعام الذي يأخذه، حفظًا للحقوق من أن تُهدر، وصيانة للملكية في زمن الأزمات.
• جواز طلب الصدقة في
زمن المجاعة:
وجواز إرضاع الصغير زمن المجاعة، كما بين الحديث
الشريف.
أما ما يتعلق بالمسلمين والمحيط الإسلامي العام، فقد ذهب العلماء إلى أن على المسلمين نجدة إخوانهم المحاصرين بالمجاعة، كما فعل أبو عبيدة بن الجراح والي الشام وعمرو بن العاص والي مصر في عام الرمادة. ومنها أولوية الصدقة على فرض التطوع زمن المجاعة كما اتفق العلماء. ومنها وجوب إنفاق الطعام الزائد عن الحاجة، فعلى كل من عنده طعام يكفيه أن يدفعه إلى الناس الواقعين في المجاعة حتى يُنقَذوا من براثن الموت، هذا إن كانوا لا يخشون على أنفسهم الموت جوعًا.
الرؤية القانونية الدولية
على
الجهة المقابلة، تجسّد الرؤية القانونية رؤية مغايرة للرؤية الإسلامية، وهي رؤية
معاصرة؛ إذ لم يعتبر القانون الدولي التجويع المتعمد جريمة يُعاقب عليها إلا منذ
عام 1977، حين أُضيف بروتوكولان إضافيان لاتفاقيات جنيف التي تهدف لحماية ضحايا
الحرب. تضمّن كل منهما حظر "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب".
وفي عام 1998، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أساليب التجويع جريمة حرب في
النزاعات المسلحة الدولية، وبعد عقدين عُدّل النص ليشمل النزاعات المسلحة غير
الدولية (النزاعات بين الدول والجماعات المسلحة المنظمة، أو بين الجماعات المسلحة).
وهناك
ثغرتان قانونيتان تقلصان جدوى القانون الإنساني الدولي وفاعليته:
1. الأولى: أن
القانون الدولي لا يجرّم استخدام التجويع ضد المقاتلين، وهو ما يعني سقوط كثير من
المدنيين جوعًا إلى جانب المقاتلين، كما أنه يعطّل بل ويمنع المساءلة القانونية
للمسؤولين عن وقوع المجاعة.
2. الثانية: أن
القانون يشترط إثبات ما إذا كان تجويع المدنيين تم قصدًا أم عن غير قصد، وهناك
صعوبات جمّة في إثبات النية في هذه الجريمة، الأمر الذي يجعل الملاحقة القضائية
للمتسببين في المجاعة أمرًا بالغ الصعوبة.
تأسيسًا
على هذا، يمكن الادعاء أن الرؤية الإسلامية أكثر اكتمالًا وشمولًا؛ بحيث تشمل
(الأفراد والحكومات) وتجمع بين الإطارين الأخلاقي والتشريعي، فضلًا عن كونها ذات
طابع إجرائي عملي ممثلًا في الإطعام والصدقات. في حين أن الرؤية القانونية الدولية
لا تتجاوز كونها بضع مواد قانونية متناثرة ومتباعدة زمنيًا، ولا يمكن وصفها
بالشمول. من جانب آخر، فإنها لا تجرّم التجويع بشكل قطعي، وتجيزه بحق المقاتلين،
وهو ما لا يجيزه الإسلام، فضلًا عن افتقادها لآليات التطبيق، مما يجعل منها مجرد
نصوص غير قابلة للتطبيق.