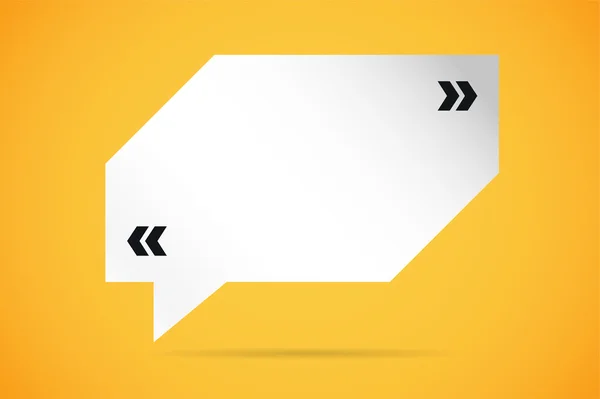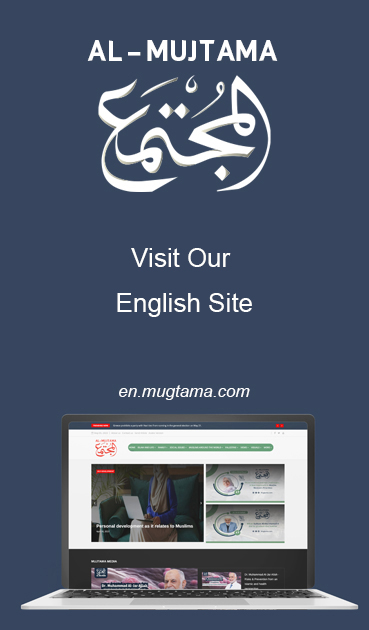الأَسْر بين الصهيوني والفلسطيني.. مفهوم متناقض يختصر جوهر الصراع

في قلب الصراع الممتد بين مشروع الاحتلال الصهيوني والشعب الفلسطيني، تتجلى مفارقة حادة في النظرة إلى الأسر والأسرى، ليس فقط كحدث عابر، بل كمعنى يُعبّر عن فلسفة الحياة والموت، عن الهوية والقيم، وعن مكانة الإنسان في معركة الإرادة بين الحق والباطل.
فبينما يحمل الأسر في وعي الصهيوني معاني الخذلان والانكسار، يتجذر في الوجدان الفلسطيني كوسام شرف ومحطة من محطات النضال، هذه التناقضات لا تأتي من فراغ، بل تعكس جوهر المشروعين المتصارعين؛ مشروع قائم على الهيمنة والخوف من الانكشاف، وآخر قائم على التضحية والصمود في وجه المحتل.
الصهيوني.. هل يرى أسراه أبطالاً؟!
الصهيوني لا يرى أسراه أبطالاً، وإنما ضحايا نظامه الأمني الذي وعده بالأمان المطلق وعجز عن تحقيقه، فالأسر لدى الاحتلال ليس مجرد مأساة فردية، بل فضيحة وطنية تهزّ صورة «الدولة التي لا تُقهر»، وتجعل المجتمع الصهيوني يواجه هشاشته أمام مقاومة لا تملك أي شيء يذكر أمام إمكاناته العسكرية؛ ولكنها تمتلك ما لا يستطيع امتلاكه؛ الإيمان والتضحية.
حين يقع الجندي الصهيوني في الأسر، يبدأ التعامل معه كحالة طارئة يجب إنهاؤها بأي ثمن، ليس من باب التقدير لشخصه ومكانته لدى الكيان المحتل، وإنما للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية التي ترتعب من فكرة أن مقاتلي المقاومة استطاعوا اختراق خطوطه الدفاعية وأخذ أسرى من وسطه؛ لذا، تتحول قضية الأسير الصهيوني إلى ورقة ضغط سياسي أكثر منها قضية فخر واعتزاز، إذ يُستخدم الأسرى كأدوات لاستعادة الثقة المهزوزة في جيش الاحتلال حكومته.
ولعلّ أبرز مثال على ذلك هو جلعاد شاليط، الجندي الذي ظلّ في قبضة المقاومة الفلسطينية لخمس سنوات قبل أن يُطلق سراحه في صفقة تبادل تاريخية عام 2011م، عند عودته، لم يكن استقبال الصهاينة له استقبال الأبطال، بل كان استقبالاً مشوباً بالشفقة، لم يُنظر إليه كمقاتل صمد بشرف، بل كضحية تحتاج للعلاج النفسي وإعادة التأهيل، حتى الإعلام الصهيوني ركّز على حالته النفسية المتدهورة، وعلى الصدمة التي عانى منها، أكثر من تصويره كرمز للقوة أو الصمود.
واليوم، مع أسر مئات من الصهاينة في ملحمة «طوفان الأقصى»، يتكرر المشهد ذاته لكن بصورة أكثر تعقيداً وألماً للمجتمع الصهيوني، فهذه المرة لم يقتصر الأسر على الجنود فقط، بل شمل مستوطنين ومدنيين؛ ما زاد من وقع الصدمة داخل الكيان، فالصهيوني بطبيعته لا يقدّس التضحية؛ لأن مشروعه الاستعماري قائم على مبدأ «الحياة فوق كل شيء»، ولذلك فإن من يقع في الأسر يصبح رمزًا لفشل النظام العسكري لا لنضاله، أما الأبطال الحقيقيون لديهم، فهم الطيارون الذين يلقون بالقنابل من مسافات آمنة، والقادة الذين يوجّهون المجازر من خلف الشاشات، وليس أولئك الذين سقطوا في يد المقاومة.
الفلسطيني.. الأسير هو التاج الذي يزين رأس القضية
على النقيض من ذلك، لا يُنظر إلى الأسر في الوعي الفلسطيني كعار أو خسارة، بل كجزء من المسيرة الطويلة في طريق التحرير، الأسير الفلسطيني هو ابن الأرض التي تأبى الانكسار، وهو الامتداد الحي لتاريخ المقاومة منذ أن بدأ الاحتلال، الأسر لا يعني نهاية النضال، بل استمراره في جبهة جديدة، حيث يتحول السجن إلى مدرسة، والأسير إلى قائد، والزنزانة إلى منبر يُصنع منه فكر المقاومة وأدبياتها.
حين يتحرر الأسير الفلسطيني لا يعود منكس الرأس أو مطأطئ الهامة، بل يعود محمولًا على الأكتاف، يلقى استقبال الأبطال، وتُقام له الاحتفالات، ويُستقبل في الميادين كمعلّم للأجيال، فهو لم يكن في نزهة، ولم يقع في الأسر لأنه خان أو هرب، بل لأنه واجه الاحتلال بكل ما يملك حتى اللحظة الأخيرة.
ولذلك، الأسرى الفلسطينيون المحررون لا يتلاشون في الظل كما يحدث للصهاينة، بل يتحولون إلى قادة سياسيين وعسكريين، وإلى رموز يستلهم منها الجيل القادم معاني الصمود.
الأسر.. صورة مصغّرة عن معركة الإرادة
هذا الفارق العميق بين نظرة الصهيوني والفلسطيني إلى الأسر يعكس الفارق بين مشروعين متناقضين؛ مشروع قائم على الاحتلال والخوف من زواله، يرتعب من أي اختراق لصورة التفوق الوهمي التي صنعها لنفسه، ومشروع مقاومة يعلم أن الطريق إلى الحرية مليء بالعقبات، لكنه لا يرى في الأسر إلا خطوة أخرى نحو النصر المحتوم.
الأسير الصهيوني يُعامَل كعبء يجب التخلص منه، أما الأسير الفلسطيني فهو بطل يُنتظر عودته بفارغ الصبر، الصهيوني يخشى الأسر لأنه يعني له الفشل والانكشاف، بينما الفلسطيني يحتضن الأسرى كجزء من تاريخه النضالي الممتد، وهذه الحقيقة وحدها تكشف لنا أي المشروعين هو الذي سيبقى، وأيهما سيزول.