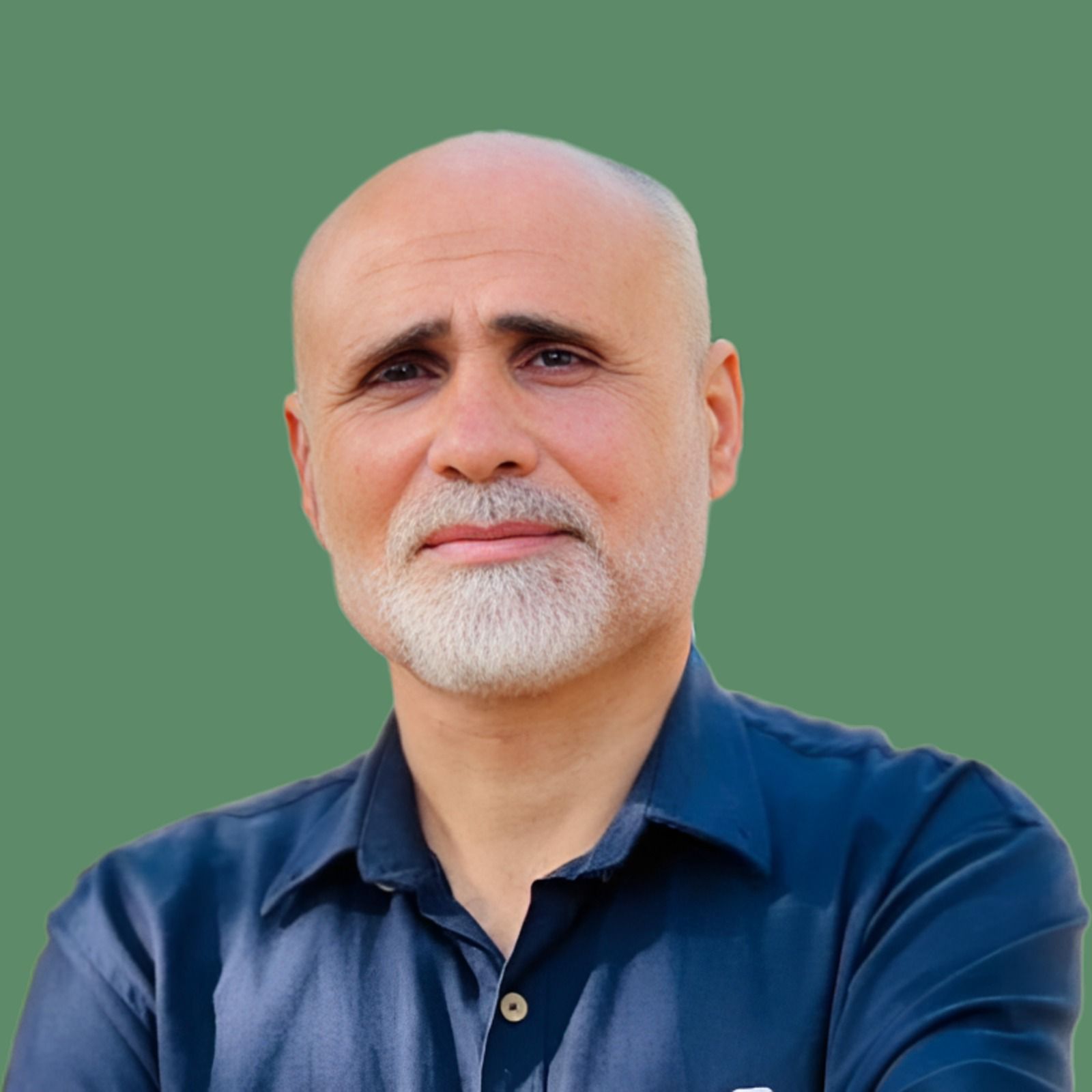خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة.. قراءة تحليلية
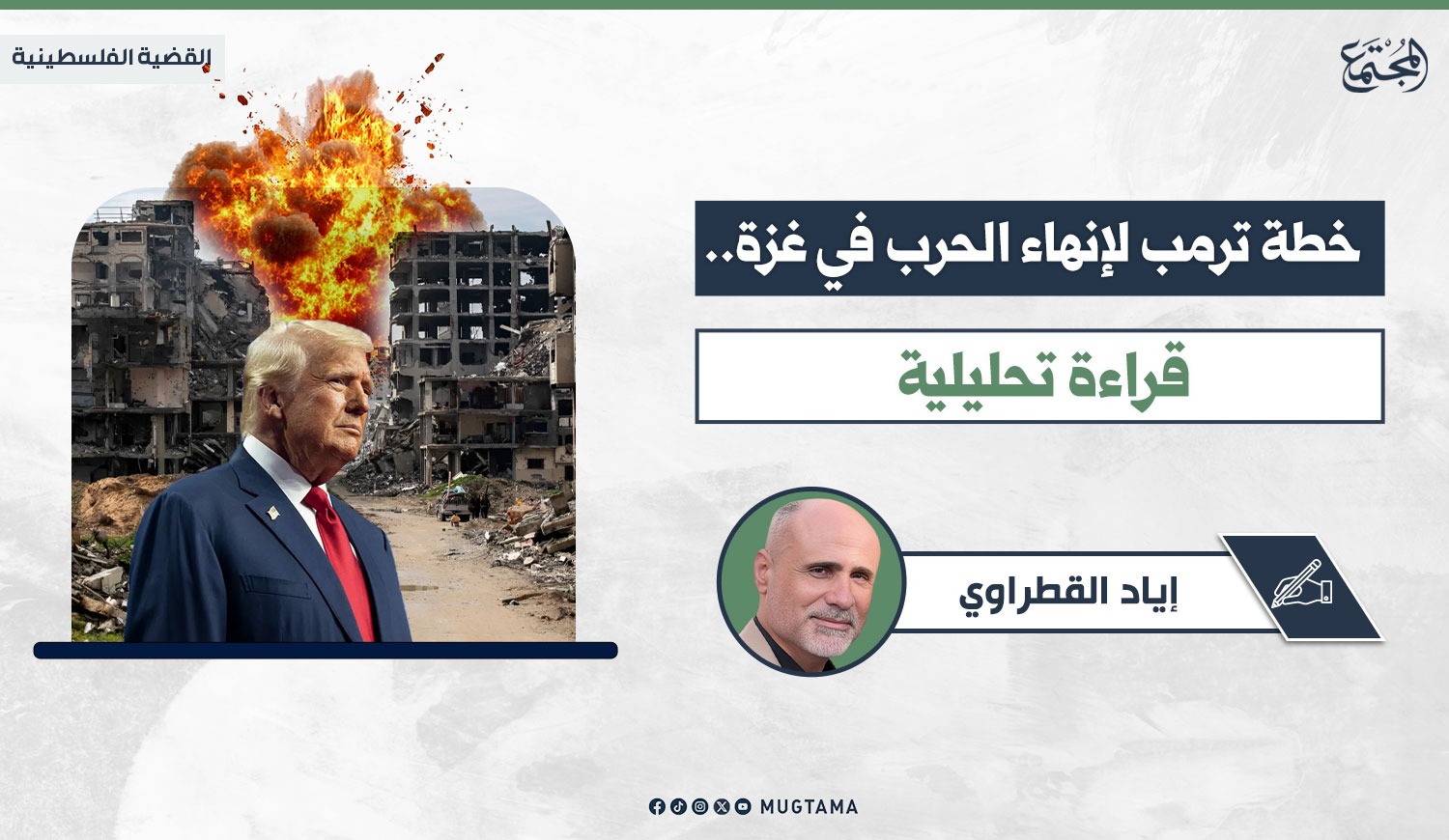
تأتي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
بشأن غزة في لحظة فارقة من تاريخ الصراع الفلسطيني–«الإسرائيلي»، حيث تتزايد
الضغوط الدولية لوقف الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023م، ويتعمّق البُعد الإنساني
للأزمة.
تحمل الخطة عنوانًا واعدًا بإنهاء الحرب
وإعادة الإعمار، لكنها في الوقت نفسه تثير أسئلة جوهرية حول إمكانية تطبيقها،
والجهات المستفيدة، والفجوة بين الطموحات المعلنة والواقع على الأرض.
البُعد الأمني: غزة خالية من الإرهاب
تنطلق الخطة من فرضية أن غزة يجب أن تكون
خالية من الإرهاب والتطرف، في صياغة تعكس خطابًا أمريكيًا– صهيونيًا تقليديًا يرى
أن جذور المشكلة أمنية قبل أن تكون سياسية أو إنسانية، هذا التصوّر يختزل غزة في
مصدر تهديد يجب تحييده، مع تأجيل أو تغييب النقاش حول جذور الاحتلال والحصار
الممتدين لعقود.
ومع أن نزع سلاح الفصائل يعدّ شرطًا
صهيونيًا قديمًا، فإن منح العفو لأعضاء «حماس» المسلّمين أو توفير ممرات آمنة
للمغادرين يمثل مقاربة هجينة بين تفكيك الحركة وإعادة تدوير عناصرها؛ وهو ما قد
يثير خلافات داخلية فلسطينية ورفضًا ميدانيًا.
البُعد السياسي: غزة معزولة عن سياقها الفلسطيني
تتعامل الخطة مع غزة ككيان منفصل يجب إدارته
مؤقتًا إلى أن تستعيد السلطة الفلسطينية زمام الأمور بعد إصلاحات داخلية، مع
الإشارة إلى خطة ترمب للسلام عام 2020م والمبادرة السعودية-الفرنسية.
لكن هذه الصياغة تُعيد إنتاج معضلة
الانقسام الفلسطيني، بل قد تعمّقها، إذ تُرسّخ واقعًا سياسيًا مؤقتًا قد يطول،
ويجعل غزة تحت وصاية دولية بينما تبقى الضفة الغربية في مسار تفاوضي غامض.
البُعد الإنساني: تبادل الرهائن والمعتقلين
من أبرز بنود الخطة ربط وقف العمليات
العسكرية بتحرير الرهائن، على أن يقابل ذلك إطلاق سراح 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد،
و1700 معتقلًا من غزة، هذه الصيغة تكرّس منطق المقايضة الإنسانية الذي عرفته
الساحة الفلسطينية مرارًا، لكنها هذه المرة تجري برعاية مباشرة من ترمب.
اللافت أن الخطة تضمنت تفاصيل دقيقة مثل
إعادة رفات الأسرى الفلسطينيين مقابل رفات الجنود الصهاينة، وهو ما يمنحها طابعًا
عمليًا، لكنه يرسّخ أيضًا اختلال التوازن في التعامل مع الضحايا.
البُعد الاقتصادي: إعادة الإعمار عبر نموذج المدينة الحديثة
تَعِد الخطة بإعادة تأهيل البنية التحتية
الأساسية (مياه، كهرباء، صرف صحي، مستشفيات، مخابز) وإطلاق خطة تنمية اقتصادية
يقودها خبراء شاركوا في بناء مدن مزدهرة في الشرق الأوسط، إلى جانب إنشاء منطقة
اقتصادية خاصة برسوم تفضيلية.
هذا البند يستدعي ذكريات السلام
الاقتصادي الذي رُوّج له في التسعينيات، حيث يُنظر إلى التنمية كوسيلة لتهدئة
السكان دون معالجة أصل القضية، ورغم أن الاستثمار والبنية التحتية ضروريان، فإن
غياب حل سياسي عادل قد يجعل هذه المشاريع رهينة التجاذبات الأمنية.
البُعد الإداري: إدارة انتقالية دولية بقيادة ترمب
تطرح الخطة إنشاء مجلس السلام برئاسة
ترمب نفسه، وبمشاركة شخصيات دولية مثل توني بلير، لإدارة غزة مؤقتًا عبر لجنة
فلسطينية فنية مستقلة، هذه البنية الإدارية المؤقتة تبدو أقرب إلى وصاية دولية على
غزة، تعكس انعدام الثقة بالسلطة الفلسطينية من جهة، واستحالة قبول حكم «حماس» من
جهة أخرى.
هذا الترتيب، إن تم، سيخلق مشهدًا غير
مسبوق؛ إدارة فلسطينية محلية-دولية بمرجعية أمريكية، وهو ما يثير أسئلة حول
الشرعية والسيادة، ومدى قبول الفلسطينيين لأي إدارة تُفرض من الخارج حتى لو كانت
تحت غطاء الإنقاذ الإنساني.
الإصرار على بلير ليس بسبب كفاءته الخاصة
بقدر ما هو نتيجة كونه شخصية مقبولة لدى اليهود والغرب، ولديه تجربة سابقة مع غزة
من خلال السلام الاقتصادي، لكن بالنسبة لعدد كبير من الفلسطينيين، بلير يُعتبر
جزءًا من المشكلة لا من الحل، لأنه تجاهل البعد السياسي للاحتلال، وساهم في تكريس
فكرة أن غزة يمكن أن تُدار عبر المساعدات والمشاريع دون معالجة القضية الفلسطينية
كقضية تحرر وحقوق وطنية.
البعد القانوني الدولي: الخطة لا تعالج الحقوق الفلسطينية
إن إنشاء إدارة مؤقتة تُشرف عليها هيئة
دولية بقيادة شخصية أجنبية (مثل ترمب)، ومع خبراء دوليين، يُشبه وصاية أو سلطة
انتدابية، لأنه يقيّد سلطة الفاعلين المحليين ويفرض مرجعية خارجية على شؤون داخلية،
هذا النمط يتعارض مع مبدأ السيادة الشعبية وحق تقرير المصير الذي تؤكده قرارات
الأمم المتحدة.
وأي ترتيبات يجب أن تُراعي قرارات مجلس
الأمن وميثاق الأمم المتحدة، خصوصًا إذا تضمن انتهاكًا لحقوق شعب محتل أو تغييرًا
في وضعية الأرض والسكان، تطبيق الخطة دون موافقة فلسطينية واسعة قد يواجه اعتراضات
قانونية وسياسية.
الخطة تُقدّم حلولًا إدارية واقتصادية
مؤقتة لكنها لا تعالج حقوقًا جوهرية؛ إنهاء الاحتلال، وحق العودة، والسيادة،
وآليات العدالة والمساءلة، هذا فراغ قانوني وسياسي كبير قد يجعل الحل هشًا وغير
مستدام.
المساعدات الإنسانية: بين التدفق والرقابة
تنص الخطة على إدخال المساعدات الإنسانية
عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي طرف، مع فتح
معبر رفح وفق آلية متفق عليها مسبقًا.
هذه الصياغة قد تبدو إيجابية من حيث ضمان
تدفق المساعدات بعيدًا عن التدخل العسكري المباشر، لكنها لا تحسم السؤال حول
السيادة الفلسطينية على المعابر، ولا حول آليات الرقابة الصهيونية التي غالبًا ما
شكّلت عقبة أساسية أمام وصول المساعدات.
بين الطموح والواقع
خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة تحمل
وعودًا إنسانية وتنموية مغرية؛ مثل: وقف فوري للحرب، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة
الإعمار، وتدفق المساعدات، وبناء اقتصاد حديث، لكنها، في المقابل، تضع هذه الوعود
في إطار سياسي-أمني شديد الانحياز، يقوم على:
- نزع سلاح المقاومة دون ضمانات سياسية
متوازنة.
- وصاية دولية بقيادة أمريكية تُقزّم
السيادة الفلسطينية.
- سلام اقتصادي مشروط قد يخفف المعاناة
دون معالجة جذور الصراع.
إنها خطة تسعى إلى إدارة الأزمة أكثر من
حلّها، وإلى هندسة واقع جديد في غزة قد يُنهي الحرب عسكريًا، لكنه لا يُنهي جذور
النزاع التاريخي والسياسي بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الصهيوني.