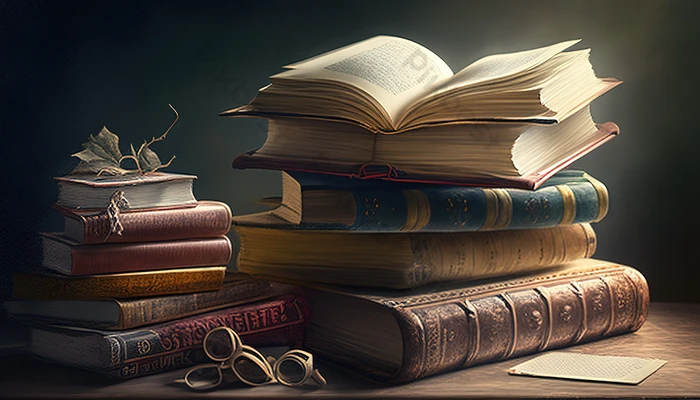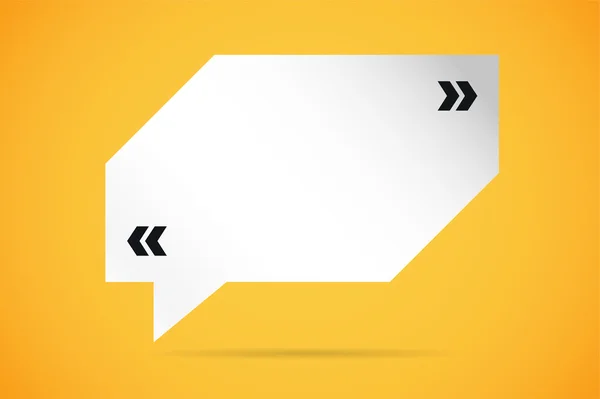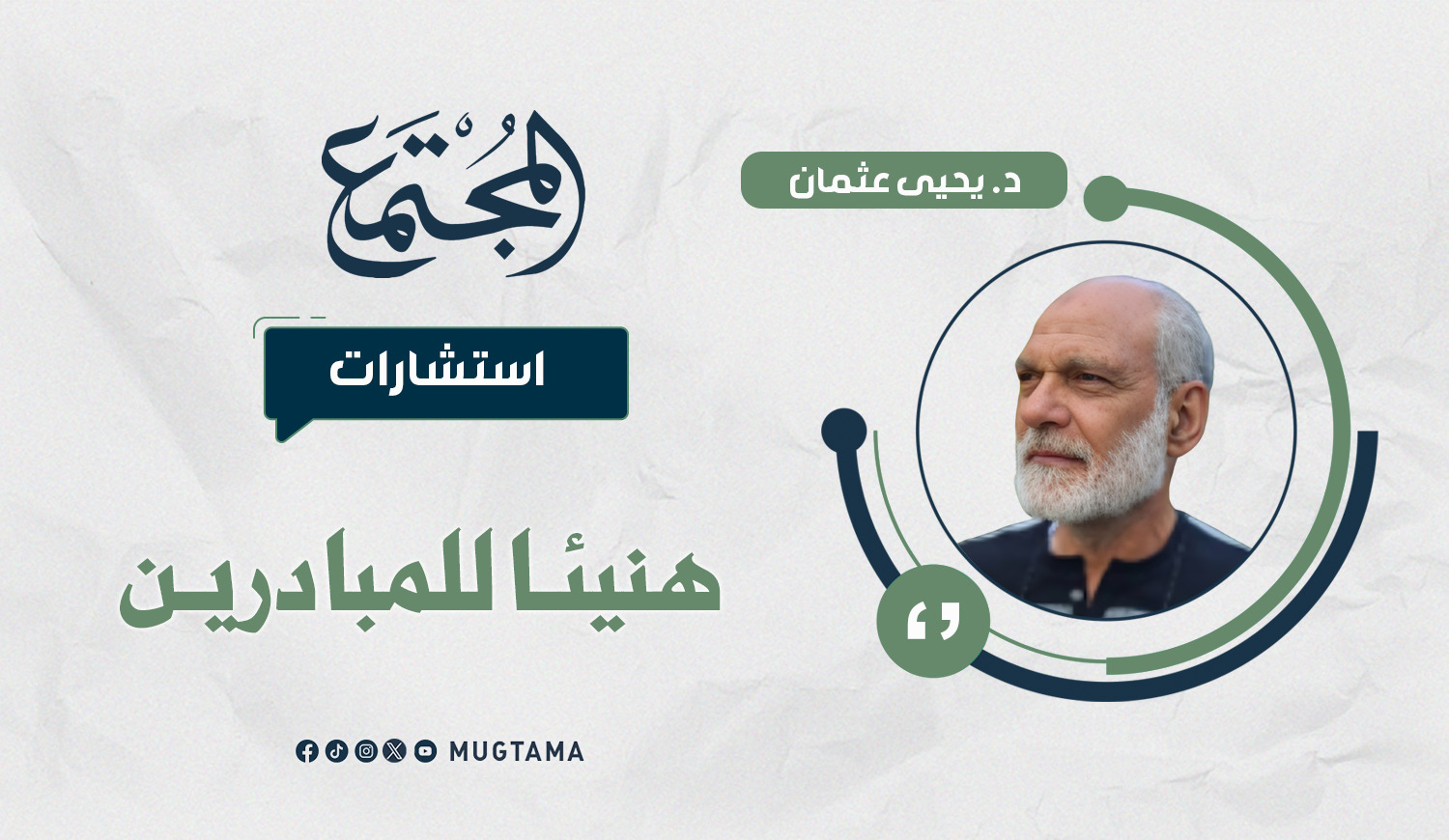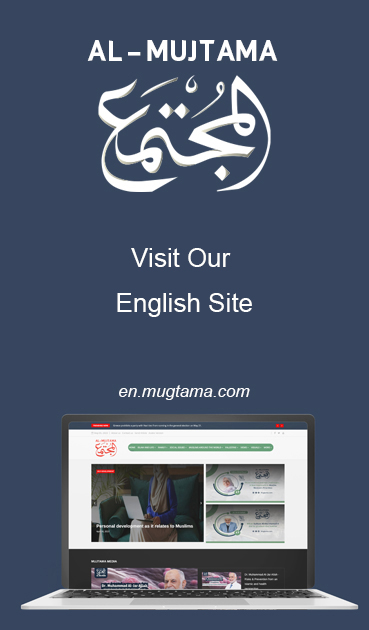معالم الهدي النبوي في صيام شعبان

إن لشهور الله عز وجل نفحات وعلامات، وقد أسكن الله تعالى في كل واحد منها من حوادث الزمان وجميل الخصال وومضات المسير ما يستمد منها نوراً لعباده، واستبياناً لطريقهم وإلهاماً ونبراساً لسيرهم، وهذا من خلال ما مر به سيد الأولين والآخرين رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من مواقفه وسيرته.
وشعبان هو اسم أحد هذه الشهور، وقد سمي بذلك –كما يقال- لأن العرب كانوا يتشعبون فيه لطلب المياه، وقيل: تشعبهم في الغارات، وقيل: لأنه شَعب؛ أي ظهر بين شهري رجب ورمضان، وقد كان العلماء والسلف يسمونه بشهر القراء.
وفي هذا المقال، نقف على بعض معالم الهدي النبوي في هذا الشهر الكريم، ليس من الناحية السردية، وإنما سنقف مع فكرة اختيار الصوم كعبادة مركزة ومرتكزة اختارها مما نستلهم به من خلال كلماته عنه وإيضاح تفكره فيه ما يجعلنا أمام منهج مبارك عظيم يسطر لأهل الإسلام والمسلمين.
المعلم الأول: إحياء العبادات في زمن الغفلات:
بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب كثرته من العبادات وحرصه على اغتنام الأوقات؛ بما لفت له الانتباه من الصحابة ودفعهم لسؤاله عن سبب هذا العمل وهذه المتابعة! فعن أسامة بن زيد قَالَ: قُلْتُ: يا رسول الله، وَلَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ: «ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» (رواه أحمد).
وقد دعتنا جملة عظيمة من تعاليم الشرع في القرآن والسُّنة لإحياء العبادات بشكل عام وفي زمن الملمات والفتن والغفلات بشكل خاص؛ مما يستدل به على حسن المعاملة مع الله والرضا بقضاه والديمومة على طلب هداه، فقد أمر الله نبيه في القرآن قائلاً: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً) (الكهف: 28)، وقوله تعالى: (وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ) (الأعراف: 205).
كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا في سُنته، فعن معقل بن يسار: «العبادة في الهرْج كالهجرة إليَّ» (رواه مسلم)، وهي وصيته لعمرو بن عبسة فعنه، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ» (رواه الترمذي).
المعلم الثاني: المعايشة الأسرية في العبادات الفردية:
كان من معالم هديه بكثرة الصيام في هذا الشهر المعايشة لأزواجه أمهات المؤمنين، حيث كن يؤخرن قضاء ما عليهن من رمضان للتفرغ لحاجته وشغله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة قَالَتْ: «مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ، إِلَّا فِي شَعْبَانَ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (رواه أحمد)، فهو بصومه هذا يجمع بين عبادته التي أعلنها بحسن ختم صحيفة عمله بالصوم، وأن يعين من أخرت من أزواجه قضاء ما عليها من رمضان من أجل راحته واحتياجه؛ فيخفف بصيامه معها حرج الصوم مع فطوره، بل ليؤسس جميل المعايشة مع زوجه وأهله في عبادة جماعية تتعايش معها الأسرة المسلمة.
المعلم الثالث: ديمومة العمل واستدراك ما فات:
من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك عملاً عمل به لله عز وجل وتقرب من خلاله إليه، كما جاء عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» (رواه مسلم).
فمن معالم هديه أنه ما يفوته من نافلة هي من أوراده الثابتة إلا أحدث لها قضاءً، كما بينت الرواية عند أحمد، فعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَشُغِلَ عَنْهُمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ رَكَعَهُمَا فِي بَيْتِي..».
وقد كان يعتري النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه ما يجعله يترك صومه المسنون وورده الثابت من مرض وسفر وغزوة وغير ذلك مما يفطر معها، فيترك صوم الإثنين والخميس أو الليالي القمرية، فيعمد إلى شعبان فيقضيها جميعاً ليؤكد ديمومة عمله ومنهجية استدراك ما يفوت من ورده لأنه ثبته وتعاهد عليه مع ربه جل وعلا.
المعلم الرابع: فقه التهيئة والاستعداد للفريضة:
فحُسْنُ الإعداد والتهيئة للأخبار السارة والمفرحة، أو الأخبار المحزنة، دال على كمال العقل ورجاحته؛ وممهد للتدرج في الوصول للخير، وقد جاء ذلك من الآيات والتوجيهات القرآنية ما يدل على ذلك: منها قوله تعالى: (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ) (الأنفال: 60).
وقد قالت السيدة عائشة: «وَمَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ» (رواه البخاري)، والمرء على ما يتعود من الخير ويوطن نفسه عليه وتدرج معه للوصول إلى أعلى مستويات الأداء والعمل، وهذا مهم للتهيئة العملية قبل بلوغ الطاقة القصوى للعمل في رمضان، وهذا مهم في فهم إستراتيجية الدخول على الأعمال، فعند ابن ماجه عن مُعَاوِيَةَ ابْنَ أَبِي سُفْيَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «الْخَيْرُ عَادَةٌ».
المعلم الخامس: الاهتمام بالخواتيم والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات:
قال النبي صلى الله عليه وسلم وقعّد لنا قاعدة فقال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ» (رواه البخاري)، وفي اختياره الصوم في شعبان لما أشار إليه من رفع التقارير إلى الله عز وجل، وقد بين العلماء أنه التقرير السنوي عما قدمه الإنسان طوال عامه المنصرم، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم صحيفته البيضاء ويعلم الأمة فقه الخواتيم والحرص عليها، وأن العبرة بكمال النهايات، ورب خاتمة جبت ما قبلها ومحت من آثار السوء ما سبقها بسبب القبول الحسن والخاتمة القوية.
المعلم السادس: حاجة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم:
استوقفني حديث عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ، أَوْ لِآخَرَ: «أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ رمضان، فَصُمْ يَوْمَيْنِ» (رواه البخاري، ومسلم)؛ وسرر شعبان آخر الشهر، سمي بذلك لاستسرار القمر فيه أي استتاره، وقيل هو وسط الشهر، وسرر كل شيء وسطه، والمراد الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ويفتح هذا الحديث باباً من السؤلات التي تجوب بالخاطر: لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمران بالتعويض عما فاته من شعبان؟ وهل ترك صيام شعبان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بصيام يومين بدلاً منه؟! وما الحكمة في ذلك كله؟!
والجواب الذي يظهر لنا أن شعبان وضع فيه من الخير والقبول والجوائز ما يدفع للصيام منه ولو قليلاً، والدخول تحت زمرة الصائمين ولو سرر الشهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن نصيب منه ولو قضاء، ولا يكون هذا إلا لخير معهود وكنز مفقود يرى بريقه عند نهاية الأعمار وظهور لائحة الأبرار.