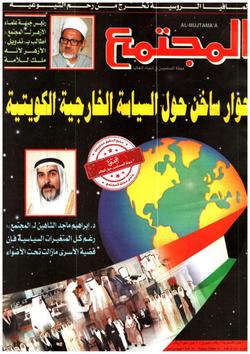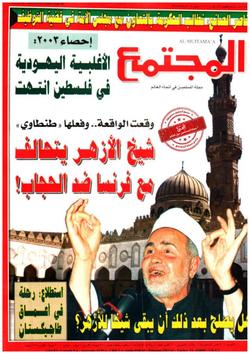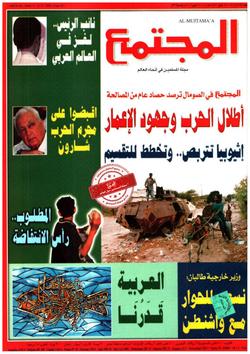العنوان ضوابط في العمل الدعوي (5)
الكاتب د. جاسم المهلهل آل ياسين
تاريخ النشر الثلاثاء 21-نوفمبر-1989
مشاهدات 783
نشر في العدد 942
نشر في الصفحة 52
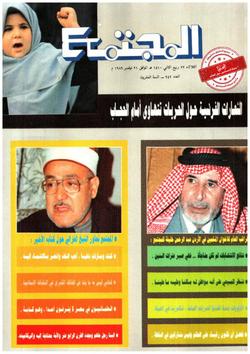
الثلاثاء 21-نوفمبر-1989
رأي للإمامين.. ابن تيمية وحسن البنا بالصوفية
- الإمام ابن تيمية: خيار المتصوفة من هم على طريقة أهل الحديث
والصوفية فيهم المخطئ وفيهم المصيب.
الضابط السابع: البعد عن
التعميم في الحكم طريق إلى الإنصاف:
الناصح والناقد إما أن يريد الإصلاح
والبناء أو يريد الهدم والإفناء، ولهذا طريقه ولذاك كذلك، والبعد عن التعميم
ومحاكمة الآحاد من العبارات والجمل مع عدم تعميمها على غيرها والبعد عن إلزاماتها
التي ليست بلازمة لها ولم يلتزم بها قائلها، هو طريق الإنصاف الذي سلكه علماء
السلف رضوان الله عليهم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن صرف الاستواء أو غيره من
الصفات من الحقيقة إلى المجاز: نعلم أن كثيرًا ممن ينفي ذلك حقيقة بعض الصفات
لا يعلم لوازم قوله، بل كثير منهم يتوهم أن الحقيقة ليست إلا محض حقائق المخلوقين.
وهؤلاء جهال بمسمى الحقيقة والمجاز،
وقولهم افتراء على اللغة والشرع.
وفي الرد عليهم يقول رحمه الله
للقائل منهم: أحسنت في نفي هذا المعنى الفاسد نفي المماثلة، ولكن أخطأت في
ظنك أن هذا هو حقيقة ما وصف الله به نفسه(1). ويقول رحمه الله مفصلًا ومدققًا: «وتجد
خلقًا من مقلدة الجهمية يوافقهم بلسانه، وأما قلبه فعلى الفطرة والسنة».
وأكثرهم لا يفهمون ما النفي الذي
يقولونه بألسنتهم، بل يجعلونه تنزيها مطلقًا مجملًا.
ومنهم من لا يفهم قول الجهمية، بل
يفهم من النفي معنى صحيحًا، ويعتقد أن المثبت يثبت نقيض ذلك، ويسمع من بعض
الناس ذكر ذلك، مثل أن يفهم من قولهم:
ليس في جهة، ولا له مكان، ولا هو في
السماء.. إنه ليس في جوف السماء.
وهذا معنى صحيح، وإيمانه بذلك حق. ولكن
يظن أن الذين قالوا هذا النفي اقتصروا على ذلك، وليس كذلك بل مرادهم:
أنه ما فوق العرش شيء أصلًا، ولا فوق
السماوات إلا عدم محض، ليس هناك إله يعبد، ولا رب يدعى ويسأل، ولا خالق خلق
الخلائق، ولا عرج بالنبي إلى ربه أصلًا. هذا مقصودهم(2).
وفي تطبيقاته رحمه الله لمنهجه هذا
مع الصوفية يتضح ذلك:
يقول رحمه الله: والصوفية يوجد فيهم
المصيب والمخطئ كما يوجد في غيرهم..
وليس أحد معصومًا في كل ما يقول إلا
رسول الله صلى الله عليه
وسلم (3).
وعن أقسامهم يقول رحمه
الله: ولأجل ما وقع من كثير منهم من الاجتهاد تنازع الناس في طريقهم؛ فطائفة
ذمت الصوفية والتصوف. وقالوا: إنهم مبتدعون خارجون عن السنة، وطائفة غلت
فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق، وأحكمهم بعد الأنبياء، وكلا طرفي هذه الأمور
ذميم. والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله، كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله،
ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل
من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب..
ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم
لنفسه، عاصٍ لربه.
وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع
والزندقة؛ ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم: كالحلاج مثلا(4).
وهذا الإنصاف منه رحمه الله لكونه
انتقل عند حكمه من الاسم إلى المسمى وحقق في معنى الاصطلاح فقال: ولفظ الفقر
والتصوف قد أدخل فيه أمور يحبها الله ورسوله، فتلك يؤمر بها وإن سميت فقرًا أو
تصوفًا لأن الكتاب والسنة إذا دل على استحبابها لم يخرج عن ذلك بأن تسمى باسم آخر.
كما يدخل في ذلك أعمال القلوب
بالتوبة والصبر والشكر والرضا والخوف والرجاء، والمحبة والأخلاق المحمودة.
وقد أدخل فيها أمور يكرهها الله
ورسوله: كما يدخل فيه بعضهم نوعًا من الحلول والاتحاد، وآخرون نوعًا من
الرهبانية المبتدعة في الإسلام وآخرون نوعًا من مخالفة الشريعة، إلى أمور
لابتدعوها، إلى أشياء أخر، فهذه الأمور ينهى عنها بأي اسم سميت..
والمؤمن الكيس يوافق كل قوم فيها
وافقوا فيه الكتاب والسنة، وأطاعوا فيه الله ورسوله، ولا يوافقهم فيها خالفوا
فيه الكتاب والسنة أو عصوا فيه الله ورسوله(5).
وقد أكد هذا المعنى الإمام البنا
رحمه الله بقوله: والعرف الخاطئ لا يغير حقائق الألفاظ الشرعية، بل يجب
التأكد من حدود المعاني المقصود بها، والوقوف عندها. كما يجب الاحتراز من الخداع
اللفظي في كل نواحي الدنيا والدين فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء(6).
وعن اشتراك لفظ التصوف واستعماله من
قبل المنحرفين، بين شيخ الإسلام تفصيلًا جميلًا حتى لا يطعن فيمن استخدمه في قاموس
الاستعمال قال رحمه الله:
«فصارت المتصوفة تارة على
طريقة صوفية أهل الحديث وهم خيارهم وأعلامهم، وتارة على اعتقاد صوفية أهل الكلام
فهؤلاء دونهم، وتارة على اعتقاد صوفية الفلاسفة كهؤلاء الملاحدة»(7).
ثم يقول
في نفس المرجع:
«فلفظ الصوفي صار مشتركًا
والقائلون بالوحدة إذا قالوا: الصوفي يريدون به هذا، ولهذا عندهم أفضل من
الفيلسوف ولأنه جمع بين النظر والتأله كالسهروردي المقتول وأمثاله»(8).
وبهذا يكون المنصف من لم يتأثر
باللفظ والمبنى بل يعطي الحكم بعد النظر في المعنى؛ ولهذا الأمر اعتنى الإمام حسن
البنا رحمه الله بمحاربة المعاني الفاسدة والاستفادة من المباني
الصحيحة: فيأخذ من كلمة الصوفية معنى الزهد والرقائق والتقلل من الدنيا
ويجعلها من قواعد بناء الدعوة ويحارب الانحرافات والمدخلات الشركية التي في اللفظ،
فيقول رحمه الله: والتمائم والرقي والودع والرمل والمعرفة والكهانة وادعاء
معرفة الغيب، وكل ما كان من هذا الباب منكر تجب محاربته إلا ما كان آية من قرآن أو
رقية مأثورة(9).
ويقول: «وزيارة القبور أيًا كانت سنة
مشروعة بالكيفية المأثورة.
ولكن الاستعانة بالمقبورين أيًا
كانوا ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشييد
القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من مبتدعات
كبائر تجب محاربتها، ولا نتأول لهذه الأعمال سدًا للذريعة»(10).
وهذا التفريق نجده واضحًا في كلام
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول في التفريق بين النوعين وإن اتفقا في
الاسم: «وشيوخ التصوف المشهورين من أبرأ الناس من هذا المذهب- مذهب ابن
العربي وأهل الإلحاد- وأبعدهم عنه وأعظمهم نكيرًا عليه وعلى أهله»(11). ويقول رحمه
الله عن كتاب إحياء علوم الدين مع انتقاده له في أشياء كثيرة وردوده عليه في مواضع
متعددة «والإحياء فيه فوائد كثيرة ولكن فيه مواد مذمومة» ثم عدد أصولها وذكر
بعد ذلك المحاسن وقال في النهاية: «فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا
فيه»(12).
ويقول كذلك: «وكلامه في الإحياء
غالبه جيد، ولكن فيه مواد فاسدة، مادة فلسفية، ومادة كلامية، ومادة من ترهات
الصوفية، ومادة من الأحاديث الموضوعة»(13).
_____________
(1) مجموع
الفتاوى ۲۱۸/۲۰.
(2) مجموع الفتاوى
٥٨/٤- ٠٥٩
(3) كتاب الاستقامة
لابن تيمية ١٦٣/١.
(4) مجموع
الفتاوى ۱۷/۱۱- ۱۸.
(5) مجموع
الفتاوى ۲۸/۱۱- ۲۹.
(6) الأصول العشرين
الأصل.
(7) الفتاوى ۱۸/۱۱، ۲۱۱، ۲۳۳.
(8) الفتاوى ٧٦/١١.
(9) الصفرية ٢٦٧/١.
(10) الأصول العشرين
الأصل.
(11) الأصول العشرين
الأصل
(12) درء تعارض العقل
والنقل ٤/٥.
(13) مجموع الفتاوى
٥٥٠/١٠- ٠٥٥٢
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل