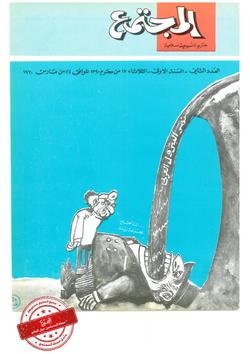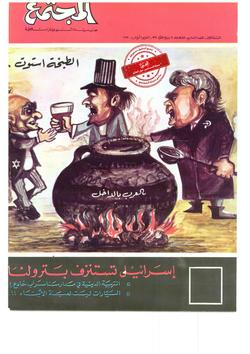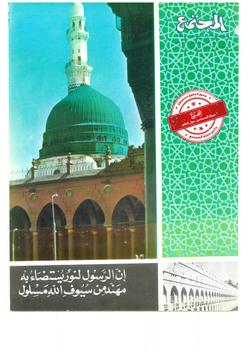العنوان المجتمع الثقافي (1270)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 07-أكتوبر-1997
مشاهدات 725
نشر في العدد 1270
نشر في الصفحة 52
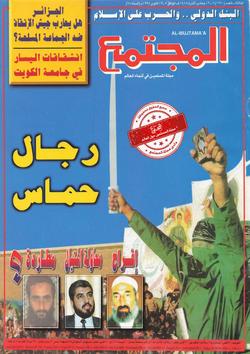
الثلاثاء 07-أكتوبر-1997
وانسابت الدموع من عيون الحاضرين وهم يشاهدون بها جثمان الزميل العزيز ملفوفًا في قماش أبيض وهو يساق إلى القبر.. فتحة صغيرة تؤدي إلى حجرة مظلمة هي البرزخ بين حياة الدنيا وحياة الآخرة.. ها هو الرجل كان يملأ القسم نشاطًا ويقترح وينشط لتنفيذ مقترحاهت ساعيًا بين العميد ورئيس القسم.. ها هو الرجل الذي كان يستثمر الخير فكان الناس في بلده يسمونه بالحاج محمد.. رحل الحاج محمد الأستاذ الدكتور إلى مثواه الأخير ولم يحمل معه مما سعى إليه شيئًا ماديًا، حتى ضوء هذه الدنيا سدوه عليه بالطين.
تأمل هذا المشهد أحد أصدقائه وقد كان من القلائل الذين تماسكوا في هذا الموقف الصعب.. وتساءل: إلى أين ذهب الرجل؟ وماذا يحدث له الآن؟ وكيف انطفأت شمعة حياته وهو صغير السن كبير الآمال والطموح؟ الرجل لم يمرض وكان معنا قبل نهايته بساعات! أين ذهب الرجل؟ وهل يمكن أن يحدث ذلك لي؟ إني لا أشتكي شيئًا الآن ولكني سأموت مثله فماذا سيحدث لي؟ إن القوانين الفيزيائية التي قرأتها ودرستها ودرستها لا تتنبأ بذلك ولا تفسره.. ولا يوجد تفسير لذلك إلا من علماء متكبرين يسمونها: ما وراء الطبيعة! فيصفون بذلك جهلهم الشديد بكلمة غامضة لا معنى لها.
إن الأديان هي التي تفسر ذلك.. روح لا يعلم بها إلا الله.. فيها طاقة الحياة.. فإذا استرجعها الله وسحبها من الجسد فنيت طاقة الحياة بداخل الشخص.. هذه الروح هي روح خالصة لصاحبها كأنها ملفه في الدنيا وستُعطى له عند البعث من جديد رغم فناء جسده في الأرض.. والدين يذكر أن كل إنسان سيحاسب فإما جنة وإما نار.. فلا يضيع سعي الناس هباء في هذه الدنيا ويأخذ كل ذي حق حقه.. فلا يفلت ظالم ولا يضيع حق مظلوم.. من يملك تفسيرًا آخر فليتقدم به ويبرهن عليه.. ومن له قدرة سحب هذه الروح من الجسد؟ ومن يملك وهبها للجسد؟ من له هذه القدرة غير الله؟
واستطرد في تأملاته.. ما دام الأمر كذلك فلماذا نرفض قيود الأديان ونظرتها الحكيمة إلى تفسير الحياة والموت؟ حتى إنها لتعطي التفسير الوحيد المقبول لهذا كله.. فالدنيا ليست خالدة لأحد فلا بد من الموت، والأمر لا يمكن أن ينتهي هكذا دون حكمة.. إني لأقدِّر تفكير أحد الفلاسفة الذي قال إنه باتباع هذه النظرة إلى الحياة والموت يكسب الإنسان ولا يخسر شيئًا، أما إذا اتبع أي رأي آخر فإنه ربما يكسب دنياه ولكنه يخسر الآخرة رغم عدم اعترافه بها.
ثم إذا ما كان على الإنسان أن يتبع الأديان في هذه النظرة فلماذا يتبع دينًا سابقًا لدين لاحق؟ إنه يجب عليه أن يتسلسل إلى الدين الخاتم الأخير وهو الإسلام.. ما المنطق الذي يستطيع به أن يقبل نبوة موسى ولا يقبل نبوة عيسى ومحمد؟ وما المنطق الذي يستطيع أن يقبل به نبوة عيسى وموسى ولا يقبل بنبوة محمد؟ ما دام قد آمن بوجود النبوة فإنه يجب أن يؤمن في النهاية بمحمد صلى الله عليه وسلم.. ولذلك فالإسلام يجعل متبعيه يؤمنون بكل من سبق من الأنبياء.. فالمسلم يؤمن بنبوة موسى وعيسى ومن سبقهم.. ويعلم أن كل الأنبياء دعوا إلى دين التوحيد الخالص وأن الشريعة قد تطورت بينهم إلى أن وصلت إلى شريعة الإسلام.. إنها متسلسلة يجب أن يذهب الإنسان إلى نهايتها ولا يملك أن يقطعها ويكتفي بعدة حدود منها.. فأي منطق يجعله يفعل ذلك ما دامت المتسلسلة متقاربة إلى مفهوم التوحيد الذي يدعو إليه كل دين؟ وما دام الأمر كذلك فإن الإسلام أعظم من أن يكون مجرد طقوس جنائزية أو غيرها. بل إنه يجب أن يكون منهاجًا لحياة الناس لأنه هو السبيل الوحيد لإسعاد البشرية في الدنيا والآخرة أو ما يسمى الحياة الممتدة للإنسان.. بل إن الأهم هو الآخرة لأن زمانها بالنسبة للفرد ممتد ولا يقاس أمامها فترة الحياة اليسيرة التي يقضيها في الحياة الدنيا.. بل إن تفسير الإسلام للموت والحياة يعطي للحياة قيمتها وأهميتها لصاحبها ثم للمجتمع والدولة والعالم كله.. إذ إنه يحافظ على القيم الصحيحة التي تحفظ النفس والمال والعرض والنسل والبيئة وغيرها من ضرورات الحياة.. ومع الأسف فإن هذا الجزء الممتد العظيم من الحياة الممتدة للناس هو الجانب المهمل الذي لا يذكرونه إلا في لحظات نادرة كمثل هذه اللحظة.
وبكى الرجل في نهاية خواطره واستمع للقرآن يقول: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ (مريم: 93- 95).
نعم.. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.. ودعا لزميله.
ترى هل هي بداية تغيير؟ بداية استقامة؟ بداية عمل للآخرة؟ لا ندري.. فالحياة تلهي الناس بالمنصب والمال والجاه والسلطان والصحة.. ودعوات التنوير التي لا تنتهي.
قراءة في كتاب:
الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم وأساليبه في التعليم:
يحيى بشير حاج يحيى
منهج المؤلف- طيب الله ثراه- في هذا الكتاب كما أشار في المقدمة إيراد الأحاديث الكثيرة من هديه صلى الله عليه وسلم في التعليم وأساليبه فيه، وعزو الحديث إلى مصادره، والتعليق، ومن ثم الإشارة إلى كثير من الفوائد والاستنباطات الجليلة، وذكر مظانها في عدد كبير من كتب الأئمة، وقد قسم الكتاب إلى شطرين: الشطر الأول اختص ببيان شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وذاته الشريفة، وبيان رفيع مزاياه وتصرفاته الحكيمة، والشطر الآخر لعرض أساليبه في التعليم وسديد إرشاداته وتوجيهه.
الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم:
جعل المؤلف- رحمه الله- هذا القسم للحديث عن كون النبي صلى الله عليه وسلم معلمًا بنص القرآن الكريم، وإثبات السنة المطهرة ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (الجمعة: 2).
«.. وإنما بعثت معلمًا» «.. إن الله لم يبعثني مُعنِّتًا ولا مُتَعنِّتًا ولكن بعثني معلمًا ميسرًا».
ثم شهادة التاريخ بكمال شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم التعليمية، بحيث تتقاصر أمامه أسماء كل الكبار الذين عرفوا وذكروا في عالم التربية والتعليم وتاريخهما، ومن ذلك حضه على محو العامية وتحذيره من الفتور في التعليم والتعلم، ثم كلمة وجيزة عن شخصيته التعليمية التي تبرز فيها الرأفة والرحمة، وترك العنت وحب اليسر، والرفق بالمتعلم، والحرص عليه، وبذل العلم والخير له في كل وقت ومناسبة، ثم كلمات جامعة في بيان خصائص هذا الرسول المعلم وفضائله، وشرف أخلاقه وشمائله، تتبدى منها جوانب شخصيته العامة، لأن معرفتها من تمام معرفة شخصيته التعليمية، التي هي جزء منها ولا تستقل عنها، كما يتبدى منها أيضًا مبعث قبول أقواله وأحكامه الصادرة عنه، والتأسي بأفعاله الواردة منه، ومدى وقعها في النفوس، وهي تشمل كل جانب من جانب الحياة والدين، وقد أثبتها المؤلف رحمه الله من كتاب «أعلام النبوة» للماوردي.
ألوان متعددة من الحديث:
ويقدم المؤلف- رحمه الله- لهذا القسم بأن من درس كتب السنة وقرأها بإمعان رأي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلون الحديث لأصحابه ألوانًا كثيرة، فكان تارة يكون سائلًا وتارة يكون مجيبًا، وتارة يجيب السائل بقدر سؤاله، وتارة يزيد على ما سأله، وتارة يضرب المثل لما يريد تعليمه، وتارة يصحب كلامه القسم بالله تعالى، وتارة يلفت السائل عن سؤاله لحكمة بالغة منه صلى الله عليه وسلم، وتارة يعلم بطريق الكتابة، وتارة بطريق الرسم، وتارة بطريق التشبيه أو التصريح، وتارة بطريق الإبهام أو التلويح»، ثم يسوق نماذج كثيرة للأساليب التعليمية من خلال تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم المدونة في كتب السنة المطهرة، وقد وصل بها إلى أربعين أسلوبًا مدللًا عليها بالشواهد، مستنبطًا منها الفوائد، محلاة بالتعليقات الطريفة اللطيفة، وما من شك أن من يمعن النظر في هذه الأساليب، وما أفاده منها التربويون والعلماء المسلمون خلال العصور، وما استنبطوه من طرائق التعليم وأساليب التدريس في هذا العصر، كانت الريادة فيها لخير المعلمين صلى الله عليه وسلم، كما كان السبق في تطبيقًا في وقت متقدم جدًا لأتباعه الذين فقهوا عنه، وتتبعوا آثاره.
أساليبه صلى الله عليه وسلم في التعليم:
ومما يجدر الإشارة إليه أن كتب التربية والتعليم المعاصرة حفلت بأساليب متعددة، كان للأسلوب النبوي فضل الريادة فيها، والإشارة إليها، وتطبيقها عمليًا، وسنقف هنا عند عشر مما أورده المؤلف- رحمه الله- لنرى أسبقية الأسلوب النبوي فيها:
- التدرج في التعليم «تعليمه صلى الله عليه وسلم الشرائع بالتدريج» مقدمًا الأهم فالأهم، ومعلمًا شيئًا فشيئًا، ليكون أقرب تناولًا، وأثبت على الفؤاد حفظًا وفهمًا، من ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن، والعمل بهن» ومن تطبيقاته في أساليب المربين ما قاله ابن شهاب: «ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي».
- رعاية الفروق الفردية في المتعلمين، وقد أشار المؤلف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد المراعاة للفروق الفردية بين المتعلمين من المخاطبين والسائلين، فكان يخاطب كل واحد بقدر فهمه، وبما يلائم منزلته، من ذلك قوله لرجل: «لا تغضب» وكررها ثلاثًا، وأمره لآخر وقد جاء يبايعه على الجهاد والهجرة أن يبقى مع والديه، ويحسن صحبتهما، وطلبه من أحدهم وقد سأله ما أكثر ما يخافه عليه، أن يمسك عليه لسانه!!
- تعليمه بالحوار والمساءلة، وهي طريقة تذهب الملل عن السامع وتجعله يحفظ ما يسمع وقد رآه شاخصًا أمام عينيه كما في حديث جبريل وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان.
- استعمال وسائل الإيضاح بأشكالها المتعددة «بالرسم على الأرض والتراب» قال جابر: «كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فخط بيده في الأرض خطًّا هكذا أمامه، فقال: هذا سبيل الله عز وجل، وخط خطين عن يمينه، وخطين عن شماله، وقال: هذه سبل الشيطان، ثم وضع يده في الخط الأوسط، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. (الأنعام: 153).
- ابتداؤه صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإفادة دون سؤال منهم! لا سيما في الأمور المهمة التي لا ينتبه لها كل واحد حتى يسأل عنها، فكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه جواب الشبهة قبل حدوثها، خشية أن تقع في النفوس فتستقر بها، وتفعل فعلها السيئ.
- تشجيع المحسن في إجابته «امتحانه صلى الله عليه وسلم» العالم بشيء من العلم ليقابله بالثناء عليه إذا أصاب.
- توظيف المناسبات (انتهازه صلى الله عليه وسلم المناسبات العارضة في التعليم) فيربط بين المناسبة القائمة، والعلم الذي يريد بثه وإذاعته كما في قصة الجدي الميت، وتهوين أمر الدنيا في قوله: «فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم».
- تعليمه صلى الله عليه وسلم (بالترغيب والترهيب) وعدم اقتصاره على الترهيب خشية التنفير، ولا على الترغيب لئلا يؤدي إلى الكسل وترك العمل.
- تعليمه بالعبرة «بالقصص وأخبار الماضين» ليكون في ذلك العبرة والموعظة والقدوة والائتساء.
كما في حديث الرجل والكلب العَطِش، وفي حديث المرأة والهرة التي حبستها.
- ضبط المعلومات بالكتابة «اتخاذه صلى الله عليه وسلم الكتابة وسيلة في التعليم والتبليغ ونحوهما» فقد كان له أكثر من خمسة عشر كاتبًا يكتبون عنه القرآن، وكتاب آخرون إلى الآفاق والملوك لتبليغ الإسلام، والدعوة إليه.
وبعد أن يورد المؤلف ثلاثين أسلوبًا، من مثل اهتمامه بتعليم النساء ووعظهن، واكتفائه بالتعريض والإشارة في تعليم ما يستحيا منه، وتعليمه بالمقايسة والتمثيل، واستعادة السؤال لإيفاد بيان الحكم، وإجماله الأمر ثم تفصيله ليكون أوضح وأمكن في الحفظ والفهم، يختم بالتعليم بذاتيته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فهو معلم بذاته الشريفة لكل متعلم ومسترشد، تتمثل فيه غاية التعليم بأساليبه المختلفة، فقد كان صلى الله عليه وسلم معلمًا، بمظهره ومخبره، وحاله ومقاله، وجميع أحواله.
كتابة اللغة الصومالية بالحرف اللاتيني.. خلفية تاريخية:
بقلم: أحمد رشيد حنفي
* محاولات الاستعمار البريطاني والإيطالي للقضاء على اللغة لم تتوقف منذ مشروع ريشارد بيرتون لكتابة الصومالية بالحروف اللاتينية!
تتبوأ اللغة العربية في المجتمع الصومالي مكانة مرموقة لكونها لغة الوحي والقرآن الكريم، ولكونها أيضًا وسيلة للمراسلات والمعاملات التجارية وتوثيق العقود، كما كانت أيضًا أداة لنشر المعارف وكتابة العلوم الإسلامية، ولا يزال هذا الأثر كامنًا في عراقة المخطوطات القرآنية والتي يرجع تاريخ بعضها إلى عام 132هـ([1])، إن ازدهار العلوم العربية والإسلامية في كل من هرر، ومقديشو، وزيلع، وبراوه، ومركة، وورشح، وباردرا لدليل ساطع على ذلك الأثر الذي تركته العربية في الإنتاج العلمي واللغوي بين أبناء تلك المدن، ويشير ريتشارد بيرتون في كتابه FIRST FOOTSTEP إلى كون المساجد في مدينة هرر مركزًا للعلم والثقافة([2])، وقد اشتهرت مدينة هرر بثرائها وإتقانها لعلوم اللغة والأصول والحديث، كما اشتهرت أيضًا مقديشو وما جاورها من المدن كبراوه ومركه بعلوم التفسير والفقه الشافعي، وقد كان لهذه الحركة العلمية أثرها في وقت من الأوقات على البلدان الإسلامية الأخرى كاليمن والتي توافد أبناؤها إلى هذه المدن طلبًا للعلم وذلك من عام 767هـ([3]).
وقد أدرك الاستعمار الأوروبي الذي هيمن على مقاليد الأمور في الصومال، مدى تغلغل العربية في أعماق المنطقة، فبذل المحاولات المضنية مستغلًا نفوذه السياسي وتدهور الأوضاع العلمية في المنطقة، فكانت محاولة ريتشارد بيرتون كتابة الصومالية بالحروف اللاتينية مقارنًا بالعربية في قواعدها، ثم تبع ذلك محاولة الإدارة البريطانية في شمال الصومال كتابة الصومالية باللاتينية عام 1938م، مما أدى إلى قيام مظاهرات عنيفة حيث اعتبرها الصوماليون محاولة مسيحية لإضعاف العربية، ومن ثم الثقافة الإسلامية.
محاولات استعمارية:
إن محاولات الاستعمار لم تقف عند ذلك الحد، بل اتخذت السلطات البريطانية سبلًا أخرى فكان مشروع مدرسة الدراسات الإفريقية والشرقية بجامعة لندن والتي تبنت تنفيذه وتمويله مصلحة التعليم في الصومال البريطاني وقد أسند المشروع إلى العالم اللغوي اليهودي البريطاني B. W. ANDREWIK وموسى جلال الصومالي الذي كان جنديًا سابقًا في الجيش البريطاني([4])، والهدف من المشروع في الظاهر استكشاف البناء اللغوي والصوتي للكلمات الصومالية، إلا أن اللجنة قامت بإعداد تقرير أوصت فيه باختيار الحرف اللاتيني لكتابة الصومالية، ولم تتكمن السلطات البريطانية من تنفيذ الخطة، وظل المشروع في طي الكتمان خوفًا من اضطرابات أو مظاهرات لا تحمد عواقبها.
وفي خضم هذه المؤامرات رفع زعماء البلاد مذكرة إلى الإدارة الإيطالية في نوفمبر 1959م مطالبين بجعل العربية اللغة الرسمية للبلاد، وقد وقع على المذكرة العلماء، والأعيان ورؤساء الأحزاب السياسية وجاء فيها ما نصه «نرفع إلى السلطات الإيطالية القائمة بإدارة هذه البلاد ما اجتمعنا على إقراره نهائيًا بخصوص اللغة الرسمية لهذه البلاد، إننا نختار العربية لغة رسمية لهذه البلاد للأسباب الآتية:
- لأنها لغة الدين والقرآن الكريم.
- لأنها لغة المحاكم الشرعية في جميع البلاد.
- لأنها لغة التجارة والمكاتبات منذ انتشار الإسلام في هذه البلاد.
- ولأن الشعب قد اختار العربية لتكون اللغة الرسمية للبلاد([5])، وبهذا أدرك العلماء والزعماء المخاطر التي قد تنجم إذا أقدم المستعمر على تنفيذ خطته القاضية بإقصاء العربية وإحلال الصومالية محلها مكتوبة باللاتينية.
والغريب أنه رغم ورود نص واضح في دستور حزب وحدة الشباب الصومالي ينص على تعزيز وتقوية مركز العربية في الصومال، بل ومنع أعضائه كتابة الصومالية بحروف أجنبية إلا أن إدارة الوصاية في جنوب الصومال ضربت بهذا النص عرض الحائط بعقدها عام 1955م مؤتمرًا ثنائيًا «بريطانيا وإيطاليا» أصدر توصياته باختيار أبجدية لاتينية معدلة تكون أساسًا لكتابة الصومالية غير أن خوف السلطات من ردود الفعل الشعبي حال دون اتخاذ أي خطوات عملية، ويبدو أن المجلس الإقليمي الذي أنشئ في الصومال تحت الوصاية الإيطالية في أول يناير من عام 1956م طلب من إدارة الوصايا الإيطالية اتخاذ موقف واضح من مسألة كتابة الصومالية بالعربية موضحًا اعتبارها اللغة الوحيدة التي تتناسب وثقافة الشعب الصومالي، بيد أن الوزير الإيطالي أعلن أنه سيتخذ الخطوات التدريجية لإخراج لغة من اللهجات المختلفة تكون اللغة الرسمية للبلاد([6])، واعتبرت تلك الخطوة من قبل ممثلي الشعب موقفًا مؤيدًا للعربية، كما اعتبرت أيضًا أول مجابهة سياسية بين حكومة الوصايا وبين ممثلي الشعب الصومالي.
دور العلماء وقادة حزب الشباب في تعزيز مركز العربية في الصومال:
أدرك العلماء وبعض قادة حزب وحدة الشباب محاولات الإدارة الإيطالية وسعيها الحثيث لإضعاف العربية فاتصلوا بالحكومة المصرية وبالذات مصطفى باشا النحاس رئيس الوزراء مطالبين تخصيص منح دراسية في الأزهر وغيره، فكانت استجابة الحكومة المصرية سريعة وخصصت للصومال 40 منحة دراسية، كما أوفدت مصر أول بعثة أزهرية في يونيو 1951م تضم علماء أجلاء كالشيخ عبد الله المشد، والشيخ محمود خليفة للوعظ والإرشاد طالبة منهم كتابة تقرير عن الوضع الثقافي في الصومال وبعدها قامت الحكومة المصرية بعقد اتفاقية ثقافية مع إدارة الوصايا الإيطالية، وبموجبها وصلت بعثة ثقافية دينية أخرى برئاسة الشيخ أبو بكر زكريا، كانت تضم الشيخ إسماعيل حمدي، والشيخ محمود عيد وعقب وصول البعثة، أصدرت اللجنة المركزية لحزب وحدة الشباب بيانًا أكدت فيه ما نصه «اللغة العربية هي اللغة الرسمية لرابطة وحدة الشباب الصومالي وكل الشعب إذ إن اللغة العربية هي هبة الله للشعب الصومالي الذي هو جزء من العالم الإسلامي([7])، واحتدم الصراع الثقافي بين الإدارة الإيطالي وبين عضو مصر السيد كمال الدين صلاح في مجلس الوصايا المكون من كل من مصر وإيطاليا وكولومبيا والفليبين والذي فطن لخطط وألاعيب الاستعمار الإيطالي، فقام بإعطاء دفعة قوية للوجود المصري المؤيد للثقافة العربية في الصومال، بل المدافع الوحيد عنها في تلك المرحلة كما تمكن من إيجاد صلة قوية بينه وبين قادة حزب الوحدة، فكان هذا كافيًا لاعتباره خطرًا على مستقبل الثقافة الإيطالية في الصومال فاغتيل في 16 أبريل 1956م، ويعتقد معظم من عاصروا تلك الحقبة من التاريخ الصومالي أن أعداء العربية كأمثال محمد زياد بري وعبد القادر زوتي وغيرهم استخدمهم الطليان لقتل السيد كمال الدين صلاح وتصفيته جسديًا.
وفي خضم الأحداث السياسية قبيل فترة الاستقلال تراجعت قضية كتابة الصومالية، إذ كان الاهتمام منصبًا على حصول الاستقلال والتخلص من الاستعمار، غير أن الاتجاه العام كان يوحي بأهمية العربية، وتم تدريسها في المدارس الابتدائية، كما ازداد النفوذ المصري في التأثير على المجرى التعليمي بوجود العلماء الأكفاء، وتخصيص المنح الدراسية للطلبة، كما أن مداولات الجمعية الوطنية الصومالية تكتب بالعربية مع صدور بعض الصحف باللغة العربية.
وبعد قيام السلطة الوطنية عام 1960م كلفت لجنة تابعة من قبل الحكومة الناشئة للبحث عن أفضل السبل لكتابة الصومالية، ورفعت اللجنة تقريرها للحكومة معتمدة على الدراسات التي سبقتها، واقترحت كتابة الصومالية بأحرف لاتينية معدلة([8])، غير أن الحكومات المتعاقبة على الحكم للفترة التي سبقت النظام الشيوعي في الصومال لم تجرؤ على تنفيذ الخطة خوفًا من رأي الحركة الشعبية المساندة لكتابة الصومالية بأحرف عربية.
حركة الثقافة والعلوم:
وفي هذه الفترة نشطت حركة الثقافة والعلوم العربية، فكانت بحق مرحلة ازدهار للعربية، ازدهارًا أعقبه بروز طبقة مثقفة بثقافة عربية مما حدا بإيطاليا وغيرها من الدول الغربية إلى تكثيف جهودهم الثقافية بافتتاح مزيد من المدارس ذات الطابع الغربي لغة واتجاهًا، فشهدت الساحة الصومالية تنافسًا ثقافيًا، واستمر هذا الصراع الثقافي حتى وقعت الصومال تحت يد الشيوعيين بقيادة محمد زياد بري عام 1969م وبذلك دخلت البلاد مرحلة اتسمت بمؤامرات ومكايد هدفها إقصاء الصومال إقصاء كاملًا عن إسلامه ولغته العربية، ولكي ينفذ النظام خططه وأهدافه قام بتكميم الأفواه، وإفساح المجال لكل ناعق متزلف حاقد كما قام بوأد كل صوت معروف بدفاعه عن اللغة العربية، وفي هذا الجو القاتم الخانق، تمكنت الحكومة الشيوعية رسميًا من كتابة الصومالية بأحرف لاتينية في يناير 1973م.
وبذلك دخلت الصومال مرحلة جديدة، وأصدرت الحكومة صحيفة «نجمة أكتوبر» باللغة الصومالية والمكتوبة بالحرف اللاتيني، وفي مجال التعليم، اعتبرت الصومالية لغة التدريس في المدارس كلها، أما في مجال الثقافة العامة والتأهيل فقد أصدرت السلطات دراسات بالأبجدية اللاتينية عن الاشتراكية العلمية والوحدة والنظام التعاوني وساعدت في ذلك وكالة نوفوستي الشيوعية.
كشف وردّ مزاعم الشيوعيين في كتابة الصومالية:
كان وقع هذا الحدث على الشعب الصومالي وعلى علمائه بالذات أليمًا، وكان الإعلام الشيوعي يردد على مسامع المواطنين استحالة كتابة الصومالية بالعربية وقد رد على ذلك العلماء وشباب الصحوة في الداخل وطرحوا قضيتهم في الخارج، وكان لمجلة المجتمع مواقف شجاعة في كشف اللثام عن مخاطر تلك الخطوة على مستقبل الإسلام في الصومال كما اتجه أولو الهمم العالية لتكثيف الجهود لنشر الوعي الإسلامي بين الشباب، فانتشرت الصحوة انتشارًا عظيمًا، فأصدرت الحكومة أوامرها القاضية بمنع كتب الإخوان من التداول في الأسواق وملاحقة من يظن أنه حائل دون رغبة الحكومة في إغواء الشباب وإلهائهم في برامج منحرفة فاسدة، ولا سيما بعد عزوفهم عن تلك البرامج واتخاذهم للمسجد منهلًا للعلم وملتقى لتبادل الآراء وملاذًا من ملاحقة رجال المخابرات، فكانت تلك بدايات الحركة الإسلامية المنظمة في الصومال والتي كان لها الفضل في الحفاظ على اللغة العربية، حيث بدأ شباب المدارس الثانوية والجامعات تعلم العربية في حلقات المساجد بعد أن حرموا من دراستها في المدارس والجامعات، وهكذا لقي الكتاب الإسلامي رواجًا وإقبالًا كما تضاعف عدد الطلاب المتخرجين من الجامعات العربية.
ولم يقف الصوماليون مكتوفي الأيدي تجاه ما يحاك لإسلامهم من مؤامرات ودسائس، فقد ضاعفوا الجهد في نشر الدعوة ومواجهة الفكر الإلحادي.
واتجهت أنظارهم نحو بناء مزيد من خلاوي تحفيظ القرآن الكريم، وتدل الإحصائيات الدقيقة أن 67% من تلك الخلاوي تم إنشاؤها من بين 1970- 1982م([9])، وتعتبر هذه الفترة هي الأكثر عنفًا في محاولة النظام لهدم أركان الإسلام، كما تعتبر أيضًا بداية العد التنازلي لنظام طالما أعلن رئيسه على الملأ بأن الإسلام غير صالح لإنسان القرن العشرين.
وعندما أدرك النظام استماتة أهل الصومال في الذود عن إسلامهم، أعلن عن انضمام الصومال إلى الجامعة العربية لتحسين صورته في الداخل والخارج، بيد أن انضمامه إلى الجامعة لم يؤدِّ إلى تخفيف الوطأة على العربية، بل ازدادت الهجمة الشرسة عليها، ويبدو أن النظام الصومالي كان يدرك أن أكثر زعماء العرب لا يذودون عن العربية إلا على استحياء، بل ربما أهينت العربية في بلادهم أو على ألسنتهم.
إن أثر كتابة الصومالية بالحرف اللاتيني على المجتمع الصومالي كان بالغًا، وقد ظهرت النتائج السلبية لذلك أثناء الحروب الأهلية مثل ضعف الوازع الديني لدى كثير من الشعب كما أثر ذلك على الصحوة عميقًا، إذ حُرم كثير من الذين لحقوا بركبها فرصة دراسة اللغة العربية، مما اضطرهم إلى الالتفاف حول من هم على شاكلتهم في السن والعلم، فكان هذا بداية ظهور فكر التكفير وجنوح بعض الشباب إلى الغلو في الدين، مما أدى إلى جر بعضهم بسهولة عن حسن نية ونُبل قصد إلى مواطن الفتن كالحروب الأهلية الأخيرة في الصومال.
([1]) السياسات الثقافية في الصومال الكبير د. حسن مكي ص 63.
([2]) تاريخ التعليم في الصومال سنة 1987م محمد علي عبد الكريم وآخرون ص 10- 12.
([3]) السياسات الثقافية في الصومال الكبير ص 62.
([4]) المصدر السابق ص 167.
([5]) استراتيجية تقوية اللغة العربية والخطة الخمسية الأولى ص 15، مقديشو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سبتمبر 1981م.
([6]) المصدر السابق ص 12- 13.
([7]) السياسات الثقافية في الصومال الكبير ص 142.
([8]) المصدر السابق ص 162.
([9]) المصدر السابق ص193.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل