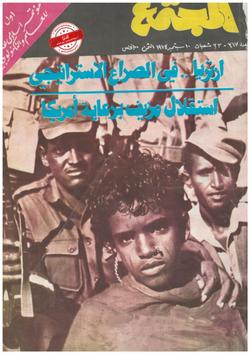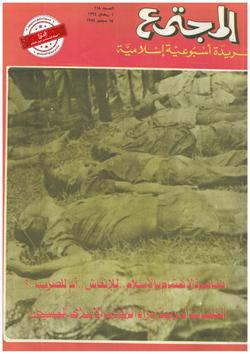العنوان الزواج.. تعبد لله أم إشباع رغبة؟!
الكاتب أحمد إبراهيم خضر
تاريخ النشر السبت 25-أغسطس-2007
مشاهدات 22
نشر في العدد 1766
نشر في الصفحة 56

السبت 25-أغسطس-2007
■ الزواج إن كان أساسه «تقوى الله ورضوانه» قوي وتوثّقت عراه.. وإذا لم يكن كذلك كان عرضة للانهيار.
■ الإمام الغزالي: من كان قصده تحصين دينه وتطييب قلب أهله وتحصيل الولد الصالح.. كان مطيعًا لله.
من المعروف أنّ ما جاء به الشّرع هو عبادة الله عز وجل، كما أنّ المقصود من بعثة الأنبياء هو التعبد، ولهذا فإنَّ الأعمال كلها بما فيها الزواج، يجب ألا تخرج عن خطاب الشارع، لأنَّ خروجها عن خطاب الشارع، يقضي بأنَّها غير مشروعة، وغير المشروع باطل.
والزواج مأذونٌ فيه شرعًا، لكن القصد من الزواج بمعنى النيّة أو الإرادة يحتاج إلى وقفةٍ. فإذا كانتْ نية المقدِم على الزواج هي: مجرد الهوى والشهوة وإنجاب الولد من غير أن يلتفت إلى خطاب الشارع، وهو أن يكون الزواج تعبدًا لله، كان هذا الزواج من الأعمال التي يقرّها الشرع، لكن ليس له ثواب في الآخرة، والسبب في ذلك أنَّ هذه النية وافقتْ أمرُ الشَّارع وإذنه، وترتَّب عليها مصلحةٌ في الدنيا، لكن هذا الزواج افتقر إلى نية الامتثال لقصد الشارع وهو التعبد لله.
يضاف إلى ذلك أنَّ الأعمال التي يكون فيها الباعث هو الشهوة والهوى ووافقتْ قصد الشَّارع، وهو التعبُّد لله تبقى ببقاء حياة صاحبها، فإذا خرج من الدنيا فنيتْ بفناء الدنيا، ولهذا يقول الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾ (سورة الشورى آية: 20).
ولما سُئِلَ العلماء: هل الزّواج من أعمال الآخرة أم من أعمال الدنيا وحظوظ النفس؟
أجابوا : «إنْ قُصد به شيئًا من الطاعات، بأن قُصِد به الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تحصيل ولدٌ صالحٌ، أو إعفاف نفسه، وصيانة فرْجه وعينه وقلبه، ونحو ذلك، فهو من أعمال الآخرة ويثاب عليه، وإن لم يقصِد به شيئًا من ذلك فهو مباح من أعمال الدنيا، وحظوظ النفس ولا ثواب فيه ولا إثم». «فتاوى الإمام النووي نقلًا عن فتاوى موقع: الإسلام سؤال وجواب».
ويقول الإمام الغزالي: إنَّ الرجل إذا تزوج وتوى بذلك حصول الولد كان ذلك قربة يُؤجَر عليها من حسُنتْ نيته، وذلك من وجوه:
الأول: موافقة محبة الله عز وجل في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان.
الثاني: طلب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكثير من يباهي بهم الأنبياء والمرسلين والأمم يوم القيامة.
الثالث: طلب البركة، وكثرة الأجر ومغفرة الذنب بدعاء الولد الصالح له بعده.
«فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب».
وقد صاغ علماء الشريعة هذه المسألة وغيرها في قاعدة مفادها أنّ المصالح المجتلبة شرعًا والمفاسد المستدفعة، إنّما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية.
ويمكن القول بمعنى آخر: إنَّ للزواج قصدًا أصليًا، وهو التعبد لله تعالى وقصدًا تابعًا: مثل قضاء الوطر، وإنجاب الذرية، والأنس بالزوج والتخلُّص من العزوبة.. إلخ، وهذا كله ليس مقصودًا من الزواج شرعًا، كما أنه غير مقصود من العبادة، ولكن صاحبه يناله ويتحصل عليه وكل تابع من هذه التوابع إمّا أن يكون خادمًا للقصد الأصلي وهو التعبد لله، وإمّا أن يكون غير خادم له، فإن كان القصد التابع خادمًا للقصد الأصلي، كانتْ بداية الزواج صحيحة، وقد قال تعالى في معرض المدح: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾ (سورة الفرقان آية: 74)، وذلك لما فيه من الثواب الجزيل في الآخرة.
وفي هذا يقول الإمام الغزالي: «كل ما كان سببًا لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات البدن، فهو يعين على الدين، فمن كان قصده من الزواج تحصين دينه وتطييب قلب أهله والتوصل به إلى ولد صالح يعبد الله تعالى ويكثر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان مطيعًا لله بزواجه هذا». أما إن كان القصد التابع غير خادم للقصد الأصلي كان القصد إلى الزواج ابتداءً غير صحيح. المشكلة هنا أن النيّة ليستْ داخلة تحت الاختيار: فإذا قال قائل: نويتُ أن أتزوَّج لله يقال له إن هذا ليس بنية إنّما هو حديث نفس، وحديث لسان وفكر أو انتقال من خاطر إلى خاطر، والقصد أو النية بمعزلٍ عن جميع ذلك، لأنَّ النية في حقيقتها: «انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى ما ظهر أنّ فيه غرضها إما عاجلًا أو أجلًا». والطريق إلى اكتساب توجه القلب إلى الشيء وميله إليه، إنّما يكون باكتساب أسبابه وهذا قد يقدر عليه صاحبه أو قد لا يقدر عليه.
فالنفس تنبعث إلى الفعل، وتتَّجه إليه استجابةً للغرض الموافق للنفس الملائم لها. فإذا غلبت شهوة النكاح مثلًا، ولم يكن لصاحبها قصدٌ أصلي في الولد دينًا ودنيا، لا يمكن أن يجامع زوجته على نيّة الولد هذه، ولكن على نية قضاء الشهوة، لأنَّ النية ما هي إلا إجابةً للباعث، ولا باعث هنا إلا الشهوة، فكيف ينوي الولد من لم يغلبْ على قلبه إقامة سنَّة النكاح، اتّباعًا لرسول الله ﷺ؟!
ولكن كيف تكتسب هذه النية؟
على من يريد اكتساب هذه النية أن يقوّي إيمانه بالشرع أولًا، ويقوي إيمانه بعظم ثواب من سعي، وإذا لم يكن في تكثير أمة محمد ﷺ، ويدفع عن نفسه
كل ما يعوقه عن ذلك من تفكير في ثقل المؤونة وطول التعب من إنفاقٍ وتربيةٍ وغير ذلك من مشاقٍّ، فإذا فعل ذلك ربما انبعث من قلبه رغبةً إلى تحصيل الولد للثواب، فتحرِّكه تلك الرغبة، وتتحرَّك أعضاؤه للبدء في خطوات الزواج، وعقد زواجه على من يراها تعينه على دينه ويعينها على دينها، ساعيًا إلى تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذرية تعبد الله عز وجل وتقيم أمره في هذه الدنيا، فإذا أجرى عقد الزواج طاعة لهذا الباعث الغالب على القلب كان صاحبها هنا «ناويًا». وإن لم تكن هذه نيته، فما يقدره في نفسه، ويردِّده في قلبه من قصد الولد إنما هو وسواس وهذيان «على حد قول الإمام الغزالي».
ومن غلب على قلبه أمر الدّين تيسر له في أكثر الأحوال إحضار النية للخيرات: بمعنى إن كان قلبه ماثلًا بالجملة إلى أصل الخير، نجده يتعدى إلى التفاصيل غالبًا، ومن مال قلبه إلى الدنيا وغلبتْ عليه الدنيا لم يتيسر له ذلك، بل لا يتيسر له في الفرائض إلّا بجهدٍ جهيدٍ، وغالب ذلك أن يتذكَّر النار ويحذِّر نفسه عقابها، أو نعيم الجنة ويرغب نفسه منها، فربما تنبعث له بواعث ضعيفة، فيكون ثوابه بقدر رغبته ونيته.
خلاصة القول: لا بُدَّ لكلِّ عملٍ من نية، فلا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له؛ أي لا أجر لمن لا يحتسب ثواب عمله عند الله عز وجل، وكل عمل لا يراد به وجه الله لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة، ولا بد للعمل من أمرين كما يقول الإمام ابن القيم: أن يكون خالصًا، بمعنى أن يقصد بالعمل في باطنه وجه الله تعالى وأن يكون صـوابًا فأفضل العمل أخلصه وأصوبه.
وقد استفضنا هنا في الحديث عن الأمر الأول، وهو أن يكون الزواج خالصًا، أما الأمر الثاني وهو أن يكون صوابًا، بمعنى أن يكون موافقًا للسنة، فهو أمرٌ يحتاج تفصيل، لأنَّ الزواج أيامنا هذه أبعد ما يكون عن سنة رسول الله ﷺ- إلَّا من رحم الله - ولهذا لا يحتاج الأمر إلى بحوث ودراسات لفهم أسباب تصدع الأسر، وارتفاع نسب الطلاق، وانحراف الأبناء..إلخ.
فالزَّواج في أصله بناءٌ، وأساس هذا البناء هو «تقوى الله ورضوانه»، فإذا كان هذا هو الأساس تماسك البناء استقام، وإذا لم يكن هذا أساسه كان عرضة لعدم الاستقرار والانهيار. يقول تعالى: ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (سورة التوبة آية: 109).
■ «الكلمة» تدل على صاحبها
د. فاطمة البريكي
التعرُّف إلى الشخصيات العامة والمشهورة .. رغبةً يشترك فيها الكثير من الناس؛ فمعظمنا يجد في نفسه ميلًا تجاه شخصيةٍ ما، برزتْ في مجالٍ من المجالات المختلفة كالرياضة، أو الفن أو الثقافة أو غير ذلك.
وقد تسنح الظروف فعلًا للاقتراب والتعرُّف إلى تلك الشخصية، ليتحول العلم إلى حقيقة في لحظة غير متوقعة غالبًا، لكن ما بعد هذه اللحظة يظلُّ أمرًا مجهولًا، فقد يكون حلمًا جميلًا بالفعل،لا يريد الشخص الاستيقاظ منه، وقد يكون كابوسًا ثقيلًا، يتمنى أن تحدث معجزةٌ، وتزيحه عن صدره.
ويتحدّد هذا بحسب طبيعة الشخصية محور الاهتمام، فبعض الشخصيات يزدادون قلقًا كلما ازدادوا قربًا من الناس، وبعضهم يحدث له العكس.
ويحدث في كثير من الأحيان أن يكون الكبير كبيرًا، ويكون مقامه عاليًا. ولكنّه يصغُر فجأةً ويسقط في لحظة، لأنّه لم يكن كبيرًا في موقف ما كان من الضروري أن يتسامى فيه عن هوى نفسه.
والكلمة دلالة على صاحبها، فإذا تكلم شخصٌ ما، فإنه يكشف عن قطعة من عقله، وقطعةٌ أخرى من نفسه، لذلك يجب على الإنسان أن يكون حريصًا على كل كلمة يتلفَّظ بها، وأن يزن كلامه بميزان أشدّ حساسيةً من ميزان الذهب. هذا إذا كان الإنسان شخصًا عاديًا من عامة الناس، فكيف إذا كان شخصيةً عامةً كبيرة القدر بين أفراد المجتمع؟ السُّلوك أيضًا يدلّ على صاحبه، وهو أحد الدلالات الواضحة التي تكشف عن سماتٍ أساسيةٍ في أي شخصيةٍ.
كما يجب على الكبير أن يكون كبيرًا في كل شيءٍ، فإذا كان كبيراً في مجاله وفي منزلته الاجتماعية، فعليه أن يكون كبيرًا بأخلاقه، وطباعه، وسلوكياته: إذ لا يكون الكبير كبيرًا إن اختار أن يكبر متى شاء، ويصغُر متى شاء.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكلفي ظِلالِ النبوَّة.. نخبة من المؤمنين بين يدي إمامهم يتحدثون
نشر في العدد 58
29
الثلاثاء 04-مايو-1971