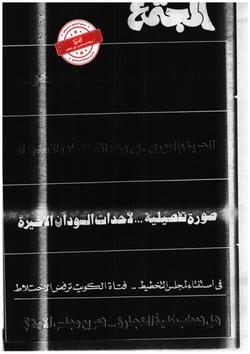العنوان إحياء فقه الدعوة.. دعوة القول الطيب
الكاتب محمد أحمد الراشد
تاريخ النشر الثلاثاء 26-فبراير-1974
مشاهدات 29
نشر في العدد 189
نشر في الصفحة 30

الثلاثاء 26-فبراير-1974
منظر جميل في كل بلد منظر أولئك البسطاء المتواضعين من أهل الأرياف والقرى حين يجتمعون يومًا في الأسبوع يقيمون سوقهم فيما بينهم، فيتبادلون إنتاجهم مقايضة، ويبيعون للغريب ما جمعوه جملة، بلا ميزان مدقق أو حساب طويل، يبنون تعاملهم وبيوعهم على النيات البيضاء، والحياء، والقناعة، وأسس الكرم، وشكر الله على ما يمنحهم من رزق، حتى إن أحدهم ليذهب من سوقه ليبذر بذره، فيقول مع كل حفنة حبوب يرشها على أرضه: للطير وما قسم الله. يرى للطير حقًا في كرمه.
لكن التعقيد والتدقيق إنما يكون في أسواق المدن، ونبات التطفيف تجدها عند كثير ممن يبيع أو يشتري من أهلها، يريد البائع أعلى ربح، ويريد المشتري أرخص ثمن ولذلك احتاجوا إلى الموازين واعتبروها حكمًا بينهم، وباتت تبعد شبهة التطفيف والمخادعة عن الطرفين، فلا يبقى أحدهما قلقًا، كما أصبحت تمنع شهوة التطفيف بعد ذاك، فلا يستطيع أحدهما التحايل، خوفًا أن يفضحه الميزان. وأنوار الفطنة هذه التي لا زلنا نمشي في أضوائها إنما هي موازين أيضًا، ترد الشبهات وتجليها، وتبرد الشهوات وتسكنها، إذا لف التعقيد مجتمع الدعاة واستعرت الفتن أو اقترب ظلامها، ولذلك كان ابن تيمية كثيرًا ما يصف المؤمن بأنه صاحب «بصر نافذ عند ورود الشبهات، وعقل كامل عند حلول الشهوات»، وركز على وجوب غلق هذين البابين اللذين تقتحم الفتن منهما حصن الجماعات: الشبهات والشهوات.
لكن، لو تعامل الدعاة بالنيات، والقناعة، والتواضع، والشكر على نعمة الإسلام والانتساب للدعوة، لوهبهم الله صواب الخطو بلا تكلف، ولما احتاجوا إلى ميزان وتدقيق، ولغشيتهم السكينة التي ينام أهل الأرياف في ظلها، غير أن فيهم نفرا يطففون.
حقيقة يجب أن نعترف بها؛ لقد تعقدنا بعض التعقيد، وتركنا سمت البساطة ومازج التكلف طبيعتنا المنسابة المنسرحة الهينة اللينة التي أودعها الرعيل الرائد فينا، ولا بد من علاج بمتابعة طلب هذه الموازين الأنوار.
● شبهة معترضة
ولقد وصف النور التاسع بأنه ساطع، لما للمساررة في نصيحة القادة من بريق لامع يحرم الفتن من بيئتها الطبيعية التي تتوالد فيها.
ولكن ربما ظن داعية أن المساررة في النصيحة تنافي طبائع الإسلام وسمته في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورأى في إنكار المرأة على عمر رضي الله عنه في المسجد جهارًا دليلًا ينفي نورانية المساررة.
والأمر ليس كذلك عند من عرف مقاصدنا، إذ لو افترضنا صحة قصة إنكار هذه المرأة على عمر- التي يضعفها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني- وفحصها فحواها، لما وجدنا لها علاقة بسياسة أو عقيدة أو موقف عام جماعي، وإنما تتناول أمر مهور الزوجات، أو أمر توزيع بعض العطايا على من له حق في بيت المال، في قصة أخرى تروى، فضلًا عن أن العامي المجهول الذي اعترض، أو المرأة المجهولة، لا يصلح عملهما أن يناهض الأدب الذي اختاره سعد بن أبي وقاص أو أسامة، وهما على ما يعرف عنهما من الفقه والتجربة، ولا أن يكونا مصدرًا لأصول الدعوة وابن حجر يفتيك بعد ابن عكيم بوجوب الأسرار عند خوف المفسدة.
إن نصيحة قادة العدل الذين يتحرون السير على موجب فقه الراشدين غير مواقف العلماء الجريئة في الإنكار على الظلمة والمبتدعة، وإنما ندعو نحن إلى مساررة لافي مثل هذه الأمور التي يحتاجها الناس في أمر معاشهم اليومي، بل فيما يتعلق بسياسة المجموعة الداخلية والخارجية ومواقفها العامة، وفي أيام الفتن خاصة، خوفًا من استغلال أصحاب الأغراض للنقد المعلن، أو اغترار المخلصين السذج وأصحاب التجربة القليلة بظاهره، إذ تصبح النصيحة في موطن يوجد فيه مثل هؤلاء مترددة بين مصلحتين: مصلحة علانية النقد، ومصلحة عدم إتاحة فرصة لاستغلال المغرض أو لاغترار الساذج به.
وبین ضررین: ضرر الاقتصار على أسماع النصيحة لنفر قليل فقط، وضرر الاستغلال والاغترار، فيعمل بالقاعدة الفقهية العامة في دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، وجلب أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وهي قاعدة أجمع الفقهاء على اعتبارها، ويقرها العقل، و توجبها التجارب الوافرة في تاريخ الإسلام القديم والحديث.
بل وإن عمر- رضي الله عنه- قد أسرع هو نفسه قبل غيره إلى الامتناع عن بحث الأمور العامة أمام الجمهور الواسع الذي قد يضم المغرضين والسذج، واقتصر على إسماع من يظن فيه الفقه والنبل فحسب، وذلك حين أراد أن يقوم في مكة أيام موسم الحج خطيبًا ليفند لغطا لغط به بعض الجهال حول بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأحداث يوم السقيفة، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه:
«يا أمير المؤمنين: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها، وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنًا، فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعونها على مواضعها.
فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة.» «١»
فها قد تظافر لدليلنا من جديد: رأي ابن عوف، وفعل عمر، رضي الله عنهما. وهكذا الداعية: لا يضع كلامه إلا عند من هو أهل لوعيه، وليعتبر بما رأينا في الفتن، فإنها تكون أول ما تكون خفيفة، ثم يتلقف أصحاب شهوة الرياسة نقد الثقات، ويزيدون فيه عشرة أمثاله، فيكون هدمًا.
إن الداعية الفطن الكيس إن كان عنده قول يرى أن لا بد من قوله لغير قادته فإنما يقوله لأهل الفقه من الدعاة وأشرافهم الذين تأدبوا بآداب السنة طويلًا، ويسارر به، لا يوزعه هاهنا وهاهنا.
يسارر، أو يتحرى العلماء النبلاء العقلاء القدماء، أصحاب الأقدام المنظورة المأثورة، ثم يسرع بعد أن ألقى التبعة نحو:
النور العاشر وهو: الإقلال من الكلام
فإنما يسألك الله عن فصاحة قلبك لا عن فصاحة لسانك.
ولا شك أنها مسألة نسبية مسألة اللسان، فليس أحسن وأبلغ من سكوت إذا كثر اللغط، ولا أجمل من كلام الناصح الآمر بالمعروف إذا أصلح.
فالمؤمن -كما يقول المحاسبي- «يحسبه الجاهل صميتًا عييًا، وحكمته أصمتته. ويحسبه الأحمق مهذارًا، والنصيحة لله أنطقته» «۲»
وهو ذاك النموذج الذي رآه الشاعر:
ضحوك السن: إن نطقوا بخير /// وعند الشر: مطراق عبوس
فطلب منك تقليده بعد أن رأى جمال تقلبه في الحالتين، فقال:
تكلم وسدد ما استطعت فإنما /// كلامك حي والسكوت جماد
فإن لم تجد قولًا سديدًا تقوله /// فصمتك عن غير السداد سداد
وهذا هو عين الصلاح الذي أراده الصالحون لكل لسان، فمن صلح لسانه عندهم، أي نطق بالخير وسكت حين الفتن: صلح عمله كله. وفي ذلك كان التابعي يونس بن عبيد يقول:
«خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سواهما: أمر صلاته، ولسانه.»
ثم زاد فقال: «ما صلح لسان أحد إلا صلح سائر عمله.»
فهو المفتاح المبارك، ولود الخيرات، من أصلحه تفتحت فيه البصائر، وهجر الكبائر والصغائر.
● الكلمة الطيبة ترفع درجات
ولذلك كثر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية اللسان، وجعل سكوته في موطن الشبهة ترجمة الإيمان، فقال:
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت.» «۳»، وفي لفظ: «أو لیسكت.» «٤»
فقول الخير من الإيمان، حتى أن الكلمة الواحدة لترفع صاحبها درجات، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات.» «٥»
ومن أجل ذلك رغب في هذه الكلمات الخيرة، فقال: «أطيبوا الكلام.» «٦»
يدلهم على باب الدرجات، وسلم العلو، إذ ليس أروع من كلمة حق منك، أو إصلاح، حين يفتتن لسان غيرك.
فإن عجز المرء: فإنه السكوت، إذ ربما تبدل الكلمة الواحدة ميزانه فيردى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالًا، يهوى بها في جهنم.» «٧» والميزان في هذا، هنا في الأقوال كما في الأعمال، هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إذا حاك في نفسك شيء فدعه.» «۸»
فإن«اکثر خطايا ابن آدم في لسانه.» «۹»
فلينظر داعية نفسه، وليرفق بها، وليلزم الجمل المفيدة، وحروف البناء، وليطب كلامه، يكون طيبًا يهدي من القول طيبًا، فإن نصف التربية قول موجه، وليدع حرفًا حاك في الصدر، فإن الشيطان يؤز، يحرف النفس إلى طلب انتصار وغلبة، فتكون الوخزة، والتهمة المتسرعة، والنبزة . أو يشجعها على طلب سلامة ودعة، فتكون حروف اللين.
والطريق الأقرب لهذا الرفق الطيب: أن يتشبه الداعية بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويقلده في خلقه، لتشمله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا له فقال: «اللهم أهد قلبه وثبت لسانه» «۱٠»
فلم يتقلب لسان علي.
فانظر: لم يكتف حتى ذكر اللسان، وبين أن ثبات اللسان قرين هداية القلب أو نتاجها!
وإلا، فإن لنا حين نرى لسانًا قلقًا لاحنا أن نتهم القلب الذي تحته بعدم استكمال الهداية، وأنه بحاجة إلى الواعظ الناصح الذي يعلمه الفصاحة في الحق، ويدق له وتدا يثبته في تيارات الأهواء.
وإنما هو نموذج دعاء حفظه الرواة فرووه لك، تعليمًا للغة الدعاء وتلقينا، كي تقول لأخيك يوم ترى بوادر الفتن:
«اللهم اهد قلبه وثبت لسانه»
تقولها بعد قولك:
«اللهم اغفر لي ولأخي هذا» معًا، مرة بعد مرة، كلما لقيته.
● صواب القول من صواب العمل
وبهذا تكون قد أديت واجبك، وأحسنت أجمل الإحسان الأخوي.
أما فقه الدعوة، فمن واجبه أن يستمر في عرض غرر النصائح، لعل حريصًا ينتفع، أو جريئا يتأنى، ليتأمل وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذ يقول له:
«أقلل من الكلام، فإنما لك ما وعي عنك.» «۱۱»
أو وصية عمر الفاروق- رضي الله عنه- إذ يترحم فيقول:
«رحم الله أمرءًا أمسك فضل القول وقدم فضل العمل.» «۱۲»
أو وصية أبي الدرداء رضي الله عنه لما ذهب في الصراحة لأبعد منهما فقال: «أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعل لك أذنان اثنتان وفم واحد، لتسمع أكثر مما تقول.» «۱۳» تلك وصاياهم.
كانوا جيل جهاد وبناء، ربته المعاناة والممارسة، وصقلته الشدائد، وعرفوا من خلالها قدرة البذل الصامت على تناوش الغايات، فخافوا أن يقطع هذر ما نصرهم المسترسل في سيره.
إن اللغو شين كله، وضرره أيام التمكين ليس أقل من ضرره أيام المحن.
وعلى دعاة الإسلام أن ينطلقوا اليوم من هذه الحقيقة، فينطقوا فيما بينهم بالخير الواسع، والمعنى الكبير، والفقه المفيد، في عبارة ضيقة المبنى موجزة، فإن الإكثار مظنة الخطأ، من غيبة، أو تهمة بريء، أو اضطرار لاستعمال دلیل ضعيف، ومن وجد في نفسه بقية شوق إلى تحريك اللسان فدونه القرآن، ومزيد التسبيح، والحمد. ودونه مجالس الواهمين والدنيويين، يصدع فيها بحق الإسلام ما شاء.
نمط تربوي لا بد منه لجيلنا، كي تتهيأ الجوارح لفضل فائض من العمل، بمثله أمات عمر الفتن في جيله، فانبغت له الفتوح.
وفتحنا المنتظر رهن بطريقة عمر.
هذا، أو التردي المعاكس الذي لا يقف، بل يستمر نازلًا هاويًا، فإن القول والعمل مرتبطان، فإن أخطأت العمل: احتاجت نفسك إلى ستر الخطأ بخطأ من القول آخر زورًا .
ذلك ما لاحظه أحد الصالحين فقال: «لن يضيع امرؤ صواب القول حتى يضيع صواب العمل»«١٤».
هكذا، في متوالية رديئة، تقدم ستر الفضيحة على قول الحقيقة، والتبرير المدلس على التوبة والاعتذار، في ظن بعيد من الانتصار يراه قريبًا، واللحن يهتك حجابه.
● وذهب الصمت عرفا!
وكان نتاج ذاك الحرص الراشد على الصمت الفعال فوجًا آخر من التابعين يترادفون على درب العمل ويجددون النصح التربوي بإقلال الكلام.
● منهم التابعي المهلب بن أبي صفرة الأزدي حين يقول:
«يعجبني أن أرى عقل الرجل الكريم زائدا على لسانه.» «۱٥»
كلمة تستوي في ظاهرها مع ما نسمع من طرف لسان أكثر الوعاظ، لكنها عند من يعرف المهلب قائدًا متحمسًا لقتال الخوارج تمثل حساسية روح وخزها شذوذ الخوارج عن إجماع المسلمين، ولذعة قلب كواه تفاصحهم وتبجحهم الزائد إزاء عقل يناديهم باجتماع تتمكن معه جيوش الإسلام من مواصلة الزحف على معاقل الكفر بدل تطاحن داخلي بين طرفين كلاهما موحد.
● ثم عمر بن عبد العزيز الذي يقول: «من عد كلامه من عمله قل كلامه»«١٦».
يذكرك، لعلك نسيت، أنك تحاسب على الكلام حسابًا مثل الذي على عمل الجوارح.
وانظر الترابط بين مشاهدته الواضحة لهذه الحقيقة، وبين رشده وعدله وطبيعة حكمه الفذة.
حتى إن المطالع لكتب المواعظ ليكاد يرى تواطئًا بينه وبين أساتذة التربية الذين عضدوه على إقرار الإقلال من الكلام خطأ تربويًا للمجتمع، ومن أبرز هؤلاء: الحسن البصري، وميمون بن مهران، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وبقية فقهاء المدينة.
● ونقلة قريبة إلى الجيل الذي بعدهم ترينا استمرار هذا السمت عند الثقات، ففي مرثية المحدث الثقة محمد بن كناسة الكوفي لخاله الزاهد المشهور إبراهيم بن أدهم إشادة بهذا الخلق وبيان تكامله مع الصفات الإيمانية الأخرى وارتباطه بها، فيقول:
زهود يرى الدنيا صغيرًا عظيمها /// وفي لحق الله فيها معظما
وأكثر ما تلقاه في القوم صامتًا /// فإن قال بز القائلين وأحكما
فاستصغار الدنيا، والوفاء، لا يبدو جمالهما الكامل إلا إذا اقترنا بصمت.
● ثم أستاذ الزهد في الجيل التالي: بشر بن الحارث الحافي، عضيد أحمد بن حنبل.
قالوا: «ما أخرجت بغداد أتم عقلًا ولا أحفظ للسانه من بشر.» «۱۷»
فأبانوا -من وجه آخر- ارتباط حفظ اللسان بالعقل، فهو قد حفظ لسانه من اللغو، فوهبه الله لسانًا جريئًا في موقف صدق إزاء أمير خدعته البدعة، فكان يجوب شوارع بغداد يوم تعذيب الإمام أحمد، ينتصر له، ويثبت الناس، ويقود جمهور محبيه المتكتل أمام قصر المعتصم.
وهذا اللسان- لعمرو الله- هو اللسان الذي يجب أن يحرص عليه الدعاة، وبه يفخرون.
لسان اللهج بحديث في مسند أحمد، والترويج لعقيدة أحمد، وقيادة من يقتفي طريقة أحمد وطرق من سبق أحمد ومن خلفه من أئمة الفقه والفضل، لا لسان التثبيط والتخذيل.
ورحم الله داعية أمسك فضل القول وقدم فضل العمل. كلمة قالها عمر، لم نقلها نحن.
----
«۱» صحيح البخاري ۸- ۲۰۹
«۲» رسالة المسترشدين- ١٠٦
«٣» صحيح البخاري ٨-١٢٥
«٤» صحيح مسلم ١-٥٠
«٥» صحيح البخاري ٨-١٢٥
«٦» صحيح الجامع الصغير للألباني ١-٣٤٠
«۷» صحيح البخاري ٨-١٢٥
«۸» «۹» صحيح الجامع الصغير ١-١٩١-٣٨٥
«۱۰» طبقات ابن سعد ۲- ۳۳۷
«۱۱» «۱۲» «۱۳» عيون الأخبار ۱- ۱۰۹- ۳۳۰- ۱۷۷
«١٤» سراج الملوك للطرطوشي- ٣٧٥
«۱٥» تاريخ بغداد ۹- ٣۰۰
«١٦» الزهد لابن المبارك - ١٢٩
«۱۷» تهذيب التهذيب ١-٤٤٥.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل