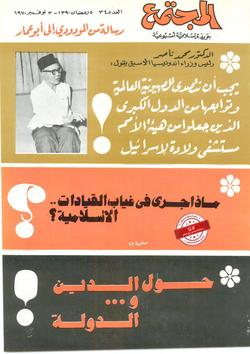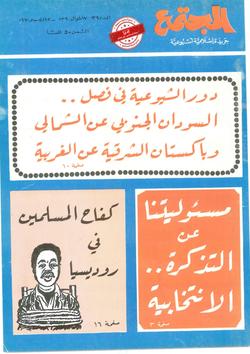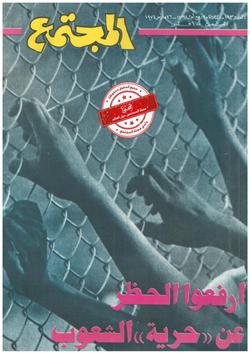العنوان الاتجاهات المخالفة.. في.. قضية القدر
الكاتب محمد عبد العزيز جبر
تاريخ النشر الثلاثاء 18-يوليو-1972
مشاهدات 17
نشر في العدد 109
نشر في الصفحة 14

الثلاثاء 18-يوليو-1972
صفحات حّرة
الاتجاهات المخالفة.. في.. قضية القدر
بقلم الأستاذ: محمد عبد العزيز جبر
سأختار هنا أقوال ثلاثة من علمائنا الأجلاء المعاصرين وهم على طريق الحق والحمد لله، غير أنهم ما أصابوا الحق في هذه الجزئية من العقيدة، ونادوا بخلاف ما عليه أهل الحق في كافة العصور، ولا يضرهم ذلك إن شاء الله، فسبحان من تنزه عن كل نقصان واتصف بكل كمال، وصدق من قال: «اتقوا زيغة الحكيم وانتظروا فيئته» أي رجوعه إلى الحق.. ونرجو أن يكون الامر كذلك، فلا عصمة في الفكر لبشر أصلًا، حتى الأنبياء فإنهم إذا تأخر عليهم الوحي، واجتهدوا، فربما لم يصيبوا، حتى ينزل التصحيح من السماء ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. (الحج: ٥٢).
ولعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا بذلك ألا ينكر بعضنا على بعض إنكار طعن وتهمة، ما دام قد تبين الإخلاص، وصدق التجرد لطلب الحق، وتنزه الباحث عن الهوى والغرض، فأرجو أن يحمل الناس جوابي على خلاف من خالف محملًا حسنًا، وأن يقع من قلوبهم موقعًا أحسن، فإني أسأل الله ألا يكون رائدي إلا بيان معتقد أهل الحق، والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل..
۱ - رأي الشيخ سيد سابق في كتابه «العقائد الإسلامية» ص ۱۰۳ ما نصه: «والآيات التي تقرر حرية الإنسان كثيرة جدًّا، منها قول الله تعالى:
﴿مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾. (فصلت: ٤٦).
فأسند العمل الصالح والعمل السيئ إلى الإنسان، ولو لم يكن الإنسان حرًّا ما أسند إليه الفعل.
وفي موضع آخر من القرآن الكريم يقول الله سبحانه:
﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾. (الشورى: ٣٠).
أي أن الشرور التي تعرض للإنسان إنما هي أثر من آثار عمله ونتاج اختياره وتصرفه.
وأن القرآن ليتحدث عن المفاسد والجرائم التي تحيط بالناس فيبين أنها ليست من صنع الله وإنما هي من عمل البشر.
﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾. (الروم: ٤١).
(انتهى كلامه بنصه).
قلت:
الاستدلال بالآيات السابقة على حرية الإنسان لا يستقيم، وإنما ضل كثير من الناس، وفيهم المخلصون الصادقون، بحملهم آيات من كتاب الله على ما يوافق آراءهم، وتأويل ما يخالف مذاهبهم من الآيات، ولو التزموا بالمعنى الذي فهمه أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من الآيات المتشابهات لاستقاموا على الطريقة، وسلموا من الانزلاق في مهاوى الخطر ولأراحوا واستراحوا..
أما الآية الأولى وهي قوله تعالى:
﴿مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ ﴾ فوجه نسبة العمل إلى الإنسان- مع أن الله خلق الإنسان وخلق عمله. فهو كون ذلـك العمل قائمًا بذلك الإنسان، وكون ذلك الإنسان مخلوقًا ليقوم بذلك العمل، فالعمل مخلوق فيه من الله على الوجه الذي بيناه في المقال السابق، ومن هنا صحت نسبة الفعل إلى الإنسان، إذ الإنسان من حيث إنه مختار من الله ليقوم بعمل قدر عليه، أوتي من الاستعدادات النفسية والبدنية، والمؤثرات الزمانية والمكانية، ما يجعله يسلك- بإذن الله السبيل الذي أراده له الله، فينفذ الإنسان مشيئة الله فيه ويحسب أنه «حر مختار» إذ لا قاهر له من غير نفسه يحس بسلطان قهره، فيحكم على نفسه بالحرية والاختيار، بينما هو وما عمل خلق من خلق الله وأثر من آثار قدرته، لا حول له في دفعه ولا قوة في صرفه عن نفسه.. ولست فيما قلت مبتدعًا والعياذ بالله، ولكني متبع إن شاء الله، وإليكم هذا النقل بنص فـإن دل على غير ما فهمت فأفيدوني أفادكم الله.
« قال البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد: عن حذيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته» قال البخاري: وتلا بعضهم عند ذلك ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾. (الصافات: ٩٦).
وقال البخاري: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن سعد يقول: «مازلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة» قال البخاري: «حركاتهم، وأصواتهم، وأكسابهم، وكتابتهم، مخلوقة».
وقال ابن القيم يشرح الاستخارة في معرض الاستدلال على أن الله خالق لأفعال العباد الاختيارية قال: «وأستقدرك بقدرتك» أي أسألك أن تقدرني على فعله بقدرتك، ومعلوم أنه لم يسأل القدرة المصححة التي هي سلامة الأعضاء وصحة البنية، وإنما سأل «القدرة التي توجب الفعل» فعلم أنها «مقدورة لله ومخلوقة له» وأكد ذلك بقوله «فإنك تقدر ولا أقدر» أي تقدر أن تجعلني قادرًا فاعلًا، ولا أقدر أن أجعل نفسي كذلك» «شفاء العليل الباب السادس عشر لابن القيم بنصه» وقال في موضع آخر من الباب: «وفي المسند وغيره أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال لمعاذ بن جبل: «يا معاذ، والله إني لاحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» قال ابن القيم: «وهذه أفعال اختيارية، وقد سأل الله أن يعينه على فعلها» ثم قال: وهذا الطلب لا معنى له عند القدرية «أي القائلين بالاختيار»، فإن الإعانة عندهم «الاقدار، والتمكين، وإزاحة الأعذار، وسلامة الآلة»، وهذا حاصل للسائل وللكفار أيضًا، والإعانة التي سألها، «أن يجعله ذاكرًا، شاكرًا، محسنًا لعبادته» انتهى بنصه.
قلت: وقد سبق في المقال السابق حكاية الإجماع على هذه المسألة وهي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر.
ولعله يستعصى على كثير من الناس أن يؤمنوا بأن يخلق الله إنسانًا ويريده على سلوك سبيل معين؛ يهيئ له أسبابه حتى لا يكون له خيار في خلافة، غير أن أقرب دليل على ذلك، وأقطعه للشبهة، وأبلغه في الحجة هو النبوة، فلا يملك إنسان أن يقول: النبوة مكتسبة، ولكن موهوبة بالاتفاق، وكذلك لا يملك إنسان أن يقول: الاستعداد لحمل النبوة مكتسب، ولكن موهوب بالاتفاق، ولا يملك إنسان أن يقول: إن الله اطلع على القلوب، فاختار أحسنها وأصفاها وحملها الرسالة، كلا وربي ولكن خلق رجالًا بذواتهم ليكونوا أنبياء ابتداء، فلم يؤهلوا أنفسهم للنبوة بكسبهم، ولكن خلقهم الله أصلًا ليكونوا أنبياء بلا خلاف، ولا يملك إنسان أن يقول: شأن النبي غير شأن الناس، فما قال أحد: الأنبياء مسيرون والناس مخيرون، ولكن حكم الله واحد في خلقه جميعًا وصدق الله العظيم ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾. (الأنعام: ١٢٤).
﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾. (القصص: ٦٨).
وأعود لمناقشة استدلال الشيخ سيد سابق فأقول: أما استدلاله بقوله تعالى ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾. (الشورى: ٣٠)، فاستدلال غير قائم، لأن المقصود من هذه الآية بيان سنة الله التي لا تتبدل في خليقته، من خلق الأسباب والمسببات، وترتيب النتائج على المقدمات، حتى صار لدينا علم يقيني بحكم السنة الماضية، أن الله يهلك الأمم عقيب التكذيب، وينزل البلاء بعد المعصية، ويبتلي بالمصائب بعد الفسوق، كل ذلك بحكم سنة الله الجارية، في جعله لكل شيء سببًا، لا بمعنى أن السبب يحدث المسبب، ولكن بمعنى أن الله رتب المسبب على السبب، فيحصل هذا عقيب ذاك، وهو سبحانه خالق الكل، خلق الأسباب والمسببات وأبدع النتائج والمقدمات، لا شريك له في ذلك، وبذلك أمرت وأنـا أول المسلمين.
فاذا قال سبحانه وتعالى ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ (الشورى- 30). أو قال سبحانه ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم : 40) فإنما يقرر سبحانه ما مضت به سنته، واقتضته حكمته، وظهر به عدله، من ترتيب النتائج على المقدمات، وتوقف المسببات على الأسباب، فالمصائب، وظهور الفساد في البر والبحر، والإهلاك، والتسليط، وإلباس الناس لباس الجوع والخوف، كل ذلك «مسبب» وحاصل عقيب «السبب»، وهو الإعراض عن الله وتكذيب الرسل وإتيان المعاصي، والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «والسبب والمسبب» كلاهما من صنع الله سبحانه، قدر السبب وأراده، فوقع كما قدَّره وأراده، لحكمة بالغة يعلمها سبحانه، ثم رتب على الأسباب نتائجها، فلم تتخلف، فنزل البلاء على ما سبق به القضاء: ﴿...وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. (البقرة: ٢١٦).
وفي تقرير هذا المعنى من ترتب المسببات على الأسباب وكون الكل من عند الله، ووجوب الإيمان بذلك، وإحالة السر إلى علم علام الغيوب، يقول الإمام ابن القيم في شفاء العليل ص ۳۷۳:
«حكمه تعالى بالذنب عقوبة علـى ذنب سابق، فإن الذنوب يكسب بعضها بعضًا، وذلك الذنب السابق عقوبة على غفلته عن ربه، وإعراضه عنه، وتلك الغفلة والإعراض هي في أصل الجبلة والنشأة، فمن أراد أن يكمله أقبل بقلبه إليه، وجذبه إليه، وألهمه رشده، وألقى فيه أسباب الخير، ومن لم يرد أن يكمله، تركه وطبعه، وخلى بينه وبين نفسه لأنه لا يصلح للتكميل، وليس محله أهلًا له، ولا قابلًا لما وضع فيه من الخير، وههنا انتهى علم العباد بالقدر، وأما كونه تعالى جعل هذا يصلح، وأعطاه ما يصلح له، وهذا لا يصلح فمنعه ما لا يصلح له، فذلك موجب ربوبيته وألوهيته، وعلمه وحكمته، فإنه سبحانه خالق الأشياء وأضدادها، وهذا مقتضى كماله، وظهور أسمائه وصفاته كما تقدم تقريره، والمقصود، أنه أعدل العادلين في قضائه «بالسبب» وقضائه «بالمسبب»، فما قضى في عبده بقضاء، إلا وهو واقـع في محله الذي لا يليق به غيره، إذ هو الحكم العدل الغني الحميد» انتهى بنصه.
فإن قلت: فما الحكمة في إعلام الله لنا أن المصيبة تتبع المعصية مع أن الكل من عند الله؟.
قلت: أجاب الإمام الغزالي عن أشكال شبيهة بهذا؛ فقال رحمه الله: «فان قلت: قلم قال الله تعالى: اعملوا، وإلا فأنتم معاقبون مذمومون على العصيان وما إلينا شيء، فكيف نذم وإنما الكل إلى الله تعالى..؟، فاعلم أن هذا القول من الله تعالى سبب لحصول اعتقاد فينا، والاعتقاد سبب لهيجان الخوف، وهيجان الخوف سبب لترك الشهوات والتجافي عن دار الغرور، وذلك سبب للوصول إلى جوار الله، والله تعالى سبّب الأسباب ومرتبها، فمن سبق له في الأزل السعادة، يسر له هذه الأسباب حتى يقوده بسلسلتها إلى الجنة، ويعبر عن مثله بأن كلًا میسر لما خلق له، ومن لم يسبق له من الله الحسنى بعد عن سماع كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام العلماء، فإذا لم يسمع لم يعلم، وإذا لم يعلم لم يخف، وإذا لم يخف لم يترك الركون إلى الدنيا، وإذا لم يترك الركون إلى الدنيا، بقي في حزب الشيطان، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، فإذا عرفت هذا تعجبت من قوم يقادون إلى الجنة بسلاسل الأسباب، وهو تسليط العلم والخوف عليه، وما من مخذول إلا وهو مقود إلى النار بالسلاسل وهو تسليط الغفلة والأمن والغرور عليه» انتهى بنص عن الإحياء ص ٨٧ ح ٤.
ونكتفي بهذا القدر من مناقشة الشيخ سيد سابق لنشرع بعون الله في الرد على الشيخ محمد الغزالي، على مسألة تفـرد بها عن صاحبه، وأرى لها خطرًا عظيمًا، تلك هي تفسيره «التقدير» بالعلم «والكتاب» بأنه سجل العلم الإلهي، والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعـم الوكيل.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل