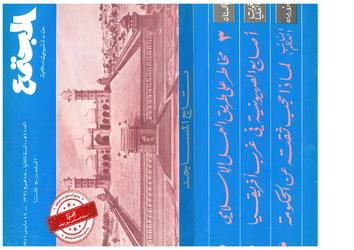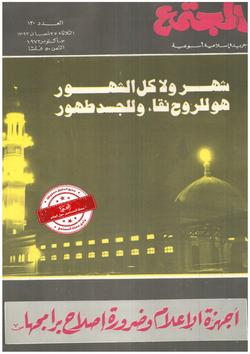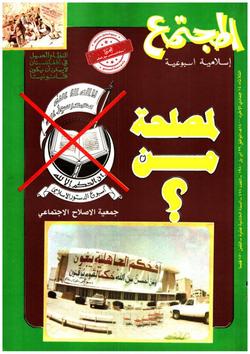العنوان الاجتهاد والتقليد
الكاتب د. محمد سليمان الاشقر
تاريخ النشر الثلاثاء 26-أغسطس-1980
مشاهدات 14
نشر في العدد 494
نشر في الصفحة 26
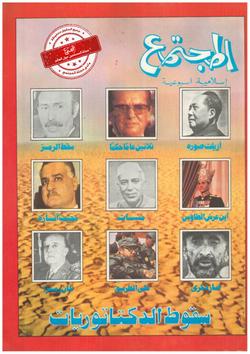
الثلاثاء 26-أغسطس-1980
الاجتهاد
بذل العلماء جهدهم لتحصيل الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية هي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد بطلب فعلها أو الكف عنها على سبيل الحتم والإلزام، أو على سبيل الترغيب، أو على سبيل التخيير.
فالاجتهاد إذًا وسيلة لتعرف مراد الله تعالى منا تجاه أي فعل نريد القيام به في عبادتنا له تعالى، مما قد يخفى على البعض أو في المعاملات كالبيع أو الشراء والكفالة وأخذ الأجرة على الحج أو الأذان، أو في آداب الطعام والشراب والمجالسة، أو في العقوبات، أو في غير ذلك.
وقد ادَّعى بعض العلماء أن كل عمل يقوم به الإنسان له حكم شرعي؛ فمجال الاجتهاد على هذا واسع كل السعة، إذ إن المصنوعات والمبتكرات والتعامل والعادات وغيرها تتجدد باستمرار ما بقيت الحياة واتسعت آفاقها، فكل ذلك بحاجة إلى أن يعرف حكمه بالاجتهاد، ويكون الاجتهاد بذلك سببًا لنمو الفقه الإسلامي واتساع آفاقه.
ولكنَّ في هذا الأصل نظرًا؛ فإن بعض الفقهاء يرون أنه ليس كل فعل يفعله البشر يفترض أن يكون لله تعالى فيه حكم، فقد أثبت بعضهم مرتبة تسمى «مرتبة العفو» معناها أن كثيرًا من الأفعال سكتت عنها الشريعة فلم تحكم فيها بأمر ولا نهي ولا تخيير، فلا يكون الله تعالى فيها حكم وللعباد أن يتصرفوا فيها كما يشاؤون، يفعلونها إن شاؤوا ويتركونها إن شاؤوا وينظمون شؤونهم فيها على الوجه الذي يتفق مع عقولهم وتجاربهم.
فإن قلنا بهذا الرأي فليس ذلك يعني الاستغناء عن الاجتهاد، لأنه لا بُد من العلم بخلو المسألة -موضوع البحث- عن حكم شرعي، ولا بُد من الاجتهاد لتحصيل ذلك العلم.
ثم إنه لو كان العلم بالحكم المجرد حاصلًا لدى الفقيه، فإن به حاجة إلى نوع من الاجتهاد، هو أن يعلم انطباق ذلك الحكم على المسألة الواقعة بمعرفة توافر الشروط المعتبرة وانتفاء الموانع، ومعرفة أن تلك المسألة الواقعة ليست خارجة عن ذلك الحكم لفقدان شرط فيها أو وجود مانع أو نقص سبب أو جزء سبب، فهذا نوع من الاجتهاد لا يستغني عنه القاضي ولا المفتي ولا من يريد تطبيق أحكام الشريعة على نفسه أو في مجال عمله.
الاجتهاد بتحصيل الأحكام الشرعية المجردة:
لیست أدلة الأحكام الشرعية بمستوى واحد من حيث قوة الثبوت ووضوح الدلالة على المراد، بل هي مختلفة؛ فمنها ما يستوي العرب في فهم الحكم منه للقطع بوروده وشدة وضوحه، كدلالة قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ﴾ (سورة البقرة: الآية: 173). وكدلالة قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» على وجوب خمس صلوات على المسلم.
ومنها ما يتمايز الناس في فهمه، كما أرشد إلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ (سورة آل عمران: الآية: 7).
فما ثبت وروده ووضحت دلالته لا مشقة في أخذ الحكم منه ولا يسمى ذلك اجتهادًا؛ لأن الاجتهاد يشعر ببذل الوسع في استنباط الحكم، وما كان بخلاف ذلك فلا بُد فيه من اجتهاد.
إمکان انفصال جهتي الاجتهاد:
لا مانع أن يكون المسلم مجتهدًا في إثبات النصوص ولا يكون مجتهدًا في دلالتها، ومن هؤلاء القوم الذين تخصصوا في الحديث وأسانيده، وبالعكس قد يكون الرجل مقلدًا في إثبات النصوص لعلماء الحديث وأهل الجرح والتعديل وعلم الرجال، فما صححوه هم يجتهد هو في استنباط الحكم منه، ومن هؤلاء بعض الفقهاء الذين يجهلون طرق إثبات الأحاديث.
شروط المجتهد:
اختلف الأصوليون ما بين متشدد في الشروط؛ بحيث لا تنطبق شروطه إلا على الأئمة الأربعة وقلة أمثالهم، وما بين متساهل يرى أن لكل إنسان الحق في الاجتهاد. والحق التوسط في ذلك كما سيتبين بعد، والشروط التي لا بُد منها للمجتهد هي ما يلي:
1-أن يكون عارفًا بنصوص الكتاب والسنة الواردة في الباب الذي يكون موضع البحث، فإن كان يجتهد في مسألة من مسائل الطلاق يكون مُلمًّا بآيات الطلاق وأحاديثه، وإن كان في الحج ففي آيات الحج وأحاديثه وهكذا.
وقد قيل إن مجموع آيات الأحكام خمسمئة آية، وأحاديث الأحكام قريب من ألفين إلى عشرة آلاف.
والأوْلى أن يقال هي أحاديث الأحكام الموجودة في كتب السنة المعتمدة، وعددها قريب من عشرة كتب قَلَّما يخرج عنها حديث صحيح، وهي: موطأ مالك، ومسند أحمد، وصحيحا البخاري ومسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجهْ، وسنن الدارمي، وصحيح ابن حبان.
ولا يشترط أن يكون الإنسان مستظهرًا لكل تلك الأحاديث، بل أن يكون لديه المقدرة على الوصول إليها، ومن أجل هذا كان علم البحث في الكتاب والسنة ميسرًا جدًّا لعمل المجتهد، وقد أمكن ذلك بترتيبات ممتازة وضعت قديمًا وحديثًا على شكل فهارس أو مجاميع أو معاجم تيسرت في الوقت الحاضر لمن يطلبها.
2-أن يكون عالمًا بلسان العرب؛ وذلك بمعرفة معاني مفردات اللغة معرفة إجمالية مع التمكن من الوصول إلى المعرفة الدقيقة بالرجوع إلى كتب المعاجم. وأيضًا بمعرفة فروق الأساليب المركبة؛ وذلك بأن يكون له ملكة في النحو والبلاغة مع التمكن من الرجوع إلى كتبها.
3- أن يكون عالمًا بأصول الفقه لأنه علم يضبط القواعد التي تتبع في الاستنباط.
4- أن يكون عالمًا بالناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث، ويكفي أن يطلع كتابًا معتمدًا في ذلك لئلا يعمل بحكم المنسوخ.
قاعدة تجزؤ الاجتهاد:
الصحيح إمكان تجزؤ الاجتهاد، فيكون المرء مجتهدًا في باب معين من أبواب الفقه كأمور الحج مثلًا يتخصص فيها حتى يحيط بها علمًا، ولكن لا بُد من أن يكون له إلمامٌ بسائر أبواب الفقه لأن بعضها يعين على بعض.
تربية الملكة الفقهية:
إن كثرة المطالعة في كتب الفقهاء وخاصة الأئمة المتقدمين منهم، يربي الملكة الفقهية، ويقوي ملاحظة مواضع الدلالة وأساليبها، ويولد المراس والدربة على استخدام الأحكام.
ويحسن أن يتتبع الطالب كتب الفقه المقارن التي تذكر الخلاف في المسائل مع الأدلة والتعليل دون تلك التي تذكر الأقوال المجردة.
وعلي الطالب أن يديم المباحَثة مع أهل العلم في المسائل، وخاصة المسائل الواقعة، ويعرف كيفية استدلالهم والأصول العامة التي يراعونها، وعليه أن يطلع على المؤلفات التي تبرز القواعد الفقهية التي تضم شتات المسائل الفرعية ليعلم الاتجاهات العامة للتشريع، ولئلا يشذ في استنباطاته عن القياس.
تقليد المجتهد لمذاهب الغير
إذا اجتهد العالم المؤهل للاجتهاد في مسألة وتوصل إلى حكم فيها، فليس له تقليد غيره ممن يخالفه القول في تلك المسألة.
أما إن لم يجتهد فإن لم يكن لديه متسع من الوقت قبل العمل فله أن يقلد غيره، وإن كان لديه متسع من الوقت فقد قيل يجوز له التقليد.
والأوْلى أن يقال في الحالة الأخيرة: ليس له أن يقلد غيره مهما علا مقام ذلك الغير، بل عليه أن يستعين بالله ويستمد منه التوفيق ويحاول الوصول إلى مطلوبه من الدلائل على الحق التي بثها الله في كتابه وسنة نبيه، لتكون منارًا للحق يهتدي بها في الظلمات. وإن قلد وهو قادر على الوصول إلى الحق بنفسه دون أن يكون عليه في ذلك ضيق وحرج فقد أخطأ، فإن ضمَّ إلى ذلك التعصب لإمام معين لا يقبل إلا قوله ولا يتبع إلا مذهبه فقد حرم نفسه خيرًا كثيرًا، وما من أحد لا يصيب ويخطئ. فإن ضم إلى ذلك نهْي غيره عن الاجتهاد وألزمهم بالتقليد والتعصب لمن يقلدهم، كان ممن يدعو الناس إلى الضلال عن الهدى وإلى إلغاء عقولهم التي وهبهم الله، ويحول بينهم وبين فهم كتاب الله وسنة نبيه.
بالإضافة إلى أن هذه الدعوة تفرق جماعة المسلمين وتجعلهم كمن قال الله فيهم:
﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ (سورة المؤمنون: الآية: 53).
وضم البعض إلى ذلك سوء آخر، فزعم أن الاجتهاد أقفل بابه، وهذا سوء ظن بالله تعالى.
الاجتهاد الجماعي:
إن كثيرًا من المسائل التي تحدث ولم تكن معروفة من قبل، تتجدد -كما قلت- باستمرار ما بقيت الحياة؛ وذلك كنقل الدم للعلاج والتلقيح الصناعي وزرع الأعضاء ومواقيت الصلاة والصوم في المناطق القطبية ورحلات الطيران السريع الذي يسبق -أو يساوي- دورة الأرض ورحلات الفضاء، فهذه الأمور التي تمس أحكامها الكافة ينبغي أن يكون النظر الاجتهادي فيها جماعيًّا لتكون حصيلته أدعى إلى الثقة العامة به، وليكون أبعد عن اتباع الهوى والاحتطاب في حبال أصحاب الجاه والمال والمناصب.
والواجب على علماء الملة أن يجعلوا اعتمادهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم ينهلون من منبعيهما الصافيين، ويسترشدون لفهمهما والاستنباط منهما بطرق من سبقوهم من الأئمة في الاستنباط، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
الطريق العملي للوصول إلى الحكم:
على المجتهد أولًا أن ينظر في آيات كتاب الله، فإن وجد نصًّا صريحًا غير منسوخ وليس له مُعارض، فعليه أن يعمل به.
فإن لم يجد نظر في السنة كذلك.
ثم ينظر، فإن كان النص عامًّا وفي الكتاب أو السُنة أخص منه أو ظاهرًا، وفي الكتاب أو السُنة ما يدل على تأويله أو مجملًا وفيهما ما يبينه، فعليه أن يأخذ بذلك.
ثم ينظر الإجماع، فإن لم يجد من ذلك شيئًا قاسَ الأمر المسؤول عنه على ما يساويه في العلة مع ملاحظة القواعد الكلية. فإن لم يجد نصًّا يقيس عليه، جاز له أن يحكم بما يراه محققًا للمصلحة ودارئًا للمفسدة حسب القواعد المقررة لذلك.
التقليد:
التقليد قبول قول الغير من غير معرفة بدليله، فليس عمل الإنسان بناءً على ما فهمه من آية من كتاب الله تقليدًا، ولا العمل بالحديث كذلك تقليد ولا بالإجماع.
وقد اختلف الأئمة في حكم التقليد على ثلاثة أقوال:
1- فبعضهم حرمه.
2- وبعضهم أوجبه.
3- وبعضهم أوجب الاجتهاد عند إمكانه وأجاز التقليد عند تعذر الاجتهاد أو تعسره. فقالوا إن العامي الذي لا قدرة له على الاجتهاد فرضه التقليد، والذي شدَا طرفًا من العلم ولم تتحصل له شروط الاجتهاد يقلد، والذي تحصلت له آلة الاجتهاد وشروطه وضاق وقته عن الاجتهاد يجوز له التقليد، والذي حصل له بعض الشروط دون بعض كمن حصل آلة الفهم ولم يحصل معرفة طرق ثبوت الحديث يقلد في الثبوت ويجتهد في الدلالة.
والشوكاني ممن رأى تحريم التقليد، ولكنه أثبت واسطة بين الاجتهاد والتقليد سماها «الاتِّباع» ومعناها أن من لا يعلم ولا يستطيع الوصول إلى العلم بنفسه يسأل العالم، ولكنه لا ينبغي أن يسأله عن رأيه واجتهاده، وإنما يسأله عن الأدلة التي يعرفها من الكتاب والسُنة ليذكر لغير العالم فيعمل بها.
قال: «والحاصل أنه لم يأت من جوَّز التقليد فضلًا عمن أوجبه، ينبغي الاشتغال بجوابها قط». ثم قال: «وأما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغًا للتقليد، فليس الأمر كما ذكروه، فها هنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد وهي سؤال الجاهل العالم عن رأيه فيما يعرض له لا عن رأيه البحث واجتهاده المحض».
وعندي أن أقول بعدم جواز التقليد غلو وإفراط وإنكار للبديهيات؛ فلن يجد كل المسلمين الوقت الكافي والقدرة التامة لإثبات الأدلة الشرعية بالنقول الموثقة ثم الاجتهاد في دلالاتها وخاصة عند التعارض أو إخفاء الدلالات، ومن قال إن بإمكانهم ذلك فإن قوله دعوى يكذبها الواقع.
ومن جهة أخرى لا نرى حجة مع موجبي التقليد على كل أحد حتى على العلماء وقفل باب الاجتهاد والإلزام بالتعصب المذهبي.
وأوْلى الأقوال عندي بالصواب هو القول الثالث الذي ذكرناه آنفًا مع الاسترشاد بما ذكره الشوكاني في مسألة «الاتباع»، فعلى المفتي والمجتهد إذا بين الأحكام أن يبينها مقرونة بالنقول القريبة من إفهام العامة، مع الإشارة إلى وجه استخراج الحكم منها، مع العلم أن ذلك لا يخرجهم عن حيز التقليد، ولكن هو أهل أن يفتح لهم باب فهم الكتاب والسُنة شيئًا فشيئًا ويدلهم على كيفية الوصول إلى النقول وكيفية الفهم فيها، لتتربى لديهم القدرة على الإدراك السليم لأحكامها ومراميها.
وما نقل عن الأئمة الأربعة وكثير غيرهم من علماء الأمة مثل قولهم: «لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا الشافعي وخذ من حيث أخذوا». محمله على إنهم قالوا ذلك لتلاميذهم المؤهلين يحثونهم بذلك على عمل هم عليه قادرون، وليس قولهم ذلك موجهًا إلى العوام العجزة عنه، ولكن يستفاد من فحواه إرشاد العوام إلى سلوك طريق التفهم للكتاب والسُنة شيئًا فشيئًا، وإن كانوا لا يستقلون بإدراك الأحكام الاجتهادية في حال عجزهم.. والله أعلم.
ما على المقلد أن يفعله:
إذا وقعت للمقلد واقعة، فعليه أن يتجه إلى أهل العلم المعروفين بالدين والعدالة فيسألهم عن العلماء بالكتاب والسنة، العارفين بما فيهما، المستكملين لآلة الاجتهاد، فإذا دل على هؤلاء سألهم عما عندهم من الأدلة الواردة في مسألته، فإن كان فيها نصوص صريحة غير محتملة تنطبق على مسألته انطباقًا واضحًا أخبروه بها وكانت هي جوابه، وإن كان فيها احتمال أو تعارض ظاهر أو لم يكن في المسألة نقول طلب منهم أن يخبروه باجتهادهم فيها.
فإذا أخبروه واطمأن قلبه إلى عملهم وصدقهم ونصحهم فعليه أن يعمل بذلك.
وإن اختلفت عليه أقوال المجتهدين وجب عليه اتباع أوثقهم في نفسه إذا اطمأن قلبه إلى قولهم.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل