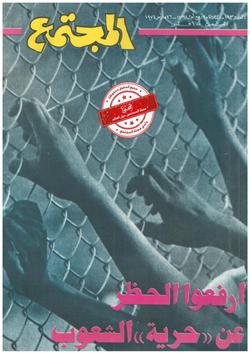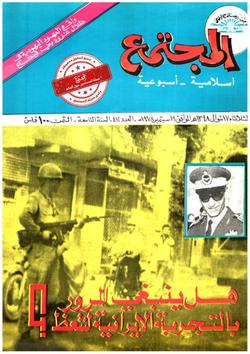العنوان التصوف والسياسة.. علاقة وجودية
الكاتب د. محمد يتيم
تاريخ النشر السبت 26-أبريل-2008
مشاهدات 22
نشر في العدد 1799
نشر في الصفحة 66

السبت 26-أبريل-2008
إذا كان من المفهوم منهجيًا التمييز بين الشريعة والحقيقة باعتبارهما مجالًا لبحثين متخصصين أملى ظهورهما تطور العلوم الإسلامية والحاجة المتزايدة إلى التخصص، فإن من الأخطاء التاريخية تطور بعضهما في انفصال عن البعض الآخر؛ بل أحيانا في نزاع وتشاكس بينهما.
لكن التاريخ يشهد رغم ذلك أن التصوف في صورته السنية «الجنيدية»، قد سعى إلى ردم هذه الهوة بين المطلبين؛ إذ زاوج بين مفهوم «الرباط الروحي التربوي» ومفهوم «الرباط السياسي»، أي الانخراط في هموم الأمة، وحماية الثغور والسير في مصالح الخلق والوطن.
صحيح أن «الكمال الإنساني» الذي يطلبه «المتصوف» عزيز المنال، ولكن إذا لم يتحقق الكمال المذكور، فإن «ما لا يدرك كله، لا يترك جله»، فتهذيب النفس مبتدأ واستمرارًا، وتهذيبها على الدوام حتى «يأتي اليقين»، مطلب لا غنى عنه لمن يسعى في خدمة مصالح الأمة.
وسوف نبين العلاقة الوجودية الضرورية بين التجربتين: الصوفية والسياسية.
وأقصد بالتصوف المعنى الاصطلاحي الذي ظهر عند علماء الأمة، والمقصود به: علم السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، أي ذلك العمل التربوي الذي يعتكف فيه الإنسان من أجل إصلاح نفسه؛ تخلية لها من كل «خلق دني»، وتحلية لها بكل «خلق سني»، إما بتجربة خاصة أو بمساعدة «شيخ»، أو «مرشد»، أو «مرب»، ويرجع إلى التجربة النبوية في السلوك إلى الله -عز وجل-، ولا يضيف عليها في جانب التعبد الذي أصله الاتباع شيئا في المقدار والكيفية.
أما السياسة فمعناها: الانتصاب لخدمة الغير والسير في مصالح المسلمين، وإدارة الشأن العام، والتماس المصالح لهم، ودفع المفاسد عنهم سواء كانت المصالح المذكورة قد نص عليها صراحة في الشرع أم كانت تحتاج إلى اجتهاد وإعمال للعقل من أجل استخراجها؛ لأنه كما قال ابن القيم: «أينما كانت المصلحة فثم شرع الله -عز وجل-، غير أن المصلحة كما هو مبين عند الأصوليين منضبطة بعدة ضوابط، مبناها على ألا تكون متعارضة مع نص شرعي «قطعي الدلالة قطعي الثبوت» وأن تكون المصلحة معتبرة لا أن تكون وهمية، وأن تكون منضبطة بمقاصد الشريعة لا بأهواء النفوس وشهواتها. والسياسة بهذا المعنى الشرعي تختلف عن السياسة بمعناها الوضعي الذي نظر له «ميكيافيللي» «الغاية تبرر الوسيلة».
والداخل في السياسة دون تجربة تزكية كالداخل إلى ظلمات بحر لجي، ذلك أن السياسة متلبسة بالسلطة، والسلطة مدعاة للاستكبار والاستبداد والطغيان؛ إذ هي باب الوجاهة ومنبرها الظاهر، والوجاهة وحسن الذكر في الناس والحكم والتحكم من أعظم الشهوات الخفية التي لا يسلم منها الخلق، وهذه حقيقة كونية وجودية، وهي غريزة متأصلة، ولولاها لما انتصب قائم إلى الولاية العامة وخدمة مصالح الناس، تماما كما أنه لولا غريزة الجنس وحب النساء لما تحمل الناس تبعات النسل، ولولا شهوة المال لما انتصب إنسان لعمارة الأرض وسخر بعضهم لبعض.
السياسة إذن من أهم مجالات التحقق بأعلى درجات الترقي في مراتب «الفناء»، وإنكار الذات والانتصار على حظوظ النفس والتحقق بكل خلق «سني» والتخلص من كل «خلق دني»، ولا يزعم زاعم تحققًا بذلك دون أن يختبر بجاه أو مال أو سلطان، أي بدون مكابدة تلك الشهوات، وقد تكلم الصوفية عن خلوة مع المخالطة، وعن أنس بالحق سبحانه وتعالى في غمرة اتصال بالخلق .
السياسة بهذا المعنى هي المجال العملي لاختبار ما حققته تجربة التزكية من خلال الذكر والتبتل وصحبة الصالحين، إنها محك لاختبار حقيقة التجربة «الصوفية»، أو «التربوية» التي تلقاها السالك إلى الله -سبحانه وتعالى-.
ولعل البعض قد يذهب إلى أن الحل هو ترك السياسة والانقطاع إلى التصوف حفاظًا على نقائه وصفائه من السياسة أن تكدره، وهو مذهب ينكره الراسخون في التجربة الصوفية والسالكون على الطريقة السنية «الجنيدية»، ويرون تمام التحقق في معانقة الحق -سبحانه وتعالى- مع مخالطة الخلق؛ لأن تلك كانت طريقة رسول الله ﷺ .
وشبيه بهذا الموقف وقريب منه، ما يذهب إليه البعض «عن حسن نية»، من ضرورة الفصل بين الدين والسياسة، بين التجربة الصوفية والممارسة السياسية على اعتبار أن الدين هو مجال «المطلق» و «السياسية» هي مجال النسبي، وهو قول ليس صحيحًا على إطلاقه، فلا السياسية تستقيم بمنأى عن «الثوابت»، و «المطلقات»، وعن الأخلاق والقيم، ولا الدين كله عبارة عن مطلقات وثوابت، إذ فيه قطعيات وظنيات، ومحكمات، ومتشابهات، ومنطقة فراغ تشريعي، أو منطقة «عفو» كما ورد في الحديث النبوي، تركت للاجتهاد البشري؛ ولذلك فالدين أصول، وفروع، شريعة، وفقه، عقيدة وحضارة، نص، ومقاصد، وتاريخ وثقافة، أخلاق ونظام، تربية وتصوف وسياسة وجهاد .
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل