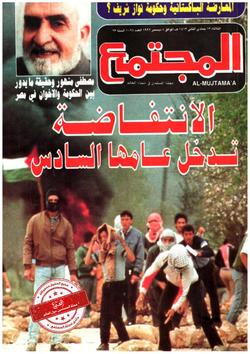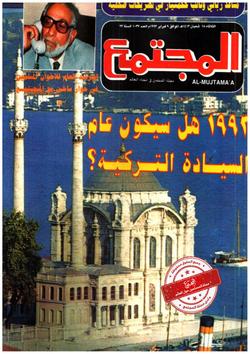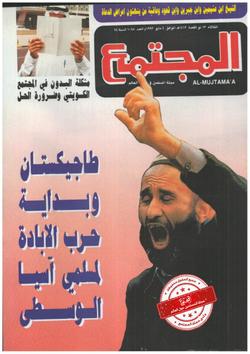العنوان المجتمع التربوي: المجتمع (1042)
الكاتب د.عبدالحميد البلالي
تاريخ النشر الثلاثاء 16-مارس-1993
مشاهدات 10
نشر في العدد 1042
نشر في الصفحة 44
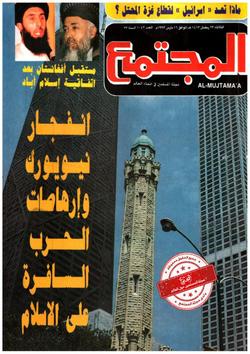
الثلاثاء 16-مارس-1993
وقفة تربوية
اعتزال أو اختراق (٢)
إن أبرز ما يغضب الله -تعالى- بتركنا اختراق المجتمع.
(۱) إن أصحاب الأهواء، والأعداء التقليديين للدعاة هم الذين يحتكون بطبقات المجتمع، ومن ثم فهم الذين يؤثرون فيهم، وخاصة في أصحاب النفوذ والقرار في البلد.
(۲) وهؤلاء الخصوم الذين سيختارون الصورة التي يرسمون فيها لتقديمها لأصحاب النفوذ والقرار، سواء كانت هذه الصورة هي التطرف، أو الجمود، أو الإرهاب، أو العمالة لدولة أخرى، أو الإخلال بالأمن، أو نية قلب النظام وغيرها من الصور، والتي عادة يرسمها أولئك الخصوم المخترقون لشرائح المجتمع، بعد أن تخلى الدعاة طواعية عن الاختراق.
ولا بد للدعاة أن يتذكروا بأن الاختراق أمر أمرنا به الله تعالى، وهو الشغل الشاغل الذي كان يشغل الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- كما أن الدعاة لا بد أن يتوقعوا تلك الخسائر التي توقعوها، ولكن ليس معنى ذلك أن نتخلى عما أمرنا به الله تعالى، وإلا فمن للناس غيرنا؟ وماذا سنقول لربنا يوم القيامة؟ ولا بد أن ننتبه عند الاختراق الذي لا بد منه للدعاة لأمور منها:
1 – التذكر أن هذا الاختراق إنما نبتغي به وجه الله تعالى، وليس حظًا من حظوظ النفس، وتجديد النية لذلك دائمًا.
٢ – الإلحاح بالدعاء بالحفظ والثبات قبل وأثناء وبعد الاختراق باستمرار؛ لأنه هو -سبحانه- مالك القلوب، وهو الذي يتصرف بها، فمن يثبت قلوبنا غير مالكها.
٣- زيادة القربات لله -تعالى-، وخاصة قراءة القرآن والصيام والقيام وعدم التنازل عن ذلك لأي ظرف من الظروف؛ وذلك لأنها جزء رئيسي من الوقود الإيماني الذي يحتاجه الداعية أثناء الاختراق.
٤ – محاسبة النفس بعد كل اختراق وحساب الربح من الخسارة محاسبة دقيقة لتجنب أسباب الخسارة في المرات القادمة.
ونسأل الله -تعالى- أن يحفظ الجميع من السقوط.
أبو بلال.
تأملات في السيرة:
بقلم المستشار مصطفى الشقيري.
في الأوقات العصيبة وفي فترات المحن والشدائد تظهر أقدار الرجال، وتبرز خصائصهم النفسية، ويظهر ما كان مخبوءًا في حنايا الصدور، ويعرفون من أي معدن هم، أهم من ذلك النوع الهش الذي لا يثبت في موقف، ولا يصبر على ملمة، ولا يقوى على تبعات الرجولة ومغارمها، وتطير نفسه شعاعًا وتتهاوى تحت مطارق المحن، وتعتصرها آلام الشدائد، وتعصف بها رياح الفتن؟ أم أنهم من نوع المعادن النفيسة التي لا يزيدها لهب النيران إلا بريقًا ولمعانًا، وينفي خبثها، ويذهب بما علق بها من أوحال الأرض وشوائبها، فتخرج من المحن أصلب عودًا وأقوى شكيمة.
كما تتجلى في الشدائد والمحن المواهب الفذة للقادة والزعماء، وهم يعالجون الأزمات، وكم من أمة هوت وانتكست خلال المحن؛ لأنها رزئت بقادة كل مؤهلاتهم للقيادة هي النزق، والطيش، والحماقة، لكنهم غلفوا هذه الخصائص الدنيئة بصيحات عنترية كاذبة وطنطنات جوفاء، صنعها إعلام فاجر، فلما جد الجد انكشفت الحقائق، وظهر المخبوء، وإذا بمن كانوا أسودًا أو شئت قلت من استأسدوا، إذا بهم نعامات تجيد العدو والفرار، وإن شئت قلت أسودًا من دمى صنعها كتاب، وأدباء، وشعراء، وفنانون.
كذلك تجد أصنافًا من الناس يعيشون في دنيا الناس مغمورين لا يعرف لهم فضل، ولا يمتازون بموهبة تسلكهم في عداد العظماء، وأصحاب المواهب، وقد تنطوي نفوسهم على طاقات كامنة ومواهب متعددة، وهم لا يشعرون كل ذلك أنت واجده في سيرة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- وفي سيرة أصحابه الأخيار.
فبين يدي الرسول -صلى الله عليه وسلم- وفي غزوة حنين؛ حيث أسفرت هذه المعركة عن نصر مؤزر للمسلمين، وهزيمة نكراء لقوى الشرك والضلال، وخلف المنهزمون في ميدان المعركة (٢٤٠٠٠) ألفًا من الإبل، وأكثر من أربعين ألف شاة، وأربعة آلاف أوقية من الفضة، وستة آلاف من السبي، وكانت كلها لهوازن، ولم يتعجل الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- قسمة السبي عسى أن يأتوا مسلمين فيرد عليهم ما غنمه المسلمون.
وبعد بضع عشرة ليلة بدأ بتوزيع وقسمة الأموال، وهنا تجلت حكمة الرسول، ونظرته الثاقبة، وحسن تدبيره أن أمامه أصنافًا من الشر تتطلع نفوسهم إلى هذا المال بشراهة منقطعة النظير، وهم حديثو العهد بالإسلام ودعوته، ويريد لهم أن يثبتوا على دينهم لعل نفوسهم تسمو فيما بعد، وترقى إلى مستوى الإسلام وآفاقه العالية، ويكونون للدعوة خير جند وأعوانًا، فأعطى أبا سفيان مائة من الإبل، وأربعين أوقية من الفضة، ومثليها لابنيه معاوية، ویزید.
ويتجمع طلاب الدنيا حول الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويزاحمون حتى ألجئوه إلى شجرة انتزعت رداءه، وهنا ينطق الرسول بكلمات كلها تجرد وزهد أنه داعية حق، لا يبغى عليه أجرًا «أيها الناس ردوا على ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان لكم عندي عدد شجر تهامة نعمًا لقسمت عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلًا ولا جبانًا ولا كذابًا» ثم أخذ وبرة من سنام بعير ثم دفعها بين إصبعيه وقال: «أيها الناس والله مالي من فينكم، ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم» (حديث صحيح رواه أحمد والبيهقي والبخاري).
كما أعطى بعض المشركين من غنائم حنين الشيء الكثير، ومن هؤلاء صفوان بن أمية حتى قال مازال رسول الله يعطيني من غنائم حنين وهو أبغض الخلق إليَّ حتى ما خلق الله شيئًا أحب إليَّ منه (رواه مسلم).
يا لها من حكمة بارعة، وسياسة رشيدة في التعامل مع الأحداث سرعان ما تظهر نتائجها فيتحول القلب المبغض للدعوة والداعية وليس شيئًا على وجه الأرض أبغض إليه منهما- يتحول بحكمة الداعية هذا التحول العظيم وما من شيء أحب إليه من محمد -صلى الله عليه وسلم- ودعوته.
ويظل الرسول يعالج الآثار التي نجمت عن توزيع الغنائم على النحو الذي فعله الرسول -صلى الله عليه وسلم- وما كان فيه شيء إلا الحكمة وحسن التدبير، وإن خفي ذلك على بعض قصار النظر في بادئ الأمر.
روى البخاري عن عمرو بن تغلب قال أعطى رسول الله قومًا ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه فقال: إني أعطي قومًا أخاف هلعهم وجزعهم، وأكل قومًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير، منهم (عمرو بن تغلب) قال عمرو فما أحب إلي بكلمة رسول الله حمر النعم.
إن الأمر ليس إعطاء هذا أو حرمان ذاك، إن صاحب الدعوة أوتي بصرًا ثاقبًا وإدراكًا جيدًا لطبائع البيئة المحيطة به، وما جبل عليه الناس فمنهم من يرجح في نظره رضوان الله وكلمة حانية ولفظة رقيقة من الرسول الكريم على أموال الدنيا وكنوزها، أمثال عمرو بن تغلب، ومنهم لا يصلح شأنه إلا أن ينال من حظ الدنيا ما يصلح به شئونه المعاشية، فكان لكلٍ معاملة، ولكلٍ سياسة، وما أجمل قول الشيخ محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة «إن في الدنيا أقوامًا كثيرين يقادون إلى الحق من بطونهم، لا من عقولهم، فكما تهدي الدواب إلى طريقها بحزمة برسيم تظل تمد إليها فمها حتى تدخل حظيرتها آمنة، فكذلك هذه الأصناف من البشر تحتاج إلى فنون من الإغراء حتى تستأنس بالإيمان وتهش له».
ومن خلال توزيع الغنائم يظهر معدن الأنصار النبيل، وتتجلى سجاياهم الكريمة، فلقد فوجئوا بالرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- يؤثر سائر العرب عليهم، ويخصهم بغنائم حنين، ويمنع منها الأنصار وهم من هم في حسن البلاء في سبيل الدعوة والداعية إيثارًا، وبذلك وتضحية وفداء، أو ليس هم الذين أمنوا الدعوة والداعية من خوف، وفتحوا لها صدورهم وقلوبهم إيمانًا وتصديقًا وبراء ووفاء، وفتحوا لها ديارهم إكرامًا وإيثارًا؟ فكيف يمنعون رفدها وعطاياها المادية؟ فكأن في نفسهم شيئًا من حرمانهم من غنائم حنين، لكن الرسول الكريم كان يعرف أن قدر الأنصار ومكانتهم وحسن بلائهم أكبر بكثير من أن يكافئوا عليها بشاة أو بعير، ولا يوزن بعرض زائل من أعراض هذه الدنيا.
ومع صاحب الدعوة سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- في حديثه العذب عن الأنصار، وقدر الأنصار عن أبي سعيد الخدري لما أصاب رسول الله الغنائم يوم حنين، وقسم للمتآلفين من قريش وسائر العرب ما قسم، ولم يكن في الأنصار شيء منها قليل ولا كثير، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى قال قائلهم: لقى والله رسول الله قومه، فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار وجدوا عليك في أنفسهم قال فيم؟ قال فيما كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب، ولم يكن فيهم من ذلك شيء.
قال رسول الله: «فأين أنت من ذلك يا سعد؟، قال ما أنا إلا امرؤ من قومي، فقال رسول الله أجمع لي قومك في هذه الحظيرة» فإن اجتمعوا فأعلمني.
فخرج سعد فصرخ فيهم فجمعهم في تلك الحظيرة، حتى إذا لم يبق من الأنصار أحد إلا اجتمع له أتاه فقال يا رسول الله اجتمع لك هذا الحي من الأنصار حيث أمرتني أن أجمعهم، فخرج رسول الله، فقام فيهم خطيبًا فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالًا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم، قالوا بلى، قال رسول الله ألا تجيبون يا معشر الأنصار.
قالوا وما نقول يا رسول الله؟ وبماذا نجيبك؟ المن لله ورسوله، قال والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، جئتنا طريدًا فأويناك، وعائلًا فآسيناك، وخائفًا فأمناك، ومخذولًا فنصرناك فقالوا: المن لله ورسوله.
فقال: أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لهاعة من الدنيا تآلفت بها قومًا أسلموا، ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير، وتذهبون برسول الله إلى رحالكم.
فوالذي نفسي بيده، لو أن الناس سلكوا شعبًا، وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار، اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار.
فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا رضينا بالله ربًا ورسوله قسمًا،
ثم انصرف وتفرقوا (صحيح البخاري وصحيح مسلم).
أي شرف عظيم هذا الذي حازه الأنصار وأبوا به؟ وأي مجد هذا الذي ضمه الأنصار إليهم؟ تتضاءل أمامه كل كنوز الأرض؛ إنه صاحب الرسالة محمد -صلى الله عليه وسلم-، والدعاء بالرحمة لهم ولذراريهم، لقد أذابت حرارة الكلمات النبوية الدافئة ما علق بنفوسهم من توزيع الغنائم، وظهر معدنهم النبيل، وبرزت خصالهم الكريمة وسجاياهم الطيبة، وأنهم على العهد ثابتون، وعلى الوفاء للدعوة باقون، لا يغيرهم مغنم يحرمون منه بعد أن منحوا رضوان الله، ورجعوا بالرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- ويا نعم ما رجعوا به، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.
خواطر في شهر رمضان الكريم
بقلم يمن محمد عبد الرحمن المنلا-
المدينة المنورة – السعودية
- إلى الله.
يهزنا الشوق والحنين -ونحن نعيش رمضان- إلى العودة الصادقة إلى الله، نشتاق لأن نعيش بالقلب الطاهر، والأخلاق النبيلة الرفيعة بعيدًا عن الموت الروحي والاخلاقي البطيء الحياة، نشتاق لأن نحطم القيود التي تكبل فكرنا وقولنا، نشتاق كثيرًا للعيش في خلال هذه المعاني لأن ما نحققه منها، في حياتنا قليل جدًا؛ لذ إن العودة إلى الله لن تتحقق بتلك العواطف والوجدانات الملتهبة فحسب، ولكن بإخلاص العمل لله، والرجوع إليه في كل صغيرة وكبيرة.
إن العودة الصادقة إلى الله سوف تجلي حواسنا وقدراتنا، وتفجر منابع الطاقة والعمل فينا من جديد، هذا فضلًا عن أنها ستعيد إلينا الإنسانية التي افتقدناها زمنًا طويلًا، يجب أن تتفكر جيدًا في قوله -تعالى-: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ (سورة القصص: 77) لتعرف أن العودة إلى الله هي أبعد ما نكون عن الرهبانية والتبتل، ومما قد يتبادر إلى الأذهان ما هو فوق القدرة والاستطاعة.
كما يجب أن نتوقف طويلًا في هذا الشهر الكريم عند قوله -تعالى- ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ (سورة طه: 82).
(۲) هل تتحقق المعاني التربوية في صيامنا؟
لم يعد يخفى علينا أن العبادات التي نمارسها لا تثمر السلوك الرفيع، ولا القلب الطاهر، ولا النفس التي تسعى إلى مدارج الرقي والكمال؛ لأن هذه العبادات تحولت بمرور الوقت إلى نمط من السلوك، لا روح فيه ولا قلب ولا حياة، من هنا نستطيع أن نتبين لماذا لا نحقق اليوم البطولات الرائعة التي قام بها الأوائل؛ حيث امتدت الفتوحات ليدخل الإسلام، ويقتطع أعظم الممالك والقوى التي عرفها التاريخ، ومن هنا نستطيع أن ندرك سبب ضعفنا وهواننا اليوم.
إن ما كلفنا به من العبادات لا يختلف عن ما كلف به المجتمع الأول في صدر الإسلام، ولكن الذي اختلف وتغير هو الدافع الروحي لتلك العبادة، فهناك فرق بين من يعبد الله بقلبه وروحه، وهو ساجد الضمير لله، وبين من يؤدي سلوكًا ينبغي القيام به من غير أي واقع إيماني، إن تلك العبادة ترتقي بالفرد، وتزلزل الجاهلية إن وجدت، وهذه تجمده وتصيبه بالخواء.
إن هذا الشهر الكريم يجب أن يكون ترويضًا لأنفسنا على السلوك والقول المستقيم، كما يجب أن تعمق واجباته وسنته الهوة في حسنا بيننا وبين الجاهلية التي لا تعرف الله على آية صورة من الصور، وتعمق فينا أيضًا شعور قوة الانتماء إلى الإسلام دين الأخلاق والضمير، والإنسانية، والرحمة، والتعاون.
يجب أن نعرف جيدًا أن الله غني عن صيامنا إذا كان امتناعًا عن الطعام والشراب فحسب، ولم يكن تربية لذاتنا وجوارحنا وضميرنا الإنساني، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا؛ إنك سميع الدعاء.
لكل مقام مقال:
بقلم: بشار العلي.
طيلة فترة وجودي على مقاعد الدراسة ومخالطتي لمصادر العلم والمعرفة- كثيرًا ما كنت أعجب بالحكم والأمثال التي يحفل بها تراث أمتنا الأدبي، وأكثرها يحفظه الصغير والكبير، ويتداوله الجاهل والعالم والمتعلم، فكنت أسمع حكمة من هنا، وعبرة من هناك يلقيها هذا، أو يتندر بها ذاك، أو أمر عليها في تلك الصحيفة، أو ذلك الكتاب، حكم كثيرة وأمثال عديدة تمس أكثر جوانب الحياة، حتى أنك قد لا تجد صغيرة ولا كبيرة إلا وقيل فيها ما يناسبها.
ومن تلك الحكم التي تعودتها مسامعنا ورددتها ألسنتنا قول القائل: «لكل مقام مقال».
هذه الحكمة التي يعرفها أهل العلم، ويحفظها طلابه كنت قد حفظتها، وعرفت معناها المجرد، كما يعرفه غيري إلا أنني لم أتعرف إلى حقيقة ما تعنيه، وأهمية ما ترمي إليه، حتى بضعة أيام خلت، وذلك عندما أجبت دعوة لحضور وليمة زفاف أحد الإخوة؛ حيث تجمع ما يربو على الخمسين من أقاربه وأصحابه للدعاء له بالبركة والمشاركة في الوليمة.
وبعد السلام عليه، والدعاء له قعدنا ننتظر طلائع الطعام، وكان لسان حال الحاضرين يقول إن بطونهم الفارغة ونفوسهم المتحفزة لا تروم في هذه اللحظات سوى وصول أطباق الطعام والانقضاض عليها لالتهام ما فيها.
وبينما نحن كذلك أن علا صوت من بين الحضور، ينبه الجمع المتحفز إلى أن أحد الإخوة سيقوم بإلقاء كلمة، فاعتدل الحاضرون، وجلسوا منصتين، وبدأ الخطيب بتلاوة مقدمة خطبة النكاح بطلاقة وفصاحة، وهذا من سنة الهادي -عليه الصلاة والسلام- وهديه في مثل هذه المقامات، إلا أنه لم يكد ينهي مقدمته، حتى بدأ بالكلام عن أهمية الأخذ بالنصوص، وضرورة التحاكم إليها، وخطورة التعصب لشيخ أو مذهب، وهذا كلام جيد، ولكنه أخذ في التوسع والاطراد، حتى تنوعت مواضيع الخطبة، وتشعبت فتكلم عن التيمم وصيغته، وذكر خلافًا للصحابة حول مشروعيته، معرجًا على موضوع النزاع بين علي ومعاوية، وصولًا إلى مشاكل الحركات الإسلامية وخلافاتها، مبديًا مأخذه عليها، حتى أنه روى حديثًا -واحدًا على الأقل- بإسناده، فيما أذكر.
- هذا كله، والحاضرون يبتهلون -في أنفسهم- إلى الله أن يخفف عنهم، وينهي هذا الخطيب المتحمس خطبته، فالسفرة مدت، وأطباق الطعام وضعت، وعدة الأكل جهزت، وأما العريس المسكين، فكان يتعامل ويترقب ويتحرق، وربما حدثته نفسه بالقيام ومغادرة المجلس.
إلا أن أحد الحاضرين تجرأ وأنقذ الموقف مشيرًا إلى الخطيب أن أوجز فانتبه هذا إلى نفسه، واعتذر عن الإطالة، مذكرًا بأهمية الموضوع وحساسيته، ثم تنحى مفسحًا المجال أمام الحاضرين لالتهام الطعام المعدود بين أيديهم بعد طول انتظار.
- وكم تمنيت تلك الليلة، لو أن ذلك الخطيب كان يعلم من آداب الخطابة الحكمة التي تقول، ولكل مقام مقال، فيلقي من المقال ما يناسب المقام بتخفيف وإيجاز، ويذكر بأهمية الزواج ومحاسنه، وينصح المقبل على الزواج بطيب المعشر، وحسن الخلق، والتأسي بنهج النبي -عليه الصلاة والسلام- في معاملته لأزواجه، وهو القائل: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، ثم يحض العزاب على الزواج، ويذكر من الأحاديث الواردة في هذا الشأن ما يتيسر، فهذا مما يوافق الحال، ويقتضيه المقام، وأما الذي تطرق إليه الخطيب، فهو حسن في مقام يناسبه، ويحمد عليه، وأما في مثل مقامنا ذاك، فلن يحصد مثل هذا الخطيب سوى الدم.
فليتق الله خطباؤنا ووعاظنا، وليقتدوا بخير الخطباء -عليه الصلاة والسلام- فيعطوا كل مقام حقه من المقال، وإلا فليذروا.
عجبًا لمكروب:
وروي عن الحسن البصري التابعي الجليل أنه قال: عجبًا لمكروب غفل عن خمس، وقد عرف ما جعل الله لمن قالهن.
۱ – قوله -تعالى-: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ (سورة البقرة ١٥٠ – ١٥٧).
۲ – قوله -تعالى-: ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا﴾ (سورة آل عمران: ۱۷۳).
٣- وقوله -تعالى-: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة الأنبياء: 86-88).
٥- وقوله: ﴿وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين﴾ (آل عمران: ١٤٧– ١٤٨).
قال الحسن البصري: من لزم قراءة هذه الآيات في الشدائد كشفها الله عنه؛ لأنه قد وعد، وحكم فيهن بما جعله لمن قالهن، وحكمه لا يبطل ووعده لا يخلف.
أحمد السبيعي.
أخلاقيات الصحوة الواقع والأمل
بقلم: عادل أحمد بابطين
- ينبع - المملكة العربية السعودية.
الصحوة الإسلامية المباركة التي تعيشها المجتمعات المسلمة حققت ولا تزال تحقق - بحمد الله – تقدمًا كميًا ونوعيًا، فقد استوعبت الأساتذة الجامعيين، والأطباء، والمهندسين، والمدراء التنفيذيين، وأعدادًا غفيرة من الجماهير، ومع المحاولات المستديمة التي تباشرها جهات متعددة لتشويه صورة المنتسبين لهذه الصحوة، إلا أن ممارسة أتباعها لكثير من الأنماط والسلوكيات المتحضرة يدحض تلك الادعاءات، ويمكن أن تمثل لتلك السلوكيات بما يأتي:
١ – حب العمل والإنتاج: فلا يزال الإسلاميون والذين يعنيهم مصير الأمة ومستقبلها، يتألمون من واقع المسلمين وتخلفهم عن غيرهم من أمم العالم، فأكثر المسلمين يقطعون أوقاتهم بعيدًا عن الإبداع والإنتاج، والعجيب أن مؤسساتنا الرسمية لم تحقق نجاحًا في نقل إبداع الغرب وأستاذيته إلا في فنونه الموسيقية، وحفلاته وأعياده، وأصناف مشروباته وملبوساته، ودقيق عاداته.
وكأن الغرب لم يفرض احترامه، ويبسط نفوذه إلا بتلك الفنون والعادات، وهذا من الخلط الذي تمارسه تلك المؤسسات بدعم معنوي من الغرب في هذه المتاهات، ومع انشغال شعوب الأمة عن غاياتها وقضاياها المصيرية يقف الإسلاميون ليشخصوا أحد أدواء الأمة، ويباشروا العمل لعلاجها.
٢ – التعلق بالمبادئ واحترامها: فهذا ليس من التعصب، بل من بعد النظر وتبني الأهداف الإستراتيجية، فإن وضوح الأهداف يجعل المنتسبين للصحوة يتبنون الوسائل المشروعة والفعالة للوصول إلى غاياتهم بأيسر السبل، كما يقيهم الانحراف عن أهدافهم، وفوق ذلك فإن المبادئ هي المظلة التي تجمعهم، وهذا كله خير من البراجماتية أو النفعية؛ حيث لا ثوابت، وحيث إن المصالح متغيرة وغير ثابتة، فإن البراجماتيين مضطربون، بل ومتنازلون عن كثير من أهدافهم بحجة الواقعية والمصلحة، كما أن تحديد تلك المصالح ليس من الأمور التي تجتمع عليها الأفهام، بل هي متباينة، وتحتاج إلى قدرات غير طبيعية، وهذا ما لا يتوفر في جموع الناس، والصحوة الإسلامية تتميز بوضوح الأهداف والغايات، وذلك لوضوح الشريعة وسهولتها؛ مما يجعل عامة الناس تتفهمها وتتبناها، وهذا كله بتوفيق الله.
- الإخلاص والبعد عن النفعية: فالإسلاميون -في مجملهم- متجردون، يظهر من سخائهم في بذل الجهد والمال لنفع الغير على حساب الذات، وهذا ما يدهش معارضيهم، ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أن من أول منهجهم الرباني ابتغاء ما عند الله دون الالتفات غير المعتدل على نتائج هذه الدنيا، كما أن الشريعة تحملهم المسئولية بكل أنواعها في مداولة المال العام والخاص، وفي مناولة الأفكار والمفاهيم، وفي النصح للخلق وحفظ حقوقهم، وكثير من المقاصد الشرعية السامية التي تتجاوز الفردية الأنانية إلى عموم الإحسان للخلق، وطلب الأجر من الله، هذه نماذج ثلاث مبسطة، تبين جانبًا مما همشه الإعلام العالمي والإقليمي، بل تجاوزه إلى التشويه والتزييف، وفي الظروف الراهنة التي تمر بها الصحوة الإسلامية يجب أن يعمق في اتباعها كل خلق وسلوك إنساني قويم، وسأمثل بثلاث صفات تعظم الحاجة إليها:
١ – التسامح والبعد عن التعصب: فالتباين في مفاهيم الأفراد والجماعات من الضرورات التي جبل الله عليها الخلق، يجب أن نسلم بهذا التعدد وإلا اصطدمنا مع حقائق حياتية تفضح مفاهيمنا المضللة عن الحياة، يجب أن نتوقع أن يخالفنا الآخرون، وعليه يجب أن يكون لدينا تصور مسبق عن كيفية التعامل مع هذه الحالات لنحقق أهدافنا دون أن نتصادم مع سنن كونية، إن أسلوب الحوار والسماع من الآخرين مع محاولة أسماعهم وتداول الآراء والوصول إلى اتفاق شامل- يجب أن يقدر بعضنا بعضا، وأن نبقي أبواب الحوار مفتوحة، لا سيما في المسائل الفرعية والدقيقة التي يسع فيها الخلاف.
٢ – تقبل النقد وتشجيعه: أكبر ما يميز مجتمعاتنا حساسيتها من النقد، وعدم تفهمه، بل والانفعال ضده، ويظهر هذا ابتداءً من علاقاتنا البينية في المجتمع، وصولًا إلى المؤسسات الرسمية التي لا تطيق إلا سماع آيات الثناء والتأييد. إن انغلاق صدورنا وعقولنا من تقبل النقد يفوت علينا كثيرًا من المصالح والنصائح، يجب أن نتأقلم على تقبل النقد، وأن نتوقعه، بل وأن نشجعه مع محاولاتنا الجدية في أن ندرب ذاتنا وغيرنا على طرق النقد الصحيح ووسائله.
٣- الموضوعية وعدم الانفعال: وهذا أيضًا من عيوبنا أننا انفعاليون، وغير موضوعيين، فبعض كتاباتنا وخطاباتنا إنشائية نادرة التقارير الخبرية والمعلومات المنطقية، وعندما نخاطب عقولًا ذكية يجب أن نتأكد من موضوعيتنا في الطرح، إن وجود الصواب معنا لا يكفي لكسب جولات المداولة، بل أسلوب إدارة الحوار، وتناول المعلومات الصائبة والموثقة بأسلوب موضوعي بعيد عن الانفعال- قد يكون مجديًا، إن الانفعال مؤشر على قلة الرصيد وضعف الحجة؛ ولذا يلجأ إليه لسد الفراغ برفع الصوت، وزيادة الانفعال حتى يوفر غطاء لذلك النقص، ولذا نجده يكثر من صغار السن، ويقل عند الكبار المجربين، ثم شريعتنا الجليلة مطابقة للفطرة ومنضبطة وغير مضطربة، مما يجعل عرضها بموضوعية أسهل وأنفع، يجب ألا يضطرنا ضغط الواقع، مما يجعل عرضها بموضوعية أسهل وأنفع، يجب ألا يضطرنا ضغط الواقع، وكثرة التهديدات أن تخرج عن طورنا، أو أن نتصرف بدون تمام إدراكنا مع ثقتنا بأن الله معنا، وأنه مظهر دينه، هذا الأمل والثقة في الله يكسب قلوبنا اطمئنانًا ورسوخًا عند الملمات والشدائد، كما أنه يدفعنا إلى الاستمرار والعمل، هذه صفحات بيضاء تسطرها الصحوة الإسلامية في تاريخنا المعاصر، والوقت جزء من الحل، وهو لا يزال مع الصحوة، والله تعالى ولي المؤمنين.
الأفضل:
- الأفضل في وقت حضور الضيف مثلًا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب.
- الأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن، والدعاء، والذكر، والاستغفار.
- الأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به.
- الأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من ورده، والاشتغال بإجابة المؤذن
- الأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل.
- الأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته، وإغاثة لهفته، وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك.
- الأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه.
- الأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك.
- الأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد؛ فهو أفضل من الجهاد غير المتعين.
- الأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد فيه، والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس، والاشتغال بهم.
- الأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته، وحضور جنازته، وتشييعه، وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك.
- الأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك، أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه، والأفضل خلطتهم في الخير فهي خير من اعتزالهم فيه، واعتزالهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه.
- الأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله -تعالى- في ذلك الوقت، والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت، ووظيفته، ومقتضاه.
ماهر السعيد السعودية – أبقيق.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل