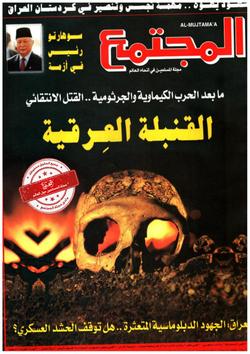العنوان المجتمع الثقافي (1628)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 27-نوفمبر-2004
مشاهدات 10
نشر في العدد 1628
نشر في الصفحة 50
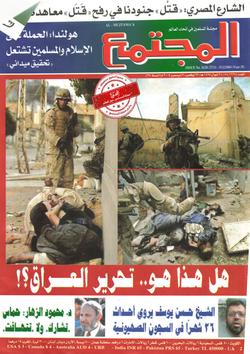
السبت 27-نوفمبر-2004
هولاكو.. وسجلات التاريخ
تنافس على السقوط!
د. عبد العظيم محمود الديب
في منتصف القرن السابع الهجري، كانت قوة التتار قد بلغت مداها، وصار خلفاء جنكيز خان آنذاك كأنهم القوة القائدة للنظام العالمي الجديد، وجاؤوا كالإعصار المدمر، لا يقف في طريقهم شيء، كانوا قد استولوا على عواصم الإسلام الحضارية والثقافية، مثل «بخارى»، و«سمرقند» و«بلخ»، و«هراة»، و«نيسابور»، و«الري»، و«جورجانية»، و« خوارزم»، و«نسا»، و«مرو»، و«الطالقان»، ودمروها تدميرًا، وربطوا خيولهم بالمساجد، وألقوا الكتب على الأرض، واتخذوا صناديقها المذهبة مزاود يعلفون فيها دوابهم.
وما لبثت العاصفة الهوجاء أن هبت على «بغداد» دار السلام، عاصمة الدنيا كلها في ذلك الزمان، ترنحت بغداد تحت مطارق الخيانة، وانحلال البذخ، وغفلة الترف.
كان لسقوط بغداد ومقتل خليفة المسلمين دوي هائل أفزع العالم الإسلامي كله، وعلاه الوجوم، وغشاه الحزن، والأدهى من ذلك أن الفزع والرعب استولى على القلوب، حتى راجت في الناس مقولة: «إذا قيل لك إن التتار انهزموا فلا تصدق».
وصار واضحًا لدى الأعمى والبصير، أن بغداد ليست آخر المطاف، وأن الجناح الآخر للعالم الإسلامي، المتمثل في الشام، ومصر، والشمال الإفريقي، هو الجولة القادمة، لذلك السفاح هولاكو قائد الجيش الذي لا يقهر، والذي لا يقبل في العالم سيدًا سواه، على حد تعبير «ستيفن ونسمان» في كتابه تاريخ الحروب الصليبية، فمع أن كل القوى الكبرى في العالم آنذاك سعت للتحالف مع التتار ومعاونتهم، فقد تحالفت معهم القوى الصليبية، إذ أرسل إليهم «لويس التاسع» بعثة قُبلت بالاحترام والتقدير، كما تحالف معهم «هيتوم» ملك أرمينية، وكذلك «بوهمند السادس» ملك انطاكية، وقدم البطريرك الأرمني ليمنح البركة «للخان» وجيوش الخان، كما انتشى الصليبيون بسقوط بغداد، وأذاعوا أخبارها، وهم في فرحة النصر، ويسمونه «سقوط بابل» الثانية.
مع ذلك أي وجود حلفاء وشركاء مع التتار فلم يكونوا يعترفون لهم بحق المشاركة، فقد كانت سياستهم تقوم على مبدأ واضح؛ هو أن أصدقاءهم حلفاءهم ليسوا غير أتباع لهم، أما أعداؤهم فيجب إفناؤهم، واستئصال شأفتهم أو إخضاعهم حتى يصيروا أتباعًا لهم هكذا، «ما أشبه الليلة بالبارحة».
فماذا بعد؟: كان على حكام الشام -وقد كان موزعًا ممالك وإمارات عدة- أن ينظروا ويتدبروا، وكان على حكام مصر أن يتفكروا ويقدروا!
وأمام هذا الخطر الداهم، كان هناك رأيان وطريقان: طريق المقاومة وطريق الاستسلام.
التاريخ لا يرحم: نعم لا يعرف التاريخ المجاملة، ولا المحاباة، فقد سجل بأمانة لكل عمله، وماذا جناه من سلوكه وفعله، سجل صفحات سوداء مجللة بالعار، وسجل صفحات ناصعة ناطقة بالفخار.
أ- سجل التاريخ أن جماعة من الحكام جبنوا، أو خدعوا، أو ضعفوا، أو خانوا، ولم ينس التاريخ أدق التفاصيل، لم ينس شماتة الناس بابن العلقمي الوزير الخائن، الذي سهل للتتار دخول بغداد، ثم ذهب إلى هولاكو يظن أنه سينال عنده الحظوة، فما راعه إلا أن هولاكو يهينه ويذله ويصب عليه السباب واللعنات، قائلًا: «لقد خنت ولي نعمتك» ثم انتقم منه انتقامًا فكاهيًا ظريفًا، فقد وهبه عبدًا لخادم من خدم الخليفة المستعصم، وأوصاه بإذلاله، فكان ذلك الخادم يطوف بالوزير الخائن على حمار ووجهه للخلف والصبية يسخرون والناس يستهزئون.
اعتذار عجيب
ولم ينس التاريخ ذلك الاعتذار العجيب الغريب، وذلك الاستسلام البشع الذي قام به أحد الحكام، طالبًا من «هولاكو» العفو والصفح والدخول في طاعته، ويبدو أنه كان متحضرًا جدًا، فقد كان فنانًا يجيد الرسم، فقد قدم إلى «هولاكو» ضمن ما قدم من هدايا وتحف «نعلًا» جديدًا، نعم نعل جديد، رسم صورته -صورة الحاكم المعتذر على أسفله- وناوله إلى «هولاكو»، وهو يحني رأسه، ويقول: «عبدك يأمل أن يتفضل الملك -يقصد هولاكو- فيشرف رأس عبده بوضع قدمه المباركة عليها»! فما كان من هولاكو إلا أن رفض هذا الاعتذار الخانع الذليل، وأصر على قطع رأسه!
ولكن يبدو أن النساء يعجبن دائمًا بالتحف والنوادر، والمبتكرات والغرائب، فقد سرت «دوقوز خانون» زوجة هولاكو بهذا الاعتذار المبتكر، وهذا الحاكم التحفة، فتشفعت له حتى رق له قلب الخان.
وإلى هنا ألقاه التاريخ في مزبلته، فلم نسمع عنه شيئًا بعد، والعجيب أنه كان يلقب نفسه عز الدين.
ولم ينس التاريخ أن يسجل لأصحاب الحلول الاستسلامية مواقفهم، فقد رفض الناصر صاحب دمشق وحلب فكرة الاتحاد والمقاومة حينما عرضها عليه الملك الأشرف صاحب «ميافارقين»، وبدلًا من ذلك أرسل ابنه العزيز إلى هولاكو بالهدايا والتحف، ويحمل وثيقة حل الطاعة والخضوع، والأدهى من ذلك يعرض عليه أن يزوده بقوات يغزو بها مصر.
ويسجل التاريخ أن هولاكو غضب إذ أرسل إليه ابنه، وكتب إليه أن يأتي بنفسه، ليقدم فروض الطاعة، والتبعية من غير قيد ولا شرط.
كما سجل مواقف العقلاء، الذين حسبوها بالأرقام والأعداد، ورأوا استحالة الوقوف أمام ذلك الجيش الجرار، فآثروا الوسيلة «الذكية» والأسلوب «الحضاري»، وقالوا: «لا بديل له للتفاوض ولا مفر من خيار السلام»، فسلموا مدنهم، وبلادهم على شرط حمايتها والحفاظ على سلامتها، ثم لما رأوا استباحتها ونهبها وتدميرها من قبل التتار أخرجوا لهم «وثائق المعاهدة» و«شروط الصلح» و«إعلان النوايا» فتلقوا صفعة على وجوههم، وبصقة على وثائقهم.
قائمة الشرف
ب- وسجل صفحات أخرى: سجل التاريخ أن حكامًا غير هؤلاء آمنوا بربهم، ووثقوا بقرآنهم ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ﴾ (آل عمران : ١٢٦) وارتفعوا فوق الماديات الغليظة، وأيقنوا أنها إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، وعلموا أن قوة الأمم لا تقاس بالسلاح والعتاد، وفقهوا التاريخ، وتذكروا «بدرًا والقادسية واليرموك»، وساروا على الطريق.
سجل التاريخ أن صاحب حصن «ميا فارقين» صمد مدة عامين كاملين لحصار «عات قاس» وأذاق التتار المر والعلقم، وأوقع بقناصته بين صفوفهم الرعب والهلاك، ولم يدخلوا الحصن إلا بعد أن نفد الماء، وفني الزاد، واستشهد كل من فيه عن آخرهم.
سجل التاريخ أن قلعة حلب، ومثلها قلعة دمشق، لم تلتزما بشروط التسليم، بل قاومت الحاميتان حتى استشهد رجالهما، ولم يبق منهما فرد واحد. سجل التاريخ أن نابلس أثرت القتال على الاستسلام، فصمدت صمود الأبطال، ولم يدخلها التتار إلا بعد أن فنيت حملتها عن آخرها.
سجل التاريخ شجاعة سيف الدين قطز، الذي زحف من مصر لملاقاة التتار ولم ينتظر حتى يصلوا إليه، وسجل له إيمانه واستقتاله، فحينما رأى كثرة العدو، وتواضع جيشه أمامهم، رمى بدرعه، وخوذته -علامة على أنه يقاتل للموت- واندفع أمام جنوده صائحًا، «وا إسلاماه» فكان النصر!!
سجل التاريخ أن إيمان الأمم بحقها في الحياة، يحطم أقوى الجيوش، ويمزق طغيان الجبابرة، ولو اجتمعوا جميعًا.
وصدق الله العظيم﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ١٧٣ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ(١٧٤)﴾ (آل عمران: ١٧٣-١٧٤).
قصة قصيرة
زيارة كان لابد منها
كم مرة سأقرع الباب الخشبي القديم في حارتكم الضيقة، وكم مرة ستخرج أيها الفتى لتعتذر، فأرثي لعرجتك الحقيقية، وأرتاح لوجهك الصبيح، وأقبض على يد صغيري أفرغ فيها بعض حزني ونفاد صبري؟
آسف.. غير موجود، أسف.. ظننته سيعود اليوم من المصيف، أنا خجلان منك والله.. تعرفين أن سنه لم تعد تسمح.. لم يعد اليوم..
أرجوك، تفضلي بالدخول.
جلست قليلًا في غرفة قديمة، لولا هذا الفتى لظننت أني في بيت مهجور، لكنه يعبق بأنس سنين مضت؛ في شكل الكنبة ذات الخشب المحفور المذهب، في القماش الثمين يحمل صورًا طبيعية حائلة اللون يغلف كل كتبه، في أطباق الصيني الشهيرة برسومها الزرقاء معروضة على طاولة في وسط غرفة، «الكتبية» وهي أرفف داخلة في الجدار رصت فيها أطباق وفناجين وأكواب يبهج عادة أصحاب الدار أن يراها زوارهم، ومن سقف الغرفة تدلى سلك ينتهي بثريا قديمة بسيطة لا تتناسب مع غيرها من الأثاث، إضافة إلى فقدها ثلاثة مصابيح.
أأنا في متحف لا يلقى العناية، أم في غرفة من بيت عربي الطراز قديم، فقد رجاله ونساؤه الرغبة في الحياة فجأة، فإذا بجماله يشحب دون أن ينتهي؟
وما الفائدة من دخولي بعد ما شاهدت من خجل هذا الفتى ذي الستة عشر ربيعًا، ولا ربيع سوى في عينيه الخضراوين، يجملهما جحوظ محبب وأهداب كستنائية كثيفة في وجه شاحب بشوش.
أحضر الفتى كأسًا من الشاي لم أستسغ ثقلها وحلوها، وارتشفت رشفة ثم أعدتها إلى طاولة صغيرة أمامي.
في أي صف أنت؟
تركت الدراسة منذ..
أه... نعم، وإخوانك كذلك؟
كلهم تركوا المدرسة، الصغير فقط يتابع إنه الآن في السنة الرابعة.
خيرًا؛ تعملون جميعًا في المكتبة؟
نعم، نتناوب.. أخي الأكبر في الخدمة العسكرية.
ازدردت ريقي، الأب الذي أحاول رؤيته منذ أسبوع غير موجود، متى سأحظى بهذا اللقاء، متى يا رب؟
تحدثت بتردد وخجل وكأني تلميذة جديدة، تمنيت ألا أثقل عليكم، لقد سمعت من بعضهم، لكن تعرف أتمنى أن أسمع بنفسي.
هز رأسه الأشقر، بدا معتادًا سماع هذا الكلام، ابتسم وقال:
طبعًا.. معك حق، أبي يحب ذلك.. يريد أن يطمئن الجميع.
جزاه الله كل خير، قلتها من أعماقي، متى أعود إذن؟
غدًا، وعدني أن يكون غدًا هنا إن شاء الله.. تفضلي بعد العصر.
خرجت إلى الدهليز الواصل بين الباب الخارجي وساحة الدار، لمحت نورًا وأشجارًا، وفستقية صامتة في بحيرة من الرخام المجزع، أوراق الشجر تتناثر على الأرض بكثرة، ولا حياة في الدار.
أصبحت في الحارة المعتمة، في حي قلما طرقته من قبل، أسمع عن عراقته ورطوبته وجمال دوره المختبئ خلف الأبواب.
تململ صوت ابني..
سنعود مرة أخرى يا أمي؟
نعم، لابد أن نعود، ألا تريد الاطمئنان على أبيك؟
بلى.. هو رآه؟
هكذا قيل لي.
يعني كان معه في السجن؟
لست أدري، لم أتأكد، أما سمعت بنفسك.. أما رأيت؟
- لم يأبه ابني بثورتي التي يعرف مداها.
- يعني هو كان يعرف أبي من قديم..
كان جاره في بيت أهله.
برطم ابني ذو الأعوام التسعة، وصمت.. وسعدت بصمته لأشق طريقي بين المارة الذين اكتظ بهم الشارع، يجب أن أظفر بسيارة تعيدني إلى بيتي قبل حلول الظلام، تحاصرني صورة تلك الغرفة التي كنت فيها، من جديد لقد بلغ حزن ثماني سنوات مبلغه في ذلك البيت الجميل الأصيل، إن كل زاوية فيه تشكو إهمالًا لا تستحقه، أين هم؟
ماذا فعلوا في غياب أبيهم، وكيف هي أمهم؟ ماذا تفعل؟ كيف كبروا؟ كيف استطاعت؟ كيف أصبحوا هكذا متسقي الأجسام، وسيمي الوجوه، لبقي الحديث؟
عرفت الأب من خلال أحاديث زوجي، جار قديم ودود، تميزه صراحة وعصبية في الطبع ونكتة لاذعة، على مكتبته إقبال ومعظم مبيعاته من الكتب المتخصصة في علوم العربية والدين، وكان يومًا حزينًا طويلًا ذلك اليوم الذي بلغنا فيه نبأ اعتقاله، لم يخفف عنا سوى أخبار المزيد من الاعتقالات في ذلك الزمن الباكي دموعًا ودماء ورعبًا.
أدمنا ذلك زمنًا ليس باليسير، وكنت أظن أني بمنجاة من هذا الوباء، وأن زوجي لا اسم له في تلك القوائم السوداء التي لا ندري كيف كتبت، ووفق أي معيار؟!
لم نكن نملك مشاركة أكبر من الحزن ودمعة القلب، إن الإخلاص لمن تحبهم حتى دون أن تعرفهم، يأمرك بذلك أمرًا لا خيار لك فيه.
الشارع على ازدحامه هادئ، ربما بسبب الإضاءة الخفيفة، ربما لأن الناس أصبحوا أميل إلى الصمت، إن أصوات الباعة هي المهيمنة، كازوز بارد، بوظة، ذرة مسلوقة، ذرة مشوية..
أواخر الصمت
كيف اتفق أن آتي في أواخر الصيف لأطمئن على زوجي الذي اعتقل منذ سنوات ثمان؟ في مثل هذا الوقت من العام في صباح جميل وآسر، خرج ولم يعد، مثل آلاف غيره، ثم أصبح السؤال عنهم جريمة، لابد أنه -وقد غاب كل هذا العمر- صنف مع المتآمرين على أمن الوطن وسلامته، تتكرر هذه الظاهرة كثيرًا في بلادنا، الصائمون المصلون المتسنمون ذرا الطهارة والاستقامة يتآمرون على أمن الوطن.. لعلها مصادفة.
هذا الشارع خبرته أثناء دراستي كثيرًا، كنت أحضر لتغليف أمالي الجامعية، ثم أغتنم الفرصة فأتفرج على واجهات المكتبات التي تملؤه، كانت متعة كبيرة ودون مقابل: الكتب الجامعية والروايات والدواوين الشعرية والمؤلفات القديمة الرصينة أعيد طبعها أو تحقيقها في أثواب جديدة قشيبة، تفتن كل مكتبة في عرض مبيعاتها، كل الجامعيين يجدون ما يبغون من كتب ومراجع، وكذلك محبو القصص والتسلية، وكذلك الأطفال يجدون حكاياتهم وأدواتهم المدرسية.
بعد تراكض من مكان إلى مكان ظفرت بسيارة تقلني وصغيري إلى البيت.
يجمع ابني أصابع يده الخمس معًا، ويتساءل ببراءة وحماس: لماذا، لماذا.. لا أعرف لماذا لا أراه ولا مرة واحدة؟ كيف؟ لا أفهم
أتمنى.. يا الله.. لو يخرج.
لست وحدك في ذلك.. أنت تعرف.
أعرف، أعرف هم كثيرون وصابرون وسيفرج الله عنهم.
ولكن طارق مثلًا يعرف أباه، ليس مثلي، يتذكره تمامًا.
إنه أكبر منك.
ضرب سريره براحة كفه وقال بلهجة مستسلمة: كأني دون أب.
ألوف الأطفال المسلمين لا أب لهم ولا أم ولا بيت، فانظر؛ ألست في نعمة كبيرة؟ بلى.. الحمد لله
ابتسم وهو يتلقى قبلتي، وبدأ يتلو الآيات والأذكار، وانتظمت أنفاسه قبل أن ينتهي.
أجري وراء سراب مع كل خارج من السجن وما أقلهم، لن أسمع سوى الكلمات المعودة: هو بخير، اطمئني، شطر العبارة يذكرني دائمًا برسائل الفلسطينيين إلى ذويهم خارج فلسطين اطمئنوا وطمئنونا عنكم، تلك التي طالما سمعتها وبكيت لأصوات العجائز والشيوخ والفتيان والأطفال، أما زوجي السجين فيصعب أن أعرف باستمرار أنه على قيد الحياة.
لكني سأذهب لن أكتفي بما وصلني عن طريق الناس، سأذهب من أجل الطفل الذي يحلم بخبر عن أبيه وقد بات يائسًا من رؤيته.
وكيف أقضي هذه الليلة، وسحابة نهار غدا؟ أتأمل الليل وسكون الشارع الذي يزداد، أحلم أن عودة زوجي وشيكة طالما أن ذلك الجار العزيز عاد؟ وما الفائدة؟ ما الذي سيختلف بعد الزيارة؟ أما اعتدت؟ بلى كثيرًا! وإلى حد ذهلني ويخجلني.. ها قد حزن الدمع، وأقبل النوم جريئًا مع نسمات رخية معتدلة تتسلل من نافذتي المفتوحة.
العودة مرة أخرى
طرقت الباب من جديد، وقلبي ينتفض.. فتحت الباب هاشة باشة امرأة تقارب الخمسين، بوجه قمحي كثيب رغم الضحكة فيه، عرفتها بنفسي فازدادت ترحيبًا وأدخلتني إلى غرفة الأمس، طلبت الشاي من ابنتها الصبية الجميلة، وعدتني بحضور زوجها فورًا.
الحمد لله، لا تيأسي.. لقد تعبت كثيرًا، وأخيرًا أفرجها الله.
الحمد الله.
شاركتها وعشرات الأسئلة تتدافع، ليتني أعرف قصتها منذ اعتقل زوجها وإلى لحظة خروجه، لكنها كانت تتحدث دون سؤال.
تحدثوا كثيرًا عني وعن أولادي... لكن الحمد لله.
الحمد لله على سلامته.
ياه.. كان يومًا، لم نصدق.. أنزلوه قريبًا من الباب، بعد الظهر كان ابني الأكبر قادمًا من رأس الحارة، تخيلي ظنه عمه لم يتوقع، حين اقترب ورآه سقط فورًا على الأرض؛ لم تحمله رجلاه.. فتحنا، فتح ابني الآخر، ارتمى على أبيه، شيء لا يصدق، الصغير لا يعرفه... حين قلنا له هذا بابا التصق بي، لم يألفه إلا بعد أيام.
وأنت؟ «كيف أخفي لهفتي»؟
ضحكت، تنحنحت وشدت ثوبها عند الخصر، وأجابت كالمحرجة:
أنا؛ ناداني الأولاد تعالي، كنت في المطبخ، عندنا زائر يريد أن يراك.. أقبلت.. لم لا يقولون من هو توقفت عن الكلام.. ثم أضافت الحمد لله .. ما بعد الضيق إلا الفرج.
وصحته.. كيف كانت؟
كيف يسبقني لساني هكذا، أضع أصابعي الفضولية على مواضع الألم.. لماذا أعذبها وأعذب نفسي؟
الحمد لله.. هو أحسن كثيرًا الآن.. قبل دخوله السجن كان يشكو ضعفًا في عينيه ومعه عصبي.
عافاه الله..
وسمعت صوت الرجل، لا شك وصل ينتعل حذاء منزليًا ويخفي منامته بثوب جيد التفصيل، يبتسم بحنو وأبوة وراء نظارة سوداء، دخل بخطى بطيئة، وانحناءة في ظهره، علا صوته بالترحيب، ثم جلس يتذكر جيرانه وابنهم الفتى ثم الشاب.. أأسأله فورًا أم أتركه يتحدث؟ وماذا أسأل؟ إنه ليعرف ما الذي أتى بي هنا؟، وحسن منه ألا يكلفني حرج السؤال.
طمأنت كثيرين، جاءني كثيرون.. لم أخش أحدًا، قيل لي إني مراقب، لا يهم، ماذا سيفعلون بي أكثر؟!
تعتقد أن الجميع سيخرجون قريبًا؟
هذا هو المفروض، منذ عامين أنا في سجن مختلف، ممتاز، الحمد لله.. لولا هذان العامان ما رأيتني الآن على هذه الحال، لكني لا أستطيع أن أعد، لا يمكن.. الثقة مستحيلة.
والتفت إلى ابني الصامت طوال الوقت وكأنه رأه اللحظة، ما شاء الله ابنك كأنه الأب الصغير...ما شاء الله.
تمتمت بكلمات امتنان، لكني في الانتظار، وقلبي المضطرب لا يستطيع انتظارًا أكثر: رأيته هناك إذن؟
اعتدل في جلسته، وكان يترك كفيه تتدليان خارج ذراع الكتبة، وقال بروية: منذ عامين -هناك- قبل نقلي، وصلني منه سلام خاص وتأكيد أنه بخير، عن طريق سجين انتقل من مهجعه إلى مهجعنا، كان قريبًا مني.. لكني لم أره.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكلمن ثمرات التاريخ.. عين جالوت أو قفت الكارثة عن العالم (1من2)
نشر في العدد 1778
39
السبت 24-نوفمبر-2007