العنوان كتب جديدة.. عبقرية خالد لعباس محمود العقاد
الكاتب عبدالرحمن إبراهيم محمد
تاريخ النشر الثلاثاء 21-مارس-1972
مشاهدات 93
نشر في العدد 92
نشر في الصفحة 26
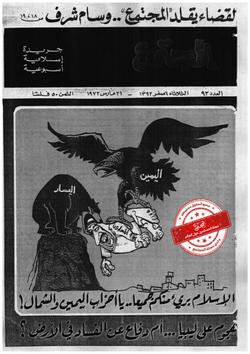
الثلاثاء 21-مارس-1972
كتب جديدة
عبقرية خالد
لعباس محمود العقاد
الحلقة 1
هذه دراسة في حلقات نقدمها لطلابنا في الشهادة الثانوية عن كتاب العقاد «عبقرية خالد»، والمقرر على طلاب هذه الشهادة في هذا العام.
ونحن إذ نقدم هذا الكتاب لهذا المؤلف إنما نقصد خدمة الطلاب، وإعطاءهم فكرة تشمل أفكار الكاتب وأسلوبه، حتى نظل معهم ويظلوا معنا وهم على أبواب الامتحانات.
غير إن هذا لا يمنعنا من الإفصاح عن أن لنا في عبقريات العقاد رأيًا نختصره في قولنا: بأن العقاد أضفى على ذات الأشخاص في عبقرياته أهمية فاقت أهمية العقيدة الدافعة، والمساندة الربانية التي صاحبت الشخصيات التي تحدث عنها، ولعل العقاد يعكس ذاته وما يعتقده من خلال هذه العبقريات.
العقاد.. فكرًا وأسلوبًا
لعل من اللمحات السريعة التالية عن العقاد ما يلقي بعض الضوء على العبقرية، وييسر تجوالنا بين سطورها، لقد عرف الناس الأستاذ عباس محمود العقاد الأديب العالم الشاعر، من خلال أكثر من مائة كتاب وأكثر من خمسة عشر ألف مقال، هي ثمار عقله الفذ في شتى فنون المعرفة، وهي حصاد الطريق الذي شقه في الحياة العلمية والأدبية بقدم راسخة مستعينًا بصبر لا حدود له على الاطلاع، وجد في أخذه كل ما خاض فيه بحيث يملي عليك إيمانًا صادقًا بكل ما يقول، وهكذا نجد ثقافة مترامية الأطراف تنسحب على أدبه، إلى جانب عمق الفكرة والميل إلى الاستدلال المنطقي.
بدأ الرجل حياته بعد حصوله على الشهادة الابتدائية عام ۱۹۰۳، ثم اتجه إلى الصحافة فكان يخشى قلمه، ثم راح يثقف نفسه عاكفًا على كتب الأدب والعلم من كل جنس ولون، ولقد كان لإعجابه بابن الرومي أثر واضح، فاتجه إلى محاكاته في كثير من أشعاره استقصاءً وتحليلًا، واختتم حياته بالكتابة عن الإسلام وأبطاله، وما عبقرية خالد إلا حلقة في هذه السلسلة التي عني العقاد بإصدارها من التراجم والسيَر.
لقد عرفت مصر مكانة العقاد، فاختارته عضوًا في المجمع اللغوي، ونال جائزة الدولة التقديرية في الأدب سنة ١٩٦٠، ثم انتقل إلى جوار ربه في ١٢ من مارس سنة ١٩٦٤، ودفن بمسقط رأسه «أسوان» تاركًا لنا مقالًا واضحًا عن العبقرية في صورة جلية.
ينبغي قبل تناول الكتاب بالتحليل، أن نشير إلى المنهج النفسي الذي اتبعه العقاد في تناوله للشخصيات الإسلامية.. وهو المنهج الذي يعتمد على رسم صورة متكاملة، تستمد الضوء من الأعماق فتظهر جلية واضحة.. ثم ينسحب الضوء على السلوك، فيكوّن القارئ رأيًا مستنيرًا ملمًا بجميع جوانب حياة الشخصية ويصل إلى الأسباب بيسر وسهولة.
على أن العقاد لم يكن ليتقصى تاريخ الشخصية بكل وقائعه من خلال هذا المنهج.. إذ المقصود أساسًا رسم «الصورة النفسية»، وبالتالي نجده لم يلتزم بالترتيب التاريخي للأحداث، بل آثر التحليل والاستقصاء من خلال زاوية ضيقة تنفرج عن أدلة واضحة وأسانيد كبيرة.. وهو لذلك يهتم بما توحي إليه الأحداث أكثر من الأحداث ذاتها.. فالحدث عنده مهم بقدر ما يلقى من ضوء.
هكذا نهج العقاد في العبقريات جميعًا، مستعينًا بثقافة واسعة في العلوم الإنسانية، خاصة كمعلم المنطق والفلسفة، وبأسلوب يتميز بالتركيز الشديد، وصل به إلى أغوار عميقة في النفس البشرية.
البادية والحرب.
هذا مدخل عام من خلال حدث مهيمن! بيد أن له مدلولاته الواسعة المشعة على رمال البادية المترامية، فهذا قتيبة بن مسلم من نوابغ قادة الأمة العربية من صدر الإسلام يدلي برأيه في وكيع بن مسعود فيقول: «إن وكيعًا رجل به كبر يحتقر أعداءه، ومن كان هكذا قلت مبالاته بعدوه، فلم يحترس منه فيجد عدوه منه غرة»، يخرج العقاد من هذه الكلمات بعدة حقائق، فهي تنبئ عن ملكه القيادة من أبناء هذه الأمة، فقد امتازوا بتقدير قوة العدو والإعداد له.. ودليل ذلك رفض قتيبة بن مسلم «والي خراسان» توجيه وكيع بن مسعود لتأديب من تمردوا على السلطان، لاستخفافه بخصمه وعدم احتراسه، وهذا شرط ملزم من شروط القيادة.
«كانت دولة الفرس لا تنظر إلى البادية العربية إلا نظرة السيد المبجل إلى الغوغاء المهازيل.. أيضًا كان للروم غرور كهذا في مواجهة البادية.. فلما جدَّ الجد عرف الفرس والروم من تقاتل.. فتنقلب الغفلة الشديدة إلى فزع شديد»، ودليل استخفاف كل من الدولتين بعرب البادية أحداث تاريخية منها: استخفاف الفرس بجيش خالد الزاحف إليهم، وركونهم إلى الطعام الذي هيأوه، ولم يكلفوا أنفسهم مشقة استطلاع الطريق، فكان أن أخذهم خالد على غرة، ومنها ما بعث به کسری من جند كي تأتيه بمحمد «صلى الله عليه وسلم» في الأصفاد حين جاءته الدعوة المحمدية.
من هنا يخلص العقاد بعدة أسباب أدت إلى هزيمة دولة الفرس، ودولة الروم أمام العرب.. أهمها استخفافهـم بالعرب وإصابتهم بالغرور، ثم كثرة الترف واختلال نظام الدولتين، وتفرق الآراء ثم نقص القيادة، وضعف العقيدة، وقد ركز عليها تركيزًا شديدًا، ولعل ارتباط العمل بالعقيدة من أهم ما أوضحته العبقرية، فقد كان من التحامهما مجد هذه الأمة ورفعة شأنها، فانفصال العقيدة عن العمل لا ينتج عنه سوى الفوضى والاضطراب.
على أن المؤرخين التمسوا أسبابًا لتبرير هزيمة الدولتين بدافع من هذه العلة القديمة.. فلا يزال الأكثرون منهـم يستعظمون على العرب أن يغلبوا الفرس والروم، فبعضهم يلتمس الصلة، فيقول إنما النصر كان لضعف الدولتين، أو أن النصر كان نتيجة لعقيدة المسلمين القوية وافتقـار الدولتين إلى مثل هذه العقيدة.. وبعضهم من قال إن النصر قد حصل وكان ينبغي ألا يحصل، وهو مصادفة لا تقبل التكرار.
هنا نرى الحماس الشديد من رد الشبهات، فبدافع من قوة من يملك الحق يرد العقاد على مزاعم المستشرقين وأعداء الإسلام فيقول: «إن المصادفة لا محل لها في حوادث الوجود، كما أنها لا تطرد من قتال بعد قتال، من جوف الصحراء إلى عمران العراق والشام ومصر، ومشارق الأرض ومغاربها بين إفريقيا والصين، يقول: «إن انحلال دولة من الدول قد يعجزها عن النصر، ولكنه ليس سببًا لإقامة دولة أخرى لم تتجمع لها أسباب النهوض، ثم يثبت أخيرًا أن العقيدة وحدها لا تغني عن الخبرة الحربية والاستعداد الكامل، ودليل ذلك يوم حنين يوم التقى المسلمون بهوازن وشيعتها من بوادي حنين.
وبأسلوب شديد التركيز، يحاصر العقاد المؤرخين، فــلا يستطيعون الهرب من الحقيقة.. وهي أن المسلمين كانوا أخبر بالفنون العسكرية من أهل فارس والروم، وكانوا أقدر على تنفيذ الخطط العسكرية التي تنفعهم من قواد تينك الدولتين.
لقد أزاح العقاد غبرة كثيفة تراكمت على صورة مشوهة، عن حرب الصحراء في خيال أكثر الناس، إذ توهم هؤلاء أن الصحراء لم تكن إلا مشاجرات بالسيوف والرماح والقش، ليس فيها نظام ولا فن حرب، وإن قوام أمرها شراذم من السطاة صغيرة تقبـل وتدبر.
فمن خلال اطلاع واسع وإيمان صادق بما يقول، يسحب العقاد ضوءًا باهرًا على حرب الصحراء فيقول: «لقد عاش العرب في الصحراء، في حيطة المدافع واستعداد المهاجم، فكسبوا حاسم الحرب، وهي ملكة لا تحصل لأبناء المدن الذين يندبون للقتال ويتدربون عليه، كأنه عمل يؤدى من مكان العمل ثم يطرح في سائر الأوقات.
إن أهمية الميدان التي لازمت البدوي ليل نهار، علمته الصبر على الفرار وملّكته ثبات القلب عندما يضطر إلى التقهقر.. لأن الفرار عنده حركة مألوفة في كل وقعة يخوض غمارها، ولیست هزيمة تطيش باللب وتخلع الفؤاد.
ثم علم العصابات المغيرة بأصول الاستطلاع والمباغتة، والتبيت والمخاتلة ونصـب الكمائن، حتى يصل الأمر إلى معرفتهم بالحرب النظامية، فجيش الغساسنة الذي حارب المنذر بن ماء السماء لم يكن يقل عن أربعين ألفًا.. ولقد احتوى لقاء مذحج بتميم يوم الكلاب الثاني، كل عناصر الكفاح الأولى في كل زمان.
ومن خلال ما حدث يوم ذي قار، نجد أن غلبة العرب إنما كانت غلبة لليقظة على الغفلة.. وللكفاية على العجز وللخفة على الفخام، وللفن الحربي الصحيح على النظم التقليدية التي لا تصرف فيها، وللعزة المشكورة على الكبرياء المذموم.
حقًا لقد كان المسلمون أخبر بفنون العسكرية، فقد اكتسبوا طريقتي الحرب:
طريقة حرب العصابات بحكم نشأة البادية، وطريقة الجيوش النظامية بحكم اقترابهم من دول الحضارة، فكانوا يقاتلون بالفنين معًا، في حين التـــزم الفرس والروم بفن واحد لا تجديد فيه ولا ابتكار، ولقد وضحت قدرتهم على تنفيـذ الخطط جلية في موقع ذي قار، مما يؤكد خبرتهم العالية بفنون الحرب.
يوم ذي قار
عقد العرب مجلس حرب في الميدان، أوحى فيه كل زعيم ما عنده من خبرة، ورسموا خطة بارعة لم يكن في يد الفرس إلا العجز أمامها، يساعدهم في ذلك يقظتهم الشديدة وغفلة الفرس، خفة حركتهم أمام فخام الفرس في جيش نظامي ثقيل الخطى، محمل بعدة حرب لم تكن صالحة للالتحام، حيث ضاق كثير من فرسانهم بدروعهم، إيمان العرب بعزتهم وتمسك الفرس بكبريائهم.
وبعث العرب بالطلائـع يوم ذي قار، وبثوا العيـون وأعدوا الكمائن للمباغتة، ثم قسموا جموعهم إلى ميمنة وميسرة وقلب، ولم يهملـوا السلاح النفسي، فقد قتلوا الروح المعنوية عند العـدو بضراوة الهجوم، عند انسحاب جزء أثناء المعركة، بينمـا أزكوا الروح المعنوية بين مقاتليهم، فعمد حنظلة بن ثعلبة إلى وضين راحلة امرأته -أي حزامها- فقطعه وتتبع رواحل النساء، فقطع وضنها جميعًا فسقطت على الأرض وصاح بقوم: ليقاتل كل رجل منكم عن خليلته، وتسابق الشعراء في التذمير والتحريض، وراح الجميع يرددون: «النية لا الدنية!».
لقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم ذي قار، وهو يدعو العرب إلى التوحيد، فرأى فيه بوادر نصر العرب على العجم، وأيقن أنه يوم تتلوه أيام، وأنه مسمع بدعوته الأمم جميعًا عما قريب.
وهكذا اكتملت أسباب النصر لهذه الأمة بعقيدة الإسلام، التي جمعت شتاتهم وبعثــت كرامتهم وانطلقت بهم إلى الأفاق شرقًا وغربًا.
عبد الرحمن إبراهيم محمد



