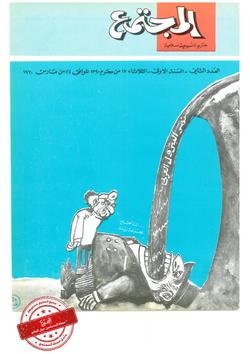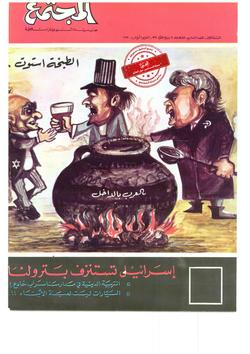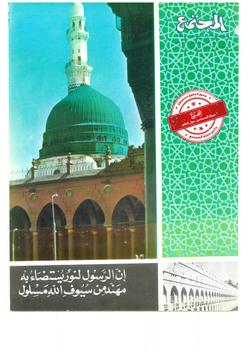العنوان مناقشات حول مجموعة من آراء الشيخ محمد متولي الشعراوي
الكاتب عطية الحاج عبد المعطي
تاريخ النشر الثلاثاء 18-فبراير-1975
مشاهدات 19
نشر في العدد 237
نشر في الصفحة 44

الثلاثاء 18-فبراير-1975
﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾( الأعراف: 43). صدق الله العظيم.
الرد على الأستاذ الشعراوى فيما يتعلق باستشهاده بأقوال كتاب الغرب:
هل أورد الأستاذ هذه الأقوال ليزيد بها إيماننا بالقرآن الكريم؟ كيف؟ والقرآن يقرر أن تلاوة آيات الكتاب المبين وذكر اللـه بالحمد وبأسمائه الحسنى هي التي تزيد القلب وجلًا والنفس إيمانًا وهدى.
وإني أرى أن هذا الاستشهاد يرمي إلى أن نجعل إيماننا بالقرآن معلقًا على أقوال جميلة يرصفها هؤلاء، وينسى الأستاذ ما في معسول هذه الأقوال من خبث لفعوه بثياب من رقيق الكلام.
إنه بهذا الاستشهاد يلفتنا من الإيمان الراسخ يقينا في صدورنا إلى تلهف لسماع شهادات كتاب الغرب، وكأننا لا نطمئن إلى إيماننا وقرآننا إلا إذا شهد هؤلاء لمصلحة الكتاب الكريم.. فهو يريد أن يكون إیماننا متوقفًا على ما يقوله هؤلاء وليس نابعًا من الإيمان بالله ورسوله وبقوله تعالى ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: 9).
إن هذه الأقوال التي استشهد بها في قضية توثيق النصوص القرآنية لا تصدر عن إيمان بأن القرآن من عند الله، فكيف نطمئن إلى مثلها وهي في نفس الوقت ترفض أن تشهد بأن القرآن من عند الله؟ ثم لو شهد أصحابها بذلك عن إيمان لأسلموا ولكننا نعلم أنهم لم يفعلوا ذلك. ثم ألم يشهد رب العالمين بأن المنافقين كاذبون فيما يشهدون به؟
ثم هل كان الأستاذ يتحدث إلى أناس لا يؤمنون بالكتاب الكريم حتى يستشهد بأقوال أهل الغرب في قضية توثيق النص القرآني؟ هل نحن نؤمن بأقوال هؤلاء أكثر من إيماننا بآيات كتابنا؟
ولا ننسى أمر الإسرائيليات التي دخلت الى كتب التفسير وما الذي فعلته فيها، فهل يريد الأستاذ أن يُدخل الى تفسير كتابنا ما يمكن أن نسميه «الأوروبيات»؟
ألم يستمع الأستاذ إلى قول الله تعالى ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ﴾ (فصلت: 5) فكيف يريدنا مع هذا أن نثق بأقوال هؤلاء؟ وهي أقوال أناس شهد القرآن نفسه بأنهم لا يفقهونه.
ونستشعر في كلامه أنه يلقي إليهم بالمودة، وقد حذر الله من ذلك ونهى عنه نهيًا كاملًا لا خير لنا فيه.
ولم أسمع الأستاذ يستشهد بأقوال علماء المسلمين، وكأننا لا نلتفت إلى أنفسنا ولا نعتبر لنا فكرًا ولا رأيا ولا شهادة.
ولا أجد ضرورة أو أي تسويغ أو تبرير يمكن قبوله للاستشهاد بأقوال هؤلاء؛ فهم لا تقبل شهاداتهم أبدا لأنهم لا يؤمنون بأن الكتاب الكريم جاء من عند الله وبلغه رسول أمين هو محمد صلى الله عليه وسلم.
• الرد على قضية السير في الأرض.
أذكر أن الأستاذ تطرق في كلامه إلى قوله تعالى ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (الأنعام: 69) ووقف دون أن يكمل الآية الكريمة. ولقد ركز الأستاذ على مجيء حرف الجر «في» وناقش الآية على أساس بلاغي، أقصد أنه قال: لماذا جاء في الكتاب «في الأرض» ولم يذكر القرآن على الأرض.. لقد أرجع الأستاذ ذلك إلى أن الإنسان عندما يسير فإنه يكون ضمن الغلاف الغازي الذي اعتبره جزءًا من الأرض، إذن فهو يسير ضمن هذا الجزء الذي هو غلاف الغاز، فهو عنده لذلك يسير في الأرض لا على الأرض.
ولكن النظر الى الآيات القرآنية يوجه اهتمامنا الى معرفة خبايا الأرض من مخلوقات حية، وأكثرها في الماء، ومعادن وأقوات هي في باطن الأرض، ثم يوجهنا إلى البحث عن بقايا الأمم التي أهلكها رب العالمين وهذه البقايا مطمورة في طبقات التراب على الغالب. فالقضية إذن ليست نكتة بلاغية أبدًا.
والاستعمال اللغوي أو أسلوب العرب هو أن نقول سار أو يسير أو سرت أو سيروا «في الأرض» ولا يقال للإنسان سار على الأرض، أي إنه ليس هناك في الأصل مجال لنفرق بين مجيء هذا الحرف أو ذاك من حروف الجر مع الفعل سار، والأمر واضح إن نحن ذكرنا أن الإنسان عندما يسير فإنه يسير في سبل جعلها الله خلال الأرض. قال تعالى ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ (الملك: 15) وهناك آيات كثيرة منها الآية ٢٢ يونس ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ﴾ (يونس: 22). فليس سير الإنسان مقصورًا في الأرض بل هو ممتد الى البحر كذلك. وأذكر الأستاذ بالغواصات وكذلك بمحطات القطار التي تسير تحت السطح وبالأنفاق التي حفرها الإنسان طرقًا لسياراته. ثم إن قصد القرآن من الأمر بالسير في الأرض واضح في آيات كثيرة، فقد طلبت أكثر من عشر آيات أن يسير الإنسان لينظر ويبحث في عاقبة الذين من قبل كيف دمرهم الله جزاء الكفر وذلك للاعتبار، ومنها فى سورةالأنعام الآية ۱۰۹ ويوسف الآية 36 والنحل، وأذكر آيات أخرى هى الآية ١٥ النحل ﴿وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا﴾ (النحل: 15) والآية ٥٣ طه ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾ (طه: 53).
ثم إن الله يدعوهم إلى السير في الأرض ليبحثوا وينظروا كيف بدأ الله الخلق ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ (العنكبوت: 20)
• الرد على ما ذكره الأستاذ فيما يتعلق بظلمات الجنين الثلاث:
أذكر أنه قال عن هذه الظلمـات الثلاث التي يخلق الله فيها الإنسان خلقًا من بعد خلق بأنها ثلاثة أحجبة: أحدها ضد الضوء، والثاني ضد الصوت والثالث ضد الحرارة. أمّا تسويغه لاستعمال الظلمات بدلًا من الأحجبة فهو:
أ- الحجاب ضد الضوء يؤدي الى الظلام إذن فهو ظلمة.
ب- الحجاب الذي ضد الصوت؛ فالليل عند الأستاذ أهدأ من النهار في كل مناطق العالم، إذن فالهدوء أو انعدام الصوت مرتبط بالليل، والليل ظلمة إذن فهذا الحجاب ظلمة.
جـ- الحجاب ضد الحرارة، وهو أن الليل عنده أبرد من النهار في كل مناطق الأرض؛ إذن فالبرودة ترتبط بالليل والليل ظلمة، إذن فالحجاب الذي ضد الحرارة ظلمة. هكذا فسر الأستاذ، ومع أنني لا أذكر كلماته حرفيًّا فإنني واثق من أنه هكذا فسرها.
والردود:
إن ما سماه الأستاذ بالأحجبة هو تسمية خاطئة؛ إذ يسمي العلماء هذه الظلمات «أغشية». وفرق كبير بين الغشاء وبين الحجاب. ثم إن كلمة حجاب تجمع على «حُجب» وليس على «أحجبة».
ويقول لسان العرب في الغشاء هو الغطاء، ويقال له غشاء وغشوة وغشاية وغشاوة إلخ، وكلها بمعنى واحد. وغاشـية القلب وغشاوته هي قميصه قال أبو عبيدة: «في القلب غشاوة وهي الجلدة الملبسة». وكل ما كان مشتملًا على الشيء فهو يبنى على فعالة مثل غشاوة وعصابة وعمامة. انتهى الكلام للسان العرب.
2- والحجاب يكون بين الشيئين أو دون أحدهما وهو الستار، ووظيفته حجب الرؤيا من ناحية معينة أو وقف الاتصال بين منطقتين، أما علم التشريح فيقول عن هذه الأغشية:
أ- الغشاء الأول ويسمونه عندنا «الخلاص» ووظيفته تتعلق بالإخراج وتبادل الغازات.
ب- الغشاء الداخلي الذي يحيط بالجنين مباشرة واسمه «السلي» ووظيفته مع ما فيه من السائل هي حماية الجنين الرقيق ضد الصدمات الحركية أو الميكانيكية، وليس ضد صدمات الصوت أو الضوء أو الحرارة.
جـ- الغشاء الثالث أو «المشيمة» وهو يشترك مع الخلاص في عملية الإخراج والتنفس وذلك لما ينتشر فيهما من الأوعية الدموية.
والذي هو مؤكد من القرآن أن الغشاوة ترد فيه بمعنى الظلمــــة وجمعها ظلمات وأذكر الآية ٤٠ في سورة النور ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّور﴾( النور: 40).
من هذه الآية الكريمة يظهر بوضوح أن الغشاوة هي الظلمة، والغشاوة عند العرب هي الغشاء نفسه إذن فالظلمات هي الأغشية تمامًا.
ثم الآية ١٦ من سورة البقرة ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ﴾ (البقرة: 17).
وقبلها في نفس السورة جاءت الآية 7 ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (البقرة: 7).
ومن هاتين الآيتين الكريمتين يظهر بوضوح أن الغشاوة هي الظلمة تمامًا وهناك آيات أخرى وردت فيها هاتان الكلمتان بمعنى واحد، وأذكر الأستاذ بأن الجنين موجود في الرحم، وهو قرار مكين كما وصفه رب العالمين، فما الحاجة إلى حمايته ضد الصوت وضد الضوء وضد الحرارة وهو في مأمن منها جميعًا؟
وهكذا أخطأ الأستاذ:
في الناحية العلمية- وظائف الأغشية.
في الناحية اللغوية وفقه اللغة- قال أحجبة بدل حجب ثم اعتبر الأحجبة هي الظلمات واعتبر الأمر مجازًا على حقيقة.
في ناحية التفسير- وهو ما سوغه لاستعمال الظلمات كما مر في أول الرد.
خطأ في الفهم والتصور.
• الرد على ما ذكره الأستاذ فيما يتعلق بمكنونات الطين وما ذكره من العناصر:
1- إن الاستاذ لا يميز بين شيء اسمه الوظائف وشيء اسمه التركيب أو البنية في أجسام المخلوقات الحية. فمن هنا خلط العناصر التي تكون الجسم بالعناصر التي ليس لها علاقة في هذه البنية وإنما علاقتها بوظائف الجسم.
إن تكوين الجسم أو خلقه هو في المركبات العضوية، وهذه المركبات أساسها الهيدروجين والكربون حتى إن عملية الانقسام في الخلية أو تكاثر الكروموزومات الى الضعف كله يقتصر على المركبات العضوية..
(يوجد سقط ... العمود الثالث ص 46 والعمود الأول ص 47)
حروف أو كتابة حجر رشيد هو أول من قال بأن حاكم مصر كان في عهد يوسف عليه السلام يسمي الملك.
الردود:
1- في الكتاب- الذي يزعم أهل الكتاب أنه مقدس- جاء في الفصل التاسع والثلاثين في العهد القديم «وأما يوسف فأنزل الى مصر فاشتراه فوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط.. رجل مصري من أيدي الإسماعيليين الذين نزلوا الى هناك» ومن هنا أقول للأستاذ إن ملك مصر في عهد يوسف كان يقال له فرعون أيضًا.
ثم جاء في الفصل الأربعين «وكان بعد هذه الأمور أن ساقي ملك مصر والخباز أجرما إلى سيدهما ملك مصر فسخط فرعون على كلا خصييه رئيس السقاة ورئيس الخبازين.
إذن فالأمر واضح بأن شامبليون ليس أول من ذكر أن الحاكم في مصر في عهد يوسف عليه السلام كان يسمى «الملك» بل إن الكتاب الذي يسميه أهل الكتاب مقدًسا قد ذكر ذلــك بوضوح، والكتاب موجود قبل القرآن الكريم، إذن فكيف يضرب الأستاذ ورود كلمة «الملك» في سورة يوسف بأنها خرق لحجاب الزمن المستقبل؟
ومع أنني لا آخذ بشيء مما في كتب أهل الكتاب لتفسير القرآن فإن هذا الكتاب يبقى وثيقة تاريخية لها قيمتها في الاستشهاد لمثل هذه الأمور، وإنني أؤمن بأن التوراة والإنجيل جاءتا من عند الله مثل إيماني بالقرآن، وبأن التوراة والإنجيل قد حُرِّفتا على أيدي أحبار أهل الكتاب، ومع عدم حصولي على النسخة العبرية للعهد القديم فإنني واثق من أن كلمة «ملح» العبرية والتي تقابل كلمة «ملك» العربية قد وردت في قصة يوسف فيه.
2- من القرآن الكريم آية 51 سورة الزخرف ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي﴾ (الزخرف: 51) والقائل هنا هو فرعون في عهد موسى فهو ملك كما يظهر من الآية، وآية أخرى هي ٢٩ من سورة غافر ﴿يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ﴾) غافر: 29( والخطاب هنا موجه من موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه.
ومع عدم معرفتي بمعنى كلمة فرعون فإنها قد تكون اسمًا للملك في عهد موسى أو قد تكون لقبًا للملك في مصر حينذاك يناديه به النـاس للتبجيل والاحترام، ثم قد تكـون ايضا اسما للملك في عهد يوسف عليه السلام.
• الرد على ما ذكره الأستاذ فيما يتعلق برب المشارق.
ليس للشمس أكثر من مشرق واحد بالنسبة لمنطقة معينة من سطح الأرض، وكلمة أشرق لا تستعمل للشمس وحدها، بل تستعمل كذلك لكل الكواكب والقمر معها ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ (الزمر: 69).
رب المشرقين ورب المغربين: قصد بها القرآن مشرق الشمس ومشرق القمر ثم مغرب الشـمس ومغرب القمر.
رب المشارق: قصد بها القرآن مشارق الكواكب أو النجوم، ويمكن لنا أن نعتبر مشرق الشمس ومشرق القمر اثنين منها.
رب المشرق ورب المغرب: ذلك بخصوص الشمس وحدها ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ (البقرة: 258).
لماذا يسير ذو القرنين كل هذه المسافة الواسعة ليبلغ مشرق الشمس أو مطلعها؟ ثم لماذا كل هذه المسافة ليبلغ مغرب الشمس؟ فإن للشمس مشارق ومغارب في كل نقطة وفي كل لحظة. (طالع سورة الكهف).
٦- ثم إن السجود لله وتسبيحه متصل ومستمر على الأرض إلى يوم يبعثون من قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وبدون أن يكون لأذان الصلاة علاقة بذلك أبدًا ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (الرعد: 15).
الرابط المختصر :
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل