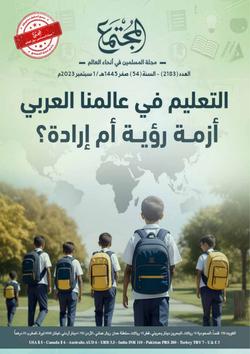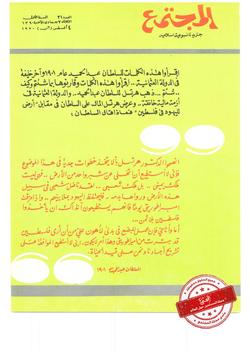العنوان من بحوث مؤتمر التعليم الإسلامي.. تدريس القرآن الكريم
الكاتب الدكتور ناصر بن سعد الرشيد
تاريخ النشر الثلاثاء 31-مايو-1977
مشاهدات 14
نشر في العدد 352
نشر في الصفحة 38
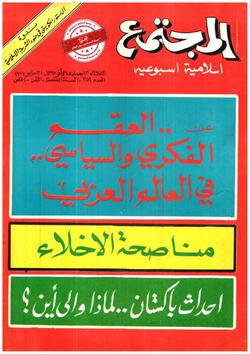
الثلاثاء 31-مايو-1977
اعتنى سلف المسلمين بالقرآن الكريم عناية لم تعتن مثلها أمة من الأمم في كتب من كتبها، أكبوا على قراءته وتدبره واستنباط شريعة حياتهم من توجيهاته، وقصر أقوام منهم حياتهم على دراسته وخصائص أسلوبه وإعجازه وقراءاته، ومنهم من رسم خطة لتدريسه ووضع أسسًا وطرقًا لمعلمه ولمتعلمه على حد سواء فاستفادوا من ذلك أشد الفائدة، وبحثي هذا سيكون إن شاء الله عن تتبع هذه الأسس والطرق ومدى الاستفادة منها في عصرنا الحديث، ذلك لأننا في أشد الحاجة اليوم إلى قراءة هذا الكتاب العظيم وفهمه حق الفهم وتدارس ما فيه من أحكام وشرائع تعود على المسلمين بالنفع والعزة وأحسب أن في طريقة تدريسه اليوم ما يعوق المتعلم من إدراك غاية تعلمه وذلك إما عن قصور في معلمه أو عدم تهيئة الوسائل الملائمة لمتعلمه.
تعليم القرآن وحفظه:
حض الإسلام على تعليم القرآن وتعلمه وبين ما في ذلك من المثوبة ترغيبًا في تعلمه وتعليمه وجعل خير المسلمين من علم القرآن وتعلمه ففي صحيح البخاري -رحمه الله-: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وعرف المسلمون الأوائل مرمى هذا الترغيب ومغزى هذا النعت العظيم فعكفوا على القرآن يعلمونه حينًا ويتعلمونه حينًا آخر، فهذا مثلًا أبو عبد الرحمن السلمي راوي الحديث الآنف يقرئ الناس في خلافة عثمان حتى كبار الحجاج ويقول: «ذاك الذي أقعدني مقعدي هذا» ويفسر القابسي هذا القول بقوله: فأبو عبد الرحمن هو القائل «وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا» يريد أن حديث عثمان -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في فضل القرآن أو علمه «هو الذي أقعده لتعليم الناس القرآن يقرئهم إياه».
وحرص المسلمون على تعليم أولادهم وبناتهم القرآن لضرورة ذلك في إصلاحهم واستقامتهم وأداء شعائرهم الدينية كالصلاة مثلًا، وللقابسي كلام جميل في هذا الموضوع ناقش فيه واجبات الوالد في تعليم بنيه القرآن وبناته وواجب المجتمع الإسلامي وحاكم المسلمين في تعليم اليتامى الذين لا يجدون ما ينفقون على تعليمهم فقال: «إن الذي قدمت لك مما يرجى للوالد في تعليم ولده القرآن إنما هو على وجه الترغيب للوالد في تعليم ولده الطفل الذي لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا، ولا يميز لنفسه ما يأخذ لها وما يدفعه عنها وليس له ملجأ إلا لوالده الذي تجب عليه نفقته لمعيشته فما زاد بعد ذلك الواجب فهو إحسان من الوالد كما لو أحسن للأجنبي أو لمن لا يلزمه نفقته ولكن يرجى له فيما أحسن به إلى ولده لمحتاج إليه ما هو أفضل، إذ ليس يشركه فيه غيره ولا حيلة للطفل يستعين بها فيستغني بنفسه فيها عن نظر والده له فيها، وقد أمر المسلمون أن يعلموا أولادهم الصلاة والوضوء لها، ويدربوهم عليها، ويؤدبوهم بها ليسكنوا إليها ويألفوها فتخف عليهم إذا انتهوا إلى وجوبها عليهم، وهم لا بد لهم إذا علموهم الصلاة أنهم يعلمون أولادهم القرآن ويأتونهم بالمعلمين ويجتهدون في ذلك وهذا مما لا يمتنع منه والد لولده وهو يجد إليه سبيلًا إلا مداركة شح نفسه فذلك لا حجة له، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ (النساء: 128) وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الحشر: 9) ولا يدع أيضًا هذا والد واحد تهاونًا واستخفافًا لتركه إلا والد جاف لا رغبة له في الخير إن الله سبحانه وصف في كتابه عباده فقال سبحانه: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ إلى قوله -عز وجل- ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (الفرقان: 63-74). فمن رغب إلى ربه أن يجعل له من ذريته قرة عين لم يبخل على ولده بما ينفق عليه في تعليمه القرآن: قال الله جل ذكره: ﴿وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (الطور: 21) أي وما نقصناهم من عملهم من شيء، فما يدع الرغبة في تعليم أهله وولده الخير شحًّا على الإنفاق أو تهاونًا به يفقدهم ذلك الخير إلا جاف أو بخيل، إن حكم الولد في الدين حكم والده ما دام طفلًا صغيرًا، أفيدع ابنه الصغير لا يعلمه الدين، وتعليمه القرآن يؤكد له معرفته الدين؟ أم يسمع قول الرسول عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما نتائج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس بها من جدعاء فقالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين». فأخبر بما يدرك الولد من أبويه مما يعلمانه، فمن مات قبل أن يبلغ أن يعلم رد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره إلى علم الله بما كانوا عاملين بما عاشوا، فإذا كان ولد الكافرين يدركهم الضرر من قبل آبائهم انبغى أن يدرك أولاد المؤمنين النفع في الدين من قبل آبائهم ولقد استغنى سلف المؤمنين أن يتكلفوا الاحتجاج في مثل هذا، واكتفوا بما جعل في قلوبهم من الرغبة في ذلك فعملوا به وأبقوا ذلك سنة ينقلها الخلف من السلف فاحتسب في ذلك على أحد من الآباء ولا تبين على أحد من الآباء أنه ترك ذلك رغبة عنه ولا تهاونًا به، وليس هذا من صفة المؤمن المسلم ولو ظهر على أحد أنه ترك أن يعلم ولده القرآن تهاونًا بذلك لجهل وقبح حاله ووضع عن حال أهل القناعة والرضا، ولكن قد يخلف الآباء عن ذلك قلة ذات اليد فيكون معذورًا حسب ما يتبين من صحة عذره، وأما إن كان للولد مال فلا يدعه أبوه أو وصيه - إن كان قد مات أبوه - وليدخل للكتاب ويؤاجر المعلم على تعليمه القرآن على حسب ما يجب، فإن لم يكن لليتيم وصي نظر في أمره حاكم المسلمين وسار في تعليمه سيرة أبيه أو وصيه، وإن كان ببلد لا حاكم فيه نظر له في مثل هذا لو اجتمع صالحو ذلك البلد على النظر في مصالح أهله، فالنظر في هذا اليتيم من تلك المصالح.
وإن لم يكن لليتيم مال فأمه وأولياؤه الأقرب فالأقرب به هم المرغبون في القيام به في تعليم القرآن، فإن تطوع غيرهم بحمل ذلك عنهم فله أجره وإن لم يكن لليتيم من أهله من يعني به في ذلك فمن عني به من المسلمين فله أجره، وإن احتسب فيه المعلم فعلمه لله -عز وجل- وصبر على ذلك فأجره إن شاء الله يضعف في ذلك.
وأما تعليم الأنثى القرآن والعلم فهو حسن ومن مصالحها، وأحسب أن الممعن في نص القابسي يقدر أن يتحسس أن المسلمين وعلماء التربية فيهم كانوا يرون إشاعة التعليم وواجب الدولة في تعليم من لا يستطيع ذلك ماديًا، وأحسبه يلمح من هذا النص أيضًا مبدأ إجبارية التعليم خاصة تعليم القرآن الكريم.
وأما حفظ القرآن الكريم ففرض كفاية على الأمة أي أن الأمة جميعها تأثم بعدم حفظ طائفة منهم للقرآن الكريم، ولذلك لم يخل عصر من العصور من طائفة تحفظه، وهذه خصيصة تميزه عن غيره من الكتب الأخرى، وقد صرح الجرجاني في «الشافي والبادي» وغيرهما من علماء الشافعية بأن حفظه واجب على الأمة والعلة في ذلك كما قال الجويني «ألا ينقطع عدد التواتر فيه ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف» ذلك لأن رواية القرآن الكريم لا تكفي فيها الكتابة أو الإجازة أو المكانية أو الإعلام أو الوجادة كما في غيره وإنما لا بد من حفظه جيلًا بعد جيل، ولهذا يقول ابن الجزري: «ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدر لا على حفظ المصاحف والكتب وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن ربي قال لي قم في قريش فأنذرهم فقلت له: رب إذن يثلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة فقال: مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابًا لا يغسله الماء تقرؤه نائمًا ويقظان فابعث جندًا أبعث مثلهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك وأنفق ينفق عليك» فأخبر الله تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء بل يقرؤه في كل حال كما جاء في صفة أمته «أناجيلهم في صدورهم».
ويقول شيخ الإسلام منوهًا بأهمية حفظ القرآن: «أما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما يسميه الناس علمًا وهو إما باطل أو قليل النفع وهو أيضًا مقدم في التعليم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع فإن المشروع في حق مثل هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن فإنه أصل علوم الدين بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع والأعاجم وغيرهم يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام والجدال أو الفروع النادرة أو التقليد الذي لا يحتاج إليه أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها وكثير من الرياضيات التي لا تقوم عليها حجة ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله».
آداب معلمه ومتعلمه:
نظر المسلمون إلى المعلم على أنه رجل علم وأدب يفيد بأدبه كما يفيد بعلمه، ذلك لأن المتعلم الصغير يتأسى به ويأخذ من طباعه وأدبه فأكدوا على حسن سلوك المعلم وعقله وتدينه مثل أو أكثر من تأكيدهم على علمه ويلخص لنا الصفات اللازمة في المعلم - خاصة معلم القرآن - ابن سيناء فيقول: - لا بد أن يكون - عاقلًا، ذا دين، بصيرًا برياضة الأخلاق حاذقًا بتخريج الصبيان، وقورًا رزينًا، بعيدًا عن الخفة والسخف، قليل التبذل والاسترسال بحضرة الصبي» ولهذا فإن على المعلم أن يحرص على التحلي بهذه الصفات ليغرسها عن طريق الإيحاء والتأسي في صبيانه الذين يدرسون عن ركبته في كل حركة من حركاته وسكنة من سكناته فيستحب له أن يجلس مستقبلًا القبلة إن أمكن بوقار وسكينة وتواضع وخشوع متربعًا أو غير ذلك مما لم يكره من الجلسات ولا يجلس مقعيًا ولا مستوفزًا، ولا رافعًا إحدى رجليه على الأخرى ولا مادًّا رجليه أو إحداهما من غير عذر ولا متكئًا على يده إلى جنبه وراء ظهره» وكما حرصوا على بذل ما في وسع المعلم من تلقين صبيانه علمه وخلقه فقد حرصوا أيضًا على الطالب في أن يستفيد مما عند معلمه من علم وخلق ما وسعته الطاقة فوضعوا له منهجًا يطبقه في حلقة درسه وهو «أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ أو متربعًا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع ويصغي إلى الشيخ ناظرًا إليه ويقبل بكليته عليه متعقلًا لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية ولا يلتفت من غير ضرورة ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه بغير حاجة ولا سيما عند بحثه له أو عند كلامه معه فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه عند بحث له ولا ينفض كمية ولا يحسر عن ذراعيه ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه ولا يضع يده على لحيته أو فمه أو يعبث بها في أنفه أو يستخرج منها شيئًا ولا يفتح فاه ولا يقرع سنه ولا يضرب الأرض براحته أو يخط عليها بأصابعه ولا يشبك بيديه أو يعبث بأزراره، ولا يسند بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو درابزين أو يجعل يده عليها ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره ولا يعتمد على يديه إلى ورائه أو جنبه ولا يكثر كلامه من غير حاجة ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذاءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب ولا يضحك لغير عجب ولا يعجب دون الشيخ فإن غلبه تبسم تبسمًا بغير صوت البتة».
ما يتبع القرآن:
اختلفت أمصار المسلمين بالنسبة لتدريس القرآن الكريم في أمر تدريس القرآن، هل يدرس وحده أم تشترك معه مواد أخرى ذات علاقة وطيدة به أو ليست ذات علاقة وطيدة، فأهل أفريقية لهم فلسفة في التعليم القرآني تختلف عن فلسفة إخوانهم في الأندلس وفي المشرق الإسلامي، وتعرض ابن خلدون لمظاهر هذا الاختلاف وأشبعه حقه فقال:
«أما أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط وأخذهم في أثناء الدراسة بالرسم ومسائله، واختلاف حملة القرآن فيه، لا يخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم لا من حديث ولا من فقه ولا من كلام العرب إلى أن يحذق فيه.
أما أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هو، وهذا هو الذي يراعونه في التعليم إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك وأساسه ومنبع الدين والعلوم جعلوا، أصلًا في التعليم فلا يقتصرون لذلك عليه فقط، بل يخلطون في تعليمهم الولدان رواية الشعر في الغالب والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخط والكتابة، ولا تختص عنايتهم بالقرآن دون غيره، بل عنايتهم بالخط أكثر من جميعها إلى أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة.
وأما أهل أفريقية فيخلطون في تعليمهم للولدان القرآن بالحديث في الغالب إلا أن أكثر عنايتهم بالقرآن واستظهار الولدان إياه، ووقوفهم على اختلاف رواياته وقراءته مما سواه وعنايتهم بالخط تبع لذلك.
وأما أهل المشرق فيخلطون في التعليم كذلك على ما يبلغنا ولا أدري بهم عنايتهم منها، والذي ينقل لنا أن عنايتهم بدراسة القرآن وصحف العلم وقوانينه في زمن الشبيبة ولا يخلطونه بتعليم الخط، بل لتعليم الخط عندهم قانون ومعلمون له على انفراده، كما نتعلم سائر الصنائع، ولا يتداولونها في مكاتب الصبيان».
ويصف ابن العربي منهج المشرق الإسلامي فيقول: «ومنهم - وهم الأكثر - من يزخر حفظ القرآن ويتعلم الفقه والحديث وما شاء الله فربما كان إمامًا وهو لا يحفظ».
ومن رأى أن تدريس القرآن لا يكون وحده فقد نظر إلى أن القرآن يحتاج في فهمه إلى علوم أخرى خاصة القراءة المتأملة ومعرفة الحركات والخط والهجاء وما إلى ذلك من كلام العرب الذي لا فحش فيه، قال في ذلك سحنون: «وينبغي له أن يعلمهم إعراب القرآن وذلك لازم له والشكل والهجاء والخط الحسن والقراءة الحسنة والتوقف والترتيل يلزمه ذلك، ولا بأس أن يعلمهم الشعر مما لا يكون فيه فحش من كلام العرب وأخبارها، وليس ذلك بواجب عليه أي «على المدرس» ويلزمه أن يعلمهم ما علم من القراءة الحسنة وهو مقرأ نافع ولا بأس إن أقرأهم لغيره إذا لم يكن مستبشعًا مثل - يبشرك- و- ولده- و- حرم على قرية- لكن يقرئها- يبشرك- و- ولده- و- حرام على قرية- وما أشبه هذا، وكل ما قرأ به أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليعلمهم الأدب فإنه من الواجب لله عليه النصيحة وحفظهم ورعايتهم».
وقال في موضع آخر: «ويلزمه أن يعلمهم الوضوء والصلاة لأن ذلك دينهم، وعدد ركوعها وسجودها والقراءة فيها والتكبير وكيف الجلوس والإحرام والسلام وما يلزمهم في الصلاة والتشهد والقنوت في الصبح، فإنه من سنة الصلاة ومن واجب حقها الذي لم يزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليها حتى قبضه الله تعالى صلوات الله عليه ورحمته وبركاته وليتعاهدهم بتعليم الدعاء ليرغبوا إلى الله، ويعرفهم عظمته وجلاله، ليكبروا على ذلك، وينبغي أن يعلمهم سنة الصلاة مثل ركعتي الفجر والوتر وصلاة العيدين والاستسقاء والخسوف وحتى يعلمهم دينهم الذي تعبد الله به وسنة نبيهم -صلى الله عليه وسلم-».
متى يبدأ تدريس القرآن:
معظم ما بين أيدينا من المصادر لا تدلنا دلالة واضحة على سنة معينة يبدأ بها المسلمون تعليم أبنائهم كتاب الله العزيز أو غيره من العلوم، وكل ما لدينا من مصادر تفيد الدلالة الظنية وتجعلك تضطر معها إلى التخمين بأن المسلمين حرصوا على تعلم القرآن في زمن الشبيبة لأن ذلك أفضل فيختلط بلحمهم ودمهم وهذا ما أومأ إليه سحنون لما استدل بحديث أبي هريرة «من تعلم القرآن في شبيبة اختلط القرآن بلحمه ودمه ومن تعلمه في كبره وهو يتفلت منه ولا يتركه فله أجره مرتين» وكلمة - الشبيبة - في هذا الحديث لا تدلنا على سنة معينة يجب أن يبدأ بها التعلم على أنها تدلنا على أنه يبدأ في فترة معينة من حياته وهي زمن الشبيبة، أما ابن سيناء فيربط ذلك باشتداد مفاصل الصبي واستواء لسانه واستعداده للتلقين، وهذا لا شك متوقف على غذاء الطفل ومدى نموه وبيئته التي نشأ فيها دون توقفه على سن معينة يقول ابن سيناء «فإذا اشتدت مفاصل الصبي واستوى لسانه، وتهيأ للتلقين، أخذ في تعلم القرآن وصور له حروف الهجاء، ولقن معالم الدين، وإذا فرغ الصبي من تعلم القرآن وحفظ أصول اللغة نظر عند ذلك إلى ما يراد أن تكون صناعته فوجه لطريقه».
ويربط أهل الأندلس تعليم القرآن وغيره بإيناسهم العقل عند الصبي ومقدرته على التمييز بين الأشياء يذكر ذلك ابن العربي بقوله: «فصار الصبي عندهم إذا عقل، فإن سلكوا به أمثل طريقة لهم علموه كتاب الله فإذا حذقه نقلوه إلى الأدب فإذا نهض منه حفظوه الموطأ، فإذا لقنه نقلوه إلى المدونة» ومن أمعن النظر في كلام ابن العربي لحظ أن أهل الأندلس يبدأون تعليم أولادهم في سن تتأخر عن تلك التي أرادها ابن سيناء، أما أهل المشرق في عهد ابن العربي فتشبه طريقتهم طريقة أهل الأندلس إلى حد ما وذلك أن الطفل يبدأ في التعليم بعد أن يعقل ولكنه لا يبدأ في تعلم القرآن كما يفعل ذلك أهل الأندلس، ويصف ابن العربي هذه الطريقة فيقول: «وللقوم في التعليم سيرة بديعة وهي أن الصغير منهم إذا عقل بعثوه إلى المكتب، فإذا عبر المكتب أخذوه بتعلم الخط والحساب والعربية. فإذا حذقه أو حذق منه ما قدر له خرج إلى المقرئ فلقنه كتاب الله فحفظ منه كل يوم حزبًا أو نصفه حتى إذا حفظ القرآن خرج إلى ما شاء الله من تعليم أو تركه».
ويبدو لي أن المسلمين كانوا يبدأون بتعليم أولادهم القرآن في سن السادسة أو السابعة على الأقل، ذلك لأن السابعة هي بدء تعليمهم الصلاة وأمرهم يبدأ بتعليم الطفل الصلاة دون سبق تعليمه شيئًا من القرآن أو على الأقل فإن تعلم القرآن يصحب تعلم الصلاة، ويؤيد هذا ما أورده القابسي إذ يقول: «وما زال المسلمون وهم يرغبون في تعليم أولادهم القرآن وعلى ذلك يدربونهم، وبه يبتدرونهم وهم أطفال لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ولا يعلمون إلا ما علمهم آباؤهم»، ومن قبيل هذا، ما ورد أن ابن عباس -رضي الله عنه- قرأ المحكم وهو ابن عشر سنين ففي الصحيح «قال ابن عباس توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم ومعلوم أن قراءة ابن عباس لم تكن قراءة مجردة من الفهم وتدبر ما يقرأ، وإذا عرفنا ذلك ثبت لدينا أن ابن عباس تعلم القرآن في سن السابعة أو قبلها، مثل ذلك ما ثبت من أن ابن سيناء أتقن علم القرآن العزيز عندما بلغ العاشرة من عمره وقد ذكر ذلك في قصة حياته التي أثبتها ابن أبي أصيبعة «ثم انتقلنا إلى بخارى وأحضرت معلم القرآن ومعلم الأدب وأكملت العشر من العمر، وقد أثبت على القرآن وعلى كثير من الأدب حتى كان يقضي من العجب» ويأتي ابن الجوزي فيقرر أن الصبي يجب أن يحمل على العلم منذ بلوغه سن الخامسة وهو الوحيد الذي حدد السن التي يبدأ بها تعليم القرآن العزيز يقول: «فأما تدبير العلم فينبغي أن يحمل الصبي من حين يبلغ خمس سنين على التشاغل بالقرآن والفقه وسماع الحديث وليحصل له المحفوظات أكثر من المسموعات لأن زمان الحفظ إلى خمس عشرة سنة».
وكما اختلفت مناهج التعليم والسن التي يبدأ التعليم فيها عند المسلمين فقد اختلفوا أيضًا في مسألة هل يبدأ بتعليم القرآن للصبي أم تقدم عليه بعض العلوم الأخرى، وهم في ذلك طائفتان:
1- طائفة ترى أن القرآن يجب أن يبدأ به الطفل - وما أبدوا لذلك سببًا تربويًا وإنما هي عادة اعتادوها - وفي ذهنهم أن الطفل المسلم يجب أن يتعلم أول شيء أفضل علم وهو علم القرآن الكريم فهو أول علم يحتاجه في حياته عندما يبلغ السابعة من عمره ويبدأ في أداء الصلوات، وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد وأتباعه رحمهم الله، وقد عقد ابن مفلح الحنبلي فصلًا تحت عنوان «فصل في طلب العلم وما يبدأ منه»، فقال: «قال الميموني: سألت أبا عبد الله أيهما أحب إليك أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ قال: لا بالقرآن قلت: أعلمه كله؟ قال: إلا إن تعسر فتعلمه منه، ثم قال لي: إذا قرأ أولًا تعود القراءة ثم لزمها»، وعلى هذا أتباع الإمام أحمد إلى زمننا هذا، ولقد مر بنا آنفًا ما ذكره ابن خلدون عن مناهج تعليم القرآن عند أهل المغرب وأهل الأندلس وأهل أفريقية وأهل المشرق، وهذه المناهج في جملتها تدل على أنهم كانوا يبدأون بتعليم القرآن إما منفردًا وإما مع غيره من العلوم التي لها مساس قوي به أو ليس لها، وهذا أيضًا هو مفاد نص ابن العربي الآنف ذكره، ويقرر ابن الجوزي أن الطفل يبدأ بالقرآن حفظًا ويعتني بحفظه أكثر من سماعه فيقول: «وأول ما ينبغي أن يكلف حفظ القرآن متقنًا فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم ثم مقدمة من النحو يعرف بها اللحن ثم الفقه مذهبًا وخلافًا، وما أمكن بعد هذه من العلوم فحسن».
2- طائفة ترى ألا يبدأ بالقرآن وإنما يبدأ بتعليم الطفل بعض النشاطات الجسمانية كالسباحة مثلًا وهو رأي الحجاج بن يوسف فقد قال لمعلم ولده «علم ولدي السباحة قبل الكتابة» أو يبدأ بتعليم الحساب وهو رأي رائج وله أنصار ومؤيدون ومنهم ابن التوأم الذي نقل الجاحظ عنه قوله: «علم ابنك الحساب قبل الكتابة، فإن الحساب أكسب من الكتاب ومعونة نقله أيسر، ووجوه منافعه أكثر».
وبعد هذا كله فلابن العربي المفسر رأي عجيب جدًا مفاده أن القرآن يجب أن يتأخر تعليمه حتى يتمكن الصبي من إحراز بعض الملكات وحتى يستوي عقله على سوقه، وقد لخصه ابن خلدون بقوله: «وقد ذهب القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب رحلته إلى طريقة غريبة في وجه التعليم وأعاد في ذلك وأبدأ وقدم تعليم العربية والشعر على سائر العلوم كما هو مذهب أهل الأندلس ثم ينتقل منه إلى الحساب ثم ينتقل إلى درس القرآن ثم قال: «ويا غفلة أهل بلادنا في أن يؤخذ الصبي بكتاب الله في أول أمره يقرأ ما لا يفهم» ويعلق ابن خلدون على هذا الراي الذي يؤيده، بيد أن العوائد لا تستسيغه فيقول: «وهو لعمري مذهب حسن إلا أن العوائد لا تساعد عليه».
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل