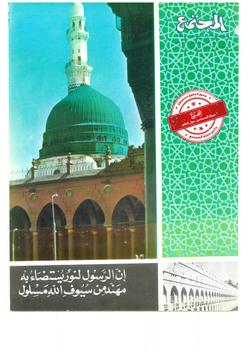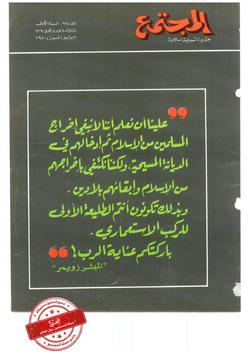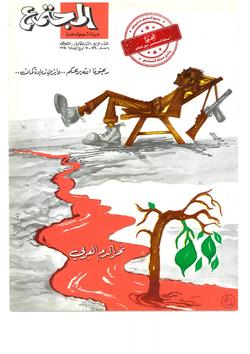العنوان نهضة المسلمين الأوائل.. وواقعنا المعاصر «١ من ٢»
الكاتب علي عزت بيجوفيتش
تاريخ النشر الثلاثاء 05-يوليو-1994
مشاهدات 41
نشر في العدد 1106
نشر في الصفحة 38
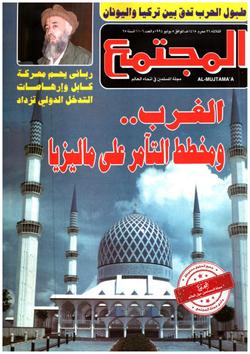
الثلاثاء 05-يوليو-1994
الإسلام حكم العالم خمسمائة سنة من «٧٠٠- ١٢٠٠م» وذلك لتفوقه الحضاري على الأمم الأخرى.. فأين المسلمون الآن من هذه الحضارة الرائدة
يقول دوزي العالم الهندي: أن جميع سكان الأندلس عندما كانت عاصمة الخلافة الإسلامية كانوا يحسنون القراءة والكتابة.. في وقت كانت الكتابة حكرًا على رجال الكنيسة فقط
لیست هذه المشكلة من قبيل المشكلات المخترعة، كما أنها ليست من نسيج الترف الفكري. تفرض هذه المشكلة صورة السبات والركود التي غلبت منذ زمن طويل على مناطق شاسعة تمتد من جبل طارق غربًا إلى إندونيسيا شرقًا، ولكن أبرز صورة لهذه الظاهرة التي يسميها البعض بــ«ليل أو غروب الإسلام»، ظهرت من مرحلة الاستعمار الإنجليزي للهند وامتدت إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، إلا أن جذور وبداية الأسباب الحقيقية لها ترتد إلى أبعد من ذلك، كما أن آثارها ما زالت قائمة إلى درجة كبيرة حتى يومنا هذا.
إن أسباب نهضة أو انحطاط أمة ما تكون دائمًا معقدة ومتعددة الأبعاد، ومع ذلك فلا يكون إلا جانب منها من الأسباب الموضوعية، وبالتالي تخضع للتحليل والإدراك، بينما يظل جانبها الآخر غير خاضع للتحليل والإدراك لأنها تكمن في قلوب وإرادة البشر.
ما الأسباب الكامنة التي جعلت ينابيع الحياة والإرادة والعلوم تنبع من أرض مصر القديمة واليونان وروما والجزيرة العربية والهند والصين والمكسيك، وفي أوروبا وأمريكا، كما نشهدها اليوم في الوقت الذي تعيش وتموت أجيال لا حصر لها من الفلاحين في مناطق شاسعة خارج النطاق الأول، سائرة دومًا في دائرة نفسها لتستقر في مجاهيل التاريخ؟ ما الأمر الذي يجعل شعبًا ما يكتشف هويته فجأة ويتحول إلى مهد الشجعان العمالقة والرجال المقدسين وفطاحل الشعراء، بينما تظل شعوب أخرى تطلع وتغرب عليهم الشمس نفسهايعيشون في ظروف مشابهة، ومع ذلك لا تشكل إلا مستنقع المجاهيل؟
إن التوضيح المعتاد للأمر المطروح يدور حول ما يلي: العلة في الحكام والمؤسسات والظروف الاقتصادية وأمية الشعوب، وهلم جراء أو إن الشعوب غير المتعلمة، لذلك تستحمل طغيان الحكام والحكام أنانيون، لذلك لا يعملون لتعليم شعوبهم، والمؤسسات التعليمية انعكاس مباشر لمستوى المجتمع الثقافي بالإضافة إلى تحكم النظام القائم فيها إذن أين السبب وأين النتيجة؟
إن علم التاريخ ليس علمًا من العلوم التطبيقية، كالرياضيات مثلًا لا شك في أن التاريخ قواعد وقوانين، ولكنها ليست في شكل القواعد التي تضمن لنا صحة افتراض وتوقع مجريات أحداث ما، أو تضمن صحة تحليل ما قد جرى فعلًا، إن التاريخ قصة حياة والحياة انعكاس للحرية والعفوية وعدم الخضوع للتوقعات، ولكن التعريف الحقيقي للحياة يظل سرًا، لذلك لن تقوم- ولا يمكن أن تقوم- إجابة علمية عن سؤال: ما سبب تخلف أمة ما؟
ومع أن غرض هذه المقالة ليس في بحث أو تعداد- على الأقل- أسباب تخلف الشعوب الإسلامية فإنني سأعرض هنا لذكر السببين الاثنين اللذين يبرزان أكثر من غيرهما، نظرًا إلى أهميتهما:
الأول- خارجي- وهو هجوم المغول.
والثاني- داخلي- وهو التفسير الديني المحض للإسلام.
أظن أن الوعي البشري ما زال لا يدرك إلى الآن كل الآثار المدمرة لكارثة الاجتياح المغولي مهما كتبنا وتحدثنا عنه لقد تم تدمير مئات المدن وكل ما صنعته يد الإنسان في مساحة مترامية الأطراف في منطقة حيوية بالنسبة للإسلام، في شكل لا مثيل له في تاريخ البشرية القديم والحديث إنه لمن قبيل المعجزات أن تنهض من جديد تلك الشعوب التي اجتاحتها جيوش المغول وأفنت بعض الشعوب عن آخرها؟
ومن جانب آخر كان التفسير الديني المحض للإسلام، الذي حصر الإسلام في دائرة رسالة دينية مهملًا ومنكرًا دوره في تنظيم وتغيير العالم الخارجي، عامل إضعاف داخلي لقوة ومناعة الأمة الإسلامية، وجعلها غنيمة سهلةللجيوش البربرية.
ولنعد الآن إلى الغرض الأصلي من هذا المقال، وهو محصور في محاولة استخلاص الإجابة عن السؤال- من خلال سلسلة من الأسباب: هل كان الإسلام- باعتباره دينًا وفكرًا ونمط حياة وفلسفة حياة الملايين من البشر الذين يسمون بالمسلمين- أحد عوامل تخلف الشعوب الإسلامية؟
لم تكن الشعوب الإسلامية- أو غالبها- متخلفة في الماضي- وأما اليوم فإنها متخلفة ولكنها لا تتبع الإسلام بالمفهوم العملي، إن التاريخ شاهدي لما قلته في الشق الأول، وأنا وأنتم ونحن جميعًا شهود على الشق الثاني إن الإسلام مجموعة تعاليم حواها القرآن الكريم والحديث الشريف والمصادر الأخرى المعروفة، ولكن الإسلام أيضًا عنوان لظاهرة تاريخية في العالم الواقعي، وعنوان للحركة التي أقامت نظام القضاء وأنشأت المدن والدول والحضارات، إن الإسلام سواء باعتباره رسالة أو ظاهرة تاريخية ليرفض الركود والتخلف.
ولنتذكر بأن الإسلام قد أتهم بأنه «دين السيف» ودين «أولئك الذين لا يخشعون حتى في صلاتهم»، وأن هدفه السيطرة على العالم، وليس تهيئة الإنسانية للمملكة الإلهية، وأن الصوم في الإسلام أقرب إلى نظام صارم منه إلى زهد وخشوع، وأنه دين اختلطت فيه القسوة بالرأفة والعبادة بالانغماس في ملاذ الدنيا.
إن هذا الهجوم بغض النظر عن بواعثه فيه جانب من الحق، لأن الإسلام يسعى دائمًا إلى تحقيق عالمين خارجي وداخلي، أخلاقي وتاريخي هذه الدنيا والآخرة، لذلك يمكن تعريف الإسلام بهذه الثنائية، يطالب الإسلام بالامتثال لله والعمل الصالح، ولكن رسالته الوحيدة للشر والبغي والأعداء، والأمراض وقلة النظافة والخرافة- هي الجهاد.
ويذهب الباحث الفرنسي جاك ريسلر Jacques Risler إلى أن الإسلام بني على ستة أركان- وليس على خمسة، ويضيف الجهاد ولا شك في أن أوثق من فسر روح الإسلام هم المسلمون في القرون المفضلة من هنا ستوضح الحقائق التي سنسردها أنهم أدركوا أن الإسلام يفرض على أتباعه تحرير وتغيير العالم، وأن الإسلام ليس دعوة إلى مجرد الاستسلام للمصير.
ظهر الإسلام سنة ٦١٠م بين قبائل جاهلة بعيدًا عن حواضر شعوب الحضارات القائمة آنذاك، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى سنة ٦٣٢م، ولكن بعد مرور مائة سنة فقط وقفت الجيوش الإسلامية تحت أسوار باريس في معركة بويتيرسا سنة ٧٣٢م! فلنتأمل بركان الحياة هذا ولننظر إلى ما جرى في هذه الوثبة العملاقة في غضون مائة عام فقط.
لقد قامت حضارة متكاملة مغايرة لجميع الحضارات المعروفة ووضعت أسسها على مدى مائة عام من الحركة الدؤوب والهدم والبناء، وتم احتواء شعوب متحضرة كاملة في هذه الرقعة الشاسعة بقوة الدين والعلم فقط فتحت سوريا سنة ٦٣٤م وفتحت دمشق ٦٣٥م، وكتيسيفون ٦٣٦ والهند ومصر سنة ٦٤١ وقرطاجنة ٦٤٧ وسمرقند ٦٧٦ والأندلس ۷۱۰ وأوقفت الجيوش الإسلامية في فرنسا سنة ٧٢٠م ووصل الدعاة المسلمون إلى الصين سنة ٧٢٩م وسلموا رسالة الخليفة إلى القيصر تاي شونغ وحصلوا على إذن بنشر الإسلام ثم أقاموا مسجدًا في مقاطعة كانتون الذي ما زال قائمًا للآن ويعد أقدم مسجد في هذا الجزء من العالم.
هذه النهضة أو تحرير للقدرات البشرية لا مثيل له «الفيلسوف سبنغلر O.Spengler» تظل فريدة من نوعها في تاريخ البشرية بذلك أصبحت الجزيرة العربية نبع دين وإرادة، كما يصف تلك الأيام هـ. غ ويلز H.G.Wels في كتابه « تاريخ العالم» هزمت البحرية الإسلامية بحرية البيزنطيين في معركة قرب اللاذقية سنة ٦٥٥م، ويظل إلى الآن غير واضح من أين حصل العرب على تلك السفن؟ يحاصر الخليفة معاوية بن أبي سفيان مدينة القسطنطينية سنة ٦٦٢ و٦٦٧م بينما تمتد الخلافة الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك وابنه الوليد «٦٨٥- ٧١٥م» من جبال يبريني غربًا حتى الصين شرقًا، ثم إن الدول الإسلامية في الأندلس والشرق الأوسط والهند مع مراكزها في قرطبة وبغداد ودلهي تمتد مدة ألف عام وعندما أخذ الإسلام يتراجع من الأندلس التي حكمها أزيد من ٧٠٠ عام وأزهر بأجمل زهور حضارته منسحبًا أمام الضربات الموجعة على يد محاكم التفتيش، فاضت ينابيعه الجديدة في آسيا الوسطى، ثم غمرت قسطنطينية، عبر البلقان فاضت في أوروبا.
حاصر العثمانيون مدينة فينا آخر مرة سنة ١٦٨٢م أي قبل نحو ٣٠٠ عام بينما سقط الحكم الإسلامي في الهند قبل نحو ٢٥٠ عامًا، بعد عهد وصف بأنه أجمل وأزهر عهد عاشته الهند في تاريخها «هـ. غ ويلز» أي في عهد أسرة المغول العظام من «١٥٢٦- ١٧٠٧م».
وأسرد هنا بعض الحقائق التاريخية لتقريب الصورة كان أكبر شاه- أحد ملوك من أسرة المغول العظام- أحد أكبر عظماء ملوك الهند، كما كان قد تبوأ مكانة بين عظماء الملوك في تاريخ الإنسانية الذين كانوا عظماء بتمام معنى الكلمة إن أغلب جوانب النظام الذي أقامه في الهند ما زال قائمًا إلى الآن- كان أشجع الشجعان في القتال، ولكن بمجرد تحقيق الانتصار يظهر في معاملة الأسرى المهزومين في منتهى الإنسانية وكان عدوًا لدودًا لجميع ألوان الظلم والوحشية سفر قوته لأعمال عظام وقت السلم، وأقام المدارس في أنحاء الهند، ومع أنه لم يدرك أهمية ذلك بقدر ما أدركه الإنجليز الذين قضوا على حكمه في الهند، إلا أنه عمل أكثر بكثير منهم لسعادة شعب بلده، الدكتور شميت Dr Schmidt في تاريخ العالم للهيلمهولتوف:
وكان حفيد أكبر شاه أور إنغزيب «١٦٥٨- ۱۷۰۷» حاكمًا فعليًا في:
كافة أراضي شبه الجزيرة الهندية وعلى القارئ الكريم أن يلاحظ أن ذلك لم يكن قبل زمن طويل جدًا!!
لم يهدم المسلمون شيئًا في الأراضي الخاضعة لسلطانهم، بل استوعبوا العلوم التي ازدهرت بين الشعوب الواقعة تحت حكمهم وأثروها ونقلوها إلى الشعوب الأخرى، ولا شك أن الفضل في هذا التصرف العام يعود إلى روح وتعاليم الإسلام. إن أحد قياصرة بيزنطة لم ينقطع عجبًا أمام إصرار القائد الهمجي على إدخال بند يضمن له حق شراء المخطوطات اليونانية من ضمن بند اتفاقية السلام، وكان هذا القائد الهمجي، قائدًا عربيًا مسلمًا.
لقد استوعب الإسلام إبداع الفينيقيين في مجال معالجة الزجاج، ومن المصريين في مجال النسيج، ومن السوريين في مجال القطن، ومن الفرس في مجال الحرير، يقول ريسلير: لقد كان نسيج البيزنطيين والأقباط والساسانيين ذائع الصيت في ذلك الوقت، ولكن المسلمين استطاعوا الحفاظ على مستوى روعته وهناك نماذج من الأقمشة المصنوعة في ذلك الوقت تحفظ في متحف لوفر في فرنسا والمتحف القيصري في اليابان، لم يدرك أحد حتى الآن مهارة وهندسة العرب في معالجة الزجاج.
يحتفظ متحف لوفر والمتحف البريطاني بقطع من روائع المصنوعات الزجاجية من سامراء وفسطاط، وكان الكيميائيون العرب أول من اخترع الصابون وأقاموا مصانع لإنتاجه، وكان للوزير الفضل البرمكي قصب السبق في إنشاء مصنع الورق في بغداد، ولكن صناعة الورق الذي اخترع في الصين تطورت وانتقلت بسرعة فائقة عن طريق المسلمين في الأندلس إلى أنحاء أوروبا، بينما ظلت مدينة سمرقند تنتج أجود أنواع الورق في العالم مدة طويلة من الزمن.
اختط العرب مدينة بغداد- المدينة السحرية من قصص ألف ليلة وليلة- بعد أن فتحوا بلاد العراق، وعندما حكمها الخليفة الأسطوري هارون الرشيد لم يكن قد مضى على تأسيس بغداد أكثر من خمسين سنة، ولكنها كانت حاضرة العالم في الثقافة والرخاء، وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد سكان بغداد في القرن الحادي عشر بلغ أكثر من مليونين، وكانت أكبر مدينة في العالم في ذلك الوقت، وعند حديثه عن هارون الرشيد راعي الحضارة الإسلامية، يقول ي ريسلر: «كانت عظمته تجذب نوابغ الرجال إليه مثل المغنطيس، فجمع حوله برلمانًا غير مألوف تكون من الشعراء والفقهاء والأطباء واللغويين والموسيقيين والفنانين»، ولم يسجل التاريخ أن قصر حاكم ما اجتمع فيه هذا العدد من العلماء الفطاحل، مثلما حصل في عهد هارون الرشيد، لأن عهده كان عهد حضارة راقية وتسامح.
وفي عهد ابنه الخليفة المأمون كان في أنحاء الخلافة الإسلامية أكثر من أحد عشر ألف كنيسة، ومئات المعابد اليهودية ومعابد عبدة النار، وأصبحت الجامعة النظامية التي أسست سنة ١٠٦٥م أنموذجًا اتبعته أغلب المراكز العلمية في كبرى مدن الخلافة، وكانت تدرس علوم القرآن والحديث والفقه- خاصة فقه المذهب الشافعي- وعلم اللغة والأدب والتاريخ وعلم حضارات الشعوب والآثار والفلك والرياضيات والكيمياء والفيزياء والموسيقى والهندسة، بعد قيام النظامية بمدة وجيزة أسست في بغداد الجامعة المستنصرية وكانت بحق مركز العالم الإسلامي يرعى علوم الفقه والعلوم التطبيقية والأدب والفنون وغيرها، وهذا النظام الحقيقي لتدريس العلوم هو النظام ذاته الذي قلده الغرب بعد ذلك بتوحيد علوم المذاهب النصرانية الأربعة في جامعة باريس.
كانت الدراسة في المراحل الابتدائية- ما يعرف اليوم بالمدارس الابتدائية والثانوية- بدون مقابل ومن أجل السماع من إعلام عصرهم والأخذ عنهم رحل آلاف طلبة العلم إلى مكة والمدينة والقاهرة ودمشق وبغداد، وأثناء رحلتهم العلمية قدمت لهم خدمات المبيت والطعام والدراسة بدون مقابل في جميع المدن التي مروا بها، وبعبارة أخرى يمكن أن نستخلص مما ذكرنا: إننا نرى في العالم الإسلامي في القرنين العاشر والحادي عشر ظاهرة لم نسمع بها قط في أي حضارة أخرى أينما يممت وجهك ترى الشغف بالكتاب والعلم، تدوي أصوات أفصح العلماء في آلاف المساجد، تعج قصور الحكام والأمراء بحلقات الشعراء والفلاسفة، تقابل في الطرقات علماء جغرافيا وتاريخ وشريعة يبحثون- عن العلم، إن هذه المرحلة لهي أهم مرحلة في تاريخ الفكر الإسلامي» «ي ريسلر».
وكان الإسلام يحكم العالم خمسمائة سنة من «۷۰۰ - ۱۲۰۰م» بمحض تفوقه الحضاري على الأمم الأخرى «كان الخليفة الناصر في مدينة مراكش يتباحث مع الفيلسوف ابن رشد في فكر أرسطو وأفلاطون في وقت كان أمراء ونبلاء الدول الغربية يتفاخرون بأنهم لا يعرفون القراءة أو الكتابة».
كان الخليفة الحاكم الأموي يملك مكتبة تحتضن ٤٠٠ ألف مجلد وكان ملك فرنسا كارلو الخامس الملقب بـ«المعلم» يفتخر بعد ذلك بأربعمائة سنة بمكتبته التي تكونت من أكثر من ألف مجلد ويذكر اليعقوبي أنه أحصى سنة ٨٩١م أكثر من مائة مكتبة في بغداد وحدها، ويضيف ي ريسلر «لم يجرأ أحد من أغنياء المسلمين على إمساك ماله عن الإنفاق في العلم والأدب والفنون».
وحوت خزانة مكتبة مدينة النجف الصغيرة في العراق ما يزيد على ٤٠ ألف مجلد، ومكتبة أبي الفداء أحد الأمراء الأكراد من حماة- ٧٠ ألف مجلد، ومكتبة المؤيد من جنوب الجزيرة العربية أكثر من ١٠٠ ألف مجلد ومكتبة مراغة ٤٠٠ ألف مجلد، وكانت أسماء الكتب الموجودةفي مكتبة مدينة الري مدونة في عشرة سجلات «فهارس» ضخمة ولكن أضخم مكتبة وقتئذ وجدت في العالم كانت مكتبة العزيز في مدينة القاهرة، وحوت مليون وستمائة ألف «١,٦٠٠٠,٠٠٠» مجلد منها ٦,٥٠٠ مجلد في الرياضيات، و۱,۸۰۰ مجلد في الفلسفة، وأما مكتبة مدينة بخاري فقد وصفها الفيلسوف الشهير ابن سينا بقوله «رأيت فيها كتبًا لا وجود لها في أي مكان في العالم»، وفي معرض ذكره للحاكم الإسلامي العظيم في الأندلس الإسلامية عبد الرحمن الأول، ومحاولته جمع كل العلماء من مختلف الأجناس في الجزء الغربي من الخلافة، مثل العرب والبربر والمرابطين والأندلسيين يقول ي ريسلر: «إن هذا الهدف كان في حقيقة أمره حركة استطاعت عبر القرون القادمة النهوض بالأندلس الإسلامية إلى ذروة الحضارة البشرية وعند وفاة الخليفة عبد الرحمن الأول سنة ٧٨٨م كانت الأندلس الإسلامية أضاءت عالم الغرب بأنوار علوم الشعر والفنون والهندسة».
ويذكر العالم الهولندي دوزي أن جميع سكان الأندلس الإسلامية كانوا يحسنون القراءة والكتابةفي وقت كانت الكتابة حكرًا على عدد من رجال الكنيسة، ويضيف: لقد جذبت هذه الحضارة المزدهرة رجال الكنيسة وعامة الناس في الغرب النصراني ورحلوا بكل حرية إلى قرطبة وإشبيلية وطليطلة ليحضروا محاضرات مشاهير العلماء المسلمين في الجامعات الإسلامية.
وكانت الزراعة بلغت مستوى عاليًا من التقدم في أرجاء بلاد الخلافة لأنها كانت تحت تأثير مباشر لمعطيات العلوم، ونظرًا إلى ضيق الوقت للاسترسال في هذا الموضوع، فإننا سنسرد بعض الحقائق الموجودة في متناول يدنا: عينت الدولة موظفًا رسميًا مسؤولًا عن شبكة الري في جميع أقاليم الدولة الإسلامية.. وقد ظهرت بحوث علمية في مدينة إشبيلية تناولت تفاصيل زراعة ما يزيد على خمسين نوعًا من الفواكه وذكرت أمراض النباتات وأساليب علاجها... وكان إنتاج الحرير في بلاد فارس ارتقى إلى مستوى الإنتاج وفق الحقائق العلمية، لذلك استطاعت الفرس تغطية احتياجات الأسواق الأوروبية في الحرير لمدة تزيد على مائة عام، ويصف الإدريسي وصفًا دقيقًا ٣٦٠ عقارًا من العقاقير المستخدمة في استخراج الأدوية، بينما قام ابن العباس من إشبيلية بإجراء أبحاث في نباتات البحار، وبذلك استحق لقب «النباتي»... وفي سنة ١١٩٠م اشتهر أبو العوام بكتابه «كتاب الفلاحة» في إشبيلية أيضًا، وصف فيه أنواعًا من نبات وفواكه وذكر أنواعًا رئيسية من الأسمدة.. إن هذا التطور الكبير في علوم الزراعة يعتبر أحد المنافع المستمرة التي استفادتها دولة إسبانيا الحديثة من حضارة العرب، وكانت حالة الرخاء قد عمت وادي دجلة والفرات والنيل، كما عمت سكان هضاب الفرس وسوريا بقدر ما عمت الحواضر والموانئ على سواحل البحار «ي ريسلر».
وصل الطب والصحة إلى مراحل متقدمة جدًا، وهذا ما يهمنا بشكل خاص، لأن هذا الجانب- بدون شك- يدخل ضمن النتائج المباشرة لأوامر وفروض الإسلام، يزيد عدد الأحاديث التي تتحدث عن الطب والصحة عن ۳۰۰ حديث، وقد جمعت في كتاب الطب النبوي، والنتيجة المباشرة لهذا أننا نجد في كافة المناطق التي خضعت يومًا ما للسلطة الإسلامية عناية خاصة بشبكة المياه والحمامات والمستشفيات، هذه هي الوظيفة العامة للحكومة الإسلامية، نجد أربعة وثلاثين مستشفى في أنحاء الدولة الإسلامية سنة ٨٥٠م، وقد كان مستشفى «بیمارستان» دمشق يدار من تبرعات الدولة السخية، وكان مجهزًا تجهيزًا فائقًا ومفتوحًا أمام الأغنياء والفقراء، ويديره فريق مكون من أربعة وعشرين طبيبًا مختصًا يقول نيوبورغر Neuburger أستاذ تاريخ الطب: «إن جميع الرحالين في القرون الوسطى- وهم جم غفير- متفقون في إعجابهم بمستشفيات الشرق، وكان تنظيم وإدارة المستشفيات يمثل أحد أروع منجزات الحضارة الإسلامية».
وقد أقيمت شبكة المياه في سراييفو - بـ١٤٨ سنة قبل لندن و٣٧٨ سنة قبل فينا: إن الحمامات العامة ظاهرة مألوفة وخاصية من خصائص الإسلام، وكان الاهتمام بالنظافة الشخصية شيئًا اعتياديًا في بيوت المسلمين أغنيائهم وفقرائهم على حد سواء، تدل على ذلك حمامات في غرف مفردة داخل البيوت، ولمجرد المقارنة نضرب مثلًا بصورة واقعية عن حي هارلم المخصص للسود في نيويورك- من النصف الثاني من القرن العشرين الذي تنتشر في شوارعه الروائح الكريهة والقمامة ورائحة أنواع الخمر الرخيصة وبيوت الدعارة.
أمر الخليفة المنصور سنة ٧٧٣م بترجمة كتب علم الفلك التي كتبت حول سنة ٤٢٥ قبل الميلاد من اللغة الساسانية، كان إبراهيم الزركلي وضع جداول طليطلة، في ضبط دوران الكواكب، وظلت أساس علم الفلك في أوروبا مدة طويلة، وقد فتح البيروني الطريق أمام كوبيرنيك يدحض نظرية انحراف الكواكب عن مراكزها التي وضعها بطليموس في تفسير دوران الكواكب، وتمكن عمر الخيام «المشهور في الغرب بشعره» أكثر من علومه من وضع تقويم أدق من التقويم الغربي الذي نستخدمه اليوم، لأنه يخطئ في حساب يوم واحد كل خمسة آلاف سنة، بينما التقويم الغربي المستخدم يخطئ في حساب يوم واحد كل ثلاثة آلاف وثلاثمائة سنة.
وكانت كتب ابن الهيثم، العالم المسلم من الأندلس، في علم البصريات أساسًا لبحوث علماء أوروبا مثل كابلير وغيره، بينما قال عالم الرياضيات شاسليس Chasles في القرن التاسع عشر عن بحوث ابن الهيثم: «إنها كانت أساس وكنه ما توصلنا إليه في مجال علم البصريات ويضيف عالم الفلك بايغورد أين Bigourdain : كانت بحوثه أدق بكثير من نظرية بطليموس: إن النتيجة العامة التي يخرج بها سايديلوت Sedilot في دراسة علم الفلك عند العرب هي وصلت مدرسة علم الفلك في بغداد في نهاية القرن العاشر إلى أقاصي حدود المعرفة التي كان يمكن للإنسان الوصول إليها دون استعمال العدسات والمرقب «التلكسوب».
ونجد أثر الشعر العربي واضحًا في ملحمة رونالد أول ملحمة كبيرة في الأدب الغربي كتبت سنة ۱۰۸۰م تقريبًا كما لا ينكر أحد تأثير الشعر العربي في الشعراء مثل بوكاشو Chancer وشانسير G.Boccaccio وتنيسون A.Tenny son، ويراونينغ ,R.Browning وكان الشاعر دانتي، كاتب الكوميديا الإلهية تحت تأثير قوي للشعر الإسلامي» حفلت فصول هذه الملحمة الرائعة بأوصاف عربية أصيلة لرحلة في أسرار ملكوت السماء والجحيم، يقول أحد نقاد الأدب، ويعزو باروخ كالمي Baruh Kalmy هذا التأثير إلى تأثير مباشر للقرآن الكريم والإسراء والمعراج بينما يعزوه آخرون إلى الأدب العربي، وخاصة إلى كتب الفيلسوف ابن عربي من القرن الثالث عشر «ي ريسلر».
إن فكرة رواية «دون كيخوته»- Don Qui jote مقتبسة في أصلها من العرب، لأن المؤلف Miguel de Cervanantes سيرفانتس عاش مدة طويلة أسيرًا في الجزائر، واعترف بأنه كتب روايته هذه باللغة العربية أولًا، كما أن الأديب دانيال ديفو Daniel Defoeاستلهم فكرة روايته الشهيرة روبينسون كروسو- Rob inson Crusoe من كتاب «حي ابن يقظان» للفيلسوف العربي ابن طفيل،... إلخ
ولا بد لي في هذا المقام من الاعتذار إلى القارئ الكريم لأنني أمطرته بوابل من الحقائق التي كان لا مفر من إيرادها، لأفسح أمامه مجالًا كي يجيب بنفسه وفي نفسه عن السؤال: هل الإسلام يخدر ويثبط قوة وإرادة شعب ما؟ وهل يمكننا قبول رأي يرى أن الإسلام الذي كان مصدر إلهام وحركة إبداعية أقامت مدنًا ودولًا في عهوده السالفة، يأتي اليوم- أو في أي زمان مستقبلي- بنتائج مخالفة كليًا لما كان عليه؟
«*» رئيس جمهورية البوسنة والهرسك.
- نقله إلى العربية: حسين عمر سباهيتش.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل