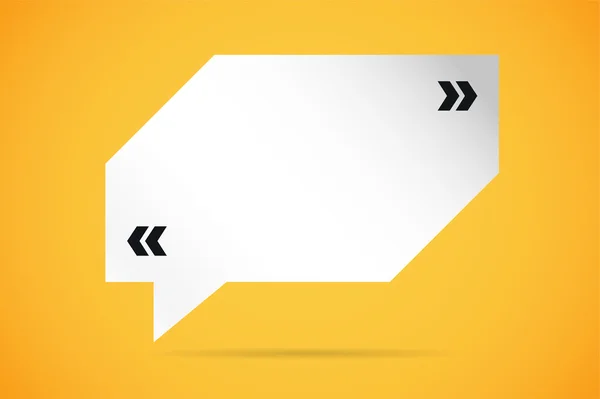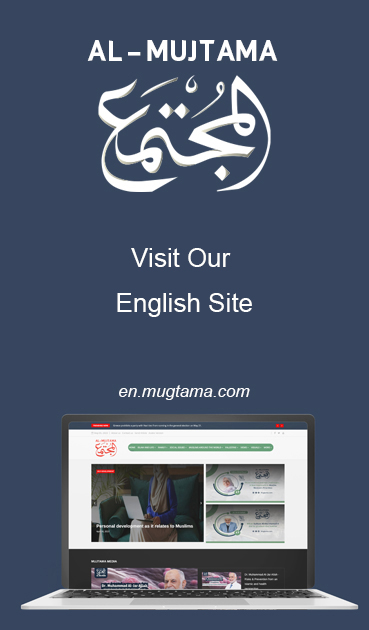أوجه انتفاع المسلمين بالنبي ﷺ في الدنيا

كان لابتعاث النبي صلى الله عليه وسلم أثر بالغ في تغيير الأفراد الذين استيقنوا صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به وصدقوه ودافعوا عنه؛ لأنهم وجدوا في الوحي الإلهي ما يرفع قدرهم ويقدر شأنهم ويحترم كرامتهم وإنسانيتهم، فتعددت منافع النبي صلى الله عليه وسلم نحوهم في الدنيا، ومن هذه المنافع:
أولاً: حرص النبي على المؤمنين:
بذل النبي صلى الله عليه وسلم جهده وتحمل الأذى من أجل أن يصل الإسلام إلى الناس، فقد قال الله عز وجل: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ) (التوبة: 128)؛ أي حريص عليكم أن تؤمنوا(1)، حَرِيصٌ عَلَى هِدَايَتِكُمْ ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم(2).
ووصف النبي صلى الله عليه وسلم مدى حرصه على المؤمنين بأنه يريد الخير لهم وإبعاد الضرر عنهم، فقال: «إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنتم تقحمون فيها»(3).
ثانياً: العفو عن الخطأ والنسيان وحديث النفس:
رحمة الله بالمؤمنين بالله ورسوله واسعة، منها أن المسلم إذا أخطأ أو نسي شيئاً، فإن الله تعالى يعفو عنه، فقد روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ الله تعالى تجاوز لي عن أمّتي الخطأ، والنّسيان، وما استكرهوا عليه»، فقد كان -في الأمم السابقة- حكم الناسي كالعامد في الإثم، وأن ذلك من الإصر الذي كان على من قبلنا(4)، فالله تعالى رفع بعفوه الإصر عن المؤمنين الذي كان على الأمم السابقة بسبب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أما حديث النفس، فقد روى مسلم أنه لما نزل قول الله تعالى: (وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ) (البقرة: 284) جاء أبو بكر، وعمر، وعبدالرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وناس من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، والله ما نزلت آية أشد علينا من هذه الآية، إن أحدنا ليحدث نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبه وأن له الدنيا وما فيها وإنا لمؤاخذون بما نحدث به أنفسنا هلكنا والله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هكذا أنزلت»، فقالوا: هلكنا وكلفنا من العمل ما لا نطيق، قال: «فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا، قولوا: سمعنا وأطعنا»، فقالوا: سمعنا وأطعنا واشتد ذلك عليهم، فمكثوا بذلك حولاً، فأنزل الله تعالى الفرج والراحة بقوله: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) (البقرة: 286)، فنسخت هذه الآية ما قبلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد تجاوز لأمتي ما حدثوا به أنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلموا به»(5)، فقد رفع الله تعالى الحرج والمشقة عن المسلمين فيما يتحدثون فيه داخل نفوسهم، فلا يعاقبون على ذلك ما لم يصدر منهم كلام أو تعمل جوارهم ما حدثت به نفوسهم.
ثالثاً: تيسير التشريع:
كانت بعض جوانب التشريع فيها من المشقة على الأمم السابقة، لكنها أصبحت ميسورة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل قال: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: 185)، فشريعته صلى الله عليه وسلم أكمل الشّرائع وأسهلها وأيسرها، ومن الأمثلة على مظاهر هذا التيسير:
أ- العلاقة الزوجية:
روى مسلم عن أنس أنّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل الصحابة النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) (البقرة: 222)؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كلّ شيء إلّا النّكاح»، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرّجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلّا خالفنا فيه.
ب- تخفيف العقوبة:
عن عبدالله بن مسعود قال: كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح قد كتب كفّارة ذلك الذّنب على بابه، وإذا أصاب البول شيئاً منه قرضه بالمقراض، فقال رجل: لقد آتى الله بني إسرائيل خيراً، فقال عبدالله: ما آتاكم الله خير ممّا آتاهم، جعل الله الماء لكم طهوراً، وقال: (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء: 110)(6).
فهنا يتضح أن الله كان يظهر ذنب المذنب فيما سبق، ومن أصاب بوله ملابسه قطع موضع النجاسة من ثوبه، على أن ذلك أصبح ميسوراً في الإسلام، فيستر الله على عبده الذنب، وجعل الماء طاهراً لما أصاب ثوبه من نجاسة.
جـ- القصاص:
روى البخاري عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) (البقرة: 178)، قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فالفرق واضح بين لا حل إلا القصاص، وبين أن القصاص حل والعفو وقبول الدية حل آخر، فدل ذلك على يسر شريعة الله بوجود النبي صلى الله عليه وسلم.
رابعاً: الثواب الكثير بالعمل القليل:
منح الله تعالى المسلم أجوراً كثيرة بأعمال قليلة، سواء كانت هذه الأعمال قولية أو فعلية أو قلبية.
فالأعمال القولية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمدُ وهو على كل شيء قديرٌ في يومٍ مائةَ مرة، كانت له عَدلَ عشرِ رقابٍ، وكُتِبَت له مائةُ حسنةٍ، ومُحِيَت عنه مائةُ سيئةٍ، وكانتْ له حِرزًا من الشيطانِ يومَه ذلك حتى يُمسي، ولم يأتِ أحدٌ أفضَلَ مما جاء به إلا أحدٌ عمِلَ أكثرَ من ذلك»(7)، فهذا الذكر يرفع الله به درجات المسلم ويحط عنه الأوزار ويبعد عنه الشيطان، ويصبح به المسلم من أفضل الناس عند الله عز وجل.
والأعمال الفعلية كالصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فرض الله عليَّ خمسين صلاة، فرجعت بذلك، حتى أمُر بموسى، فقال موسى: ما الذي فرض على أمتك؟ قلت: فرض عليهم خمسين صلاة، قال: فراجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فرجعت فراجعت ربي فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى، فقال: راجع ربك، فذكر مثله فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فرجعت فراجعت ربي، فقال: هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لديَّ، فرجعت إلى موسى، فقال: راجع ربك، فقلت: قد استحييت من ربي»(8)، فالصلاة خمس في العمل وخمسون في الأجر.
والأعمال القلبية؛ كسلامة الصدر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: «تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا(9)، فالله تعالى يفتح الجنة لمن سلم صدره وصلح فؤاده ونقى قلبه.
_________________
(1) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (8:302).
(2) تفسير القرآن، ابن كثير (4:211).
(3) رواه البخاري (6118).
(4) فتح الباري: ابن حجر (11/ 560).
(5) أسباب النزول للواحدي، ص96.
(6) تفسير الطبري (5/ 175).
(7) رواه البخاري (3119).
(8) رواه البخاري (3164).
(9) رواه مسلم (2565).