حول التخلف الحضاري في العالم الإسلامي وأسبابه
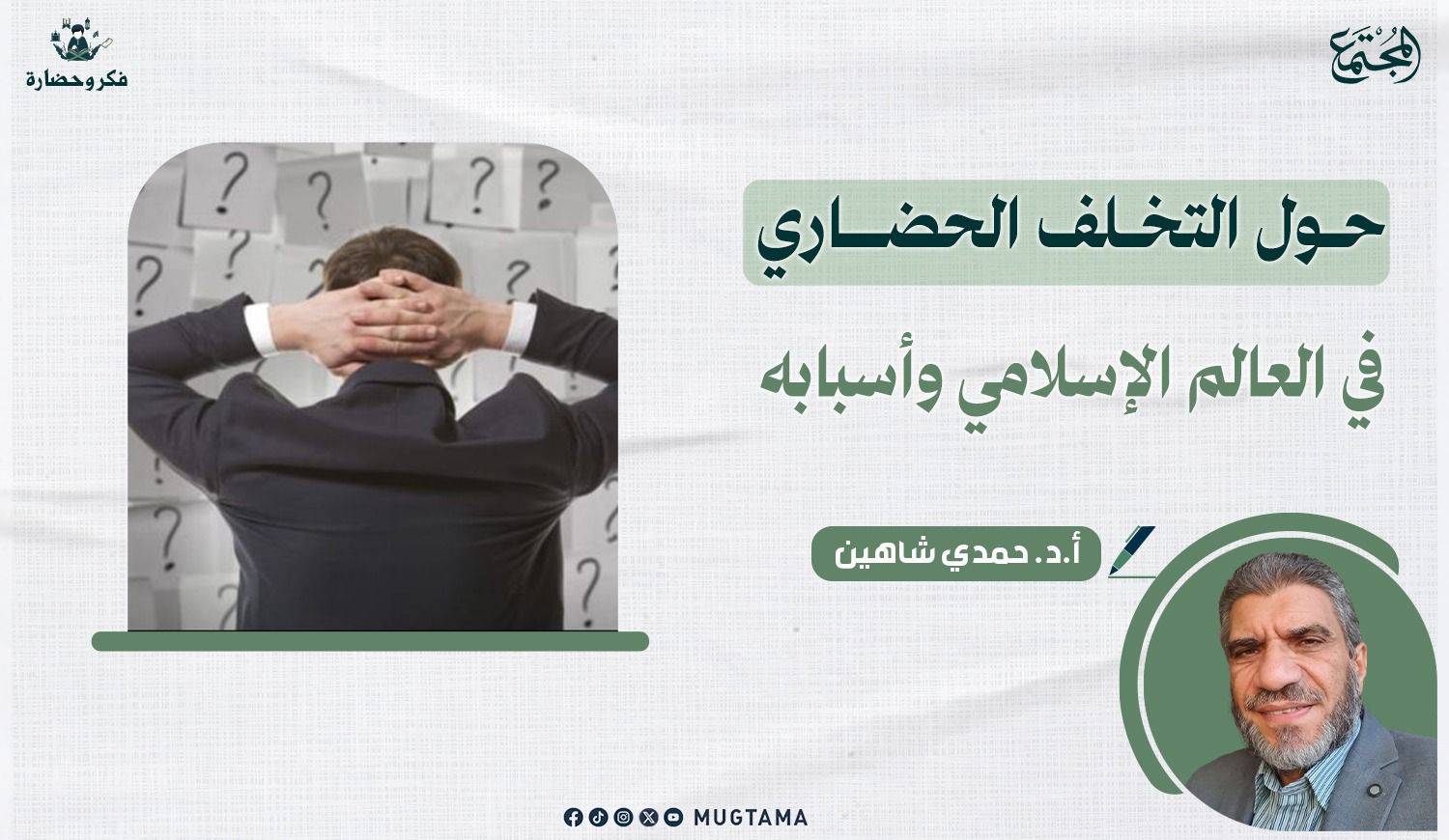
يربط أبو الأعلى
المودودي في كتابه «نحن والحضارة الغربية» بين التأخر الحضاري في العالم الإسلامي
والانهزام النفسي أمام الغرب، حيث المتصدرين سباقات العلم وتطبيقاته، فيقول: «لما
انقطع في المسلمين نبوغ أهل الفكر وأصحاب التحقيق، ولما ترك القوم مزاولة التفكير
والبحث والتدقيق، وقعد بهم اللغوب عن موالاة الاجتهاد وتحصيل العلم، فلكأنهم
تنازلوا من تلقاء أنفسهم عن مكانتهم في قيادة العالم، ونهضت من جانب آخر أمم الغرب
تتقدم في هذا السبيل».
ويلخص مالك بن نبي في كتابه «شروط النهضة» أسباب أزمة العالم الإسلامي بقوله: «إن جوهر المسألة
هو مشكلتنا العقلية»، ويعني بها التجافي الحاصل بين الهوية الإسلامية -التي يجب أن
تنبع منها الحضارة- والواقع العقلي والثقافي للأمة.
لقد أوضح
المفكران المسلمان بعض أهم أسباب تأخر المسلمين، ومنها التأخر في سباق العلم
والبحث الدقيق، وتعارض سعيهم في اللحاق بركب المتصدرين مع هويتهم الراسخة التي
برهن التاريخ على أن التوافق معها، والانبعاث منها هو السبيل للنهوض.
من مظاهر التخلف الحضاري في العالم الإسلامي
تتعدد المظاهر
الدالة على عمق الهوة العلمية التي تردى فيها العالم الإسلامي منذ عقود من الزمن،
وآلت إلى ما يعانيه اليوم، بعدما عاش قرونًا من الألق العلمي والزهو الحضاري الذي
تأسس على القيم الأصيلة لبنائه العقدي، وامتد عطاؤه الثري ليشمل عالم تلك القرون.
فالأمة التي
خاطبها القرآن الكريم بأول نداء إلهي: «اقرأ»، بلغت فيها نسبة الأمية نحو 40% في
صفوف الذكور، و65% في صفوف الإناث، وفق تقرير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم
والثقافة (إيسيسكو) عام 2014م، أما في العالم العربي فقد ذكرت المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، أن نسبة الأمية فيه تجاوزت 19%؛ أي أن عدد
الأميين به يفوق 96 مليوناً.
وذهبت بعض
التقارير المنسوبة إلى عدد من المراكز البحثية إلى أن متوسط القراءة في العالم
العربي ربع صفحة للفرد سنويًا، بينما تصل معدلات القراءة سنويًا للفرد في أمريكا
إلى 11 كتاباً، وتصل في بريطانيا إلى 7 كتب، وقد تشكك بعض الباحثين، مثل لي كادويل،
في صدقية هذه التقارير، وأكد أنه استقصى ما تنسب إليه من مصادر فلم يجد نسبة منها
صحيحة.
وإذا نظرنا إلى
الأوضاع في جامعاتنا العربية والإسلامية، فإن هناك 14 جامعة فقط تنتمي إلى الدول
الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في قائمة أفضل 500 جامعة في العالم، ضمن تصنيف
التايمز للجامعات العالمية عام 2021.
أما في تاريخ
جوائز «نوبل» التي من المفترض أن تعطى لأكثر العلماء تميزًا في مجاله، فإن نصيب
العالم الإسلامي منها في مجال العلوم 3 جوائز، حيث حصل العالم الباكستاني د. محمد
عبدالسلام في عام 1979 على جائزة «نوبل» في مجال الفيزياء، كما مُنح العالم المصري
د. أحمد زويل جائزة «نوبل» في الفيزياء عام 1999م، وفي مجال الكيمياء حصل د. عزيز
سنجار من تركيا على جائزة «نوبل» عام 2005م.
وفي دائرة البحث
العلمي والتطوير، فإن البيانات المتاحة عام 2016م تشير إلى أن نسبة إنفاق الدول
الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على البحوث والتطوير تبلغ 0.37% من إجمالي
الناتج المحلي لهذه الدول، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 1.75%، بحسب
دراسة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب التابع لمنظمة
التعاون الإسلامي (sesrıc): التعليم والتنمية العلمية في الدول
الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عام 2016، أما في العالم العربي فلم يتجاوز
معدل الإنفاق القومي على البحث العلمي عام 2020 في الدول العربية قاطبة 0.72 %،
بينما بلغ في دولة الاحتلال الصهيوني 5.44%،
بحسب تقرير منشور على موقع البنك الدولي.
ووفقاً
للإحصاءات الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في عام
2014م، يصل العدد الإجمالي لطلبات براءات الاختراع في جميع أنحاء العالم نحو 2.68 مليون،
بينما بلغ في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 46781 براءة اختراع؛ أي نحو
1.74% منها.
ويتراوح عدد
مستخدمي الإنترنت بين 3 لكل ألف فرد في السودان، و313 لكل ألف في الإمارات العربية
المتحدة، وأقل من 50 مستخدماً لكل ألف في 11 بلدًا عربيًا (تقرير السكان والتنمية،
العدد الثالث «الهجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية: التحديات والفرص»،
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا): الأمم المتحدة، نيويورك، عام
2007).
ولا سبيل لتجاوز
تلك الهوة العلمية إلا بإحداث نهوض علمي شامل يعالج أسباب التخلف والعجز، ويأخذ
بأسباب الانبعاث الحضاري والقوة العلمية، في زمن لا يعترف إلا بالأقوياء في شتى
مجالات الحياة.
ويمكن رد أسباب
ذلك التخلف العلمي في العالم الإسلامي إلى مجموعتين من الأسباب؛ داخلية وخارجية:
1- الأسباب الداخلية للتخلف العلمي:
وترجع في
مجموعها إلى سوء فهم الموروث الثقافي والديني للأمة، فقاد ذلك المشهد الثقافي على
مدى عقود إلى مهالك دفعت الأمة ثمنها في عصورها المتأخرة، ولم تكن بها بصيرة، إذ
غطت أنوارُ التقدم السالف أسبابَ الضعف، حيث ظلت الأمة ردحًا سائرة بالقصور
الذاتي.
من ذلك إهمال
العلوم التجريبية العملية، أو علوم الحياة من طب وهندسة وفلك وطبيعيات، مع تغليب
العلوم النظرية من تفسير وفقه وتاريخ، وقسموا العلوم فجعلوا منها العلوم «الشريفة»
المتصلة بالشرع الحنيف، والعلوم الأخرى المتصلة بعمارة الكون، مع أن عمارة الكون
إحدى صور العبادة الشاملة في الإسلام، بل إن الغاية من الخلق هي عمارة الدنيا
بالدين، فلا فصل بينهما، ولم يفيقوا من خطأ ذلك إلا على سنابك خيل الغزاة الذين
أخذوا بأسباب العلوم.
ويتصل بهذه
الأسباب التي أدت إلى الضعف إغلاق باب الاجتهاد في العلوم الشرعية، ناهيك عن
الدنيوية، فجمدت، وأسن نهرها، وكان دفَّاقًا فيما مضى، واقتصروا على مذاهب الفقه
المعروفة المستقرة، والشروح حولها والحواشي، ولم ينتبه كثير من الدعاة إلى أن
النصوص الشرعية تتناهى، والمستجدات الحياتية لا تتناهى، ولا سبيل إلا الاجتهاد
المستمر بضوابطه، لتنزيل النصوص الشرعية على وقائع الحياة.
كما وسَّعوا
مفهوم البدعة ليشمل كل جديد، فخلطوا معناها بمعنى الإبداع الواجب في الحياة،
وأساؤوا الظنون بكل جديد مما لم يألفوه، فأساء ذلك الفهم إلى حقيقة الدين الخاتم
الذي جاء ليحكم حركة الحياة إلى قيام الساعة.. ووقف بالأمة وخصومها يسابقون إلى
ساحات التقدم، ويرتادون عصر البخار فالكهرباء فالذرة فالفضاء.
2- الأسباب الخارجية للتخلف العلمي والحضاري:
وهناك جملة من
الأسباب الخارجية للتخلف العلمي والحضاري نشير منها إلى اجتذاب العقول الإسلامية إلى الغرب وهجرتها إليه، حيث استطاع اجتذاب جملة من أذكى العقول، وأجود الخبرات
إليه، وقد تفاقمت هذه الهجرات في الألفية الجديدة إثر الاضطرابات السياسية
والثورات الشعبية والانقلابات العسكرية والتدخلات الأجنبية.
في الوقت نفسه،
تتعدد العوامل الداخلية التقليدية الطاردة للعلماء، ومنها ضعف العوائد المالية،
والميزانيات العلمية، في حين نجد العوامل الجاذبة لهم في الغرب كاحترام العلماء،
والتقدير الأدبي والمادي لهم، وانفتاح أبواب الحياة الكريمة أمامهم، وتوفر
ميزانيات البحث العلمي ووسائله، وأجواء الترقي العلمي وآفاقه.
















