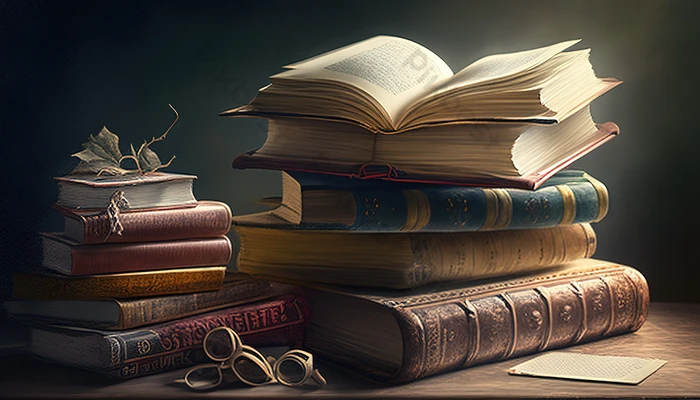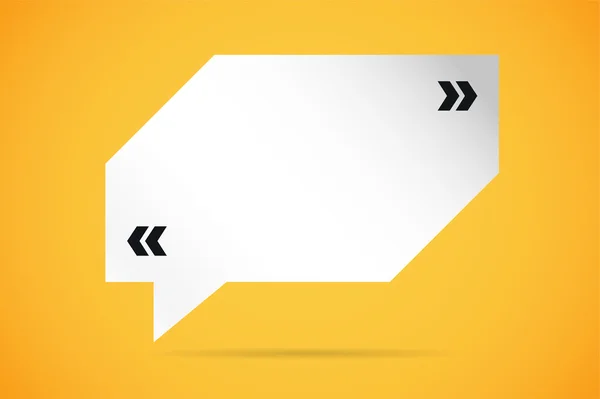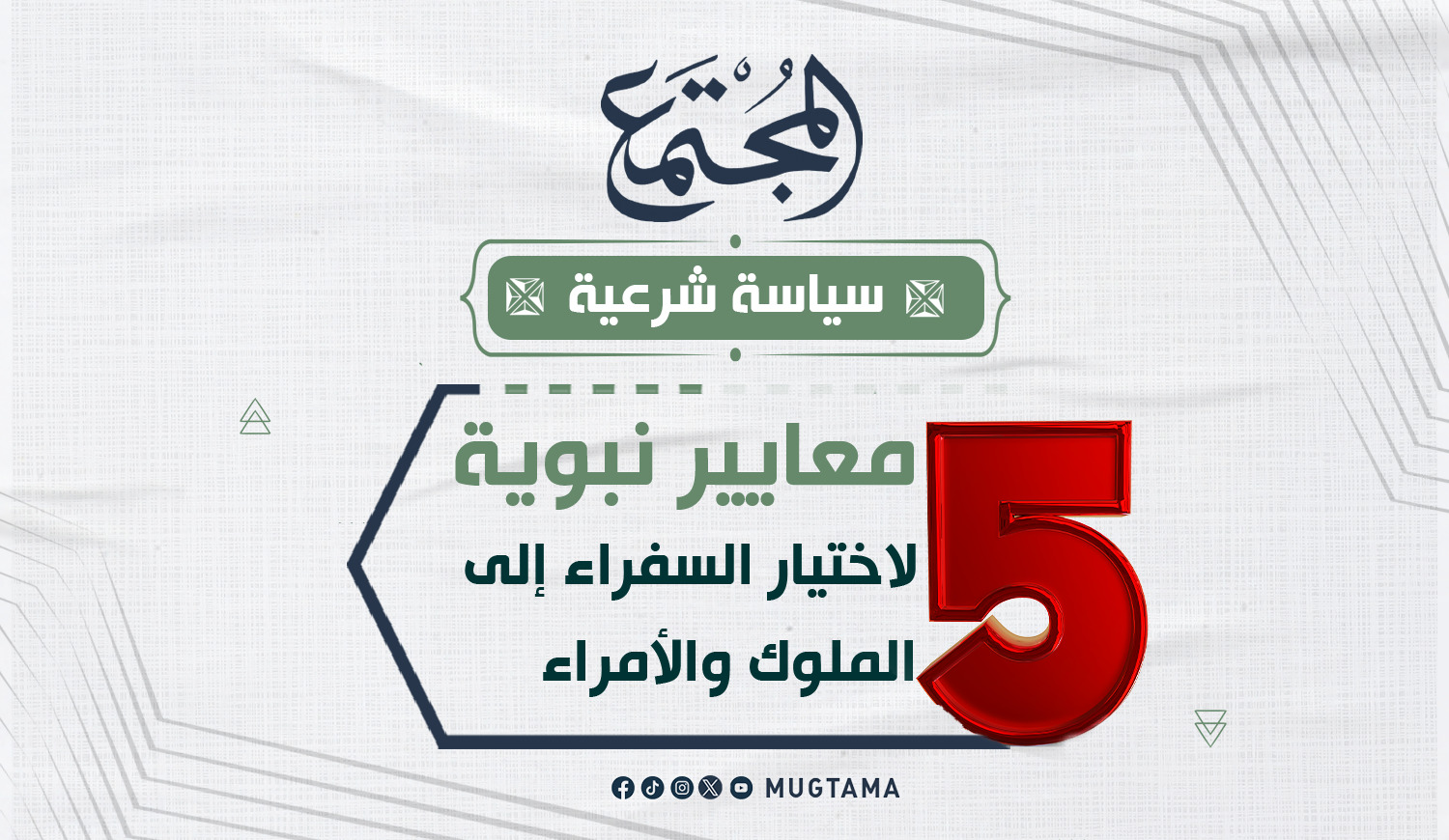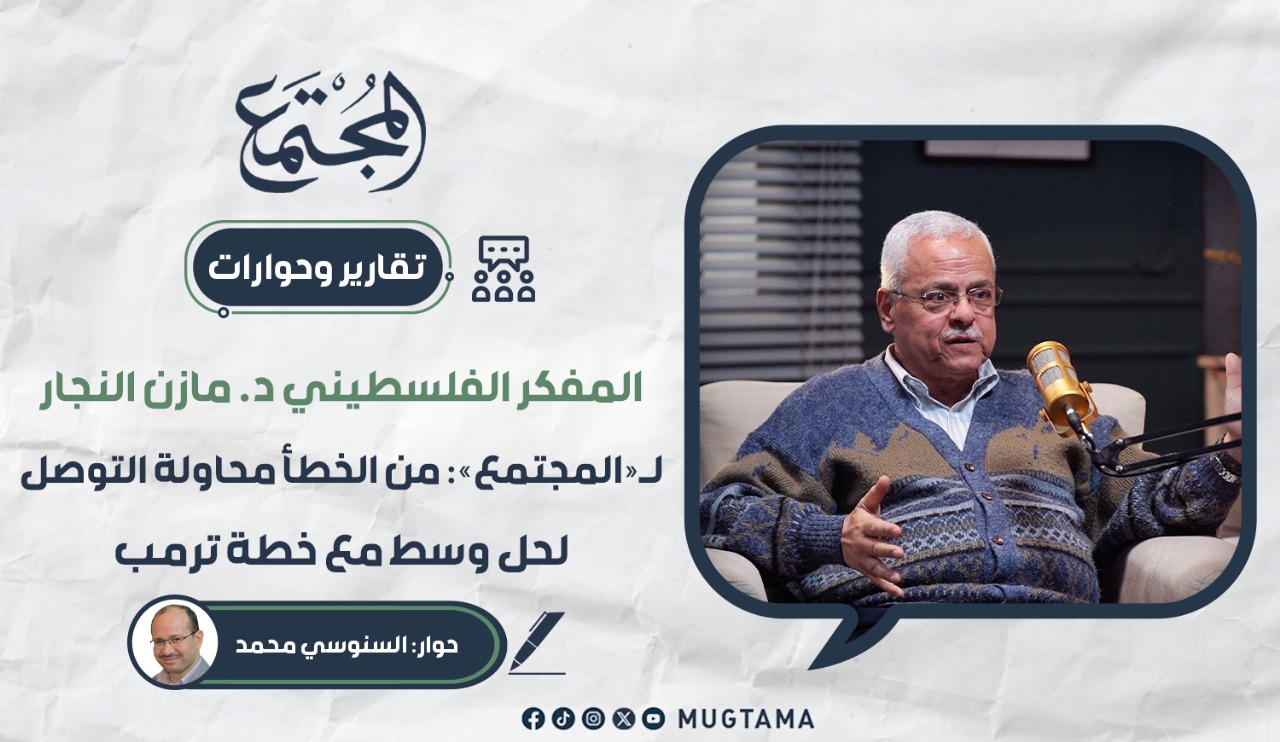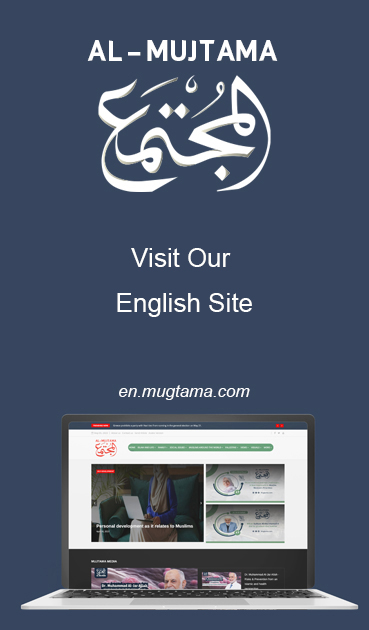الأخلاقيات السياسية عند ابن أبي الربيع

اعتبر المنظرون المسلمون السياسة مجالاً لا ينفصل عن القيم والأخلاق، حيث ذهبوا إلى أن الأخلاق لا يقتصر دورها على تقويم وترشيد الممارسة السياسة، ولكنهم ذهبوا إلى إمكانية دمجها في السياسات العامة بحيث تتحول إلى إجراءات واقعية، وهذا الدمج نجده لدى جل المنظرين السياسيين المسلمين في مصنفاتهم المعروفة باسم «الآداب السلطانية» و«السياسة الشرعية» و«مرايا الملوك»، وهو ما نجده لدى الماوردي في «الأحكام السلطانية»، والمرادي في «الإشارة إلى أدب الإمارة»، وابن الأزرق في «بدائع السلك في طبائع الملك»، وكذلك ابن أبي الربيع في «تدبير المالك في سلوك الممالك» الذي أقام كتابه على إثبات الصلة العضوية بين القيم والسياسة، وكيفية التخطيط للسياسات العامة على نحو يستوعب القيم.
وفيما يلي نقدم نبذة عن تصور ابن أبي الربيع السياسي:
المعلومات حول شخصية ابن أبي الربيع شحيحة فلا يعرف عنه سوى أنه عاش ابن أبي الربيع في بغداد في القرن الثالث الهجري، وأنه وضع كتابه سلوك المالك بطلب شخصي من الخليفة المعتصم العباسي، وهو ما يعني أنه عاش في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، ويعني أيضاً أن الكتاب سابق على كتابات الفارابي، بل وجميع المؤلفات السياسية الكبرى بنحو قرن من الزمان.
ينطلق ابن أبي الربيع في تنظيره السياسي من النظام القيمي الإسلامي؛ أي مجموعة المثاليات والقواعد الأخلاقية الإسلامية التي تنظم السلوكيات الفردية والجمعية، وتضع الإطار النظري الحاكم للدولة والمؤسسات العامة، ولا تنفرد الحضارة الإسلامية بهذا، فكل حضارة لها نظامها القيمي، وعلى سبيل المثال تعد الحرية القيمة الكبرى في الحضارة الغربية، وقد انعكس هذا على النظام السياسي الغربي، أما الحضارة الإسلامية فتعد العدالة القيمة العليا فيها وهي تنبع من قوله جل شأنه: (وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ) (الشورى: 15)، تتبعها قيم أخرى تابعة مثل الأمن أو الطمأنينة.
استوعب ابن أبي الربيع مركزية فكرة العدالة في المخيال الإسلامي وأفلح في صياغة تصور يعبر عن خصائص النظام السياسي ووظائف الدولة خلاله انطلاقاً من قيمة العدل، إذ يذهب إلى أن أركان المملكة (الدولة) أربعة، وهي: المُلك، والرعية، والعدل، والتدبير؛ ويقصد به التخطيط المستقبلي.
وأول هذه الأركان هي المُلك، وهو شخص الحاكم على السلطة، ولكنه كما يقدمه لا يمثل السلطوية السياسية أو الاستبداد، إنما هو شخص يتسم بالحكمة ويمارس الشورى ويتصف بالفضائل المعنوية والكمالات الفكرية كما يبدو في عباراته.
والثاني الرعية، وهو لا يتبنى التقسيم الثلاثي الشائع (الحاكم، العلماء، العامة)، وإنما يتبنى تقسيماً أكثر تركيباً؛ إذ يقول: إن أصناف الرعية كثر، ويذكر منهم 7 أصناف، وهم: المتأهلون أي الزهاد؛ وهم في الرتبة العليا، ثم الحكماء (علماء الطبيعة والهندسة والطب..)، ثم العلماء الشرعيون، ثم ذوو أنساب؛ أي الأشراف وأهل الجاه، ثم أرباب الحروب، وعمار السوق من الصناع والأتباع؛ «وبهم تتم أمور الناس وينالون حوائجهم من قرب»، وأخيراً سكان القرى الذين هم عماد الحرث والنسل والزرع والغرس وباقي الناس محتاج إليهم.
وهنا يلاحظ غياب النظرة السلبية للطوائف الحرفية -كما نجد في العصور المتأخرة- بل نلحظ التقدير والإجلال لمن هم عماد العمران الحضاري، ويلاحظ أيضاً تأخر طبقة الجند إلى ما بعد العلماء الطبيعيين والشرعيين.
والثالث: العدالة، وهي صفة تتخلل مفاصل النظرية السياسية والممارسة السياسية للحاكم، وفي هذا الصدد يمكن أن نتحدث عن مسألتين تبدو فيهما العدالة جلية ناصعة.
أولاهما: القواعد الحاكمة للتعامل بين الحاكم والرعية من جهة، والرعية والحاكم من جهة أخرى، ويبدو من خلالها كيف يتم دمج العدل في الممارسة السياسية للحاكم والمحكوم، ويذهب ابن أبي الربيع إلى أنه يجب على الحاكم أن يراعي في تعامله مع الرعية هذه الأمور التي تضمن صلاحها:
- باستعمالهم في صناعتهم حتى لا يجدوا فراغاً لفكر في مفسدة، بالأخذ للضعفاء من الأقوياء ويساوي الأدنين (القريبين) والبعيدين في السياسة.
- ترك التعرض للمظلوم وإنصافه من الظالم.
- أن يجلس إليهم في كل وقت لشكوى أو وصف حال أو لشكوى.
- أن يؤمنوا من الأعداء بتأمين الثغور وإحكامها.
- وليحرسهم من قطاع الطريق لئلا ينقطع معاشهم بانقطاع سيرهم.
- وليؤمنهم من اللصوص في منازلهم لتكون الثغور مصونة والطرق آمنة وأيدي الأشرار مقبوضة.
ويفترض ابن أبي الربيع أن الإخلال بهذه الأمور ينتقل بالرعية من الصلاح إلى الفساد، والذي يستلفت النظر أنه جعل من تأمين سبل المعاش للناس الأمر الأول الذي يجب أن يكفله الحاكم للرعية.
وعلى الجهة المقابلة، فإن على الرعية ألا يدعو أمر النصيحة للحاكم، وليجتهدوا في تحسين العدل عنده وتقبيح الجور وهذه لخواصهم دون عوامهم، وإن عرض لهم مكروه من خواصه فلا يتعرضوا له دون رفع الأمر للحاكم.
وفي هذه الطائفة من الحقوق والواجبات المتبادلة تبرز قيمة العدل جلية بحيث تبدو هي القيمة العليا، وهي ليست قاصرة على الحاكم، وإنما تتعدى إلى المحكوم، كما نجد حضوراً للأمن والشورى وتلبية لمطالب المعاش واحتراماً لها.
وثانيتهما: في كيفية تضمين العدل كأحد عناصر النظام السياسي، يعرف ابن الربيع العدل بقوله: «هو حكم الله تعالى في أرضه»، ويستدل على منزلته بإطباق الأمم عليه مع اختلاف مذاهبهم فليس منهم إلا من يوصي به ويعرف فضله، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حق لله تعالى، وحق الناس على بعضها، وحق أسلافهم، وأساس تدبير المملكة أو التخطيط لها يعتمد على عمارة البلدان، وهي على قسمين مزارع (قرى) وأمطار (مدن).
فأما المزارع فهي أصول المواد التي يقوم بها أود الخلق ويلزم الحاكم في التخطيط المستقبلي لها 3 أمور:
1- القيام بأمور المياه لينتفع بها القريب والبعيد.
2- كف الأذى عنها لئلا يشتغل أهلها بغير الزراعة.
3- تقدير ما يؤخذ منهم من ضرائب بحكم الشرع بلا عسف أو جور.
وأما الأمصار الجامعة التي يسكنها أهلها فهي بحاجة إلى 5 أمور:
1- أن يستوطنها أهلها طلباً للدعة والهدوء.
2- حفظ الأموال فيها من الاستهلاك.
3- صيانة الحريم والخدم من الانتهاك
4- التماس ما تدعو الحاجة إليه من متاع وغيره
5- لا يتعرض للكسب وطلب المادة.
وفي هذه القائمة من عناصر السياسة العمرانية نلحظ أيضاً محورية العدل ممثلاً في عدالة توزيع موارد المياه، وعدم التعرض للأموال، وتقدير الضرائب بالشرع، كما يحضر الأمن والطمأنينة وحماية الأموال والأعراض وكلها تتضافر وتندمج في بنية التخطيط السياسي والعمراني.
وبالجملة، برهن ابن أبي الربيع في كتابه على إمكانية الدمج بين الأخلاق والسياسة؛ سواء على مستوى التخطيط والتنظير، أو على مستوى الممارسة السياسية.