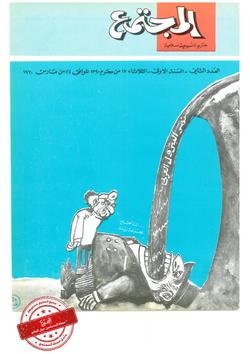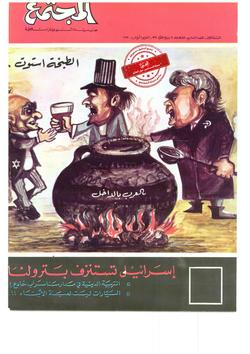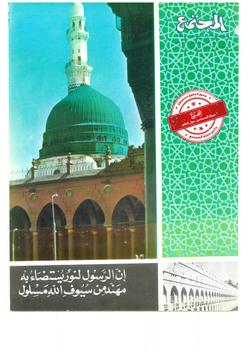العنوان الدين كما فهمه جنبلاط والدين كمَا أنزل
الكاتب الأستاذ محمد الحانوتي
تاريخ النشر الثلاثاء 30-يونيو-1970
مشاهدات 887
نشر في العدد 16
نشر في الصفحة 18
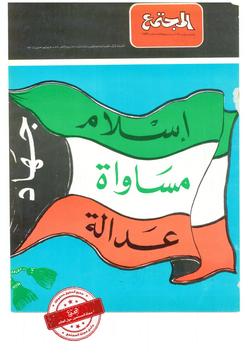
الثلاثاء 30-يونيو-1970
حَولَ محَاضَرة جنبلاط في الكوَيت
الدين كما فهمه جنبلاط والدين كمَا أنزل
للأستاذ: محمَد الحَانوتي
جنبلاط يحاضر:
ألقى الأستاذ جنبلاط محاضرة في الثالث عشر من الشهر الحالي في فندق هيلتون، وقد جاء في محاضرته بعض الغمزات للدين، وكان ذلك ناتجًا عن جهل الأستاذ الفاضح بحقيقة هذا الدين ومعناه وطبيعته.
لحن في القراءة
فهو إذا قرأ آية لم يعـرف كيف يقرأها، فمثلًا قرأ آية على الوجه التالي «ادفع بالَّتي هي أحسن لا تستوي الحسنة ولا السيئة.. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم!»، والصحيح: ﴿وَلَا تَسۡتَوِي ٱلۡحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُۚ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ﴾ (فصلت: 34).
وقرأ آية أخرى على الوجه التالي: «لا يبدل الله ما في قوم إلا إذا بدلوا ما في أنفسهم»، وأصل الآية: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ﴾. (الرعد: آية 11).
تفسير خاطئ:
وحتى إذا ما قرأ آية بصورةٍ صحيحة، فإنه لا يعرف معناها فيستشهد بها استشهادًا مريبًا، ومثال ذلك استشهاده بالآية ﴿ وَخَلَقۡنَٰكُمۡ أَزۡوَٰجٗا﴾. (النبأ: 8). فهو يقول: «أي أزواجًا من التناقضات المتكاملة في وحدات الوجود المشخصة في صوره»، ولعل الأستاذ أحد المفسرين العصريين للقرآن وتفسيره متطوّر، ولكن ألا ينبغي بالمفسِّر أن يكون مجيدًا للعربية، لا أن يقع في اللحن كثيرًا كما حصل له، وأن يكون حافظًا للقرآن، لا أن يعسر عليه نقل آية أو آيتين نقلًا صحيحًا كما جرى له، ومعنى الأزواج كما في التفاسير هو الأصناف والأنواع والأجناس والألوان، فأين هذا المعنى من ذاك؟!
كلام غامض
ولم أرد أن أستعرض محاضرة الأستاذ، لأنني موقن أن أحدًا من الجالسين لم يفهم ما جاء فيها، وذلك لأحد أمرين: إما سمـو الأستاذ الفكري والثقافي، فهو يتكلَّم بلغة ليست لغة الجماهير، أو أن الأستاذ قد تكلَّم بلغة طائفة من أهل الشِعر الحرّ، فهم يجمعون الكلمات من هنا وهناك من غير إدراكٍ لمعنى أو هدف لفكرة، ثم تصبح قصيدة، ومن يدري لعل الأستاذ أراد أن تكون محاضرته قصيدة حرّة حول الاشتراكية.. إلخ.
الذي يهمنا في هذا الرد عليه، هو ذكره للدين ذكرًا خاطئًا حسب سجيته -بالنسبة إلى آرائه الدينية في المحاضرة- فنورد في هذا المقال مفهوم الدين لدى العرب قبل الإسلام، ثم بعده موضحًا أن الأستاذ لا بد أن يكون فهم الدين فهمًا مترجمًا.
لِمَ تقولون ما لا تفعلون؟
وعجيب أنه يدعو الشباب إلى المعرفة الشاملة وينسى هو نفسه، فلا يعرف عن الإسلام شيئًا مذكورًا، وبالطبع إذا كان جاهلًا بالإسلام فإنه سيصفق لكل مذهبً ملفق، وبهرجة غربية أو شرقية، وعذره في ذلك أنه: ﴿ذَٰلِكَ مَبۡلَغُهُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِۚ﴾ (النجم: 30).
وكم كان يسرنا لو أن الأستاذ كان دارسًا للإسلام، ثم أعطى نظرة مقارنة لنلتمس له العذر ولنجد فيه محاولة الباحث، ولكن! فهو يقول عن الدين: «إنه ظاهرة اجتماعية وفكرية تنبع من طاقة العقل وقدرته على التعبير الرمزي وخَلْق النظام العام المتمثّل بالأخلاق على هذا الصعيد والمتمم المكمِّل لنظام القوانين على صعيد الدولة».
ثم يقول: «فلا بد إذن من أن تتطوّر هذه المدركات والتصوّرات الدينية وَفْق تطوّرات المعرفة العقلية ومفاهيم الاختبار العلمي ونظرياته الثقافية، ولا بد من انحسار تصوّرات العقائد الدينية في نطاقٍ خاص معين».
الدين في اللغة
وردت كلمة الدين في كلام العرب بمعانٍ كثيرة «كما في مقاييس اللغة لابن فارس ولسان العرب لابن منظور».
وهذه المعاني هي:
1- القهر والسُّلطة والحكم والأمر، والإكراه على الطاعة، واستخدام القوة القاهرة فوقه، وجعله عبدًا، ومطيعًا.
2- الإطاعة والعبودية والخدمة والتسخر لأحد، والائتمار بأمر أحد، وقبول الذلة والخضوع تحت غلبته وقهره.
3- الشروع والقانون والطريقة والمذهب والملة والعادة والتقليد.
4- الجزاء والمكافأة والقضاء والحساب.
الدين والقرآن:
هذه المعاني الأربعة هي القائمة في الذهن العربي حول كلمة «الدين»، ثم جاء القرآن فأحلها في مكانها واصطنعها مصطلحـًـا له مخصوصًا. لذا فأنت ترى أن كلمة الدين في القرآن تقوم مقام نظامٍ بأكمله يتركَّب من أجزاءٍ أربعة هي:
1- الحاكمية والسُّلطة العليا.
2- الإطاعة والإذعان لتلك الحاكمية والسُّلطة.
3- النظام الفكري والعملي المتكوّن تحت سلطان تلك الحاكمية.
4- المكافأة التي تكافئها السُّلطة العليا على اتباع ذلك النظام والإخلاص له أو على التمرُّد عليه والعصيان له.
ويطلق القرآن كلمة «الدين» على أحد هذه المعاني تارة، وأحيانًا يريد بها المعاني الأربعة التي تدل على النظام الكامل وما يتبعه من أمور.
فالآيات الكريمة التالية تعني بالدين المعنيين الأول والثاني:
﴿هُوَ ٱلۡحَيُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدۡعُوهُ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَۗ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ (غافر: آية 65).
﴿قُلۡ إِنِّيٓ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ﴾ (الزمر: 11).
﴿قُلِ ٱللَّهَ أَعۡبُدُ مُخۡلِصٗا لَّهُۥ دِينِي﴾ (الزمر: 14).
﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ. أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُۚ﴾ (الزمر: 2-3).
﴿وَلَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًاۚ﴾ (النحل: آية 52).
﴿أَفَغَيۡرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبۡغُونَ وَلَهُۥٓ أَسۡلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ طَوۡعٗا وَكَرۡهٗا وَإِلَيۡهِ يُرۡجَعُونَ﴾ (آل عمران: 83).
﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ﴾ (البيّنة: 5).
ففي جميع هذه الآيات وردت كلمة «الدين» بمعنى السُّلطة العليا، ثم الإذعان لتلك السُّلطة وقبول إطاعتها وعبديتها، والمراد بإخلاص الدين لله ألا يُسلم المرء لأحدٍ من دون الله بالحاكمية والحكم والأمر، ويخلص إطاعته وعبديته لله تعالی إخلاصًا لا يتعيَّن بعده لغير الله ولا يطيعه إطاعة مستقلة بذاتها.
الدين والقانون والفكر
· أما المعنى الثالث «النظام الفكري والعملي» ففي قوله تعالى:
﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي شَكّٖ مِّن دِينِي فَلَآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِنۡ أَعۡبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّىٰكُمۡۖ وَأُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ. وَأَنۡ أَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ (يونس: 104 - 105).
﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ﴾ (يوسف: 40).
﴿فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗاۚ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ﴾ )الروم: 30).
﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ﴾ (النور: 2).
﴿كَذَٰلِكَ كِدۡنَا لِيُوسُفَۖ مَا كَانَ لِيَأۡخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلۡمَلِكِ﴾ (يوسف: 76).
﴿وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٖ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ قَتۡلَ أَوۡلَٰدِهِمۡ شُرَكَآؤُهُمۡ لِيُرۡدُوهُمۡ وَلِيَلۡبِسُواْ عَلَيۡهِمۡ دِينَهُمۡۖ﴾ (الأنعام: 137).
﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾ (الشورى: 21).
﴿لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِيَ دِينِ﴾ (الكافرون: 6).
والمراد بالدين في جميع هذه الآيات هو القانون والحدود والشرع والطريقة والنظام الفكري والعملي، الذي يتقيّد به الإنسان. فإن كانت السُّلطة التي يستند إليها المرء لاتباعه قانونًا من القوانين أو نظامًا من النظم سلطة الله تعالى، فالمرء لا شك في دين الله عز وجل. وأما إن كانت تلك السُّلطة سلطة ملك من الملوك فالمرء في دين الملك، وإن كانت سلطة شيخ من المشايخ أو قس من القسس فهو في دين ذلك الشيخ أو ذلك القسيس.
· أما المعنى الرابع، ففي قوله تعالى:
﴿وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَٰقِعٞ﴾ (الذاريات: 6).
﴿أَرَءَيۡتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ﴾ (الماعون: 1).
﴿وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ ١٧ ثُمَّ مَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ ١٨ يَوۡمَ لَا تَمۡلِكُ نَفۡسٞ لِّنَفۡسٖ شَيۡٔٗاۖ وَٱلۡأَمۡرُ يَوۡمَئِذٖ لِّلَّهِ﴾ (الانفطار: 17 - 19).
فكلمة الدين وردت بمعنى المحاسبة والقضاء والمكافأة.
الدين في الشرائع السابقة
ثم الأديان جميعًا جاءت لتطبق وتكون منهاج حياة شامل، سواء منها اليهودية أو المسيحية حسبما جاء في قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ﴾ (النساء: 64).
التوراة
فالتوراة جاءت عقيدة وشريعة، وكُلِّفَ أهلها أن يتحاكموا إليها في كل شؤون حياتهم، لا أن يجعلوها مواعظ تهذيبيَّة لا تتجاوز وجدانهم، ولا شعائر تعبدية يقيمونها في هياكلهم.
﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيۡهِ شُهَدَآءَۚ فَلَا تَخۡشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلَا تَشۡتَرُواْ بَِٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗاۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ. وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ (المائدة: 44 - 45).
وهذا الذي ذكره القرآن من شريعة التوراة مثل لكثير مما تحتويه، والذي نظَّم به موسى -عليه السلام- ومن بعده أنبياء بني إسرائيل حياتهم الواقعية عدّة قرون.
الإنجيل
ثم جاء المسيح عليه السلام مصدقًا لشريعة التوراة..
﴿وَقَفَّيۡنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِۖ وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡإِنجِيلَ فِيهِ هُدٗى وَنُورٞ وَمُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَهُدٗى وَمَوۡعِظَةٗ لِّلۡمُتَّقِينَ ٤٦ وَلۡيَحۡكُمۡ أَهۡلُ ٱلۡإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾ (المائدة: 46 - 47).
ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام، لا ينقض الشرائع السماوية الصحيحة قبله، ولكن يصدقها، ويهيمن عليها بما أنه الرسالة الأخيرة الشاملة للبشرية كافة.
﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن لِّيَبۡلُوَكُمۡ فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ٤٨ وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩ أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ﴾ (المائدة: 48 - 50).
﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِۚ﴾ (البقرة: 213).
فهل كان الدين ظاهرة اجتماعية، أو مجرد عقيدة؟
الخضوع للدين في كل شئون الحياة؟
وكيف يكون الإنسان خاضعًا لربه في ناحية، ثم يكون خاضعًا لسلطانٍ آخر في نشـاطاته الأخرى؟ وهذا ما يؤدِّي به إلى انفصام الشخصية «الشيزوفرينيا» كما هو شأن الكثيرين المصابين بهذا الداء العضال في جيلنا المعاصر.
وختامًا لا يسعنا إلا أن نستوحي من محاضرة الأستاذ فكرته القائلة: «إن فهم الروح التي أملت على ماركس وأنجلز ما كتب أهم بكثير من الإطلاع التفصيلي على كتاباتهما ومحاولاتهما في التحليل». فنقول إن معرفة الأمور المحيطة بحياة الأستاذ ومعتقداته هي الجديرة بالبحث، أما المحاضرة فلا أظن أحدًا يستطيع أن يفهمها.
ولا جنبلاط نفسه !
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل